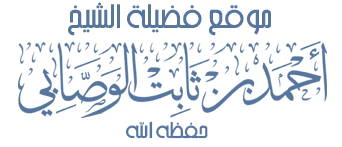سلسلة الفوائد اليومية المنتقاة
انتقاها وألفها الشيخ
أحمد بن ثابت الوصابي

152- الأحاديث التي جمعت آدَابَ الْخَيْرِ أربعة
سلسة الفوائد اليومية:
152- الأحاديث التي جمعت آدَابَ الْخَيْرِ أربعة
** قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه: جامع العلوم والحكم (1/ 388) عند شرحه لحديث «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»:
** وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْأَدَبِ،
** وَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الصَّلَاحِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ إِمَامِ الْمَالِكِيَّةِ فِي زَمَانِهِ أَنَّهُ قَالَ:
جِمَاعُ آدَابِ الْخَيْرِ وَأَزِمَّتُهُ تَتَفَرَّعُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ:
- قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»
- وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»
- وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي اخْتَصَرَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ: «لَا تَغْضَبْ»
- وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 25 / 4 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
151- أربعة أمور تعصم العبد من الشيطان وتحرم جسده على النيران
سلسة الفوائد اليومية:
151- أربعة أمور تعصم العبد من الشيطان وتحرم جسده على النيران
151- أربعة أمور تعصم العبد من الشيطان وتحرم جسده على النيران
** قال الحافظ ابن رجب في كتابه: جامع العلوم والحكم (1/ 368):
** وَقَالَ الْحَسَنُ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ عَصَمَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَحَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ:
** مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ.
** وَهَذِهِ الْأَرْبَعُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَسَنُ هِيَ مَبْدَأُ الشَّرِّ كُلِّهِ،
** فَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِي الشَّيْءِ هِيَ مَيْلُ النَّفْسِ إِلَيْهِ لِاعْتِقَادِ نَفْعِهِ،
** فَمَنْ حَصَلَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي شَيْءٍ، حَمَلَتْهُ تِلْكَ الرَّغْبَةُ عَلَى طَلَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يَظُنُّهُ مُوَصِّلًا إِلَيْهِ؛ وَقَدْ يَكُونُ كَثِيرٌ مِنْهَا مُحَرَّمًا؛ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمَرْغُوبُ فِيهِ مُحَرَّمًا.
** وَالرَّهْبَةُ: هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الشَّيْءِ، وَإِذَا خَافَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَيْءٍ تَسَبَّبَ فِي دَفْعِهِ عَنْهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ يَظُنُّهُ دَافِعًا لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ كَثِيرٌ مِنْهَا مُحَرَّمًا.
** وَالشَّهْوَةُ: هِيَ مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى مَا يُلَائِمُهَا، وَتَلْتَذُّ بِهِ، وَقَدْ تَمِيلُ كَثِيرًا إِلَى مَا هُوَ مُحَرَّمٌ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَإِلَى الْكُفْرِ وَالسِّحْرِ وَالنِّفَاقِ وَالْبِدَعِ.
** وَالْغَضَبُ: هُوَ غَلَيَانُ دَمِ الْقَلْبِ طَلَبًا لِدَفْعِ الْمُؤْذِي عِنْدَ خَشْيَةِ وُقُوعِهِ، أَوْ طَلَبًا لِلِانْتِقَامِ مِمَّنْ حَصَلَ لَهُ مِنْهُ الْأَذَى بَعْدَ وُقُوعِهِ، وَيَنْشَأُ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَأَنْوَاعِ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَقْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْقَذْفِ وَالسَّبِّ وَالْفُحْشِ، وَرُبَّمَا ارْتَقَى إِلَى دَرَجَةِ الْكُفْرِ، كَمَا جَرَى لِجَبَلَةَ بْنِ الْأَيْهَمِ، وَكَالْأَيْمَانِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْتِزَامُهَا شَرْعًا، وَكَطَلَاقِ الزَّوْجَةِ الَّذِي يُعْقِبُ النَّدَمَ.
** وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ تَكُونَ شَهْوَتُهُ مَقْصُورَةً عَلَى طَلَبِ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ، وَرُبَّمَا تَنَاوَلَهَا بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ، فَأُثِيبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يَكُونَ غَضَبُهُ دَفْعًا لِلْأَذَى فِي الدِّينِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَانْتِقَامًا مِمَّنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ – وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ}.
** وَهَذِهِ كَانَتْ حَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ إِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّهِ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَضْرِبْ بِيَدِهِ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اهـ المراد
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 24 / 4 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
150- مراتب تأليف الْكَلَام
سلسة الفوائد اليومية:
150- مراتب تأليف الْكَلَام
** قال أبو البقاء الحنفي أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي،
(المتوفى: 1094هـ) في كتابه:(الكليات),معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(ص: 288)
** ومراتب تأليف الْكَلَام خمس:
** الأولى: ضم الْحُرُوف المبسوطة بَعْضهَا إِلَى بعض لتَحْصِيل الْكَلِمَات الثَّلَاث: الِاسْم وَالْفِعْل والحرف
** وَالثَّانيَة: تأليف هَذِه الْكَلِمَات بَعْضهَا إِلَى بعض لتَحْصِيل الْجمل المفيدة، وَيُقَال لَهُ: المنثور من الْكَلَام
** وَالثَّالِثَة: ضم بعض ذَلِك إِلَى بعض ضما لَهُ مباد ومقاطع ومداخل ومخارج، وَيُقَال لَهُ: المنظوم
** وَالرَّابِعَة: أَن يعْتَبر فِي أَوَاخِر الْكَلَام مَعَ ذَلِك تسجيع، وَيُقَال لَهُ: المسجع
** وَالْخَامِسَة: أَن يَجْعَل لَهُ مَعَ ذَلِك وزن، وَيُقَال لَهُ: الشّعْر
** والمنظوم: إِمَّا محاورة , وَيُقَال لَهُ الخطابة , وَإِمَّا مُكَاتبَة وَيُقَال لَهُ: الرسَالَة
** فأنواع الْكَلَام لَا تخرج عَن هَذِه الْأَقْسَام
** وَأما أَجنَاس الْكَلَام فَهِيَ مُخْتَلفَة , ومراتبها فِي دَرَجَات الْبَيَان مُتَفَاوِتَة،
** فَمِنْهَا : البليغ الرصين الجزل،
** وَمِنْهَا : الفصيح الْقَرِيب السهل؛
** وَمِنْهَا : الْجَائِز الطلق الرُّسُل،
** وَالْأول : أَعْلَاهَا ، وَالثَّانِي : أوسطها , وَالثَّالِث : أدناها وأقربها .
** (وَقد حازت بلاغات الْقُرْآن من كل قسم من هَذِه الْأَقْسَام حِصَّة، وَأخذت من كل نوع شُعْبَة)
** وَقد تُوجد الْفَضَائِل الثَّلَاث على التَّفَرُّق فِي أَنْوَاع الْكَلَام.
** فَأَما أَن تُوجد مَجْمُوعَة فِي نوع وَاحِد مِنْهُ فَلم تُوجد إِلَّا فِي كَلَام الْعَلِيم العلام .اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 4 / 4 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
149- الأصول الستة في معرفة البدعة
سلسة الفوائد اليومية:
149- الأصول الستة في معرفة البدعة
** قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه: (التلخيص المعين في شرح الأربعين), (ص: 48):
** وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: سببه ، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه.
** فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه.
** أولاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه:
** وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً .
** مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود.
مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة.
** ثانياً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس،
** فلو تعبّد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة،
** مثال ذلك: لو أن أحداً ضحى بفرس، فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
** أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز،
** ثالثاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر:
** فلو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه،
** ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة،
** بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ “.
** رابعاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية:
** فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.
** ومثاله: لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.
** خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان:
** فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.
** سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان:
** فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد.
** فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. اهـ المراد
وقد نظم هذه الأصول الستة أخونا الفاضل الشيخ أبو إبراهيم عبدالله بن مقبل الضبيبي حفظه الله في بيتين ، فقال:
ولا تخالف سنة الرسول
في واحد من ستة أصول
في سبب والجنس والمكان
والكيف والمقدار والزمان
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 1 / 4 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
148- الضرورة الشديدة إلى معرفة الرسول وشريعته الرشيدة
سلسة الفوائد اليومية:
148- الضرورة الشديدة إلى معرفة الرسول وشريعته الرشيدة
** قال الإمام ابن قيم رحمه الله في كتابه القيم: (زاد المعاد)
(1/ 68):
** فَصْلٌ:
** وَمِنْ هَاهُنَا تَعْلَمُ اضْطِّرَارَ الْعِبَادِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ، وَتَصْدِيقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ.
** فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْفَلَاحِ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا عَلَى أَيْدِي الرُّسُلِ.
** وَلَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ الطَّيِّبِ وَالْخَبِيثِ عَلَى التَّفْصِيلِ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ.
** وَلَا يُنَالُ رِضَا اللَّهِ الْبَتَّةَ إِلَّا عَلَى أَيْدِيهِمْ.
** فَالطَّيِّبُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَخْلَاقِ لَيْسَ إِلَّا هَدْيَهُمْ وَمَا جَاءُوا بِهِ.
** فَهُمُ الْمِيزَانُ الرَّاجِحُ الَّذِي عَلَى أَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ تُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَخْلَاقُ وَالْأَعْمَالُ.
** وَبِمُتَابَعَتِهِمْ يَتَمَيَّزُ أَهْلُ الْهُدَى مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ.
** فَالضَّرُورَةُ إِلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ ضَرُورَةِ الْبَدَنِ إِلَى رُوحِهِ وَالْعَيْنِ إِلَى نُورِهَا وَالرُّوحِ إِلَى حَيَاتِهَا.
** فَأَيُّ ضَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ فُرِضَتْ، فَضَرُورَةُ الْعَبْدِ وَحَاجَتُهُ إِلَى الرُّسُلِ فَوْقَهَا بِكَثِيرٍ.
** وَمَا ظَنُّكَ بِمَنْ إِذَا غَابَ عَنْكَ هَدْيُهُ وَمَا جَاءَ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَسَدَ قَلْبُكَ، وَصَارَ كَالْحُوتِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ وَوُضِعَ فِي الْمِقْلَاةِ.
** فَحَالُ الْعَبْدِ عِنْدَ مُفَارَقَةِ قَلْبِهِ لِمَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ كَهَذِهِ الْحَالِ بَلْ أَعْظَمُ، وَلَكِنْ لَا يُحِسُّ بِهَذَا إِلَّا قَلْبٌ حَيٌّ , وَ:(مَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ)
** وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الْعَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ مُعَلَّقَةً بِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ وَأَحَبَّ نَجَاتَهَا وَسَعَادَتَهَا أَنْ يَعْرِفَ مِنْ هَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَشَأْنِهِ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْجَاهِلِينَ بِهِ، وَيَدْخُلُ بِهِ فِي عِدَادِ أَتْبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ وَحِزْبِهِ.
** وَالنَّاسُ فِي هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلٍّ وَمُسْتَكْثِرٍ وَمَحْرُومٍ، وَالْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 30 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
147- ذكر بعض الأمور التي بها يستجاب الدعاء
سلسة الفوائد اليومية:
147- ذكر بعض الأمور التي بها يستجاب الدعاء
** قال الإمام ابن قيم رحمه الله في كتابه القيم: (الجواب الكافي)
(ص: 12):
** فَصْلٌ:
** وَإِذَا جَمَعَ مَعَ الدُّعَاءِ حُضُورَ الْقَلْبِ
** وَجَمْعِيَّتَهُ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ،
** وَصَادَفَ وَقْتًا مِنْ أَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ السِّتَّةِ، وَهِيَ:
(1) الثُّلُثُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ،
(2) وَعِنْدَ الْأَذَانِ،
(3) وَبَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ،
(4) وَأَدْبَارُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ،
(5) وَعِنْدَ صُعُودِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى تُقْضَى
الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ،
(6) وَآخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.
** وَصَادَفَ خُشُوعًا فِي الْقَلْبِ،
** وَانْكِسَارًا بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ،
** وَذُلًّا لَهُ، وَتَضَرُّعًا، وَرِقَّةً.
** وَاسْتَقْبَلَ الدَّاعِي الْقِبْلَةَ.
** وَكَانَ عَلَى طَهَارَةٍ.
** وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ.
** وَبَدَأَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ.
** ثُمَّ ثَنَّى بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
** ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ التَّوْبَةَ وَالِاسْتِغْفَارَ.
** ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللَّهِ، وَأَلَحَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ،
** وَتَمَلَّقَهُ وَدَعَاهُ رَغْبَةً وَرَهْبَةً.
** وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِهِ.
** وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ دُعَائِهِ صَدَقَةً،
** فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لَا يَكَادُ يُرَدُّ أَبَدًا،
** وَلَا سِيَّمَا إِنْ صَادَفَ الْأَدْعِيَةَ الَّتِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا مَظَنَّةُ الْإِجَابَةِ، أَوْ أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِلِاسْمِ الْأَعْظَمِ … ) .اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 29 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
146- ذكر بعض أسباب شرح الصدر
سلسة الفوائد اليومية:
146- ذكر بعض أسباب شرح الصدر
** قال الإمام ابن القيم رحمه الله في: (زاد المعاد ), (2/ 22):
**
** فَأَعْظَمُ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ: (التَّوْحِيدُ):، وَعَلَى حَسَبِ كَمَالِهِ وَقُوَّتِهِ وَزِيَادَتِهِ يَكُونُ انْشِرَاحُ صَدْرِ صَاحِبِهِ.
** قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ}.
** وَقَالَ تَعَالَى : {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ}.
** فَالْهُدَى وَالتَّوْحِيدُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ، وَالشِّرْكُ وَالضَّلَالُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ وَانْحِرَاجِهِ .
** وَ(مِنْهَا): النُّورُ الَّذِي يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ، وَهُوَ نُورُ الْإِيمَانِ، فَإِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيُوَسِّعُهُ وَيُفْرِحُ الْقَلْبَ. فَإِذَا فُقِدَ هَذَا النُّورُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ ضَاقَ وَحَرَجَ، وَصَارَ فِي أَضْيَقِ سِجْنٍ وَأَصْعَبِهِ.
** وَقَدْ رَوَى الترمذي فِي ” جَامِعِهِ ” عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ( «إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ. قَالُوا: وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ» ) .
** فَيُصِيبُ الْعَبْدَ مِنِ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ بِحَسَبِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا النُّورِ، وَكَذَلِكَ النُّورُ الْحِسِّيُّ، وَالظُّلْمَةُ الْحِسِّيَّةُ، هَذِهِ تَشْرَحُ الصَّدْرَ، وَهَذِهِ تُضَيِّقُهُ.
** وَ(مِنْهَا): الْعِلْمُ، فَإِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّدْرَ، وَيُوَسِّعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْيَا، وَالْجَهْلُ يُورِثُهُ الضِّيقَ وَالْحَصْرَ وَالْحَبْسَ، فَكُلَّمَا اتَّسَعَ عِلْمُ الْعَبْدِ انْشَرَحَ صَدْرُهُ وَاتَّسَعَ،
** وَلَيْسَ هَذَا لِكُلِّ عِلْمٍ، بَلْ لِلْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، فَأَهْلُهُ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَوْسَعُهُمْ قُلُوبًا، وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا، وَأَطْيَبُهُمْ عَيْشًا.
** وَ(مِنْهَا): الْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَمَحَبَّتُهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالتَّنَعُّمُ بِعِبَادَتِهِ، فَلَا شَيْءَ أَشْرَحُ لِصَدْرِ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ. حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ أَحْيَانًا: إِنْ كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنِّي إِذًا فِي عَيْشٍ طَيِّبٍ.
** وَلِلْمَحَبَّةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَطِيبِ النَّفْسِ وَنَعِيمِ الْقَلْبِ، لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ لَهُ حِسٌّ بِهِ، وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَقْوَى وَأَشَدَّ كَانَ الصَّدْرُ أَفْسَحَ وَأَشْرَحَ، وَلَا يَضِيقُ إِلَّا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَطَّالِينَ الْفَارِغِينَ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ، فَرُؤْيَتُهُمْ قَذَى عَيْنِهِ، وَمُخَالَطَتُهُمْ حُمَّى رُوحِهِ.
** (وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ): الْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ، وَالْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَمَحَبَّةُ سِوَاهُ، فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ، وَسُجِنَ قَلْبُهُ فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ،
** فَمَا فِي الْأَرْضِ أَشْقَى مِنْهُ، وَلَا أَكْسَفُ بَالًا، وَلَا أَنْكَدُ عَيْشًا، وَلَا أَتْعَبُ قَلْبًا،
** فَهُمَا مَحَبَّتَانِ: مَحَبَّةٌ هِيَ جَنَّةُ الدُّنْيَا، وَسُرُورُ النَّفْسِ، وَلَذَّةُ الْقَلْبِ، وَنَعِيمُ الرُّوحِ وَغِذَاؤُهَا وَدَوَاؤُهَا، بَلْ حَيَاتُهَا وَقُرَّةُ عَيْنِهَا، وَهِيَ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَحْدَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ، وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَيْلِ وَالْإِرَادَةِ، وَالْمَحَبَّةُ كُلُّهَا إِلَيْهِ.
** وَمَحَبَّةٌ هِيَ عَذَابُ الرُّوحِ، وَغَمُّ النَّفْسِ، وَسِجْنُ الْقَلْبِ، وَضِيقُ الصَّدْرِ، وَهِيَ سَبَبُ الْأَلَمِ وَالنَّكَدِ وَالْعَنَاءِ، وَهِيَ مَحَبَّةُ مَا سِوَاهُ سُبْحَانَهُ.
** (وَمِنْ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ): دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَفِي كُلِّ مَوْطِنٍ، فَلِلذِّكْرِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَنَعِيمِ الْقَلْبِ، وَلِلْغَفْلَةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي ضِيقِهِ وَحَبْسِهِ وَعَذَابِهِ.
** وَ(مِنْهَا): الْإِحْسَانُ إِلَى الْخَلْقِ وَنَفْعُهُمْ بِمَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالنَّفْعِ بِالْبَدَنِ وَأَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ، فَإِنَّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنَ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَطْيَبُهُمْ نَفْسًا، وَأَنْعَمُهُمْ قَلْبًا، وَالْبَخِيلُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِحْسَانٌ أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَنْكَدُهُمْ عَيْشًا، وَأَعْظَمُهُمْ همًّا وَغَمًّا.
** وَقَدْ ( «ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحِ مَثَلًا لِلْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيُنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ وَانْبَسَطَتْ حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ وَيُعْفِيَ أَثَرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا وَلَمْ تَتَّسِعْ عَلَيْهِ» )
** فَهَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَصَدِّقِ، وَانْفِسَاحِ قَلْبِهِ، وَمَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ، وَانْحِصَارِ قَلْبِهِ.
** وَ(مِنْهَا): الشَّجَاعَةُ، فَإِنَّ الشُّجَاعَ مُنْشَرِحُ الصَّدْرِ، وَاسِعُ الْبِطَانِ، مُتَّسِعُ الْقَلْبِ، وَالْجَبَانُ أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَحْصَرُهُمْ قَلْبًا، لَا فَرْحَةٌ لَهُ وَلَا سُرُورٌ، وَلَا لَذَّةٌ لَهُ، وَلَا نَعِيمٌ إِلَّا مِنْ جِنْسِ مَا لِلْحَيَوَانِ الْبَهِيمِيِّ،
** وَأَمَّا سُرُورُ الرُّوحِ وَلَذَّتُهَا وَنَعِيمُهَا وَابْتِهَاجُهَا فَمُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ جَبَانٍ، كَمَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ بَخِيلٍ، وَعَلَى كُلِّ مُعْرِضٍ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، غَافِلٍ عَنْ ذِكْرِهِ، جَاهِلٍ بِهِ وَبِأَسْمَائِهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَدِينِهِ، مُتَعَلِّقِ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ.
** وَإِنَّ هَذَا النَّعِيمَ وَالسُّرُورَ يَصِيرُ فِي الْقَبْرِ رِيَاضًا وَجَنَّةً، وَذَلِكَ الضِّيقُ وَالْحَصْرُ يَنْقَلِبُ فِي الْقَبْرِ عَذَابًا وَسِجْنًا.
** فَحَالُ الْعَبْدِ فِي الْقَبْرِ كَحَالِ الْقَلْبِ فِي الصَّدْرِ نَعِيمًا وَعَذَابًا، وَسِجْنًا وَانْطِلَاقًا،
** وَلَا عِبْرَةَ بِانْشِرَاحِ صَدْرِ هَذَا لِعَارِضٍ، وَلَا بِضِيقِ صَدْرِ هَذَا لِعَارِضٍ، فَإِنَّ الْعَوَارِضَ تَزُولُ بِزَوَالِ أَسْبَابِهَا، وَإِنَّمَا الْمُعَوَّلُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي قَامَتْ بِالْقَلْبِ تُوجِبُ انْشِرَاحَهُ وَحَبْسَهُ، فَهِيَ الْمِيزَانُ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
** وَ(مِنْهَا , بَلْ مِنْ أَعْظَمِهَا): إِخْرَاجُ دَغَلِ الْقَلْبِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي تُوجِبُ ضِيقَهُ وَعَذَابَهُ، وَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُصُولِ الْبُرْءِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَتَى الْأَسْبَابَ الَّتِي تَشْرَحُ صَدْرَهُ، وَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ الْأَوْصَافَ الْمَذْمُومَةَ مِنْ قَلْبِهِ، لَمْ يَحْظَ مِنَ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ بِطَائِلٍ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَادَّتَانِ تَعْتَوِرَانِ عَلَى قَلْبِهِ، وَهُوَ لِلْمَادَّةِ الْغَالِبَةِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا.
** وَ(مِنْهَا): تَرْكُ فُضُولِ النَّظَرِ وَالْكَلَامِ وَالِاسْتِمَاعِ وَالْمُخَالَطَةِ وَالْأَكْلِ وَالنَّوْمِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْفُضُولَ تَسْتَحِيلُ آلَامًا وَغُمُومًا وَهُمُومًا فِي الْقَلْبِ، تَحْصُرُهُ وَتَحْبِسُهُ وَتُضَيِّقُهُ وَيَتَعَذَّبُ بِهَا، بَلْ غَالِبُ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْهَا،
** فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَضْيَقَ صَدْرَ مَنْ ضَرَبَ فِي كُلِّ آفَةٍ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ بِسَهْمٍ، وَمَا أَنْكَدَ عَيْشَهُ، وَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ، وَمَا أَشَدَّ حَصْرِ قَلْبِهِ،
** وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَنْعَمَ عَيْشَ مَنْ ضَرَبَ فِي كُلِّ خَصْلَةٍ مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ بِسَهْمٍ، وَكَانَتْ هِمَّتُهُ دَائِرَةً عَلَيْهَا، حَائِمَةً حَوْلَهَا، فَلِهَذَا نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} ، وَلِذَلِكَ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}.
** وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
** وَالْمَقْصُودُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْمَلَ الْخَلْقِ فِي كُلِّ صِفَةٍ يَحْصُلُ بِهَا انْشِرَاحُ الصَّدْرِ، وَاتِّسَاعُ الْقَلْبِ، وَقُرَّةُ الْعَيْنِ، وَحَيَاةُ الرُّوحِ، فَهُوَ أَكْمَلُ الْخَلْقِ فِي هَذَا الشَّرْحِ وَالْحَيَاةِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ مَعَ مَا خُصَّ بِهِ مِنَ الشَّرْحِ الْحِسِّيِّ،
** وَأَكْمَلُ الْخَلْقِ مُتَابَعَةً لَهُ، أَكْمَلُهُمُ انْشِرَاحًا وَلَذَّةً وَقُرَّةَ عَيْنٍ، وَعَلَى حَسَبِ مُتَابَعَتِهِ يَنَالُ الْعَبْدُ مِنَ انْشِرَاحِ صَدْرِهِ وَقُرَّةِ عَيْنِهِ وَلَذَّةِ رُوحِهِ مَا يَنَالُ، فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذُرْوَةِ الْكَمَالِ مِنْ شَرْحِ الصَّدْرِ وَرَفْعِ الذِّكْرِ وَوَضْعِ الْوِزْرِ، وَلِأَتْبَاعِهِ مِنْ ذَلِكَ بِحَسَبِ نَصِيبِهِمْ مِنَ اتِّبَاعِهِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
** وَهَكَذَا لِأَتْبَاعِهِ نَصِيبٌ مِنْ حِفْظِ اللَّهِ لَهُمْ، وَعِصْمَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَدِفَاعِهِ عَنْهُمْ، وَإِعْزَازِهِ لَهُمْ، وَنَصْرِهِ لَهُمْ، بِحَسَبِ نَصِيبِهِمْ مِنَ الْمُتَابَعَةِ، فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثِرٌ.
** فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. اهـ
** (تنبيه): حديث : (إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ , …الخ )
ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة تحت رقم: (965)
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الاثنين 28 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
=============
145- من حكمة الله الحكيم تعاقب الحَرَّ والبرد لأجل مصالح العباد ومنافع البدن
سلسة الفوائد اليومية:
145- من حكمة الله الحكيم تعاقب الحَرَّ والبرد لأجل مصالح العباد ومنافع البدن
** قال الله عز وَجل {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}
** قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه: (مختصر الصواعق المرسلة),(ص: 229):
** وَتَأَمَّلِ الْحِكْمَةَ فِي تَعَاقُبِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ عَلَى هَذَا الْعَالَمِ وَتَعَاوُرِهِمَا عَلَيْهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالِاعْتِدَالِ، وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْحِكَمِ لِلْأَبْدَانِ وَالشَّجَرِ وَالْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ.
** وَلَوْلَا تَعَاقُبُهُمَا لَفَسَدَتِ الْأَبْدَانُ وَالْأَشْجَارُ وَانْتَكَسَتْ.
** ثُمَّ تَأَمَّلْ دُخُولَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِهَذَا التَّدْرِيجِ وَالتَّرَسُّلِ، فَإِنَّكَ تَرَى أَحَدَهُمَا يَنْقُصُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، وَالْآخَرُ يَزِيدُ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى يَنْتَهِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مُنْتَهَاهُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ،
** وَلَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَجْأَةً لَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالْأَبْدَانِ وَأَسْقَمَهَا، كَمَا لَوْ خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَكَانٍ شَدِيدِ الْحَرِّ إِلَى مَكَانٍ مُفْرِطٍ فِي الْبَرْدِ وَهْلَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهِ جِدًّا،
** وَلَوْلَا الْحَرُّ لَمَا نَضِجَتْ هَذِهِ الثِّمَارُ الْمُرَّةُ الْعَفِنَةُ الْقَاسِيَةُ، وَلَا كَانَتْ تَلِينُ وَتَطِيبُ وَتَحْسُنُ وَتَصْلُحُ لِأَنْ يَتَفَكَّهَ بِهَا النَّاسُ رَطْبَةً وَيَابِسَةً.
** وانظر كلاما له نحو هذا في كتابه :
(مفتاح دار السعادة) , (1/ 207 و 208)
** وقال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه: (صيد الخاطر), (ص: 106):
** فصل:
** تأملت مبالغة أرباب الدنيا في اتقاء الحر والبرد، فرأيتها تعكس المقصود في باب الحكمة، وإنما تحصل مجرد لذة، ولا خير في لذة تعقب أَلَمًا.
** فأما [في] الحر، فإنهم يشربون الماء المثلوج، وذلك على غاية في الضرر، وأهل الطب يقولون: إنه يحدث أمراضًا صعبة، يظهر أثرها في وقت الشيخوخة، ويضعون الخيوش المضاعفة.
** وفي البرد يصنعون اللبود المانعة للبرد.
** وهذا من حيث الحكمة يضاد ما وضعه الله تعالى؛ فإنه جعل الحر لتحلل الأخراط، والبرد لجمودها،
** فيجعلون هم جميع السنة ربيعًا، فتنعكس الحكمة التي وضع الحر والبرد لها، ويرجع الأذى على الأبدان.
** ولا يظنن سامع هذا أني آمره بملاقاة الحر والبرد.
** وإنما أقول له: لا يفرط في التوقي، بل يتعرض في الحر لما يحلل بعض الأخلاط إلى حد لا يؤثر في القوة، وفي البرد بأن يصيبك منه الأمر القريب لا المؤذي، فإن الحر والبرد لمصالح البدن.
** وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد أصلًا، فزاد جوفه فمات عاجلًا، وقد ذكرت قصته في كتاب لقط المنافع في علم الطب. اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 26 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
144- الترغيب في التبكير يوم الجمعة , وحرص السلف على ذلك
سلسة الفوائد اليومية:
144- الترغيب في التبكير يوم الجمعة , وحرص السلف على ذلك
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفق عليه
** وعَنْ أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني
** قال بعض السلف: أوفر الناس نصيباً يوم الجمعة من راعاها وانتظرها من الأمس .
** وأخس الناس منها نصيباً من يصبح يوم الجمعة فيقول: أيش اليوم.
** وقد كان بعضهم يبيت ليلة الجمعة في الجامع لأجل صلاة الجمعة ومنهم من كان يبيت ليلة السبت في الجامع لمزيد الجمعة .
** وكثير من السلف من كان يصلِّي الغداة يوم الجمعة في الجامع ويقعد ينتظر صلاة الجمعة لأجل البكور ليستوعب فضل الساعة الأولى ولأجل ختم القرآن .
** وعامة المؤمنين كانوا ينحرفون من صلاة الغداة في مساجدهم فيتوجهون إلى جوامعهم .
** ويقال: أوّل بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجوامع.
** وكانت الطرقات ترى يوم الجمعة سحراً وبعد صلاة الفجر مملوءَة من الناس يمشون في السرج يزدحمون فيها إلى الجامع كما ترون اليوم في الأعياد حتى درس ذلك وقل وجهل وترك .
** أولا يستحي المسلمون من اليهود والنصارى وهم يبكرون إلى البيع والكنائس يوم السبت والأحد قبل خروجهم إلى مساجدهم .
** أولا يعتبر المؤمن بطلاب الدنيا , كيف يبكرون إلى رحاب المساجد والأسواق للبيع والشراء والربح قبل غدوّه هو إلى اللَّه تعالى وإلى الآخرة .
** فينبغي للمؤمن اللبيب أن يسابقهم إلى مولاه ويسارعهم إلى ما عنده من زلفاه . اهـ بتصرف من (إحياء علوم الدين), (1/ 182) وغيره .
** وفي كتاب: (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين), (16/ 140)
** سئل فضيلة الشيخ – رحمه الله تعالى -: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟
** فأجاب فضيلته بقوله: الساعات التي ذكرها الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمس: فقال: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» .
** فقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر؛ لأن الوقت يتغير، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة.
** وتبتدئ من طلوع الشمس، وقيل: من طلوع الفجر، والأول أرجح؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر. اهـ
** وفي (تتمة أضواء البيان ) , للشيخ عطية محمد سالم (1/ 263)
** (مَسْأَلَةٌ)
** وَقْتُ السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، أَنَّ السَّعْيَ يَكُونُ بَعْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ تَرْكِ الْبَيْعِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ قَبْلَ النِّدَاءِ لَا يَلْزَمُ السَّعْيُ وَلَا تَرْكُ الْبَيْعِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنَ النَّصِّ،
** وَلَكِنْ جَاءَتْ نُصُوصٌ لِلْحَثِّ عَلَى الْبُكُورِ إِلَى الْجُمُعَةِ،
** مِنْهَا : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَكَّرَ، وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَصَلَّى مَا تَيَسَّرَ لَهُ» . الْحَدِيثَ.
** وَحَدِيثُ: «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى» إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، فَكَانَ الْبُكُورُ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِهِ،
** وَلَكِنْ وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ فِي مَبْدَأِ الْبُكُورِ، وَمَعْنَى السَّاعَةِ الْأُولَى أَيِّ سَاعَةٍ لُغَوِيَّةٍ أَوْ زَمَنِيَّةٍ، وَهَلْ هِيَ الْأُولَى مِنَ النَّهَارِ أَوِ الْأُولَى بَعْدَ الْأَذَانِ؟ ،
** فَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّ السَّاعَةَ لُغَوِيَّةٌ، وَهِيَ الْأُولَى بَعْدَ الْأَذَانِ، إِذْ لَا يَجِبُ السَّعْيُ إِلَّا بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ لَا تَكْلِيفَ بِهِ.
** وَحَمَلَ الْجُمْهُورُ السَّاعَةَ عَلَى السَّاعَةِ الزَّمَنِيَّةِ، وَأَنَّ الْأُولَى هِيَ الْأُولَى مِنَ النَّهَارِ، وَالرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِعِدَّةِ أُمُورٍ:
** أَوَّلًا: فِي لَفْظِ حَدِيثِ الْبُكُورِ ; لِأَنَّ لَفْظَ الْبُكُورِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِأَوَّلِ النَّهَارِ، وَلَا يُقَالُ لِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ بُكُورٌ، بَلْ يُسَمَّى عَشِيًّا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {بُكْرَةً وَعَشِيًّا} وَتَكْرَارُ بَكَّرَ، وَابْتَكَرَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي بُكْرَةِ النَّهَارِ وَأَوَائِلِهِ، وَكَذَلِكَ لَفْظَةُ: «مَنْ رَاحَ» لِأَنَّ الرَّوَاحَ لِأَوَّلِ النَّهَارِ.
** ثَانِيًا فِي الْحَدِيثِ: «وَصَلَّى مَا تَيَسَّرَ» ، لَهُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنْ هُنَاكَ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلصَّلَاةِ بِقَدْرِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ. أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ، فَلَا مُتَّسَعَ لِصَلَاةٍ بَعْدَ النِّدَاءِ، وَلَا سِيَّمَا فِي زَمَنِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَذَانٌ وَاحِدٌ، وَبَعْدَ النِّدَاءِ فَلَا مُتَّسَعَ لِلصَّلَاةِ.
** ثَالِثًا: مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَثَمَانِيَ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَكُونُ مَعَ السَّاعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ، وَمَا جَاءَ عِنْدَ النَّيْسَابُورِيِّ مِنْ قَوْلِهِ فِي تَفْسِيرِهِ: وَكَانَتِ الطُّرُقَاتُ فِي أَيَّامِ السَّلَفِ وَقْتَ السَّحَرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ غَاصَّةً بِالْمُبَكِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ يَمْشُونَ بِالسُّرُجِ.
** وَقِيلَ: أَوَّلُ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ تَرْكُ الْبُكُورِ إِلَى الْجُمُعَةِ،
** وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، هُوَ أَنَّ زَمَنَ السَّعْيِ لَهُ جِهَتَانِ:
** جِهَةُ وُجُوبٍ وَإِلْزَامٍ، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مَنْ كَانَ مَحَلُّهُ بَعِيدًا، بِحَيْثُ لَوِ انْتَظَرَ حَتَّى يُنَادَى لَهَا لَا يُدْرِكُهَا فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ السَّعْيُ إِلَيْهَا قَبْلَ النِّدَاءِ اتِّفَاقًا ; لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أداءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِذَلِكَ.
وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ مِنْ ظَاهِرِ النَّصِّ الْمُتَقَدِّمِ.
** الْجِهَةُ الثَّانِيَةُ: جِهَةُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ، وَهَذَا لَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَنٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ ظُرُوفِ الشَّخْصِ، فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنَ الْبُكُورِ، وَلَمْ يَتَعَطَّلْ بِبُكُورِهِ مَا هُوَ أَلْزَمُ مِنْهُ، فَيُنْدَبُ لَهُ الْبُكُورُ، وَبِحَسَبِ مَا يَكُونُ بُكُورُهُ فِي السَّاعَاتِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ يَكُونُ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى أَمْرَانِ:
** الْأَوَّلُ: حَدِيثُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ طَوَتِ الصُّحُفَ وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، فَكِتَابَةُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، تَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الْأَوَّلِيَّةِ قَبْلَ النِّدَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ.
** الْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّنَا وَجَدْنَا لِكُلِّ وَاجِبٍ مَنْدُوبًا وَالسَّعْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ عِنْدَ النِّدَاءِ وَاجِبٌ، فَيَكُونُ لَهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ السَّعْيُ قَبْلَ النِّدَاءِ، فَكَمَا لِلصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ، فَكَذَلِكَ لِلسَّعْيِ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ، فَوَاجِبُهُ بَعْدَ النِّدَاءِ، وَمَنْدُوبُهُ قَبْلَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. اهـ
** (تنبيه):
** التبكير يكون في حق غير الإمام , أما هو فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين .
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 24 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
143- المخلوقات بالنسبة لوجود الشر والخير فيها على ثلاثة أقسام
سلسة الفوائد اليومية:
143- المخلوقات بالنسبة لوجود الشر والخير فيها على ثلاثة أقسام
** قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه: (القول المفيد على كتاب التوحيد), (1/ 253):
** قوله: “من شر ما خلق”:
** أي: من شر الذي خلق، لأن الله خلق كل شيء: الخير والشر،
** ولكن الشر لا ينسب إليه، لأنه خلق الشر لحكمة، فعاد بهذه الحكمة خيرا، فكان خيرا.
** وعلى هذا نقول: الشر ليس في فعل الله، بل في مفعولاته، أي: مخلوقاته.
** وعلى هذا تكون “ما” موصولة لا غير، أي: من شر الذي خلق، لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت: من شر خلقك، لكان الخلق هنا مصدرا يجوز أن يراد به الفعل، ويجوز أيضا المفعول، لكن لو جعلتها اسما موصولا تعين أن يكون المراد بها المفعول، وهو المخلوق.
** وليس كل ما خلق الله فيه شر، لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر، لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
1. شر محض، كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله من أجلها، فهي خير.
2. خير محض كالجنة، والرسل، والملائكة.
3. فيه شر وخير، كالإنس، والجن، والحيوان.
** وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 23 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
142- أهل السنة يأمرون بالاتباع وينهون عن الابتداع , وليس عن ذكر الله كما يزعم بعض الملبسين
سلسة الفوائد اليومية:
142- أهل السنة يأمرون بالاتباع وينهون عن الابتداع , وليس عن ذكر الله كما يزعم بعض الملبسين
** قال الله سبحانه وتعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} [الأعراف: 3]
** تفسير القرطبي (7/ 161)
** قَوْلُهُ تَعَالَى: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) يَعْنِي الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:” وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا “.
** وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: هَذَا أَمْرٌ يَعُمُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتَهُ.
** وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَمْرٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ دُونَهُ. أَيِ اتَّبِعُوا مِلَّةَ الْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنَ، وَأَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَامْتَثِلُوا أَمْرَهُ، وَاجْتَنِبُوا نَهْيَهُ.
** وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى تَرْكِ اتِّبَاعِ الْآرَاءِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ. اهـ
** وعَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ – رضى الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : ( . . . إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ” ) رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني .
** وعَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ». متفق عليه
** وفي رواية لمسلم عنها – رضى الله عنها – قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»
** قال الإمام النووي في شرحه على مسلم (12/ 16):
** قَالَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ: الرَّدُّ هُنَا بِمَعْنَى الْمَرْدُودِ , وَمَعْنَاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ .
** وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ , وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ كُلِّ الْبِدَعِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ .
** وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ زِيَادَةٌ , وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ يُعَانِدُ بَعْضُ الْفَاعِلِينَ فِي بِدْعَةٍ سُبِقَ إِلَيْهَا , فَإِذَا احْتُجَّ عَلَيْهِ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى يَقُولُ : أَنَا مَا أَحْدَثْتُ شَيْئًا , فَيُحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِرَدِّ كُلِّ الْمُحْدَثَاتِ سَوَاءٌ أَحْدَثَهَا الْفَاعِلُ أَوْ سُبِقَ بِإِحْدَاثِهَا . . .
** وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي ابطال المنكرات واشاعة الاستدلال به. اهـ
** وفي كتاب: (الاعتصام) , للشاطبي (1/ 64)
** قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: ” مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً، زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]
** فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. اهـ
** قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه: (إرواء الغليل),(2/236):
** (فائدة) : روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين , يكثر فيها الركوع والسجود , فنهاه , فقال: يا أبا محمد! يعذبني الله على الصلاة؟ ! قال: لا , ولكن يعذبك على خلاف السنة.
** وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ,
** وهو سلاح قوى على المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكر وصلاة , ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم , ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة! !
** وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. اهـ
** قال الحافظ العلامة قدوة المحدثين أبو بكر عبد الله ابن الحافظ الكبير أبي داود سليمان بن الأشعث ابن اسحاق الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى في حائيته:
1- تَمَسَّكْ بِحَبْلِ الله وَاتَّبِعِ الْهُدَى
وَلَا تَكُ بِدْعِيًّا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ
2- وَدِنْ بِكِتَابِ الله وَالسُّنَنِ الَّتِي
أَتَتْ عَنْ رَسُولِ الله تَنْجُو وَتَرْبَحُ
…………………………. ………………………….
19- وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ
ولا تَكُ طَعَّانًا تَعِيبُ وَتَجْرَحُ
20- فَقَدْ نَطَقَ الْوَحْيُ المبِينُ بِفَضْلِهِمْ
وَفِي الْفَتْحِ آيٌ للصَّحَابَةِ تَمْدَحُ
…………………………. …………………………
31- وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرِّجَالِ وَقَوْلَهُمْ
فَقَوْلُ رَسُولِ الله أَزْكَى وَأَشْرَحُ
32- وَلَا تَكُ مِنْ قَوْمٍ تَلَهَّوْا بِدِينِهِمْ
فَتَطْعَنَ فِي أَهْلِ الحدِيثِ وَتَقْدَحُ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 22 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
141- العلوم أربعة
سلسة الفوائد اليومية:
141- العلوم أربعة
** في كتاب: (إنباه الرواة على أنباه النحاة), (1/ 381)
** وقال الأصمعيّ: قال الخليل بن أحمد: العلوم أربعة :
** فعلم له أصل وفرع،
** وعلم له أصل ولا فرع له .
** وعلم له فرع ولا أصل له .
** وعلم لا أصل له ولا فرع .
** فأما الذى له أصل وفرع : فالحساب , ليس بين أحد من المخلوقين فيه خلاف،
** وأما الذى له أصل ولا فرع له : فالنجوم, ليس لها حقيقة يبلغ تأثيرها فى العالم – يعنى الأحكام والقضايا على الحقيقة –
** وأما الذى له فرع ولا أصل له : فالطبّ , أهله منه على التجارب إلى يوم القيامة .
** والعلم الذى لا أصل له ولا فرع : فالجدل .
** قال أبو بكر الصّولى: يعنى الجدل بالباطل. اهـ
** (فائدة أخرى):
** وقال بعض السلف: العلوم أربعة:
الفقه للأديان،
والطب للأبدان،
والنجوم للأزمان،
والنحو للسان. اهـ
المرجع :
** (البصائر والذخائر) (1/ 101)
** (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار), (4/ 17)
** (المستطرف في كل فن مستطرف), (ص: 27)
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 16 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
=======================
140- إتحاف الإخوان بذكر بعض الأشياء التي اشتركت وافترقت فيها الجمعة والعيدان
سلسة الفوائد اليومية:
140- إتحاف الإخوان بذكر بعض الأشياء التي اشتركت وافترقت فيها الجمعة والعيدان
** قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه: (إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص: 116)
** اعلَمْ أنَّ الشَّارِعَ مِن حِكمَتِه، ومحَاسِنِ شَرعِهِ، شَرَعَ للمسلِمِينَ الاجتماعَ للصَّلَواتِ وأنوَاعِ اَلتَّعَبُّدَات. وَهُوَ:
** إما اجتماعٌ خَاص كاجتمَاعِ أَهْلِ المحالِّ المتقَارِبَةِ لجماعةِ الصَّلَواتِ الخَمسِ.
** وإِمَّا اجتمَاعٌ عَام يجتَمِعُ فيه أهلُ البَلَدِ في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ للجمعَةِ.
** وإِمَّا اجْتمَاعٌ أَعَم مِن ذَلِكَ كاجتماعِ أَهْلِ البَلَدِ رجَالهم ونِسَائهم أحرارِهِم وأَرِقَّائِهم في الأَعيَادِ.
** وإِمَّا اجتماعٌ أَعمَّ مِن ذَلِكَ كُلِّه كاجتماعِ المسلِمين مِن جَمِيعِ أَقْطَارِ الأَرضِ فِي عَرَفَةَ ومَنَاسِكِ الحجِّ.
** وفي هَذِه الاجتِمَاعَاتِ مِنَ الحِكَمِ وَالأَسْرَار ومَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ ومَصْلَحَةِ الأُمَّة مَالا يُعدُّ وَلا يُحصَرُ.
** فمنهَا: ( إِظْهَار شَعَائِرِ الدِّين وبُرُوزِهَا مُشَاهَدًا جمالها عِندَ الموافِقين والمخالِفين، . . . )
** ومِنهَا: أَنُّ حَقَائقَ هَذِهِ العِبَادَاتِ لا تَحصُلُ بِدُونِ الاجتِمَاعَاتِ المذكُورَةِ، فالحكَمُ الَّتِي شُرِعَتْ لأَجْلهَا مُتَوَقِّفَةٌ على هَذَا الاجتِمَاعِ.
** ومِنهَا: ( أَنَّ اجتِمَاعَ الخَلقِ لهَذِه العِبَادَاتِ مِن أَعظَمِ مَحبُوبَاتِ الربِّ، . . . )
** ومنهَا: ( مَا في اجتِمَاعِ المسلِمين مِن قِيَامِ اَلأُلْفَة والمودَّة؛ لأَنَّ الاجتِمَاعَ الظَّاهِرَ عِنوَانُ الاجتِمَاعِ البَاطِنِ، . . . )
** ومِنهَا: ( أَن فِي هَذِه الاجتمَاعَاتِ مِن مَعرِفَةِ مَرَاتِبِ المسلِمين، ومَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ العِلمِ والدِّينِ والأخلاقِ، والمحافَظَةِ على الشَّرائِعِ أَو غَيرِ ذَلِكَ مِن أَعظَمِ الفَوَائِدِ المميِّزةِ؛ لتحصُلَ مُعَامَلَتُهُم بحسَبِ ذَلِكَ. . . . )
** وفي الجملةِ: فِيهَا مِن صَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَا هُوَ مِنَ الضرُورَاتِ الَّتي لا بُدَّ مِنهَا.
** فَهَذِه الفَوَائِدُ وغَيرُهَا قد اشتَرَكَتْ فِيهَا.
** وبأنها مِن شُرُوطِ الدِّين وَوَاجِبَاتِه.
** وبأنها رَكعتَانِ يجهر فِيهِمَا في القِرَاءةِ.
** وبمشروعيَّة الخُطبَتين فيهمَا.
** فالَّذِي اشْتَرَكَتْ فيه أَكثَرُ ممَّا افترقت.
** واستِحبَابُ اَلتَّجَمُّل والتَّطَيُّب وتَبْكِيرُ المأمُومِ إليهِما وتأخر الإِمَامِ إِلَى وَقتِ الصَّلاةِ والاستِيطَانِ والعَدَدِ عَلَى القَولِ بِه.
** وافتَرقَتْ بِأَشْيَاء بحسَبِ أحوَالِها، وَمُنَاسَبَة الحَالِ الوَاقِعَةِ:
** فمنها: الوَقتُ: الجمعةُ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى وَقتِ العَصرِ عندَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ,
وعِندَ الإِمَامِ أَحمد مِن أَوَّلِ صَلاةِ العِيدِ إِلَى وَقتِ العَصرِ، وَوَقتُ العِيد ِ مِن ارتفَاعِ الشَّمسِ قَيدَ رُمحٍ إِلى قُبَيلَ الزَّوَالِ.
** ومِنهَا: أَنَّ صَلاةَ الجمعَةِ إِذَا فَاتَتْ لا تُقضَى بَل يُصَلُّونَ ظُهرًا،
وأَمَّا العِيدُ فتُقضَى مِنَ الغَد بِنَظِيرِ وَقتِهَا.
** والفَرقُ: أَن العِيدَ لما كَانَ لا يَتَكَرَّرُ إلاَّ بتَكَرُّرِ العَامِ وَلا يُمكِنُ تَفوِيتُ مَا في ذَلِكَ الاجتِمَاعِ مِنَ المصَالِحِ شُرِعَ قَضَاؤُه،
** وأَمَّا الجُمعَةُ فتتكرَّرُ بالأُسبُوعِ، فإذَا فَاتَ أسبوعٌ حَصَلَ المقصُودُ بِالآخَرِ،
** مَعَ حِكمَةٍ أُخرَى وَهِيَ أَنَّ العِيدَ كَثِيرًا مَا يُعذَرُ النَّاسُ بفَوَاتِه؛ لتعلُّقِه بالأَهِلَّة بِخِلافِ الجمعَةِ.
** ومِنهَا: أَنَّ الجمعَة الخُطبَتانِ قَبَلَهَا والعِيدَينِ بعدَهُما،
** وقد ذكر الحِكمَة في ذَلِكَ أَنَّهمَا في العِيدِ سُنَّةٌ، وفي الجمعَةِ شَرط لازِمٌ، فاهتَمّ بتَقدِيمه
** وهَذَا أَيضًا فَرق آخَرُ.
** ومِنهَا: أَنَّه يُشرَعُ في صَلاةِ العِيدِ تَكبِيرَاتٌ زَوَائِد في أَوَّلِ كُلِّ ركعَةٍ في الأُولَى سِتًّا بَعدَ تَكبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وفي الثَّانِيَةِ خَمسًا بَعدَ تَكبِيرَةِ الانتِقَالِ.
** ومِنهَا: أَنَّ المشْرُوعَ أَن تَكُونَ صَلاة العِيدَين في الصَّحرَاءِ إِلا لِعُذرٍ، والجُمعَةُ المشرُوعُ أن تَكُونَ في قصَبَةِ البَلَدِ إلاَّ لِعذرٍ.
** ومِنَ الحِكمَةِ في ذَلِكَ لاشتِهَارِ العِيدِ، وزِيَادَةِ إِظهَارِه، ولاشتِرَاكِ اَلرِّجَال والنِّسَاءِ فِيهِ،
** وهَذَا أيضًا مِنَ اَلْفُرُوق بينَهُمَا.
** ولِذَلِكَ كَانَ النَّبيُّ – صلى الله عليه وسلم – يَأمُرُ النِّسَاءَ بالخُرُوجِ للعِيدِ حَتَّى يَأمُرُ ذَوَات اَلْخُدُورِ، وحتَّى يَأْمُرُ الحُيَّضَ لِيُحْضَرْنَ دَعْوةَ المسلِمين، فَإنَّ دعوتَهُم مجتمعةً أقرَبُ للإِجَابَة.
** كَما أنَّ العِبَادَةَ المشتَرَكَة أفضَلُ مِنَ اَلْمُنْفرِدَة حتَّى فُضِّلَتْ صَلاةُ الجماعَةِ عَلَى صَلاةِ الفَذِّ بِسَبعٍ وعِشرِينَ ضِعفًا.
** وهَذَا مِنَ المعَاني المشتَرَكَةِ.
** ومِنهَا: وُجُوبُ فِطْرِ يَومِ العِيدِ دُونَ الجمعَةِ، فإنَّ إِفرَادَ صَومِه مَكرُوهٌ لِكَونِ العِبَادِ أَضيافَ كَرَمِ الكَرِيمِ فِيهمَا.
** وَمِنها: أنه في العِيدِ ينبغِي أن يَخرُجَ مِن طَرِيقٍ ويَرجِعَ فِي آخَر بِخِلافِ الجمعَةِ.
** ومِنهَا: كَرَاهَةُ التنفُّلِ في مُصَلَّى العِيدِ قَبلَ الصَّلاةِ وبَعدَهَا بخِلافِ الجمعَةِ.
** ومِنهَا: أن الجمعَةَ فَرضُ عَينٍ بالإِجمَاعِ، وأمَّا العِيدَانِ ففيهمَا خِلافٌ مَعرُوفٌ، المشهُورُ مِنَ المذهَبِ أَنَّهُمَا فَرضَا كِفَايَة.
والصَّحِيحُ: أَنَّهُمَا فَرضَا عَينٍ، وَهُوَ إِحدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحمد، اختَارَهَا الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
** ومِنها: ما يتعلَّقُ بالعِيدَينِ مِن زَكَاةِ الفِطرِ والتَّكبِيرِ المطلَقِ والمقَيَّدِ ومِنَ اَلأَضَاحِيّ والهَدْي فَلا تُشَارِكُهَا الجمعَةُ فِيهَا.
** ومِنهَا: أنَّ في الجمعَةِ سَاعَة، لا يُوافِقُهَا مُسلِمٌ يَدعُو اللَّه إِلا استُجِيبَ لَهُ، ولم يَرِد مِثلُ هَذَا في العِيدَينِ.
** وكذَلِكَ: استَحبَّ العُلَمَاءُ زِيَارَةَ القُبُورِ يَومَ الجُمعَةِ دونَ العِيدَينِ؛ فالجُمعَةُ تتأكدُ فِيهَا الزِّيارَةُ والعِيدُ استحبَابٌ مطلَقٌ كسائِرِ اَلأَيَّام.
** ومِنَ الفُرُوقِ: ما قَالَهُ الأَصحَابُ: أَنَّ خطْبتِي العِيدَينِ تُستَفتَحُ الأُولَى بتِسعِ تَكبِيرَاتٍ، والثَّانِيَةُ بِسَبعٍ، بخِلافِ الجمعَةِ فإِنَّهَا تُستَفتَحُ بالحَمْدِ.
** والصَّحِيحُ: استِوَاؤهُمَا بالاستِفتَاحِ بالحمدِ كَما كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يستَفتِحُ جَمِيعَ خُطَبِه بالحمدِ. اهـ المراد
(تنبيه):
صدر هذه الفائدة قد تقدم في فائدة سابقة بعنوان: ( ذكر بعض الفوائد والحكم السامية في اجتماع الناس على العبادة الجماعية ) ؛
فلذلك ذكرته هنا مختصرا ؛
إذ الغرض هو ذكر الاتفاقات والافتراقات بين الجمعة والعيد.
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الجمعة 11 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==============
139- الجواب المختصر الشافي الكافي لمن ابتلي بداء الإصرار على المعاصي
سلسة الفوائد اليومية:
139- الجواب المختصر الشافي الكافي لمن ابتلي بداء الإصرار على المعاصي
** سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الدواء الشافي لمن تمكنت فيه أمراض الذنوب والمعاصي , فأجاب بجواب مختصر مفيد .
** وإليك نص هذا السؤال مع الجواب :
** قال محمد بن علي ، أبو عبد الله، بدر الدين البعليّ (المتوفى: 778هـ) في كتابه: (مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية),
(ص: 650):
** مَا دَوَاء من تحكم فِيهِ الدَّاء , وَمَا الاحتيال فِيمَن تسلط عَلَيْهِ الخبال , وَمَا الْعَمَل فِيمَن غلب عَلَيْهِ الكسل , وَمَا الطَّرِيق إِلَى التَّوْفِيق , وَمَا الْحِيلَة فِيمَن سطت عَلَيْهِ الْحيرَة , إِن قصد التَّوَجُّه إِلَى الله تَعَالَى مَنعه هَوَاهُ ,
وَإِن رام الادكار غلب عَلَيْهِ الافتكار , وَإِن أرد أَن يشْتَغل لم يطاوعه الْفشل ؟
غلب الْهوى فتراه فِي أوقاته
حيران صَاحٍ بل هُوَ السَّكْرَان
إِن رام قربا للحبيب تفَرقت
أَسبَابه وتواصل الهجران
هجر الْأَقَارِب والمعارف عله
يجد الْغنى وعَلى الْغناء يعان
** أجَاب رَضِي الله عَنهُ :
** دواؤه الالتجاء إِلَى الله
ودوام التضرع وَالدُّعَاء بِأَن يتَعَلَّم الْأَدْعِيَة المأثورة
** ويتوخى الدُّعَاء فِي مظان الْإِجَابَة مثل آخر اللَّيْل وأوقات الْأَذَان
** وَالْإِقَامَة وَفِي سُجُوده وَفِي أدبار الصَّلَوَات
** وَيضم إِلَى ذَلِك الاسْتِغْفَار
فَإِنَّهُ من اسْتغْفر الله ثمَّ تَابَ إِلَيْهِ متعه مَتَاعا حسنا إِلَى أجل مُسَمّى
** وليتخذ وردا من الْأَذْكَار طرفِي النَّهَار وَوقت النّوم
** وليصبر على مَا يعرض لَهُ من الْمَوَانِع والصوارف
فَإِنَّهُ لَا يلبث أَن يُؤَيّدهُ الله بِروح مِنْهُ وَيكْتب الْإِيمَان فِي قلبه
** وليحرص على إِكْمَال الْفَرَائِض من الصَّلَوَات الْخمس بباطنه وَظَاهره فَإِنَّهَا عَمُود الدّين
** وَليكن هجيراه لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا الله الْعلي الْعَظِيم؛ فَإِنَّهُ بهَا يحمل الأثقال ويكايد الْأَهْوَال وينال رفيع الْأَحْوَال
** وَلَا يسأم من الدُّعَاء والطلب فَإِن العَبْد يستجاب لَهُ مالم يعجل فَيَقُول قد دَعَوْت فَلم يستجب لي
** وليعلم أَن النَّصْر مَعَ الصَّبْر وَأَن الْفرج مَعَ لكرب وَأَن مَعَ الْعسر يسرا
** وَلم ينل أحد شَيْئا من جسيم الْخَيْر نَبِي فَمن دونه إِلَّا بِالصبرِ .
** وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين . اهـ
** (تنبيه):
** سئل ابن القيم رحمه الله تعالى بسؤال نحو هذا السؤال
فأجاب بجواب مفصل مفيد في كتاب كامل اسمه:
(الداء والدواء) أو (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي).
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الاثنين 7 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
138- مراتب طلب العلم
سلسة الفوائد اليومية:
138- مراتب طلب العلم
** قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه: (جامع بيان العلم وفضله), (1/ 476) :
** قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : «أَوَّلُ الْعِلْمِ النِّيَّةُ ثُمَّ الِاسْتِمَاعُ ثُمَّ الْفَهْمُ ثُمَّ الْحِفْظُ ثُمَّ الْعَمَلُ ثُمَّ النَّشْرُ» اهـ
** وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه: (فتح الباري), (1/ 217):
** (. . . وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ : أَوَّلُ الْعِلْمِ الِاسْتِمَاعُ , ثُمَّ الْإِنْصَاتُ , ثُمَّ الْحِفْظُ , ثُمَّ الْعَمَلُ , ثُمَّ النَّشْرُ .
** وَعَنِ الْأَصْمَعِيِّ : تَقْدِيمُ الْإِنْصَاتِ عَلَىِ الِاسْتِمَاعِ .
** وَقَدْ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ : أَخْبَرَنِي مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهَمْسٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : الْإِنْصَاتُ مِنَ الْعَيْنَيْنِ .
فَقَالَ لَهُ بن عُيَيْنَةَ : وَمَا نَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ !
قَالَ : إِذَا حَدَّثْتَ رَجُلًا فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْكَ لَمْ يَكُنْ مُنْصِتًا . انْتَهَى
** وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ . وَاللَّهُ أعلم . اهـ
** وفي زاد المعاد في هدي خير العباد (3/ 9):
** ( . . . فالْجِهَادُ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ: جِهَادُ النَّفْسِ، وَجِهَادُ الشَّيْطَانِ، وَجِهَادُ الْكُفَّارِ، وَجِهَادُ الْمُنَافِقِينَ.
** فَجِهَادُ النَّفْسِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ أَيْضًا:
** (إِحْدَاهَا): أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى تَعَلُّمِ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الَّذِي لَا فَلَاحَ لَهَا وَلَا سَعَادَةَ فِي مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَا إِلَّا بِهِ، وَمَتَى فَاتَهَا عِلْمُهُ شَقِيَتْ فِي الدَّارَيْنِ.
** (الثَّانِيَةُ): أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ الْعِلْمِ بِلَا عَمَلٍ إِنْ لَمْ يَضُرَّهَا لَمْ يَنْفَعْهَا.
** (الثَّالِثَةُ): أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، وَتَعْلِيمِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ، وَإِلَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ، وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.
** (الرَّابِعَةُ): أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَشَاقِّ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَأَذَى الْخَلْقِ، وَيَتَحَمَّلُ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهِ.
** فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ .
** فَإِنَّ السَّلَفَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّى رَبَّانِيًّا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ .
** فَمَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ فَذَاكَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. اهـ
** وفي كتابه: (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب),
(1/ 43) للعلامة محمد بن أحمد السفاريني (المتوفى: 1188هـ):
** مَرَاتِبُ التَّعَلُّمِ سِتَّةٌ، وَحِرْمَانُ الْعِلْمِ بِسِتَّةٍ :
** وَاعْلَمْ أَنَّ لِلتَّعَلُّمِ سِتَّ مَرَاتِبَ:
** (أَوَّلُهَا): حُسْنُ السُّؤَالِ .
** (ثَانِيهَا): حُسْنُ الْإِنْصَاتِ وَالِاسْتِمَاعِ.
** (ثَالِثُهَا): حُسْنُ الْفَهْمِ .
** (رَابِعُهَا): الْحِفْظُ .
** (خَامِسُهَا): التَّعْلِيمُ .
** (سَادِسُهَا): – وَهِيَ الثَّمَرَةُ – الْعَمَلُ بِهِ وَمُرَاعَاةُ حُدُودِهِ.
** وَحِرْمَانُ الْعِلْمِ يَكُونُ بِسِتَّةِ أَوْجُهٍ:
** (أَحَدُهَا) : تَرْكُ السُّؤَالِ.
** (الثَّانِي) : سُوءُ الْإِنْصَاتِ وَعَدَمُ إلْقَاءِ السَّمْعِ.
** (الثَّالِثُ) : سُوءُ الْفَهْمِ.
** (الرَّابِعُ) : عَدَمُ الْحِفْظِ.
** (الْخَامِسُ) : عَدَمُ نَشْرِهِ وَتَعْلِيمِهِ، فَمَنْ خَزَّنَ عِلْمَهُ وَلَمْ يَنْشُرْهُ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِنِسْيَانِهِ جَزَاءً وِفَاقًا.
** (السَّادِسُ) : عَدَمُ الْعَمَلِ بِهِ، فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ يُوجِبُ تَذَكُّرَهُ وَتَدَبُّرَهُ وَمُرَاعَاتَهُ وَالنَّظَرَ فِيهِ، فَإِذَا أَهْمَلَ الْعَمَلَ بِهِ نَسِيَهُ.
** قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْعِلْمِ بِالْعَمَلِ بِهِ.
** وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ،
** فَمَا اسْتَدَرَّ الْعِلْمُ وَاسْتُجْلِبَ بِمِثْلِ الْعَمَلِ بِهِ. اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 3 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
137- غربة الدين وأهله
سلسة الفوائد اليومية:
137- غربة الدين وأهله
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
« بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ »
** رواه مسلم .
** وعَنْ عَبْد اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: ” طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ” فَقِيلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: ” أُنَاسٌ صَالِحُونَ، فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ ”
** [رواه الإمام أحمد , وصححه الألباني]
** قال الأمير الصنعاني في كتابه: (التنوير شرح الجامع الصغير) , (3/ 430)
** (إن الإِسلام بدأ) مقصور وقيل يجوز همزه أي ظهر.
** (غريباً) في النهاية أنه كان أول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده لقلة المسلمين حينئذٍ.
** (وسيعود غريباً كما بدأ) لقلة أهل الإيمان آخر الزمان فيصير كالغريب. (فطوبى) اسم للجنة أو شجرة فيها.
** (للغرباء) أي أنها لأولئك الغرباء في أول ذلك الزمان الذي بدأ فيه وتكون أيضاً لهم في آخره، وذلك لصبرهم على الغربة وأذى من يخالفهم .
** وقد ألف بعض العلماء رسالة في هذا الحديث وفي الكلام عليه. اهـ
** (قلت) : يعني به الْحَافِظُ أَبا الْفَرَجِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ ورِسَالَته سَمَّاهَا: (كَشْفَ الْكُرْبَةِ فِي وَصْفِ حَالِ أَهْلِ الْغُرْبَةِ ) وَهي مطبوعة.
** قال الأمير الصنعاني في كتابه: (التنوير شرح الجامع الصغير) , (7/ 145):
** (طوبى للغرباء) جمع غريب ولما كان المراد هنا غير معناه المتبادر فسره – صلى الله عليه وسلم – بجملة استئنافية حيث قال:
(أناس صالحون) أي هم أناس متصفون بالصلاح كائنون أو كائنين: (في أناس سوء كثير) فوصفهم بصفة الصلاح التي هي أشرف الصفات ثم بصفة كونهم في قوم خالفوهم في الصفة ولا يصلح مع فساد الكثير من قومه إلا أفراد أهل النجاة كمؤمن آل فرعون وصاحب يس .
** (من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) لاتصاف قومهم بخلاف صفاتهم فلا يرون لهم طاعة وهؤلاء هم أتباع السنة وأهل الحق لا يزالون غرباء في كل عصر وزمان مذ ملأت الدنيا البدع والتمذهبات. اهـ
** وقال بن القيم في كتابه: (مدارج السالكين) (3/ 186):
** ( . . . فَأَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي النَّاسِ غُرَبَاءُ،
** وَالْمُؤْمِنُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ غُرَبَاءُ،
** وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُؤْمِنِينَ غُرَبَاءُ.
وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ يُمَيِّزُونَهَا مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فَهُمْ غُرَبَاءُ،
** وَالدَّاعُونَ إِلَيْهَا الصَّابِرُونَ عَلَى أَذَى الْمُخَالِفِينَ هُمْ أَشَدُّ هَؤُلَاءِ غُرْبَةً،
** وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ حَقًّا، فَلَا غُرْبَةَ عَلَيْهِمْ،
** وَإِنَّمَا غُرْبَتُهُمْ بَيْنَ الْأَكْثَرِينَ، الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}، فَأُولَئِكَ هُمُ الْغُرَبَاءُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ،
** وَغُرْبَتُهُمْ هِيَ الْغُرْبَةُ الْمُوحِشَةُ، وَإِنْ كَانُوا هُمُ الْمَعْرُوفِينَ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ، كَمَا قِيلَ:
فَلَيْسَ غَرِيبًا مَنْ تَنَاءَتْ دِيَارُهُ
وَلَكِنَّ مَنْ تَنْأَيْنَ عَنْهُ غَرِيبُ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الاثنين 1 / 3 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
136- ذكر مراتب الطهارة
سلسة الفوائد اليومية:
136- ذكر مراتب الطهارة
** قال العلامة البسام رحمه الله في كتابه: (توضيح الأحكام من بلوغ المرام) (1/ 114):
** والطهارة لها أربع مراتب:
** الأولى: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس.
** الثانية: تطهير الجوارح من الجرائم والآثام.
** الثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة.
** الرابعة: تطهير السرِّ عما سوى الله تعالى.
** وهذا هو الغاية القصوى لمن قويت بصيرته فسَمَت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته، لم يفهم من مراتب الطهارة إلاَّ المرتبة الأولى.
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 25 / 2/ 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
135- ذكر بعض الفوائد والحكم السامية في اجتماع الناس على العبادة الجماعية
سلسة الفوائد اليومية:
135- ذكر بعض الفوائد والحكم السامية في اجتماع الناس على العبادة الجماعية
** قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه: (إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص: 116)
** اعلَمْ أنَّ الشَّارِعَ مِن حِكمَتِه، ومحَاسِنِ شَرعِهِ، شَرَعَ للمسلِمِينَ الاجتماعَ للصَّلَواتِ وأنوَاعِ اَلتَّعَبُّدَات. وَهُوَ:
** إما اجتماعٌ خَاص كاجتمَاعِ أَهْلِ المحالِّ المتقَارِبَةِ لجماعةِ الصَّلَواتِ الخَمسِ.
** وإِمَّا اجتمَاعٌ عَام يجتَمِعُ فيه أهلُ البَلَدِ في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ للجمعَةِ.
** وإِمَّا اجْتمَاعٌ أَعَم مِن ذَلِكَ كاجتماعِ أَهْلِ البَلَدِ رجَالهم ونِسَائهم أحرارِهِم وأَرِقَّائِهم في الأَعيَادِ.
** وإِمَّا اجتماعٌ أَعمَّ مِن ذَلِكَ كُلِّه كاجتماعِ المسلِمين مِن جَمِيعِ أَقْطَارِ الأَرضِ فِي عَرَفَةَ ومَنَاسِكِ الحجِّ.
** وفي هَذِه الاجتِمَاعَاتِ مِنَ الحِكَمِ وَالأَسْرَار ومَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ ومَصْلَحَةِ الأُمَّة مَالا يُعدُّ وَلا يُحصَرُ.
** فمنهَا: إِظْهَار شَعَائِرِ الدِّين وبُرُوزِهَا مُشَاهَدًا جمالها عِندَ الموافِقين والمخالِفين، فإِن الدِّين نفسَه وَشَعَائِره مِن أكبرِ اَلأَدلَّة على أَنَّه الحَقُّ، وأَنَّهُ شرعَ لِوُصُولِ الخلقِ إِلَى صَلاح دينهِم ودُنيَاهُم وَصِلاح أخلاقِهِم وأعمَالِهم وسَعَادَتهِم اَلدُّنْيَوِيَّة وَالأُخْرَوِيَّة،
** فوقُوف الخلقِ عَلَى حَقِيقَةِ دِينِ الإسْلامِ وشرحِه لإِفهام النَّاسِ كافٍ وَحْدَهُ لِكُلِّ مُنصِفٍ قصده الحقيقةُ لمحبته وبَيَانُ أنَّه لا دِينَ إلاَّ هوَ، وأَنَّ ما خَالَفَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ .
** وإِيصَالُ هَذَا المعنَى لأَفهَامِ الخَلقِ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ مِن أَبْلَغهَا وأَجلِّهَا إِظْهَارُ هَذِهِ الشَّعَائرِ، ومَا احتَوَتْ عَلَيهِ مِنَ التَّقَرُّبَاتِ، وأصنَافِ العِبَادَاتِ،
** ولِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الشَّعَائر عَلمًا على بَلَدِ الإِسْلامِ وظُهُورِ الدِّينِ وعُلُوِّه عَلَى سَائِر الأَديَانِ.
** ومِنهَا: أَنُّ حَقَائقَ هَذِهِ العِبَادَاتِ لا تَحصُلُ بِدُونِ الاجتِمَاعَاتِ المذكُورَةِ، فالحكَمُ الَّتِي شُرِعَتْ لأَجْلهَا مُتَوَقِّفَةٌ على هَذَا الاجتِمَاعِ.
** ومِنهَا: أَنَّ اجتِمَاعَ الخَلقِ لهَذِه العِبَادَاتِ مِن أَعظَمِ مَحبُوبَاتِ الربِّ، لما فِيهَا مِن تَنشِيطِ العِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهم، وزِيَادَةِ رَغْبَتهمْ، وتنافُسِهِم في قُربهِ، وحُصُولِ ثَوَابِه، وسُهُولَةِ العِبَادَةِ عَلَيهم وخفتِهَا، وكثرَةِ ما تَشتَمِلُ عَلَيهِ مِن الانكِسَارِ لعظَمَةِ الرّبِّ، وَالتَّذَلُّل لَهُ والتَّضَرُّعِ وخُشُوعِ القُلُوبِ، وحُضورِهَا بين يَدَي اللَّهِ، واجتمَاعِهِم عَلَى طَلَبِهِم مِن رَبِّهِم مَصَالحهم العَامَّة المشتَرَكَة والخاصة.
** ومنهَا: مَا في اجتِمَاعِ المسلِمين مِن قِيَامِ اَلأُلْفَة والمودَّة؛ لأَنَّ الاجتِمَاعَ الظَّاهِرَ عِنوَانُ الاجتِمَاعِ البَاطِنِ، وتفكِيرُهُم في مَصَالحِهم، والسَّعيُ للعَمَلِ لها، وتَعلِيمُ بعضِهِم بَعضًا، وتَعَلُّمُ بعضِهِم مِن بَعضٍ.
** فالعِلمُ الَّذِي لابِد مِنهُ للصَّغِيرِ والكَبِيرِ والذكَرِ والأُنثَى فَد تَكَفلتْ هَذِه الاجتماعَاتُ بحصُولِه.
** وَلَولا هذه الاجتِمَاعَاتِ لم يَعرِفِ النَّاسُ مِن مَبَادِئِ دِينهِم وأصُولِه شَيئًا إِلا أَفذاذًا مِنهُم. وَلِهَذَا كَانَ الوَافِدُ يَفِدُ إلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – ويسألُه عَنِ الصَّلَوَاتِ الخَمسِ فَيأمُرُه بحضورِ الصَّلاةِ مَعَه يَومًا أو يَومَينِ ثم ينصَرفُ مِن عِندِهِ فَاهِمًا لِصَلاةِ اَلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم -، وقَالَ: «صَلَوَا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلي» .
** وَقَد حَج النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – بَعدَ فَرضِ الحجِّ مَرَّة وَاحِدَة وَحَجّ مَعَهُ المسلِمُونَ وَقَالَ: «خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ» .
** فانصرَفَ النَّاسُ آخِذِينَ عن نَبِيّهمْ – صلى الله عليه وسلم – أحكَامَ اَلْحَجّ الكُلِّيَّة والتَّفصِيلِيَّةِ والتَّعليمُ العَمَليُّ أبلَغُ مِنَ التَّعلِيمِ القَوليِّ، والجمعُ بينهُمَا أكمَلُ.
** ومِنهَا: أَن فِي هَذِه الاجتمَاعَاتِ مِن مَعرِفَةِ مَرَاتِبِ المسلِمين، ومَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ العِلمِ والدِّينِ والأخلاقِ، والمحافَظَةِ على الشَّرائِعِ أَو غَيرِ ذَلِكَ مِن أَعظَمِ الفَوَائِدِ المميِّزةِ؛ لتحصُلَ مُعَامَلَتُهُم بحسَبِ ذَلِكَ.
** وَلَولا هَذَا الاجتمَاعُ لَكانَ نَاقِصُ الدِّينِ قَلِيلُ الاهتِمَامِ به يَتَمَكَّنُ مِن تَركِ شَرَائِعه، وَلا يُمكِنُ إِلزَامُه بهَا، وفي ذَلِكَ مِنْ مَضَرَّته، وَمَضَرَّة العُمُومِ مَا فِيهِ.
** وفي الجملةِ: فِيهَا مِن صَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَا هُوَ مِنَ الضرُورَاتِ الَّتي لا بُدَّ مِنهَا. اهـ المراد
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 24 / 2/ 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
134- ذكر اللغات في لفظتي : أنملة و إِصبَع
سلسة الفوائد اليومية:
134- ذكر اللغات في لفظتي : أنملة و إِصبَع
** قال النووي رحمه في شرحه على مسلم (5/ 140) :
** وَفِي الْإِصْبَعِ عَشْرُ لُغَاتٍ كَسْرُ الْهَمْزَةِ وَفَتْحُهَا وَضَمُّهَا مَعَ كَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا , وَالْعَاشِرَةُ: (أُصْبُوعٌ) .
** وَأَفْصَحُهُنَّ: كَسْرُ الْهَمْزَةِ مَعَ فَتْحِ الْبَاءِ . اهـ
** وفي كتاب:( تاج العروس) (31/ 40):
** (والأنْملَةُ، بِتَثْلِيثِ المِيمِ والهَمْزَة، تِسْعُ لُغاتٍ)
** وَزَادَ بَعْضُهُم (أُنْمُولَة) بِالْوَاو كَما فِي ” نُور النِّبْراسِ “، فَهِي عَشْرة،
** وَاقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ كالصّاغانِيِّ عَلى فَتْح الهَمْزَةِ وَالمِيم،
** وَهي (الَّتِي فِيها الظُّفُرُ) مِن المَفْصِلِ الأَعْلَى مِنَ الإِصْبَع،
** (ج: أَنامِلُ وَأنْمُلاَتٌ) . . . .
** قَالَ شَيْخُنا: وَقَدْ جَمَعَ العِزُّ القَسْطَلاَنِيُّ اللُّغاتِ التِّسْعَةَ فِي البَيْتِ المَشْهُورِ مَعَ لُغاتِ الإِصْبَعِ فَقَالَ:
(وَهَمْزُ أنْمُلَةٍ ثَلِّثْ وَثالِثُه والتِّسْعُ فِي أصْبُع واخْتِمْ بأُصْبُوعِ)
** وفي كتاب: (بغية الوعاة), للسيوطي (1/ 136):
** وَمن نظم الشَّيْخ جمال الدّين بن مَالك:
(تَثْلِيثُ بَا إِصْبَعٍ مَعْ شَكْلِ هَمْزَتِهِ * * *
بِغَيْرِ قَيْدٍ مَعَ الْأُصْبُوعِ قَدْ نقلا)
(وَأعْطِ أُنْمُلَة مَا نَالَ الإصبع إِلَّا * * *
الْمَدّ فالمد للبا وَحدهَا بذلا)
** وفي كتاب: (دليل الفالحين), لابن علان (4/ 387):
** . . . وقد نظمتها بقولي:
وفي أصبع عشر بتثليث همزة * * *
وباء له والعاشر أصبوع فاعلم
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 10 / 2/ 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
133- ذكر جملة من الأحكام المستفادة من آية الوضوء
سلسة الفوائد اليومية:
133- ذكر جملة من الأحكام المستفادة من آية الوضوء
** قال الله تعالى : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)}
** قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره (تيسير الكريم الرحمن) , (ص: 222):
** هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله.
أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} إلى آخرها.
** أي: يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.
الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} .
الثالث: الأمر بالنية للصلاة، لقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} أي: بقصدها ونيتها.
الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة.
السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، من الفرض والنفل، وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة، تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، كسجود التلاوة والشكر.
السابع: الأمر بغسل الوجه، وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
** ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، بالسنة،
** ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.
الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين
** و”إلى” كما قال جمهور المفسرين بمعنى “مع” كقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.
التاسع: الأمر بمسح الرأس.
العاشر: أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.
الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.
الثاني عشر: أن الواجب المسح.
** فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف، لأنه لم يأت بما أمر الله به.
الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.
الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة، على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.
الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين، على قراءة الجر في {وأرجلكم} .
** وتكون كل من القراءتين، محمولة على معنى،
** فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين،
** وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.
السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة.
ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.
السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية.
** وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، فإن ذلك غير واجب،
* بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، * وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين،
** وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.
الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة، لتوجد صورة المأمور به.
التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة.
العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن، ولم يخصصه بشيء دون شيء.
الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة.
الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي، ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما، أو جامع ولو لم ينزل.
الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة.
الخامس والعشرون: ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد، بمشروعية التيمم.
السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، فيجوز له التيمم.
السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه، السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء،
** فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به،
** وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر.
الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط، ينقض الوضوء.
التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.
الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} .
الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.
الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.
الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء ولو في الصلاة، يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.
الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء، فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال “لم يجد” لمن لم يطلب.
الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته، فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.
السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي: يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} .
السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: {فَتَيَمَّمُوا} أي: اقصدوا.
الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. فيكون على هذا، قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين،
** وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.
التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا.
الأربعون: أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط، دون بقية الأعضاء.
الحادي والأربعون: أن قوله: {بِوُجُوهِكُمْ} شامل لجميع الوجه وأنه يعممه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف، وفيما تحت الشعور، ولو خفيفة.
الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك.
** فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك، كما قيده في الوضوء.
الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم، لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية فلم يقيد .
** [وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء].
الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.
الخامس والأربعون: أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما، فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها.
السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان، بيده أو غيرها، لأن الله قال {فامسحوا} ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.
السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.
الثامن والأربعون: أن الله تعالى – فيما شرعه لنا من الأحكام – لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم، وليتم نعمته عليهم.
وهذا هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد، والتوبة النصوح.
الخمسون: أن طهارة التيمم، وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.
الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحِكَم والأسرار في شرائع الله، في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا لله ومحبة له، على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 3 / 2/ 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
https://binthabt.al3ilm.net/11613
================
132 ذكر مَرَاتِبُ الْجُودِ
سلسة الفوائد اليومية:
132 ذكر مَرَاتِبُ الْجُودِ
** قال ابن القيم في كتابه القيم: (مدارج السالكين ), (2/ 279):
** وَالْجُودُ عَشْرُ مَرَاتِبَ.
** إِحْدَاهَا: الْجُودُ بِالنَّفْسِ. وَهُوَ أَعْلَى مَرَاتِبِهِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:
يَجُودُ بِالنَّفْسِ، إِذْ ضَنَّ الْبَخِيلُ بِهَا *** وَالْجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُودِ
** الثَّانِيَةُ: الْجُودُ بِالرِّيَاسَةِ. وَهُوَ ثَانِي مَرَاتِبِ الْجُودِ.
** فَيَحْمِلُ الْجَوَادَ جُودُهُ عَلَى امْتِهَانِ رِيَاسَتِهِ، وَالْجُودِ بِهَا. وَالْإِيثَارِ فِي قَضَاءِ حَاجَاتِ الْمُلْتَمِسِ.
** الثَّالِثَةُ: الْجُودُ بِرَاحَتِهِ وَرَفَاهِيَتِهِ، وَإِجْمَامِ نَفْسِهِ. فَيَجُودُ بِهَا تَعَبًا وَكَدًّا فِي مَصْلَحَةِ غَيْرِهِ.
** وَمِنْ هَذَا جُودُ الْإِنْسَانِ بِنَوْمِهِ وَلَذَّتِهِ لِمُسَامِرِهِ، كَمَا قِيلَ:
مُتَيَّمٌ بِالنَّدَى، لَوْ قَالَ سَائِلُهُ * * * هَبْ لِي جَمِيعَ كَرَى عَيْنَيْكَ، لَمْ يَنَمِ
** الرَّابِعَةُ: الْجُودُ بِالْعِلْمِ وَبَذْلِهِ. وَهُوَ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْجُودِ.
** وَالْجُودُ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْجُودِ بِالْمَالِ. لِأَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ مِنَ الْمَالِ.
** وَالنَّاسُ فِي الْجُودِ بِهِ عَلَى مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٍ.
** وَقَدِ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ وَتَقْدِيرُهُ النَّافِذُ: أَنْ لَا يَنْفَعَ بِهِ بَخِيلًا أَبَدًا.
** وَمِنَ الْجُودِ بِهِ: أَنْ تَبْذُلَهُ لِمَنْ يَسْأَلُكَ عَنْهُ، بَلْ تَطْرَحُهُ عَلَيْهِ طَرْحًا.
** وَمِنَ الْجُودِ بِالْعِلْمِ: أَنَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ: اسْتَقْصَيْتَ لَهُ جَوَابَهَا جَوَابًا شَافِيًا، لَا يَكُونُ جَوَابُكَ لَهُ بِقَدْرِ مَا تُدْفَعُ بِهِ الضَّرُورَةُ، كَمَا كَانَ بَعْضُهُمْ يَكْتُبُ فِي جَوَابِ الْفُتْيَا: نَعَمْ، أَوْ: لَا. مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا.
** وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ – قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ – فِي ذَلِكَ أَمْرًا عَجِيبًا:
** كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ حُكْمِيَّةٍ، ذَكَرَ فِي جَوَابِهَا مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، إِذَا قَدَرَ، وَمَأْخَذَ الْخِلَافِ، وَتَرْجِيحَ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ. وَذَكَرَ مُتَعَلَّقَاتِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي رُبَّمَا تَكُونُ أَنْفَعَ لِلسَّائِلِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ. فَيَكُونُ فَرَحُهُ بِتِلْكَ الْمُتَعَلَّقَاتِ، وَاللَّوَازِمِ: أَعْظَمَ مِنْ فَرَحِهِ بِمَسْأَلَتِهِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
** الْخَامِسَةُ: الْجُودُ بِالنَّفْعِ بِالْجَاهِ. كَالشَّفَاعَةِ وَالْمَشْيِ مَعَ الرَّجُلِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ وَنَحْوِهِ.
** وَذَلِكَ زَكَاةُ الْجَاهِ الْمُطَالَبُ بِهَا الْعَبْدُ. كَمَا أَنَّ التَّعْلِيمَ وَبَذْلَ الْعِلْمِ زَكَاتُهُ.
** السَّادِسَةُ: الْجُودُ بِنَفْعِ الْبَدَنِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ. كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ: صَدَقَةٌ. وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ: صَدَقَةٌ. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ: صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ يُمْشِيهَا الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ: صَدَقَةٌ. وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ: صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
** السَّابِعَةُ: الْجُودُ بِالْعِرْضِ، كَجُودِ «أَبِي ضَمْضَمٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا مَالَ لِي أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى النَّاسِ. وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِي، فَمَنْ شَتَمَنِي، أَوْ قَذَفَنِي: فَهُوَ فِي حِلٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمٍ؟».
** وَفِي هَذَا الْجُودِ مِنْ سَلَامَةِ الصَّدْرِ، وَرَاحَةِ الْقَلْبِ، وَالتَّخَلُّصِ مِنْ مُعَادَاةِ الْخَلْقِ مَا فِيهِ.
** الثَّامِنَةُ: الْجُودُ بِالصَّبْرِ، وَالِاحْتِمَالِ، وَالْإِغْضَاءِ.
** وَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ شَرِيفَةٌ مِنْ مَرَاتِبِهِ.
** وَهِيَ أَنْفَعُ لِصَاحِبِهَا مِنَ الْجُودِ بِالْمَالِ، وَأَعَزُّ لَهُ وَأَنْصَرُ، وَأَمَلَكُ لِنَفْسِهِ، وَأَشْرَفُ لَهَا. وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا النُّفُوسُ الْكِبَارُ.
** فَمَنْ صَعُبَ عَلَيْهِ الْجُودُ بِمَالِهِ فَعَلَيْهِ بِهَذَا الْجُودِ. فَإِنَّهُ يَجْتَنِي ثَمَرَةَ عَوَاقِبِهِ الْحَمِيدَةِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ. وَهَذَا جُودُ الْفُتُوَّةِ. قَالَ تَعَالَى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45]
** وَفِي هَذَا الْجُودِ قَالَ تَعَالَى {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: 40]
** فَذَكَرَ الْمَقَامَاتِ الثَّلَاثَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: مَقَامَ الْعَدْلِ، وَأَذِنَ فِيهِ. وَمَقَامَ الْفَضْلِ، وَنَدَبَ إِلَيْهِ. وَمَقَامَ الظُّلْمِ، وَحَرَّمَهُ.
** التَّاسِعَةُ: الْجُودُ بِالْخُلُقِ وَالْبِشْرِ وَالْبَسْطَةِ.
** وَهُوَ فَوْقَ الْجُودِ بِالصَّبْرِ، وَالِاحْتِمَالِ وَالْعَفْوِ. وَهُوَ الَّذِي بَلَغَ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. وَهُوَ أَثْقَلُ مَا يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ»
** وَفِي هَذَا الْجُودِ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَسَارِّ، وَأَنْوَاعِ الْمَصَالِحِ مَا فِيهِ.
** وَالْعَبْدُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسَعَهُمْ بِخُلُقِهِ وَاحْتِمَالِهِ.
** الْعَاشِرَةُ: الْجُودُ بِتَرْكِهِ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ عَلَيْهِمْ. فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ. وَلَا يَسْتَشْرِفُ لَهُ بِقَلْبِهِ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بِحَالِهِ، وَلَا لِسَانِهِ.
** وَهَذَا الَّذِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ بِالْبَذْلِ.
** فَلِسَانُ حَالِ الْقَدَرِ يَقُولُ لِلْفَقِيرِ الْجَوَادِ: وَإِنْ لَمْ أُعْطِكَ مَا تَجُودُ بِهِ عَلَى النَّاسِ، فَجُدْ عَلَيْهِمْ بِزُهْدِكَ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ، تُفَضَّلْ عَلَيْهِمْ، وَتُزَاحِمْهُمْ فِي الْجُودِ، وَتَنْفَرِدْ عَنْهُمْ بِالرَّاحَةِ.
** وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْجُودِ مَزِيدٌ وَتَأْثِيرٌ خَاصٌّ فِي الْقَلْبِ وَالْحَالِ.
** وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ ضَمِنَ الْمَزِيدَ لِلْجَوَادِ، وَالْإِتْلَافَ لِلْمُمْسِكِ.
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. اهـ باختصار .
** (تنبيه): حديث: ( أَبِي ضَمْضَمٍ . . . ) رواه أبو دواد وغيره.
** [ وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع برقم :(2185) ]
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 20 / 1/ 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
131 ذكر بعض أحكام المطر وآدابه
سلسة الفوائد اليومية:
131 ذكر بعض أحكام المطر وآدابه
** إن نعم الله علينا كثيرة جدا , لا تعد ولا تحصى كما قال تعالى :
{وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}
** وقال سبحانه وتعالى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}
** وإن من أعظم هذه النعم نعمة نزول المطر الذي به حياة العباد والبلاد , وهو رحمة من الله يرحمهم بها .
** قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}
* وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ () يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}
** وقال تعالى: {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ}
** فالمطر نعمة عظيمة ومنة جسيمة ورحمة عميمة لا يستغنى عنها أبدا .
** قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ}
** وقال سبحانه : {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}
** ألا وإن لهذه النعمة أحكاما وآدابا يجهلها كثير من الناس ويغفل عنها آخرون .
** وسأذكر ما تيسر من هذه الأحكام والآداب في الفقرات التالية :
(1) تعريف المطر :
** المَطَرُ: الْمَاءُ الْمُنْسَكِبُ مِنَ السَّحابِ.
** وَالْجَمْعُ أَمْطارٌ.
** ويَوْمٌ مُمْطِرٌ وماطِرٌ ومطِرٌ ومَطِيرٌ: ذُو مطَر.
* قال تعالى: { أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ () أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ }
** وقال تعالى: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ}
** وانظر : (لسان العرب) (5/ 178)
** و(تهذيب اللغة) (13/ 231)
** و(العين) (7/ 425)
(2) جاء لفظ (المطر) في القرآن الكريم على معنيين:
* الأول : بمعنى العذاب, كقوله تعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ() فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ }.
** وهذا المعنى هو الأكثر استعمالا في القران الكريم.
** الثاني : بمعني الغيث كقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}.
** (تنبيهان) :
** أحدهما: جاء في صحيح البخاري (6/ 62) معلقا عن سفيان بْن عُيَيْنَةَ رحمه الله أنه قَالَ: « مَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَطَرًا فِي القُرْآنِ إِلَّا عَذَابًا , وَتُسَمِّيهِ العَرَبُ الغَيْثَ »، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (يُنْزِلُ الغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا) . اهـ
** وهذا القول قد رده أهل العلم .
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري), (8/ 308) :
** وَقد تعقب كَلَام بن عُيَيْنَةَ بِوُرُودِ الْمَطَرِ بِمَعْنَى الْغَيْثِ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى من مطر} فَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الْغَيْث قطعا.
** وَمعنى التَّأَذِّي بِهِ الْبَلَلُ الْحَاصِلُ مِنْهُ لِلثَّوْبِ وَالرِّجْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
اهـ المراد
** ثانيهما: إذا كان المطر بمعنى الرحمة فالأكثر في فعله أن يكون ثلاثيا , تقول: (مَطِرَتِ السماءُ),
** ويجوز على قلة أن يكون رباعيا تقول: (أُمْطِرَتِ السماءُ) ,
** وإذا كان بمعنى العذاب فبالعكس تماما , وهذا على الصحيح.
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه : (فتح الباري) (8/ 308):
** وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنْ كَانَ مِنَ الْعَذَابِ فَهُوَ (أُمْطِرَتْ) وَإِنْ كَانَ مِنَ الرَّحْمَة فَهُوَ (مُطِرَتْ) , وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا. اهـ
** وفي شرح النووي على مسلم (6/ 192)
** قَوْلُهُ: (ثُمَّ أَمْطَرَتْ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ وَكَذَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ (أَمْطَرَتْ) بِالْأَلِفِ , وَهُوَ صَحِيحٌ , وَهُوَ دَلِيلٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ يُقَالُ: (مَطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ) لُغَتَانِ فِي الْمَطَرِ .
** وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ : لَا يُقَالُ (أَمْطَرَتْ) بِالْأَلِفِ إِلَّا فِي الْعَذَابِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وأمطرنا عليهم حجارة}, وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ .
** وَلَفْظَةُ (أَمْطَرَتْ) تُطْلَقُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ , وَتُعْرَفُ بِالْقَرِينَةِ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} , وَهَذَا مِنْ أَمْطَرَ , وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَطَرُ فِي الْخَيْرِ لِأَنَّهُمْ ظَنُّوهُ خَيْرًا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به}.
** ومن أحكام المطر وآدابه :
(3) الفرح بنزوله ؛ لأنه نعمة عظيمة , ورحمة واسعة.
* قال تعالى: { اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ () وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (*) فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
** وقال تعالى:{ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}
(4) شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة.
(5) وجوب اعتقاد أن هذه النعمة من عند الله جل وعلا وحده لا شريك له.
** عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ” أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ ” متفق عليه.
** وفي شرح النووي على مسلم (2/ 60)
** وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كُفْرِ مَنْ قَالَ: (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا )عَلَى قَوْلَيْنِ :
** أَحَدُهُمَا : هُوَ كُفْرٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَالِبٌ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ مُخْرِجٌ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ قَالُوا وَهَذَا فِيمَنْ قَالَ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا أن الكوكب فاعل مدبر منشىء لِلْمَطَرِ كَمَا كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَزْعُمُ وَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ .
** وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَالشَّافِعِيُّ مِنْهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ قَالُوا: وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا) مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرَحْمَتِهِ وَأَنَّ النَّوْءَ مِيقَاتٌ لَهُ وَعَلَامَةٌ اعْتِبَارًا بِالْعَادَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مُطِرْنَا فِي وَقْتِ كَذَا , فَهَذَا لَا يَكْفُرُ .
** وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَتِهِ , وَالْأَظْهَرُ كَرَاهَتُهُ ؛ لَكِنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا إِثْمَ فِيهَا .
** وَسَبَبُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهَا كَلِمَةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ فَيُسَاءُ الظَّنُّ بِصَاحِبِهَا وَلِأَنَّهَا شِعَارُ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ .
** وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي أَصْلِ تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُرَادَ كُفْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِاقْتِصَارِهِ عَلَى إِضَافَةِ الْغَيْثِ إِلَى الْكَوْكَبِ , وَهَذَا فِيمَنْ لَا يَعْتَقِدُ تَدْبِيرَ الْكَوْكَبِ .
** وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ فِي الْبَابِ: (أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَكَافِرٌ) ,
** وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ) ,
** وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ)
** فَقَوْلُهُ: (بِهَا) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِالنِّعْمَةِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
(6) هل ثبت ذكر معين عن النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الرعد؟
** لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولكن قد ثبت عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ , وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي {يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ}، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ .
** رواه البخاري في كتابه: (الأدب المفرد)
** [وقال الشيخ الألباني: صحيح]
** فمن عمل بهذا اقتداءً بهذا الصحابي الجليل فلا بأس بذلك.
(7) قول الدعاء المأثور عند نزول المطر :
** عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُمْطِرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري.
** وفي شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1320)
** قوله: ((صيباً نافعًا)) نصبه بفعل مضمر، أي اسقنا صيبًا نافعًا،
** و((نافعًا)) تتميم في غاية من الحسن؛ لأن لفظة صيبًا مظنة للضرر والفساد.
** ((الكشاف)): الصيب المطر الذي يصوب أي ينزل ويقع: وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء،
** دل على أنه نوع من المطر شديد هائل، فتممه بقوله ((نافعًا)) صيانة عن الإضرار والفساد. نحوه قول الشاعر:
فَسَقَى دِيَارَكَ غَيْرُ مُفْسِدِهَا * * * صَوْبُ الرَّبِيعِ وَدِيمَةٌ تَهْمَى
** لكن ((نافعًا)) في الحديث أوقع وأحسن وأنفع من قوله:
((غير مفسدها)).
(8) أن يكشف شيئاً من بدنه غير عورته تبركاً به.
** عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» رواه مسلم.
** شرح النووي على مسلم (6/ 195)
** مَعْنَى: (حَسَرَ) كَشَفَ , أَيْ كَشَفَ بَعْضَ بَدَنِهِ ,
** وَمَعْنَى: (حَدِيثُ عهد بربه) أي بتكوين ربه اياه , ومعناه أَنَّ الْمَطَرَ رَحْمَةٌ وَهِيَ قَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى لَهَا فَيُتَبَرَّكُ بِهَا.
** وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِقَوْلِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ أَوَّلِ الْمَطَرِ أَنْ يَكْشِفَ غَيْرَ عَوْرَتِهِ لِيَنَالَهُ الْمَطَرُ وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا.
** وَفِيهِ أَنَّ الْمَفْضُولَ إِذَا رَأَى مِنَ الْفَاضِلِ شَيْئًا لَا يَعْرِفُهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ لِيُعَلِّمَهُ فَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ غيره.
** المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (8/ 23)
** وقوله : (( لأنه حديث عهدٍ بربه )) ؛ أي : بإيجاد ربّه له ، وهذا منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ تبرُّك بالمطر ، واستشفاء به ؛ لأن الله تعالى قد سَمّاه رحمة ، ومباركًا وطهورًا، وجعله سبب الحياة، ومُبعدًا عن العقوبة.
** ويستفاد منه احترام المطر ، وترك الاستهانة به .
** وانظر : (مجموع فتاوى ابن باز), (13/ 63)
** و(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين), (16/ 363)
** و(شرح سنن أبي داود للعباد) (578/ 34)
(9) استحباب قول المؤذن في المطر : (صلوا في رحالكم) , أو (ألا صلوا في الرحال) , أو (صلوا في بيوتكم) , أو (ومن قعد فلا حرج).
(**) وتقال إحدى هذه الألفاظ في ثلاثة مواضع:
(أ) إما بدلاً من قول: (حي على الصلاة) لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: ” إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ “، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ». متفق عليه
(ب) أو بعد (حي على الفلاح) لحديث رجل من ثقيف رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ – يَقُولُ: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» رواه النسائي وغيره وصححه الشيخان .
** والرجل الثقفي المبهم : صحابي ، فلا يضر إبهامه ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول .
(ج) أو بعد انتهاء الآذان لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» . متفق عليه
** وحديث نُعَيمِ بنِ النَّحّامِ مِن بنى عَدِىِّ بنِ كَعبٍ رضي الله عنه قال: نودِىَ بالصُّبحِ في يَومٍ بارِدٍ وهو في مِرطِ امرأَتِه فقالَ: لَيتَ المُنادِىَ يُنادِى: ومَن قَعَدَ فلا حَرَجَ. فنادَى مُنادِى النبيِّ – صلى الله عليه وسلم في آخِرِ أذانِه: ومَن قَعَدَ فلا حَرَجَ، وذَلِكَ في زَمَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
** رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني في الصحيحة برقم (2605).
(10) يستحب أن يصلي الناس في بيوتهم، أخذا بالرخصة المذكورة في هذه الأحاديث في قول المؤذن (صلوا في رحالكم) , ولحديث :
** عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ »
** رواه الترمذي وقال: « حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » ,
** وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُعُودِ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالطِّينِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ . اهـ
** وقال الشيخ الألباني: صحيح.
** والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)
** رواه الطبراني وغيره [وصححه الألباني]
** قال ابن عبد البر في كتابه: (التمهيد), (13/ 274):
( . . . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّأَخُّرِ فِي حِينِ الْمَطَرِ الدَّائِمِ عَنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَذَى الْمَطَرِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِهَذِهِ الْحَالِ . . . الخ). اهـ
(11) الجمع بين الصلوات – إن احتيج إلى ذلك – كأن يكون المطر شديدا أو متواصلا ؛ لما في ذلك من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
** وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ»
** قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا، لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ»
** وفي رواية أخرى له: (فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ)
** فإذا كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين هذه الصلوات لِيَرْفَع عن أمته الحرج الحاصل بدون خوف ولا مطر ولا سفر، فالجمع لهذه الأعذار المحرجة لأمته أولى من الجمع لغيرها.
** قَالَ الإمام الترمذي رحمه الله في سننه (1/ 259) :
** وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْمَطَرِ.
** وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. اهـ
** وقَالَ الخطابي رحمه الله في كتابه: (معالم السنن),(1/ 264) :
** قلت : وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للممطور في الحضر فأجازه جماعة من السلف،
** روي ذلك عن ابن عمر وفعله عروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينة , وهو قول مالك والشافعي وأحمد ,
** غير أن الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائماً وقت افتتاح الصلاتين معاً , وكذلك قال أبو ثور , ولم يشترط ذلك غيرهما. اهـ
** وفي كتابه: (تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام), (ص: 124) للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى.[الجمع بين المغرب والعشاء للمطر في الوقت الحاضر]
65 – ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن , والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذا لا مشقة ولا وحل؟
الجواب: لا حرج , والجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة.
والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» . زاد مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولا سفر.
فدل ذلك على أنه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرين والقصر من رخص السفر الخاصة.
والله ولي التوفيق. اهـ
** (مسألة) والجمع بين كل صلاتين يكون بأذان واحد وإقامتين تماما من غير قصر إلا إذا كانوا مسافرين .
** وفي فتاوى اللجنة الدائمة – 1 (8/ 134) برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :
(جمع الصلاة لأجل المطر)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9688)
س3: هل يجب أن نضيف الصلاة على صلاة؛ مثل أن نضيف صلاة المغرب على صلاة العشاء؟ وهل يحسن الأذان والإقامة عليهما؟
ج3: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أو مرض، ونحوهما، وذلك بأذان واحد للأولى منهما، وبإقامة لكل منهما، ويجوز ذلك في السفر أيضا بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، في وقت إحداهما، بأذان واحد وإقامتين، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ
** (مسألة أخرى) وهل يجمع بين كل صلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير؟
الجواب : يُفعلُ الأسهلُ على الناس والأرفقُ بهم .
** قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه : (الشرح الممتع على زاد المستقنع), (4/ 396):
** (مسألة): الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟
** الأفضل التقديم؛ لأنه أرفق بالناس، ولهذا تجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم.
** هذا إذا قلنا: إن الجمع للمطر خاص في العشائين.
** أما إذا قلنا بأنه عام في العشائين والظهرين، فإن الأرفق قد يكون بالتأخير. اهـ
(12) الدعاء بـ(الاستصحاء) وهو رفع المطر , أو تحويله إلى بطون الأودية ونحوها, وذلك عند كثرة المطر وخشية الضرر أو حصوله.
** عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ » . فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
متفق عليه , وهذا لفظ البخاري.
** و(الآكام): جمع الأكمة , وهى التل.
** و(انجاب) معناه : انكشف.
(13) لا يعلم بوقت نزول المطر أحد إلا الله سبحانه وتعالى :
** قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}
** وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مِفْتَاحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ المَطَرُ ” رواه البخاري
(14) الدعاء أثناء نزول المطر :
** وهذا – وإن لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم , فيما أعلم – إلا أن نزول المطر وقت لتنزل الرحمات فالدعاء في ذلك الوقت مناسب.
** قال الله تعالى: {وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد}
** وقد جاء أثر مرسل عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « اُطْلُبُوا إجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَنُزُولِ الْغَيْثِ »[أخرجه الشافعي في كتابه: ” الأم ” (1/ 289) ] ** [قال الألباني: (صحيح)] ** انظر: (صحيح الجامع), رقم: (1906)
** قَالَ الشَّافِعِيُّ: – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: بعد أن ذكر أثر مكحول المتقدم :
** وَقَدْ حَفِظْت عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ طَلَبَ الْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ. اهـ
** قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (3/ 453)
رقم الحديث : (1469) بعد أن ذكر أثر مكحول المتقدم :
** ” قلت: لكن الحديث له شواهد من حديث سهل بن سعد وابن عمر وأبي أمامة خرجتها في” التعليق الرغيب ” (1 / 116) , وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة إلا أنه إذا ضمت إلى هذا المرسل أخذ بها قوة وارتقى إلى مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى. اهـ
(15) التأمل والتفكر في آيات الله الكونية التي تحصل قبل نزول المطر ومعه وبعده : من رعد , وبرق , وظلمة , وتحمل السحاب لتلك البحار العظيمة في جوفه , وما فيها من جبال من برد، وكيفية نزول المطر على شكل قطرات، ونحو ذلك , فإن ذلك يزيد في إيمان العبد.
* قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ() يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ}
* وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ () وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ}
* وقال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ () وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (*) فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
( 16) (فائد): في ترتيب نزول المطر عند العرب من الضعف إلى القوة:
** قال أبو منصور الثعالِبي في كتابه: (فقه اللغة وسر العربية) (ص:190):
** الفصل الرابع “في تَرْتِيبِ المَطَرِ الضَّعِيفِ”.
** أَخَفُّ المَطَرِ وَأَضْعَفُهُ الطَّلُّ. ثُمَّ الرَّذَاذُ أقوَى مِنْهُ. ثُمَّ البَغْشُ والدَّثُّ. ومثله الرّكّ والرّهمة.
** الفصل الخامس “في تَرْتِيبِ الأمْطَارِ”.
** أوَّلُ المَطَرِ رَشٌّ وَطَشُّ. ثُمَّ طَلّ وَرَذَاذ. ثُمَّ نَضْح ونَضْخ “وهو قَطْر بَيْنَ قَطْرَيْنِ”. ثُمَّ هَطْل وَتَهْتَان. ثمّ وابل وجود. اهـ
** وقال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه : (المدهش), (ص: 46):
** ويفرقون (يعني العرب) فِي الْمَطَر.
** فأوله : رش , ثمَّ طش , ثمَّ طل ورذاذ , ثمَّ نضخ , ثمَّ هطل وتهتان , ثمَّ وابل وجود.
** فَإِذا أحيى الأَرْض بعد مَوتهَا فَهِيَ الْحيَاء.
** فَإِذا جَاءَ عقيب الْمحل أَو عِنْد الْحَاجة فَهُوَ الْغَيْث.
** وَإِن كَانَ صغَار الْقطر فَهُوَ القطقط.
** فَإِذا دَامَ مَعَ سُكُون فَهُوَ الديمة.
** فَإِذا كَانَ عَاما فَهُوَ الجداء.
** وَإِذا روى كل شَيْء فَهُوَ الْجُود.
** فَإِذا كَانَ كثير الْقطر فَهُوَ الهطل والتهتان.
** فَإِذا كَانَ ضخم الْقطر شَدِيد الوقع فَهُوَ الوابل. اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 13 / 1/ 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
130 من أعظم أخلاق الحلماء الكرام التي حث عليها الإسلام : دفع السيئة بالحسنة
سلسة الفوائد اليومية:
130 من أعظم أخلاق الحلماء الكرام التي حث عليها الإسلام : دفع السيئة بالحسنة
** قال تعالى:{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}
** وقال تعالى:{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}
** وقال تعالى:{وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}
** وعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ»
** رواه أَبُو دَاوُدَ وغيره , [وحسنه الألباني]
** وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّهَا قَالَتْ: ” لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ.
** رواه الإمام أحمد وغيره . [وصححه الألباني]
** وجاء هذا اللفظ في صحيح البخاري ضمن حديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
** وفي كتاب :(أدب الدنيا والدين), لأبي الحسن لماوردي (ص: 252):
** فَالْحِلْمُ مِنْ أَشْرَفِ الْأَخْلَاقِ وَأَحَقِّهَا بِذَوِي الْأَلْبَابِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ سَلَامَةِ الْعِرْضِ وَرَاحَةِ الْجَسَدِ وَاجْتِلَابِ الْحَمْدِ.
** وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ [رضي الله عنه]: أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِيمِ عَنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ.
. . . . . . . . . . . . . . .
** وَقَدْ حُكِيَ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا عَادَانِي أَحَدٌ قَطُّ إلَّا أَخَذْت فِي أَمْرِهِ بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ :
** إنْ كَانَ أَعْلَى مِنِّي عَرَفْت لَهُ قَدْرَهُ ،
** وَإِنْ كَانَ دُونِي رَفَعْت قَدْرِي عَنْهُ ،
** وَإِنْ كَانَ نَظِيرِي تَفَضَّلْت عَلَيْهِ .
** فَأَخَذَهُ الْخَلِيلُ، فَنَظَمَهُ شِعْرًا فَقَالَ:
سَأُلْزِمُ نَفْسِي الصَّفْحَ عَنْ كُلِّ مُذْنِبٍ
وَإِنْ كَثُرَتْ مِنْهُ إلَيَّ الْجَرَائِمُ
فَمَا النَّاسُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ
شَرِيفٌ وَمَشْرُوفٌ وَمِثْلٌ مُقَاوِمُ
فَأَمَّا الَّذِي فَوْقِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ
وَأَتْبَعُ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقُّ لَازِمُ
وَأَمَّا الَّذِي دُونِي فَأَحْلُمُ دَائِبًا
أَصُونُ بِهِ عِرْضِي وَإِنْ لَامَ لَائِمُ
وَأَمَّا الَّذِي مِثْلِي فَإِنْ زَلَّ أَوْ هَفَا
تَفَضَّلْت إنَّ الْفَضْلَ بِالْفَخْرِ حَاكِمُ
** قال أبو عبد الله النقذي الجعدي وفقه الله :
** وأكثر المصادر تنسب هذه الأبيات لمحمود الوراق.
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 24 / 12/ 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
https://binthabt.al3ilm.net/11613
================
129 ذكر أفضل أيام الدنيا , وسبب تفضليها
سلسة الفوائد اليومية:
129 ذكر أفضل أيام الدنيا , وسبب تفضليها
** إن من حكمة الله الحكيم الله أنه لما خلق الخلق لم يجعلهم على حد سواء بل فاضل بينهم , فجعل بعضهم أفضل من بعض .
** كما قال الله تعالى :
{ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }
** ومما فضله الله على غيره العشر الأول من شهر ذي الحجة , فقد جعلها الله سبحانه وتعالى مواسم للخيرات، وأياما للعبادات، وأوقاتا للطاعات والقربات .
** ومما يدل على فضلها ما يلي :
(1) أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا:
** عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ :
(( أفضلُ أيامِ الدُّنْيا أيامُ العَشْرِ )) [رواه الْبَزَّار , وصحيح الألباني ]
(2) أن الله أقسم بها في كتابه الكريم , والله لا يقسم إلا بشيء عظيم:
** قال تعالى : { وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ }
** وَاللَّيَالِي الْعَشْرُ: الْمُرَادُ بِهَا عَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ. كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ .
قاله ابن كثير في
( تفسيره ) (8/ 390):
(3) أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأزكى من العمل في غيرها:
** وعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى ».
** قِيلَ : وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : « وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ »
** قَالَ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا دَخَلَ أَيَّامُ الْعَشْرِ اجْتَهَدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا حَتَّى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ” رواه الدارمي , وحسنه الألباني .
(4) أنها الأيام المعلومات:
** قال تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) , وهي أيام العشر عند الجمهور .
(6) أن فيها يوم النحر الذي هو أعظم أيام السنة عند الله , وهو يوم الحج الأكبر:
** عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ ”
رواه أبو داود وغيره , وصححه الألباني
(7) أن فيها ذبح الهدايا والضحايا:
** وأما سبب تفضليها فلأنه تجتمع فيها أمهات العبادة , من صلاة وصيام وصدقة وحج .
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه : ( فتح الباري ) , (2/ 460) :
** وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ . اهـ
** فإذا كانت هذه العشر بهذه المنزلة الرفيعة , والفضائل الكثيرة والكبيرة فحري بكل مسلم عاقل لبيب يرجو رحمة ربه , ويطمع في ثوابه ومغفرته , ورفع درجاته , أن يشمر عن ساعد الجد , فينافس ويسابق في الأعمال الصالحات فرضها ونفلها بشتى أنواعها .
** وهذا سرد بعض الأعمال الصالحة , من باب التذكير :
(1) التَّوْبَةُ الصادقة إلى اللهِ تعالَى مِن جميعِ الذُّنوبِ ؛ فإنَّها مِفْتاحُ النجاح وعلامة الفلاح.
(2) المحافظة على الصلوات المفروضة في أوقاتها وأماكنها , والإكثار من النوافل.
(3) العمرة والحج للمستطيع.
(4) الصيام , لدخوله في الأعمال الصالحة، فمن قدر على صيام التسع فليصمها , وإلا صام ما تيسر منها.
(5) الإكثار من ذكر الله جل وعلا , من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير, وسائر أنواع الذكر.
(6) صوم يوم عرفة لغير الحاج.
(7) الأضحية يوم العيد.
(8) الإكثار من قراءة القران مع التدبر.
(9) الصدقة.
(11) الإكثار من الأعمال الصالحة عموما :
** مثل : صلاة الضحى ,
وصلاة الليل ,
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ,
وكثرة الاستغفار ,
وصلة الأرحام – ولو بالهاتف – ,
وبر الوالدين ,
والإحسان إلى الزوجة والأولاد والجيران
والابتسامة , وطلاقة الوجه ,
والمحافظة على الوضوء , والسواك , والصف الأول , والأذكار ,
وعيادة المرضى , وزيارة القبور , وغير ذلك.
** ( تنبيه ): هذه الفائدة اختصرتها من منشور لي سابق بعنوان :
(( فضائل عشر ذي الحجة ))
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 28 / 11/ 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
128 أقسام (أل)
سلسة الفوائد اليومية:
128 أقسام (أل)
** قال المرادي في كتابه :(الجنى الداني في حروف المعاني) (ص: 203):
** (تنبيه)
** وقد اتضح، بما ذكرته، أن الألف واللام في كلام العرب أربعة عشر قسماً، على التفصيل، بالمتفق عليه والمختلف فيه. وهي:
العهدية،
والجنسية،
والتي للكمال وهي نوع من الجنسية،
والتي للحقيقة،
والتي للحضور،
والتي للغلبة،
والتي للمح الصفة، والزائدة اللازمة،
والزائدة للضرورة،
والتي هي عوض من الضمير،
والتي هي عوض من الهمزة،
والتي للتفخيم،
وبقية الذي،
والموصولة .
** وكلها عند التحقيق، راجعة إلى ثلاثة أقسام:
معرفة ،
وزائدة ،
وموصولة.
** وقد نظمتها في هذه الأبيات:
أقسام أل أربع، وعشر … للعهد، والجنس، والكمال
ثم لماهية، ولمح أو غالب، أو حضور حال
وزيد نثراً، وزيد نظماً وفخمت، في اسم ذي الجلال
وناب عن مضمر، وهمز ومن، بذي الوصل، ذا احتفال
وقيل: بعض الذي أتانا فاحفظه، وابحث عن المثال
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 24 / 11/ 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
127 أصح كيفيات صلاة الكسوف أو الخسوف أنها ركعتان , في كل ركعة ركوعان وسجودان
سلسة الفوائد اليومية:
127 أصح كيفيات صلاة الكسوف أو الخسوف أنها ركعتان , في كل ركعة ركوعان وسجودان
** قال الإمام الصنعاني في كتابه : (سبل السلام), (1/ 445):
( . . . إذَا عَرَفْت هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فَقَدْ يَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِهَا أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ اتِّفَاقًا إنَّمَا اُخْتُلِفَ فِي كَمِّيَّةِ الرُّكُوعَاتِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي سَاقَهَا الْمُصَنِّفُ أَرْبَعُ صُوَرٍ.
(الْأُولَى) : رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَبِهَذَا أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمْ وَعَلَيْهَا دَلَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ
** قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ وَبَاقِي الرِّوَايَاتِ مُعَلَّلَةٌ ضَعِيفَةٌ.
(الثَّانِيَةُ:) رَكْعَتَانِ أَيْضًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ، وَهِيَ الَّتِي أَفَادَتْهَا رِوَايَةُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ – عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
(وَالثَّالِثَةُ) : رَكْعَتَانِ أَيْضًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ وَعَلَيْهَا دَلَّ حَدِيثُ جَابِرٍ.
(وَالرَّابِعَةُ:) رَكْعَتَانِ أَيْضًا يَرْكَعُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسَ رُكُوعَاتٍ
وَلَمَّا اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فَالْجُمْهُورُ أَخَذُوا بِالْأُولَى لِمَا عَرَفْت مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ،
** وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: إنَّهُ أَخَذَ بِكُلِّ نَوْعٍ بَعْضُ الصَّحَابَةِ،
** وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ إنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَنْوَاعِ فَأَيُّهَا فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تَعَدَّدَ الْكُسُوفُ، وَأَنَّهُ فَعَلَ هَذِهِ تَارَةً، وَهَذَا أُخْرَى
** وَلَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ كُلَّ الرِّوَايَاتِ حِكَايَةٌ عَنْ وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ صَلَاتُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ وَفَاةِ إبْرَاهِيمَ، وَلِهَذَا عَوَّلَ الْآخَرُونَ عَلَى إعْلَالِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي حَكَتْ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ
** قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: كِبَارُ الْأَئِمَّةِ لَا يُصَحِّحُونَ التَّعَدُّدَ لِذَلِكَ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَيَرَوْنَهُ غَلَطًا.
** وَذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهَا تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ النَّوَافِلِ. اهـ
** وانظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 438)
** وشرح النووي على مسلم (6/ 198)
** وفي فتاوى اللجنة الدائمة – 1 (8/ 324)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9527)
س5: كم عدد ركعات صلاة الخسوف وماذا يقرأ فيهما؟
ج5: صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر كل منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة ركوعان؛ الثاني منهما أقصر من الأول، وقراءتان، يقرأ بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة وسورة طويلة ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة، وسورة طويلة، لكنها أقصر مما قبلها، وفي كل ركعة سجدتان. هذا هو أصح ما ورد فيها. اهـ
** وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
** الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
** نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 14 / 11/ 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
126 ذكر بعض آيات موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم
سلسة الفوائد اليومية:
126 ذكر بعض آيات موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم
** قَال اللَّه تَعَالَى :{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا}
** وقَال تَعَالَى :{ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ }
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ»(ق)
** قال ابن كثير في تفسيره (5/ 114):
** يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ بَعَثَ مُوسَى بِتِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَهِيَ الدَّلَائِلُ الْقَاطِعَةُ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ وَصِدْقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَمَّنْ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ، وَهِيَ: الْعَصَا ، وَالْيَدُ ، وَالسِّنِينَ ، وَالْبَحْرُ ، وَالطُّوفَانُ ، وَالْجَرَادُ ، وَالْقُمَّلُ ، وَالضَّفَادِعُ ، وَالدَّمُ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ .
** وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: هِيَ الْيَدُ وَالْعَصَا، وَالْخَمْسُ فِي الْأَعْرَافِ وَالطَّمْسَةُ وَالْحَجَرُ،
** وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: هِيَ يَدُهُ ، وَعَصَاهُ ، وَالسِّنِينَ ، وَنَقْصُ الثَّمَرَاتِ ، وَالطُّوفَانُ ، وَالْجَرَادُ ، وَالْقُمَّلُ ، وَالضَّفَادِعُ ، وَالدَّمُ،
** وَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ حَسَنٌ قَوِيٌّ، وَجَعَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ السِّنِينَ وَنَقْصَ الثَّمَرَاتِ وَاحِدَةً، وَعِنْدَهُ أَنَّ التَّاسِعَةَ هِيَ تَلَقُّفُ الْعَصَا مَا يَأْفِكُونَ . اهـ
** وقال الزبيدي في كتابه (تاج العروس) (20/ 390):
** وقَوْلُهُ تَعَالَى: ولَقَدْ آتَيْنَا مُوَسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيَّناتٍ هِيَ:
** أَخْذُ آلِ فِرْعَوْنَ بالسِّنِينَ، وإِخْرَاجُ مُوسَى عَلَيْه السّلامُ يَدَهُ بَيْضَاءَ ، والعَصَا، والطُّوفانُ، والجَرَادُ، والقُمَّلُ، والضَّفَادِعُ، والدَّمُ، وانْفِلاقُ البَحْرِ.
** وقَدْ جَمَعَ ذلِكَ المُصَنِّفُ فِي بَيْتٍ واحدٍ فَقَالَ:
(عَصاً، سَنَةٌ، بَحْرٌ، جَرَادٌ، وقُمَّلٌ *
دَمٌ، ويَدٌ، بَعْدَ الضَّفادِعِ، طُوفانُ)
** وقَدْ ضَمَّنْتُه بِبَيْتٍ آخَرَ، فقُلْتُ:
(آياتُ مُوسَى الكَلِيمِ التِّسْعُ يَجْمَعُهَا *
بَيْتٌ فَرِيدٌ لَهُ فِي السَّبْك عُنْوَانُ)
. . . . . . . . . . . . . . .
** وجَعَلَهَا الزَّمَخْشَرِيّ إِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً،: فَزَاد الطَّمْسَةَ، والنُّقْصَانَ فِي مَزَارِعِهِم،
** وعِبَارَتُه : لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: كانَتِ الآيَاتُ إِحْدَى عَشرَةَ: ثِنْتَانِ مِنْهَا اليَدُ والعَصَا، والتَّسْعُ: الفَلقُ، والطُّوفانُ، والجَرَادُ، والقُمَّلُ، والضّفادِعُ، والدَّمُ، والطَّمْسُ، والجَدْبُ فِي بَوادِيهِمْ، والنَّقْصُ من مَزَارِعِهِم . انْتَهَى .
** ولَمْ يَذْكُرِ الجَوَابَ. اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 10 / 11/ 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
125 الأشهر في لفظ: ( ذي القعدة وذي الحجة ) فتح القاف و كسر الحاء
سلسة الفوائد اليومية:
125 الأشهر في لفظ: ( ذي القعدة وذي الحجة ) فتح القاف و كسر الحاء
** قال الإمام النووي في شرح على مسلم (11/ 168):
(أَمَّا ذُو الْقَعْدَةِ فَبِفَتْحِ الْقَافِ
وَذُو الْحِجَّةِ بِكَسْرِ الْحَاءِ
هَذِهِ اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ
وَيَجُوزُ فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ كَسْرُ الْقَافِ وَفَتْحُ الْحَاءِ). اهـ
** قال بعضهم :
وَفَتْحَ قَافِ قَعْدَةٍ قَدْ رَجَّحُوا * * *
وَكَسْرَ حَاءِ حِجَّةٍ قَدْ صَحَّحُوا
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 8 / 11 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
124 ذكر بعض الصحابة الكرام الذين جمعوا القران على عهد النبي عليه الصلاة والسلام
سلسة الفوائد اليومية:
124 ذكر بعض الصحابة الكرام الذين جمعوا القران على عهد النبي عليه الصلاة والسلام
** وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ” جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيٌّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ” قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي . متفق عليه
** وعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ – فَبَدَأَ بِهِ -، وَسَالِمٍ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ» متفق عليه
** شرح النووي على مسلم (16/ 19)
(جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ)
** قَالَ الْمَازِرِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْضُ الْمَلَاحِدَةِ فِي تَوَاتُرِ الْقُرْآنِ وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ غَيْرَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَجْمَعْهُ فَقَدْ يَكُونُ مُرَادُهُ الَّذِينَ عَلِمَهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُهُمْ فَلَمْ يَنْفِهِمْ , وَلَوْ نَفَاهُمْ كَانَ الْمُرَادُ نَفْيَ عِلْمِهِ وَمَعَ هَذَا فَقَدْ رَوَى غَيْرُ مُسْلِمٍ حِفْظَ جَمَاعَاتٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ مِنْهُمُ الْمَازِرِيُّ خَمْسَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا .
** وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ مِمَّنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَكَانَتِ الْيَمَامَةُ قَرِيبًا مِنْ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ جَامِعِيهِ يَوْمئِذٍ فَكَيْفَ الظَّنُّ بِمَنْ لَمْ يُقْتَلْ مِمَّنْ حَضَرَهَا وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا وَبَقِيَ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ أَوْ غَيْرِهِمَا .
** وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَنَحْوُهُمْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ يَبْعُدُ كُلُّ الْبُعْدِ أَنَّهُمْ لَمْ يَجْمَعُوهُ مَعَ كَثْرَةِ رَغْبَتِهِمْ فِي الْخَيْرِ وَحِرْصِهِمْ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَكَيْفَ نَظُنُّ هَذَا بِهِمْ وَنَحْنُ نَرَى أَهْلَ عَصْرِنَا حَفِظَهُ مِنْهُمْ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ أُلُوفٌ مَعَ بُعْدِ رَغْبَتِهِمْ فِي الْخَيْرِ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحَابَةِ مَعَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَحْكَامٌ مُقَرَّرَةٌ يَعْتَمِدُونَهَا فِي سَفَرِهِمْ وَحَضَرِهِمْ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ نَظُنُّ بِهِمْ إِهْمَالِهِ فَكُلُّ هَذَا وَشِبْهُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَحَدٌ يَجْمَعُ الْقُرْآنَ إِلَّا الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورُونَ .
الْجَوَابُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْهُ إِلَّا الْأَرْبَعَةُ لَمْ يَقْدَحْ فِي تَوَاتُرِهِ فَإِنَّ أَجْزَاءَهُ حَفِظَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا خَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ يَحْصُلُ التَّوَاتُرُ بِبَعْضِهِمْ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ التَّوَاتُرِ أَنْ يَنْقُلَ جَمِيعُهُمْ جَمِيعَهُ بَلْ إِذَا نَقَلَ كُلَّ جُزْءٍ عَدَدُ التَّوَاتُرِ صَارَتِ الْجُمْلَةُ مُتَوَاتِرَةً بِلَا شَكٍّ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا مُسْلِمٌ وَلَا مُلْحِدٌ . وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ
** قَوْلُهُ (قُلْتُ لِأَنَسٍ مَنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِي)
** أبوزيد هَذَا هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ النُّعْمَانَ الْأَوْسِيُّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بَدْرِيٌّ يعرف بسعد القاريء اسْتُشْهِدَ بِالْقَادِسِيَّةِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
** قال بن عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَخَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ فَقَالُوا هُوَ قَيْسُ بْنُ السَّكَنِ الْخَزْرَجِيُّ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بَدْرِيٌّ .
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : اسْتُشْهِدَ يَوْمَ جَيْشِ أَبِي عُبَيْدٍ بِالْعِرَاقِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْضًا . اهـ
** شرح النووي على مسلم (16/ 17)
** (خُذُوا القرآن من أربعة وذكر منهم بن مَسْعُودٍ)
** قَالَ الْعُلَمَاءُ : سَبَبُهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ ضَبْطًا لِأَلْفَاظِهِ وَأَتْقَنُ لِأَدَائِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ أَفْقَهَ فِي مَعَانِيهِ مِنْهُمْ .
** أَوْ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ تَفَرَّغُوا لِأَخْذِهِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَافَهَةً وَغَيْرُهُمُ اقْتَصَرُوا عَلَى أَخْذِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ..
** أَوْ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ تَفَرَّغُوا لِأَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُمْ .
** أَوْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْإِعْلَامَ بِمَا يَكُونُ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَقَدُّمِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَتَمَكُّنِهِمْ وَأَنَّهُمْ أَقْعَدُ من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم . اهـ
** وفي فتح الباري لابن حجر (9/ 52)
** ( … وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ الْحَدِيثَ , وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ .
** وَتَقَدَّمَ فِي الحَدِيث الَّذِي مضى ذكر بن مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ .
** وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقُرَّاءَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وبن مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَسَالِمًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ وَالْعَبَادِلَةَ , وَمِنَ النِّسَاءِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ .
** وَلَكِنَّ بَعْضَ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا أَكْمَلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَرُدُّ عَلَى الْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ .
** وعد بن أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَيْضًا : تَمِيمَ بْنَ أَوْسٍ الدَّارِيَّ وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ , وَمِنَ الْأَنْصَارِ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَمُعَاذًا الَّذِي يُكَنَّى أَبَا حَلِيمَةَ وَمُجْمِّعَ بْنَ حَارِثَةَ وَفَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ وَغَيْرَهُمْ وَصَرَّحَ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ إِنَّمَا جَمَعَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
** وَمِمَّنْ جَمَعَهُ أَيْضًا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ذَكَرَهُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ .
** وَعَدَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْقُرَّاءِ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَسَعْدَ بْنَ عَبَّادٍ وَأُمَّ وَرَقَةَ . اهـ
** وفي كتاب : (المدهش) , لابن الجوزي (ص: 51)
(تَسْمِيَة من جمع الْقُرْآن حفظا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)
** عُثْمَان بن عَفَّان , أبي , معَاذ بن جبل , أَبُو الدَّرْدَاء , زيد بن ثَابت , أَبُو زيد الْأنْصَارِيّ .
** قَالَ ابْن سِيرِين : وَتَمِيم الدَّارِيّ .
** وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَعبادَة بن الصَّامِت , وَأَبُو أَيُّوب . اهـ
** وانظر كتاب : ( إكمال المعلم بفوائد مسلم) , للقاضي عياض اليحصبي (7/ 492)
** وكتاب : ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم), لأبي العبَّاس القرطبيُّ (20/ 113)
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 6 / 11/ 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
===============
123 حالات المأموم مع إمامه من حيث الموافقة والمخالفة
سلسة الفوائد اليومية:
123 حالات المأموم مع إمامه من حيث الموافقة والمخالفة
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
” إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ” متفق عليه
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟» متفق عليه
** وفي كتاب (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) , (12/ 498)
** حال المأموم مع إمامه تنقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: مسابقة.
الثاني: تخلف.
الثالث: موافقة.
الرابع: متابعة.
القسم الأول: المسابقة:
** وهي أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع قبل ركوع الإمام، أو يسجد قبل سجود الإمام، أو يرفع من الركوع قبل رفع الإمام، أو يرفع من السجود قبل رفع الإمام.
** وهذا الذي يسبق الإمام قد عرض نفسه للعقوبة التي حذر منها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي: ((أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته صورة حمار)) .
وظاهر الحديث أنه حسا يعني أن يكون رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار.
** وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك التحويل المعنوي بأن يجعل رأسه رأس حمار أي رأساً بليداً، لأن الحمار من أبلد الحيوانات، ولهذا وصف الله اليهود الذين حملوا التوارة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً.
** ووصف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب بأنه مثل الحمار يحمل أسفاراً.
** وعلى كل حال فالحديث دال على أن مسابقة الإمام محرمة بل يوشك أن تكون من كبائر الذنوب.
** ولكن هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟
** الصحيح أنه إذا تعمد السبق فإن صلاته تبطل سواء سبقه بركن أو سبقه إلى الركن، فإذا تعمد السبق مع علمه بالنهي فإن صلاته تبطل، لأنه أتى محظوراً من محظورات العبادات على وجه يختص بها، والقاعدة أن من فعل محظوراً من محظورات العبادة على وجه يختص بها فإنها تبطل.
القسم الثاني: التخلف:
** يعني أن يتأخر عن إمامه، مثل أن يركع الإمام ويبقى المأموم قائماً إلى أن يقرب الإمام من الرفع من الركوع، أو يسجد الإمام ويبقى المأموم قائماً إلى أن يقرب الإمام من الرفع من السجود أو يقوم الإمام من السجود ويبقى المأموم ساجداً حتى ربما ينتصف الإمام بقراءة الفاتحة أو يكلمها.
** وحكم التخلف أنه حرام، لأنه خلاف أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: ((إذا ركع فأركعوا، وإذا سجد فأسجدوا)) . فإن الفاء في قوله ((فأركعوا)) وقوله: ((فاسجدوا)) تدل على التعقيب، أي على أن فعل المأموم يقع عقب فعل الإمام لأن قوله: ((فاركعوا فاسجدوا)) جواب الشرط، وجواب الشرط يلي المشروط مباشرة ولا يجوز أن يتخلف عنه.
القسم الثالث: الموافق:
** بمعنى أن يشرع المأموم مع الإمام في أفعاله يركع معه، ويسجد معه ويقوم معه، وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهاً، وتحتمل أن يكون محرماً لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد)).
** والأصل في النهي والتحريم، إلا الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن أهل العلم يقولون إنه إذا وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته فتكون باطلة، بل يجب أن ينتظر حتى يكمل الإمام تكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن يشرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يكمل الإمام تكبيرة الإحرام،
** ويستثنى أيضاً التسليم فإن بعض أهل العلم يقول إذا سلم الإمام التسليمة الأولى وهي التي على اليمين فللمأموم أن يسلم التسليمة الأولى وإن لم يسلم الإمام التسليمة الثانية، ثم يتابع التسليمة الثانية.
القسم الرابع: المتابعة:
** بأن يفعل المأموم ما فعله الإمام بعد الأمام مباشرة، بدون تخلف، وهذا هو الموافق للسنة ولأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لأن صفة المؤمن إذا أمر الله ورسوله بأمر أن يقول سمعنا وأطعنا , كما قال الله تعالى (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) , كما قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) . اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الاثنين 5 / 11/ 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
122 أكثر أعمار الأمة المحمدية إلى سبعين سنة , وقليل من يزيد على ذلك , وذكر بعض المعمرين
سلسة الفوائد اليومية:
122 أكثر أعمار الأمة المحمدية إلى سبعين سنة , وقليل من يزيد على ذلك , وذكر بعض المعمرين
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ »[ رواه الترمذي وغيره , وصححه الشيخان ]
** وفي كتاب: (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح),للملا علي القاري (8/ 3303):
** أَيْ : نِهَايَةُ أَكْثَرِ أَعْمَارِ أُمَّتِي غَالِبًا مَا بَيْنَهُمَا ,
(وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ ), أَيْ : السَّبْعِينَ فَيَصِلُ إِلَى الْمِائَةِ فَمَا فَوْقَهَا .
** وَأَكْثَرُ مَا اطَّلَعْنَا عَلَى طُولِ الْعُمُرِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمُعَمَّرِينَ فِي الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ :
** سِنُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , فَإِنَّهُ مَاتَ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ مِائَةٌ وَثَلَاثُ سِنِينَ .
** وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ , مَاتَتْ وَلَهَا مِائَةُ سَنَةٍ . وَلَمْ يَقَعْ لَهَا سِنٌّ وَلَمْ يُنْكَرْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ .
** وَأَزْيَدُ مِنْهُمَا عُمُرُ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ , مَاتَ وَلَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً عَاشَ , مِنْهَا سِتِّينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ .
** وَأَكْثَرُ مِنْهُ عُمُرًا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ , فَقِيلَ : عَاشَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً .
** وَقِيلَ : ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً , وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ،
** ثُمَّ مِنْ تَارِيخِ مَوْتِهِ يُفْهَمُ أَنَّهُ عَاشَ فِي الْإِسْلَامِ قَلِيلًا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّهُ مَاتَ بِالْمَدَائِنِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ،
** وَقَدْ أَدْرَكْنَا سَيِّدَنَا السَّيِّدَ زَكَرِيَّا وَسَمِعْنَا مِنْهُ أَنَّ عُمُرَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . اهـ
** وفي كتاب: (مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني), للمناوي (2/ 6)
(أعمار أمتي) أمة الدعوة لا أمة الإجابة كما هو بين ولكل مقام مقال .
(ما بين الستين) من السنين (إلى السبعين) أي ما بين الستين والسبعين.
** وإنما عبر بـ(إلى) التي للانتهاء , ولم يقل :(والسبعين) الذي هي حق التعبير ؛ ليبين أنها لا تدخل إلا على متعدد ؛ لأن التقدير :(ما بين الستين وفوقها إلى السبعين) فـ(إلى) غاية الفوقية لدلالة الكلام عليه .
** وقال بعضهم : معناه آخر عمر أمتي ابتداؤه إذا بلغ ستين وانتهاؤه سبعون.
(وأقلهم من يجوز ذلك) قال الطيبي: هذا محمول على الغالب بدليل شهادة الحال ؛ فإن منهم من لم يبلغ ستين .
** وهذا من رحمة اللّه بهذه الأمة ورفقه بهم , أخرهم في الأصلاب حتى أخرجهم إلى الأرحام بعد نفاد الدنيا ثم قصر أعمارهم لئلا يلتبسوا بالدنيا إلا قليلاً ؛
** فإن القرون السالفة كانت أعمارهم وأبدانهم وأرزاقهم أضعاف ذلك , كان أحدهم يعمر ألف سنة , وطوله ثمانون ذراعاً وأكثر وأقل ,
** وحبة القمح ككلوة البقرة .
** والرمانة يحملها عشرة , فكانوا يتناولون الدنيا بمثل تلك الأجساد وفي تلك الأعمار فبطروا واستكبروا وأعرضوا عن اللّه {فصب عليهم ربك سوط عذاب} ,
** فلم يزل الخلق ينقصون خلقاً ورزقاً وأجلاً إلى أن صارت هذه الأمة آخر الأمم يأخذون أرزاقاً قليلة بأبدان ضعيفة في مدة قصيرة كيلا يبطروا فذلك رحمة بهم .
** قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ :
** الْأَسْنَانُ أَرْبَعَةٌ : سِنُّ الطُّفُولِيَّةِ , ثُمَّ الشَّبَابِ , ثُمَّ الْكُهُولَةِ , ثُمَّ الشَّيْخُوخَةِ ,
** وَهِيَ آخِرُ الْأَسْنَانِ , وَغَالِبُ مَا يَكُونُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقُوَّةِ بِالنَّقْصِ وَالِانْحِطَاطِ .
** فَيَنْبَغِي لَهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الْآخِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى مِنَ النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ . اهـ
** وفي كتاب :(التنوير شرح الجامع الصغير), الصنعاني (2/ 513):
** (أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين) ينتهي في هذه العشر التي سمتها العرب وفاقة الرقاب كما قيل:
وإن امرأ قد صار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب
** ولذا ورد أنه قد أعذر الله من بلغ هذه السن،
** وروي أنها المراد من قوله {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّر} [فاطر: 37]
** وفائدة الإخبار بهذا حث من بلغ إليها أن يتزود للمعاد ويقطع عن الدنيا علائق كل مراد،
** وفيه رد لمن يدعي إثبات العمر الطبيعي الذي لا دليل عليه.
** (وأقلهم من يجوز) تجاوز (ذلك). اهـ
** (قلت): العمر الطبيعي للإنسان الذي ادعاه بعض الفقهاء والأطباء هو مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً .
** قال ابن كثير في تفسيره / ط العلمية (6/ 492):
** وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعُمُرَ الطَّبِيعِيَّ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً،
** فَالْإِنْسَانُ لَا يَزَالُ فِي ازْدِيَادٍ إِلَى كَمَالِ السِّتِّينَ، ثُمَّ يَشْرَعُ بَعْدَ هَذَا فِي النَّقْصِ وَالْهَرَمِ، كَمَا قَالَ الشاعر [الوافر] :
إِذَا بَلَغَ الْفَتَى سِتِّينَ عَامًا
فَقَدْ ذَهَبَ الْمَسَرَّةُ وَالْفَتَاءُ . اهـ المراد
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الجمعة 2 / 11/ 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
121 فضائل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد
سلسة الفوائد اليومية:
121 فضائل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد
** ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه القيم :(فتح الباري) (2/ 133) أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بأكثر من عشرين خصلة .
** فقال رحمه الله :
** وَقَدْ نَقَّحْتُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَحَذَفْتُ مَا لَا يَخْتَصُّ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ .
** فَأَوَّلُهَا : إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ .
** وَالتَّبْكِيرُ إِلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ .
** وَالْمَشْيُ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ .
** وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ دَاعِيًا .
** وَصَلَاةُ التَّحِيَّةِ عِنْدَ دُخُولِهِ كُلُّ ذَلِكَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ .
** سَادِسُهَا : انْتِظَارُ الْجَمَاعَةِ .
** سَابِعُهَا : صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُ .
** ثَامِنُهَا : شَهَادَتُهُمْ لَهُ .
** تَاسِعُهَا : إِجَابَةُ الْإِقَامَةِ .
** عَاشِرُهَا : السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ حِينَ يَفِرُّ عِنْدَ الْإِقَامَةِ .
** حَادِيَ عَاشِرَهَا : الْوُقُوفُ مُنْتَظِرًا إِحْرَامَ الْإِمَامِ أَوِ الدُّخُولُ مَعَهُ فِي أَي هَيْئَة وجده عَلَيْهَا .
** ثَانِيَ عَشَرَهَا : إِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَذَلِكَ .
** ثَالِثَ عَشَرَهَا : تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ وَسَدُّ فُرَجِهَا .
** رَابِعَ عَشَرَهَا : جَوَابُ الْإِمَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .
** خَامِسَ عَشَرَهَا : الْأَمْنُ مِنَ السَّهْوِ غَالِبًا وَتَنْبِيهُ الْإِمَامِ إِذَا سَهَا بِالتَّسْبِيحِ أَوِ الْفَتْحِ عَلَيْهِ .
** سَادِسَ عَشَرَهَا : حُصُولُ الْخُشُوعِ وَالسَّلَامَةِ عَمَّا يُلْهِي غَالِبًا .
** سَابِعَ عَشَرَهَا : تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ غَالِبًا .
** ثَامِنَ عَشَرَهَا : احْتِفَافُ الْمَلَائِكَةِ بِهِ .
** تَاسِعَ عَشَرَهَا : التَّدَرُّبُ عَلَى تَجْوِيدِ الْقِرَاءَةِ وَتَعَلُّمِ الْأَرْكَانِ وَالْأَبْعَاضِ
** الْعِشْرُونَ : إِظْهَارُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ .
** الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : إرغام الشَّيْطَان بالاجتماع على الْعِبَادَة والتعاون على الطاعة وَنَشَاطِ الْمُتَكَاسِلِ .
** الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : السَّلَامَةُ مِنْ صِفَةِ النِّفَاقِ وَمِنْ إِسَاءَةِ غَيْرِهِ الظَّنَّ بِأَنَّهُ تَرَكَ الصَّلَاةَ رَأْسًا .
** الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ .
** الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الِانْتِفَاعُ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَعَوْدُ بَرَكَةِ الْكَامِلِ عَلَى النَّاقِصِ .
** الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : قِيَامُ نِظَامِ الْأُلْفَةِ بَيْنَ الْجِيرَانِ وَحُصُولُ تَعَاهُدِهِمْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ .
** فَهَذِهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ خَصْلَةً , وَرَدَ فِي كُلٍّ مِنْهَا أَمْرٌ أَوْ تَرْغِيبٌ يَخُصُّهُ .
** وَبَقِيَ مِنْهَا أَمْرَانِ يَخْتَصَّانِ بِالْجَهْرِيَّةِ وَهُمَا : الْإِنْصَاتُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالِاسْتِمَاعُ لَهَا , وَالتَّأْمِينُ عِنْدَ تَأْمِينِهِ لِيُوَافِقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ , وَبِهَذَا يَتَرَجَّحُ أَنَّ السَّبْعَ تَخْتَصُّ بِالْجَهْرِيَّةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 1 / 11/ 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
================
120 من فوارس الإسلام الذين يضرب بهم المثل في الشجاعة : أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيّ , شيخ الإمام البُخَارِيُّ
سلسة الفوائد اليومية:
120 من فوارس الإسلام الذين يضرب بهم المثل في الشجاعة : أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيّ , شيخ الإمام البُخَارِيُّ
** وفي سير أعلام النبلاء / ط الرسالة (13/ 37)
22 – أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ أَبُو إِسْحَاقَ * (خَ (1))
** الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، العَابِدُ، المُجَاهِدُ، فَارِسُ الإِسْلاَمِ، أَبُو إِسْحَاقَ: مِنْ أَهْلِ سُرْمَارَى، مِنْ قُرَى بُخَارَى.
** سَمِعَ: مَنْ يَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ، وَعُثْمَانَ بنِ عُمَرَ بنِ فَارِسٍ، وَأَبِي عَاصِمٍ، وَطَبَقَتِهِم.
** حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ) ، وَإِدْرِيْسُ بنُ عَبْدَكَ، وَآخَرُوْنَ.
** وَكَانَ أَحَدَ الثِّقَاتِ، وَبِشَجَاعَتِهِ يُضْرَبُ المَثَلُ.
** قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَفَّانَ البَزَّازُ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ، فَجَرَى ذِكْرُ أَبِي إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيِّ، فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلَهُ، فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَحِيْدُ رَئِيْسُ المُطَّوِّعَةِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَغَضِبَ وَدَخَلَ عَلَى البُخَارِيِّ، وَسَأَلَهُ.
فَقَالَ: مَا كَذَا قُلْتُ: بَلْ: مَا بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ الجَاهِلِيَّةِ مِثْلُهُ.
سَمِعَهَا إِسْحَاقُ بنُ أَحْمَدَ بنِ خَلَفٍ مِنِ ابْنِ عَفَّانَ.
** قَالَ أَبُو صَفْوَانَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي يَوْماً، وَهُوَ يَأْكُلُ وَحَدَهُ، فَرَأَيتُ فِي مَائِدتِهِ عُصْفُوراً يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآنِي طَارَ.
** وَعَنْ أَحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: يَنْبَغِي لِقَائِدِ الغُزَاةِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ يَكُوْنَ فِي قَلْبِ الأَسَدِ لاَ يَجْبُنُ، وَفِي كِبْرِ النَّمِرِ لاَ يَتَوَاضَعُ، وَفِي شَجَاعَةِ الدُّبِّ يَقْتُلُ بِجَوَارِحِهِ كُلِّهَا، وَفِي حَمْلَةِ الخِنْزِيرِ لاَ يُوَلِّي دُبُرَهُ، وَفِي غَارَةِ الذِّئْبِ إِذَا أَيِسَ مِنْ وَجْهٍ أَغَارَ مِنْ وَجْهٍ، وَفِي حَمْلِ السِّلاَحِ كَالنَّمْلَةِ تَحْمِلُ أَكثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، وَفِي الثَّبَاتِ كَالصَّخْرِ، وَفِي الصَّبْرِ كَالحِمَارِ، وَفِي الوَقَاحَةِ كَالكَلْبِ لَوْ دَخَلَ صَيْدُهُ النَّارَ لَدَخَلَ خَلْفَهُ، وَفِي التِمَاسِ الفُرْصَةِ كَالدِّيْكِ.
** غُنْجَارُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بنَ خَالِدٍ المُطَّوِّعِيَّ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِدْرِيْسَ المُطَّوِّعِيَّ البُخَارِيَّ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بنَ شَمَّاسٍ، يَقُوْلُ:
كُنْتُ أُكَاتِبُ أَحْمَدَ بنَ إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيَّ، فَكَتَبَ إلِيَّ: إِذَا أَرَدْتَ الخُرُوجَ إِلَى بلاَدِ الغُزَيَّةِ فِي شِرَاءِ الأَسْرَى، فَاكْتُبْ إلِيَّ.
** فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ، فَقَدِمَ سَمَرْقَنْدَ، فَخَرَجْنَا، فَلَمَّا عَلِمَ جَعْبَوَيْه، اسْتَقْبَلَنَا فِي عِدَّةٍ مِنْ جُيُوْشِهِ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ، فَعَرَضَ يَوْماً جَيْشَهُ، فَمَرَّ رَجُلٌ، فَعَظَّمَهُ، وَخَلَعَ عَلَيْهِ، فَسَأَلنِي عَنْهُ السُّرْمَارِيُّ، فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ مُبَارِزٌ، يُعَدُّ بِأَلْفِ فَارِسٍ.
** قَالَ: أَنَا أُبَارِزُهُ.
** فَسَكَتُّ، فَقَالَ جَعْبَوَيْه: مَا يَقُوْلُ هَذَا؟
** قُلْتُ: يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا.
** قَالَ: لَعَلَّهُ سَكْرَانُ لاَ يَشْعُرُ، وَلَكِنْ غَداً نَرْكَبُ.
** فَلَمَّا كَانَ الغَدُ رَكِبُوا، فَرَكِبَ السُّرْمَارِيُّ مَعَهُ عَمُوْدٌ فِي كُمِّهِ، فَقَامَ بإِزَاءِ المُبَارِزِ، فَقَصَدَهُ، فَهَرَبَ أَحْمَدُ حَتَّى بَاعَدَهُ مِنَ الجَيْشِ، ثُمَّ كَرَّ، وَضَرَبَهُ بِالعَمُوْدِ قَتَلَهُ، وَتَبِعَ إِبْرَاهِيْمَ بنَ شَمَّاسٍ، لأَنَّهُ كَانَ سَبَقَهُ، فَلَحِقَهُ،
** وَعَلِمَ جَعْبَوَيه، فَجَهَّزَ فِي طَلَبِهِ خَمْسِيْنَ فَارِساً نَقَاوَةً، فأَدْرَكُوهُ، فَثَبَتَ تَحْتَ تَلٍّ مُخْتَفِياً، حَتَّى مَرُّوا كُلُّهُم، وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ، وَجَعَلَ يَضْرِبُ بِعَمُودِهِ مِنْ وَرَائِهِم، إِلَى أَنْ قَتَلَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِيْنَ، وَأَمْسَكَ وَاحِداً، قَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَيْهِ، وَأَطْلَقَهُ لِيُخْبِرَ،
** ثُمَّ بَعْدَ عَامَيْن تُوُفِّيَ أَحْمَدُ، وَذَهَبَ ابْنُ شَمَّاسٍ فِي الفِدَاءِ، فَقَالَ لَهُ جَعْبَوَيْه: مَنْ ذَاكَ الَّذِي قَتَلَ فُرْسَانَنَا ؟
** قَالَ: ذَاكَ أَحْمَدُ السُّرْمَارِيُّ.
** قَالَ: فَلِمَ لَمْ تَحْمِلْهُ مَعَكَ؟
** قُلْتُ: تُوُفِّيَ، فَصَكَّ فِي وَجْهِي، وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمْتَنِي أَنَّهُ هُوَ لَكُنْتُ أُعْطِيْهِ خَمْسَ مائَةَ بِرْذَوْنٍ (1) ، وَعَشْرَةَ آلاَفِ شَاةٍ.
وَعَنْ بَكْرِ بنِ مُنِيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ السُّرْمَارِيَّ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، ضَخْماً، مَاتَ بِقَرْيَتِهِ، فَبَلَغَ كِرَاءُ الدَّابَّةِ إِلَيْهَا عَشْرَةَ دَرَاهِم،
** وَخَلَّفَ دُيُوْناً كَثِيْرَةً، فَكَانَ غُرَمَاؤُهُ، رُبَّمَا يَشْتَرُوْنَ مِنْ تَرِكَتِهِ حُزْمَةَ القَصَبِ بخَمْسِيْنَ دِرْهَماً، إِلَى مائَةٍ، حُبّاً لَهُ، فَمَا رَجَعُوا حَتَّى قُضَيَ دَيْنُهُ.
** عَنْ عِمْرَانَ بنِ مُحَمَّدٍ المُطَّوِّعِيِّ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: كَانَ عَمُودُ المُطَّوِّعِيِّ السُّرْمَارِيِّ وَزْنَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَنّاً (2) ، فَلَمَّا شَاخَ جَعَلَهُ اثْنَيْ عَشَرَ مَنّاً، وَكَانَ بِهِ يُقَاتِلُ.
** قَالَ غُنْجَارُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ خَالِدٍ، وَأَحْمَدَ بنَ مُحَمَّدٍ، قَالاَ:
سَمِعْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ جَرِيْرٍ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بنَ وَاصِلٍ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ السُّرْمَارِيَّ يَقُوْلُ، وَأَخْرَجَ سَيْفَهُ، فَقَالَ: أَعْلَمُ يَقِيْناً أَنِّي قَتَلْتُ بِهِ أَلْفَ تُرْكِيٍّ،
** وَإِنْ عِشْتُ قَتَلْتُ بِهِ أَلْفاً أُخرَى،
** وَلَوْلاَ خُوْفِي أَنْ يَكُوْنَ بِدْعَةً لأَمَرْتُ أَنْ يُدْفَنَ مَعِي (3) .
** وَعَنْ مَحْمُوْدِ بنِ سَهْلٍ الكَاتِبِ، قَالَ: كَانُوا فِي بَعْضِ الحُرُوبِ يُحَاصِرُوْنَ مَكَاناً، وَرَئِيْسُ العَدُوِّ قَاعِدٌ عَلَى صُفَّةٍ (4) ، فَرَمَى السُّرْمَارِيُّ سَهْماً، فَغَرَزَهُ فِي الصُّفَّةِ، فَأَوْمَأَ الرَّئيسُ لِيَنْزِعَهُ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ خَاطَ يَدَهُ، فَتَطَاوَلَ الكَافِرُ لِيَنْزِعَهُ مِنْ يَدِهِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ ثَالثٍ فِي نَحْرِهِ، فَانْهَزَمَ العَدُوُّ، وَكَانَ الفَتْحُ.
** قُلْتُ: أَخْبَارُ هَذَا الغَازِي تَسُرُّ قَلْبَ المُسْلِمِ.
** قَالَ الحَافِظُ أَبُو القَاسِمِ الدِّمَشْقِيُّ: تُوُفِّيَ فِي شَهْرِ رَبِيْعٍ الآخرِ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ (5) – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – فَإِنَّهُ كَانَ مَعَ فَرْطِ شَجَاعَتِهِ مِنَ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ العُبَّادِ.
** قَالَ وَلَدُهُ أَبُو صَفْوَانَ: وَهَبَ المَأْمُوْنُ لأَبِي ثَلاَثِيْنَ أَلْفاً، وَعَشْرَةَ أَفْرَاسٍ، وَجَارِيَةً، فَلَمْ يَقْبَلْهَا. اهـ
____
(1) البرذون: ضرب من الدواب، يخالف الخيل العراب، عظيم الخلقة، غليظ الاعضاء.
(2) المن: زنة رطلين.
(3) انظر: تهذيب التهذيب: 1 / 14.
(4) الصفة: الظلة، والبهو الواسع العالي السقف.
(5) وذكر الصفدي وفاته في حدود سنة (250) . انظر: الوافي بالوفيات: 6 / 241.
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الاثنين 28 / 10 / 1440 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
===============
119 ليس للعبد غنى عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك
سلسة الفوائد اليومية:
119 ليس للعبد غنى عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك
** قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}
** وقال: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ}
** قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: (تيسير الكريم الرحمن) (ص: 687):
** يخاطب تعالى جميع الناس، ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه:
** فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم، لم يوجدوا.
** فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، التي لولا إعداده إياهم [بها] ، لما استعدوا لأي عمل كان.
** فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور، لما حصل [لهم] من الرزق والنعم شيء.
** فقراء في صرف النقم عنهم، ودفع المكاره، وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه عنهم، وتفريجه لكرباتهم، وإزالته لعسرهم، لاستمرت عليهم المكاره والشدائد.
** فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية، وأجناس التدبير.
** فقراء إليه، في تألههم له، وحبهم له، وتعبدهم، وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك، لهلكوا، وفسدت أرواحهم، وقلوبهم وأحوالهم.
** فقراء إليه، في تعليمهم ما لا يعلمون، وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه، لم يتعلموا، ولولا توفيقه، لم يصلحوا.
** فهم فقراء بالذات إليه، بكل معنى، وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا،
** ولكن الموفق منهم، الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له، ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه، الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها.
** {وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} أي: الذي له الغنى التام من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه، ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته، وكونها كلها، صفات كمال، ونعوت وجلال.
** ومن غناه تعالى، أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة،
** {الحميد} في ذاته، وأسمائه، لأنها حسنى،
وأوصافه، لكونها عليا،
وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة،
وفي أوامره ونواهيه،
فهو الحميد على ما فيه، وعلى ما منه،
وهو الحميد في غناه [الغني في حمده] .اهـ
** وعَنِ الْبَرَاء بْن عَازِبٍ – رضى الله عنهما – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلِ: . . . لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ . . .» متفق عليه
** وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: « . . . يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ،
يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ،
يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ،. . . » رواه مسلم .
** قال ابن القيم- رحمه الله – في كتابه:(مدارج السالكين), (3/ 156):
** ” فِي الْقَلْبِ شَعَثٌ، لَا يَلُمُّهُ إِلَّا الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ. وَفِيهِ وَحْشَةٌ، لَا يُزِيلُهَا إِلَّا الْأُنْسُ بِهِ فِي خَلْوَتِهِ.
** وَفِيهِ حُزْنٌ لَا يُذْهِبُهُ إِلَّا السُّرُورُ بِمَعْرِفَتِهِ وَصِدْقِ مُعَامَلَتِهِ.
** وَفِيهِ قَلَقٌ لَا يُسَكِّنُهُ إِلَّا الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ، وَالْفِرَارُ مِنْهُ إِلَيْهِ.
** وَفِيهِ نِيرَانُ حَسَرَاتٍ لَا يُطْفِئُهَا إِلَّا الرِّضَا بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَقَضَائِهِ، وَمُعَانَقَةُ الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ إِلَى وَقْتِ لِقَائِهِ.
** وَفِيهِ طَلَبٌ شَدِيدٌ لَا يَقِفُ دُونَ أَنْ يَكُونَ هُوَ وَحْدَهُ مَطْلُوبَهُ.
** وَفِيهِ فَاقَةٌ: لَا يَسُدُّهَا إِلَّا مَحَبَّتُهُ، وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ، وَدَوَامُ ذِكْرِهِ، وَصِدْقُ الْإِخْلَاصِ لَهُ.
** وَلَوْ أُعْطِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَمْ تَسُدَّ تِلْكَ الْفَاقَةَ مِنْهُ أَبَدًا. “. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 26/ 10 / 1440 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
118 ذكر بعض صفات قائد الجند فِي الْحُرُوبِ
سلسة الفوائد اليومية:
118 ذكر بعض صفات قائد الجند فِي الْحُرُوبِ
118 ذكر بعض صفات قائد الجند فِي الْحُرُوبِ
قال الإِمَامُ، الزَّاهِدُ، العَابِدُ، المُجَاهِدُ، فَارِسُ الإِسْلاَمِ، أَبُو إِسْحَاقَ أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيّ البُخَارِيُّ رحمه الله تعالى , كما في ترجمته من كتاب : (سير أعلام النبلاء), (13/ 37) / ط الرسالة :
** يَنْبَغِي لِقَائِدِ الغُزَاةِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَشْرُ خِصَالٍ:
** أَنْ يَكُوْنَ فِي قَلْبِ الأَسَدِ لاَ يَجْبُنُ .
** وَفِي كِبْرِ النَّمِرِ لاَ يَتَوَاضَعُ [ للِعَدُوِّ ] .
** وَفِي شَجَاعَةِ الدُّبِّ يَقْتُلُ بِجَوَارِحِهِ كُلِّهَا .
** وَفِي حَمْلَةِ الخِنْزِيرِ لاَ يُوَلِّي دُبُرَهُ ، [ إِذَا حُمِلَ ] .
** وَفِي غَارَةِ الذِّئْبِ إِذَا أَيِسَ مِنْ وَجْهٍ أَغَارَ مِنْ وَجْهٍ [ آخَرَ ] .
** وَفِي حَمْلِ السِّلاَحِ [ الثقيل ] كَالنَّمْلَةِ تَحْمِلُ أَكثَرَ مِنْ وَزْنِهَا .
** وَفِي الثَّبَاتِ كَالصَّخْرِ [ لَا يَزُولُ عنْ مَكَانِهِ ] .
** وَفِي الصَّبْرِ كَالحِمَارِ [ إِذَا أثقله ضرب السيوف، وطعن الرماح، ونصول السهام ] .
** وَفِي الوَقَاحَةِ كَالكَلْبِ لَوْ دَخَلَ صَيْدُهُ النَّارَ لَدَخَلَ خَلْفَهُ .
** وَفِي التِمَاسِ الفُرْصَةِ كَالدِّيْكِ . اهـ بزيادة ما بين المعكوفين من
كتاب :(حياة الحيوان الكبرى) للدميري (2/ 297)
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 4 / 3/ 1440 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
====================
117 من أكثر النعم التي فرط فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ
سلسة الفوائد اليومية:
117 من أكثر النعم التي فرط فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ
قال الله تعالى :{ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}
** وقال تعالى :{ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}
** وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ). رواه البخاري
** وفي (حاشية السندي على سنن ابن ماجه), (2/ 542):
** قَوْلُهُ: (مَغْبُونٌ فِيهِمَا) أَيْ: ذُو خُسْرَانٍ فِيهِمَا .
** قَالَ ابْنُ الْخَازِنِ : النِّعْمَةُ مَا يَتَنَعَّمُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَيَسْتَلِذُّهُ .
** (وَالْغَبَنُ) : أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَضْعَافِ الثَّمَنِ، أَوْ يَبِيعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ،
** فَمَنْ صَحَّ بَدَنُهُ وَتَفَرَّغَ مِنَ الْأَشْغَالِ الْعَائِقَةِ وَلَمْ يَسْعَ لِصَلَاحِ آخِرَتِهِ فَهُوَ كَالْمَغْبُونِ فِي الْبَيْعِ . اهـ
** وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ أَنَّ غَالِبَ النَّاسِ لَا يَنْتَفِعُونَ بِالصِّحَّةِ وَالْفَرَاغِ، بَلْ يَصْرِفُونَهُمَا فِي غَيْرِ مَحَالِّهِمَا فَيَصِيرُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي حَقِّهِمْ وَبِالاً بْعَدِ أنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَوْ صَرَفُوهُ فِي مَحِلِّهِ لَكَانَ لَهُمْ خَيْرًا أَيَّ خَيْر , فَكَانُوا يَتَبَدَّلُونَ بِذَلِكَ الْخَيْرِ هَذَا الْوَبَالَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ. اهـ
** وفي كتاب : (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين),
لابن علان (2/ 313):
** و(نعمتان) مبتدأ , وخبره : (مغبون فيهما) من الغبن , وهو الشراء بأضعاف الثمن، أو البيع بدون ثمن المثل وهو وصف،
و: (كثير من الناس) نائب فاعله .
** أو مبتدأ , وخبره (مغبون) و(فيهما) ظرف لغو،
** والجملة الخبر،
** والرابط ضمير الوصف ,
** وأفرد باعتبار لفظ : (كثير) .
** (الصحة والفراغ) بدلان من :(نعمتان) بدل مفصل من مجمل.
** شبه (المكلف) بالتاجر , و(الصحة) : أي في البدن، و(الفراغ): أي من العوائق عن الطاعة برأس المال ؛ لأنهما من أسباب الأرباح ومقدمات نيل النجاح،
** فمن عامل الله تعالى بامتثال أوامره وابتدر الصحة والفراغ يربح،
** ومن لا ضاع رأس ماله ولا ينفعه الندم .اهـ
** وفي كتاب (فتح الباري),لابن حجر (11/ 230) شرح أوسع لهذا الحديث فارجع إليه إن شئت :
** وفي كتاب ( الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار) , للسيوطي (ص: 5):
** أنشدنا أبو عصمة محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن خلف بن المهلّب السختياني بالبصرة لنفسه:
أنْبَـأنـا خـيـرُ بـني آدمٍ
وما على أحمد إلاَّ البلاغْ
الناسُ مغبونون في نعمتَيْ
صـحة أبدانهم والفراغْ
** أخرجه ابن النجّار في تاريخ بغداد من طريق ابن روزبة أنه قرئ عليه هذا في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. اهـ المراد
** وفي كتاب (جامع العلوم والحكم) ت الأرنؤوط (2/ 387) :
** وَمِمَّا أَنْشَدَ بَعْضُ السَّلَفِ:
إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا
وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ
فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا
فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ.
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 3 / 3/ 1440 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
=================
116 الشتاء غنيمة المؤمن , نهاره قصيرٌ فيصومه، وليله طويل فيقومه
سلسة الفوائد اليومية:
116 الشتاء غنيمة المؤمن , نهاره قصيرٌ فيصومه، وليله طويل فيقومه
** قال تعالى : (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) )
** وعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الغَنِيمَةُ البَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ.
** رواه الترمذي في سننه برقم (797 ) ( 2/ 154) وقال : هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ القُرَشِيِّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ. اهـ
** وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم : (3943) ,
** ثم حسنه في الصحيحة برقم: (1922) ببعض الشواهد .
** وفي كتاب : (تحفة الأحوذي), للمباركفورى (3/ 427):
** (عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ) بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيِّ , يُقَالُ : لَهُ صُحْبَةٌ , وذكره بن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي التَّابِعِينَ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ .
** قَوْلُهُ (الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ) لِوُجُودِ الثَّوَابِ بِلَا تَعَبٍ كَثِيرٍ وَفِي الْفَائِقِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ هِيَ الَّتِي تَجِيءُ عَفْوًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْطَلِيَ دُونَهَا بِنَارِ الْحَرْبِ وَيُبَاشِرُ حَرَّ الْقِتَالِ فِي الْبَلَاءِ .
** وَقِيلَ : هِيَ الْهَيْئَةُ الطَّيِّبَةُ , مأخوذة مِنَ الْعَيْشِ الْبَارِدِ ,
** وَالْأَصْلُ فِي وُقُوعِ الْبَرْدِ عِبَارَةٌ عَنِ الطِّيبِ وَالْهَنَاءَةِ أَنَّ الْمَاءَ وَالْهَوَاءَ لما كان طيبهما ببردهما خصوصا في بلاد الحارة قيل : ماء بارد وهواء بارد على طَرِيقِ الِاسْتِطَابَةِ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى قِيلَ : عَيْشٌ بَارِدٌ , وَغَنِيمَةٌ بَارِدَةٌ , وَبَرَدَ أَمْرُنَا .
** قَالَ الطِّيبِيُّ : وَالتَّرْكِيبُ مِنْ قَلْبِ التَّشْبِيهِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ : الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ كَالْغَنِيمَةِ الْبَارِدَةِ ,
** وَفِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ أَنْ يَلْحَقَ النَّاقِصُ بِالْكَامِلِ كَمَا يُقَالُ : زَيْدٌ كَالْأَسَدِ , فَإِذَا عُكِسَ وَقِيلَ : الْأَسَدُ كَزَيْدٍ , يُجْعَلُ الْأَصْلُ كَالْفَرْعِ وَالْفَرْعُ كَالْأَصْلِ يَبْلُغُ التَّشْبِيهُ إِلَى الدَّرَجَةِ الْقُصْوَى فِي الْمُبَالَغَةِ ,
** وَالْمَعْنَى : أَنَّ الصائم يحوز الْأَجْرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهُ حَرُّ الْعَطَشِ أَوْ يُصِيبَهُ أَلَمُ الْجُوعِ مِنْ طُولِ الْيَوْمِ . انْتَهَى
** وقال ابن رجب رحمه الله في كتابه :(لطائف المعارف), (ص: 326):
(المجلس الثالث في ذكر فصل الشتاء).
** خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الشتاء ربيع المؤمن”
** وخرجه البيهقي وغيره وزاد فيه: “طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه”
** إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات ؛
** فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام
** وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة”
** وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى فيقول: الصيام في الشتاء ومعنى كونها غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة.
** وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن وقد أخذت نفسه حظها من النوم فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه.
** ومن كلام يحيى بن معاذ : الليل طويل فلا تقصره بمنامك , والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك .
** بخلاف ليل الصيف فإنه لقصره وحره يغلب النوم فيه فلا تكاد تأخذ النفس حظها بدون نومه كله فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدة وقد لا يتمكن فيه لقصره من الفراغ من ورده من القرآن .
** ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام .
** وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه .
** وعن الحسن قال: نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه
** وعن عبيد بن عمير : أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا , وقصر النهار لصيامكم فصوموا.
** قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف ؛ ولهذا بكى معاذ عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر .
** وقال معضد: لولا ثلاث : ظمأ الهواجر , وقيام ليل الشتاء , ولذاذة التهجد بكتاب الله , ما بليت أن أكون يعسوبا .
** القيام في ليل الشتاء يشق على النفوس من وجهين:
** أحدهما : من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد .
قال داود بن رشيد: قام بعض إخواني إلى ورده بالليل في ليلة شديدة البرد فكان عليه خلقان فضربه البرد فبكى , فهتف به هاتف : أقمناك وأنمناهم وتبكي علينا خرجه أبو نعيم.
** والثاني: بما يحصل بإسباغ الوضوء في شدة البرد من التألم .
** وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال .
** وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات”؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: “إسباغ الوضوء على الكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط” . . . الخ . اهـ المراد
(تنبيه): حديث :(الشتاء ربيع المؤمن) ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم: (7172)
** وفي كتاب ( فتح الباري ) , لابن حجر (1/ 481) :
وَأخرج الْحَاكِم فِي تَارِيخه من شعره [ يعني البخاري ] قَوْله :
اغْتَنِمْ فِي الْفَرَاغِ فَضْلَ رُكُوعٍ
فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مَوْتُكَ بَغْتَةْ
كَمْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ
ذَهَبَتْ نَفْسُهُ الصَّحِيحَةُ فَلْتَةْ
** وفي كتاب :(تفسير القرطبي), (5/ 384)
** وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:
إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا
فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُكُونُ
وَلَا تَغْفُلْ عَنِ الْإِحْسَانِ فِيهَا
فَمَا تَدْرِي السُّكُونُ مَتَى يَكُونُ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 29 / 2/ 1440 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
=================
115 من طبيعة الإنسان التضجر من حاله ولو كان هذا الحال طيبا, فلا يشكر عند السراء ولا يصبر عند الضراء إلا المؤمن
سلسة الفوائد اليومية:
115 من طبيعة الإنسان التضجر من حاله ولو كان هذا الحال طيبا, فلا يشكر عند السراء ولا يصبر عند الضراء إلا المؤمن
** قال تعالى :{ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (61)}
وفي تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 280):
** يَقُولُ تَعَالَى: وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ فِي إِنْزَالِي عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، طَعَامًا طَيِّبًا نَافِعًا هَنِيئًا سَهْلًا وَاذْكُرُوا دَبَرَكم وَضَجَرَكُمْ مِمَّا رزَقتكم وَسُؤَالَكُمْ مُوسَى اسْتِبْدَالَ ذَلِكَ بِالْأَطْعِمَةِ الدَّنِيَّةِ مِنَ الْبُقُولِ وَنَحْوِهَا مِمَّا سَأَلْتُمْ.
** وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَبَطَرُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَصْبِرُوا عَلَيْهِ، وَذَكَرُوا عَيْشَهُمُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، وَكَانُوا قَوْمًا أَهْلَ أَعْدَاسٍ وَبَصَلٍ وَبَقْلٍ وَفُومٍ، فَقَالُوا: {يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا} [وَهُمْ يَأْكُلُونَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، لِأَنَّهُ لَا يَتَبَدَّلُ وَلَا يَتَغَيَّرُ كُلَّ يَوْمٍ فَهُوَ كَأَكْلٍ وَاحِدٍ]. فَالْبُقُولُ وَالْقِثَّاءُ وَالْعَدَسُ وَالْبَصَلُ كُلُّهَا مَعْرُوفَةٌ. وَأَمَّا “الْفُومُ” فَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي مَعْنَاهُ
. . .
** وَالْمَعْنَى عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لَهُمْ: هَذَا الَّذِي سَأَلْتُمْ لَيْسَ بِأَمْرٍ عَزِيزٍ، بَلْ هُوَ كَثِيرٌ فِي أَيِّ بَلَدٍ دَخَلْتُمُوهُ وَجَدْتُمُوهُ، فَلَيْسَ يُسَاوِي مَعَ دَنَاءَتِهِ وَكَثْرَتِهِ فِي الْأَمْصَارِ أَنْ أَسْأَلَ اللَّهَ فِيهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ} أَيْ: مَا طَلَبْتُمْ،
** وَلَمَّا كَانَ سُؤَالُهُمْ هَذَا مِنْ بَابِ الْبَطَرِ وَالْأَشَرِ وَلَا ضَرُورَةَ فِيهِ، لَمْ يُجَابُوا إِلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ
** وقال تعالى :{ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) }
** قال العلامة السعدي في تفسيره :(تيسير الكريم الرحمن),(ص: 887):
** وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية، أنه هلوع.
** وفسر الهلوع بأنه: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا} فيجزع إن أصابه فقر أو مرض، أو ذهاب محبوب له، من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله.
** {وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} فلا ينفق مما آتاه الله، ولا يشكر الله على نعمه وبره، فيجزع في الضراء، ويمنع في السراء.
** {إِلا الْمُصَلِّينَ} الموصوفين بتلك الأوصاف فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله، وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. اهـ
** وعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ فَوَجَدَهُ حَارًّا فَقَالَ:(حَسٍّ)
** وَقَالَ:(ابْنُ آدَمَ إِنَّ أَصَابَهُ بردٌ قَالَ: حَسٍّ وَإِنَّ أَصَابَهُ حرٌّ قَالَ: حَسٍّ)
رواه أحمد وغيره , [الألباني : صحيح]
* * وفي كتاب : (التنوير شرح الجامع الصغير) , للصنعاني (3/ 556):
** قوله :(إن أصابه حر قال: حس)
بالحاء المهملة المفتوحة والسين، وفي الشرح: المكسور والسين المهملة، كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَضَّه أو أحرقه غفلة كالجمرة أو الضربة، أفاده في النهاية .
** وليست هذه الكلمة باسم ولا فعل بل صوت كالأنين الحادث عند المرض.
** وقوله : (وإن أصابه برد قال حس) أي فهو يتوجع من الأمرين الحر والبرد،
** وهو إعلام بأن هذا طبعه وليس فيه نهي إلا أن يدعي أن السياق يفيده
** كما قال من أشار إلى معناه:
يَتَمَنَّى الْمَرْءُ فِي الصَّيْفِ الشِّتَا
فَإِذَا جَاءَ الشِّتَا أَنْكَرَهُ
فَـهْوَ لَا يَرْضَى بِحَـالٍ وَاحِـدٍ
قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ . اهـ بتصرف
** وقال محمود العقاد:
صغير يطلب الكبرا
وشيخ ” ودّ لو صغرا
وخالٍ يشتهي عملاً
وذو عمل به ضجرا
ورب المال في تعب
وفي تعب من افتقرا
ويشقى المرء منهزما
ولا يرتاح منتصرا
ويبغى المجد في لهف
فإن يظفر به فترا . اهـ
** وعَنْ أبي يحيى صُهَيْبٍ بن سنانٍ – رضي الله عنه -، ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» رواه مسلم.
** وفي كتاب : (التنوير شرح الجامع الصغير), للصنعاني (7/ 204):
** (إن أصابته سراء) يسر به ونعمة حادثة. (شكر فكان) الشكر، (خيراً له) لما فيه من الأجر.
** (وإن أصابته ضراء صبر فكان) الصبر، (خيراً له) لأنه يحوز أجر الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب فكان أمره كله خير،
** هذا إن عمل بحق الإيمان فشكر وصبر وإلا كان أمره كله شرًّا له إن لم يشكر ولم يصبر. اهـ باختصار
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 267/ 2/ 1440 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
=================
114 ذكر بعض آداب الكلام
سلسة الفوائد اليومية:
114 ذكر بعض آداب الكلام
** قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي في كتابه : (أدب الدنيا والدين), (ص: 282):
** وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْكَلَامِ آدَابًا إنْ أَغْفَلَهَا الْمُتَكَلِّمُ أَذْهَبَ رَوْنَقَ كَلَامِهِ، وَطَمَسَ بَهْجَةَ بَيَانِهِ، وَلَهَا النَّاسَ عَنْ مَحَاسِنِ فَضْلِهِ بِمُسَاوِي أَدَبِهِ، فَعَدَلُوا عَنْ مَنَاقِبِهِ بِذِكْرِ مَثَالِبِهِ.
** فَمِنْ آدَابِهِ: أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ فِي مَدْحٍ وَلَا يُسْرِفَ فِي ذَمٍّ وَإِنْ كَانَتْ النَّزَاهَةُ عَنْ الذَّمِّ كَرَمًا وَالتَّجَاوُزُ فِي الْمَدْحِ مَلَقًا يَصْدُرُ عَنْ مَهَانَةٍ.
وَالسَّرَفُ فِي الذَّمِّ انْتِقَامٌ يَصْدُرُ عَنْ شَرٍّ، وَكِلَاهُمَا شَيْنٌ وَإِنْ سَلِمَ مِنْ الْكَذِبِ.
** عَلَى أَنَّ السَّلَامَةَ مِنْ الْكَذِبِ فِي الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مُتَعَذِّرَةٌ لَا سِيَّمَا إذَا مَدَحَ تَقَرُّبًا وَذَمَّ تَحَنُّقًا.
** وَحُكِيَ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: سَهِرْت لَيْلَتِي أُفَكِّرُ فِي كَلِمَةٍ أُرْضِي بِهَا سُلْطَانِي وَلَا أُسْخِطُ بِهَا رَبِّي فَمَا وَجَدْتهَا.
** وَسَمِعَ ابْنُ الرُّومِيِّ رَجُلًا يَصِفُ رَجُلًا وَيُبَالِغُ فِي مَدْحِهِ فَأَنْشَأَ يَقُولُ:
إذَا مَا وَصَفْتَ امْرَأً لِامْرِئٍ
فَلَا تَغْلُ فِي وَصْفِهِ وَاقْصِدِ
فَإِنَّك إنْ تَغْلُ تَغْلُ الظُّنُونُ
فِيهِ إلَى الْأَمَدِ الْأَبْعَدِ
فَيَضْأَلُ مِنْ حَيْثُ عَظَّمْتَهُ
لِفَضْلِ الْمَغِيبِ عَلَى الْمَشْهَدِ
** وَمِنْ آدَابِهِ: أَنْ لَا تَبْعَثَهُ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ عَلَى الِاسْتِرْسَالِ فِي وَعْدٍ أَوْ وَعِيدٍ يَعْجِزُ عَنْهُمَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِمَا. فَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ بِهِمَا لِسَانَهُ وَأَرْسَلَ فِيهِمَا عِنَانَهُ، وَلَمْ يَسْتَثْقِلْ مِنْ الْقَوْلِ مَا يَسْتَثْقِلُهُ مِنْ الْعَمَلِ، صَارَ وَعْدُهُ نَكْثًا وَوَعِيدُهُ عَجْزًا.
** وَمِنْ آدَابِهِ: إنْ قَالَ قَوْلًا حَقَّقَهُ بِفِعْلِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ صَدَّقَهُ فَعَمِلَهُ، فَإِنَّ إرْسَالَ الْقَوْلِ اخْتِيَارٌ، وَالْعَمَلَ بِهِ اضْطِرَارٌ. وَلَئِنْ يَفْعَلَ مَا لَمْ يَقُلْ أَجْمَلُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَفْعَلْ.
** وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: أَحْسَنُ الْكَلَامِ مَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْكَلَامِ أَيْ يَكْتَفِي بِالْفِعْلِ مِنْ الْقَوْلِ.
** وَقَالَ مَحْمُودٌ الْوَرَّاقُ:
الْقَوْلُ مَـا صَدَّقَهُ الْفِعْلُ
وَالْفِعْلُ مَا وَكَّدَهُ الْعَقْلُ
لَا يَثْبُتُ الْقَوْلُ إذَا لَمْ يَكُنْ
يُقِلُّهُ مِنْ تَحْتِهِ الْأَصْلُ
** وَمِنْ آدَابِهِ: أَنْ يُرَاعِيَ مَخَارِجَ كَلَامِهِ بِحَسَبِ مَقَاصِدِهِ وَأَغْرَاضِهِ فَإِنْ كَانَ تَرْغِيبًا قَرَنَهُ بِاللِّينِ وَاللُّطْفِ، وَإِنْ كَانَ تَرْهِيبًا خَلَطَهُ بِالْخُشُونَةِ وَالْعُنْفِ، فَإِنَّ لِينَ اللَّفْظِ فِي التَّرْهِيبِ وَخُشُونَتُهُ فِي التَّرْغِيبِ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضِعِهِمَا وَتَعْطِيلٌ لِلْمَقْصُودِ بِهِمَا، فَيَصِيرُ الْكَلَامُ لَغْوًا وَالْغَرَضُ الْمَقْصُودُ لَهْوًا. وَقَدْ قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إنْ كُنْت فِي قَوْمٍ فَلَا تَتَكَلَّمْ بِكَلَامِ مَنْ هُوَ فَوْقَك فَيَمْقُتُوك، وَلَا بِكَلَامِ مَنْ هُوَ دُونَك فَيَزْدَرُوك.
** وَمِنْ آدَابِهِ: أَنْ لَا يَرْفَعَ بِكَلَامِهِ صَوْتًا مُسْتَنْكَرًا وَلَا يَنْزَعِجَ لَهُ انْزِعَاجًا مُسْتَهْجَنًا، وَلْيَكُفَّ عَنْ حَرَكَةٍ تَكُونُ طَيْشًا وَعَنْ حَرَكَةٍ تَكُونُ عِيًّا، فَإِنَّ نَقْصَ الطَّيْشِ أَكْثَرُ مِنْ فَضْلِ الْبَلَاغَةِ. وَقَدْ حُكِيَ أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَعْرَابِيٍّ: أَخَطِيبٌ أَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ لَوْلَا أَنَّك تُكْثِرُ الرَّدَّ، وَتُشِيرُ بِالْيَدِ، وَتَقُولُ أَمَّا بَعْدُ.
** وَمِنْ آدَابِهِ: أَنْ يَتَجَافَى هَجَرَ الْقَوْلِ وَمُسْتَقْبَحَ الْكَلَامِ، وَلْيَعْدِلْ إلَى الْكِنَايَةِ عَمَّا يُسْتَقْبَحُ صَرِيحُهُ وَيُسْتَهْجَنُ فَصِيحُهُ؛ لِيَبْلُغَ الْغَرَضَ وَلِسَانُهُ نَزِهٌ وَأَدَبُهُ مَصُونٌ.
** وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}.
قَالَ: كَانُوا إذَا ذَكَرُوا الْفُرُوجَ كَنَّوْا عَنْهَا.
** وَكَمَا أَنَّهُ يَصُونُ لِسَانَهُ عَنْ ذَلِكَ فَهَكَذَا يَصُونُ عَنْهُ سَمْعَهُ، فَلَا يَسْمَعُ خَنَاءً وَلَا يُصْغِي إلَى فُحْشٍ فَإِنَّ سَمَاعَ الْفُحْشِ دَاعٍ إلَى إظْهَارِهِ، وَذَرِيعَةٌ إلَى إنْكَارِهِ.
** وَإِذَا وَجَدَ عَنْ الْفُحْشِ مَعْرِضًا كَفَّ قَائِلُهُ وَكَانَ إعْرَاضُهُ أَحَدَ النَّكِيرَيْنِ، كَمَا أَنَّ سَمَاعَهُ أَحَدُ الْبَاعِثَيْنِ.
** وَأَنْشَدَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيُّ:
تَحَرَّ مِنْ الطُّرُقِ أَوْسَاطَهَا
وَعُدْ عَـنْ الْمَـوْضِعِ الْمُشْتَبِهْ
وَسَمْعَك صُنْ عَنْ قَبِيحِ الْكَلَامِ
كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنْ النُّطْقِ بِهِ
فَإِنَّك عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقَبِيحِ
شَرِيكٌ لِقَائِلِهِ فَانتَبِهْ
** وَمِنْ آدَابِهِ أَنْ يَجْتَنِبَ أَمْثَالَ الْعَامَّةِ الْغَوْغَاءِ وَيَتَخَصَّصَ بِأَمْثَالِ الْعُلَمَاءِ الْأُدَبَاءِ فَإِنَّ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْ النَّاسِ أَمْثَالًا تُشَاكِلُهُمْ، فَلَا تَجِدْ لِسَاقِطٍ إلَّا مَثَلًا سَاقِطًا وَتَشْبِيهًا مُسْتَقْبَحًا.
** وَلِلسُّقَّاطِ أَمْثَالٌ فَمِنْهَا تَمَثُّلُهُمْ لِلشَّيْءِ الْمُرِيبِ، كَمَا قَالَ الصَّنَوْبَرِيُّ:
إذَا مَا كُنْتَ ذَا بَوْلٍ صَحِيحٍ … أَلَا فَاضْرِبْ بِهِ وَجْهَ الطَّبِيبِ
** وَلِذَلِكَ عِلَّتَانِ. إحْدَاهُمَا: أَنَّ الْأَمْثَالَ مِنْ هَوَاجِسِ الْهِمَمِ وَخَطِرَاتِ النُّفُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ لِذِي الْهِمَّةِ السَّاقِطَةِ إلَّا مَثَلٌ مَرْذُولٌ، وَتَشْبِيهٌ مَعْلُولٌ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْأَمْثَالَ مُسْتَخْرَجَةٌ مِنْ أَحْوَالِ الْمُتَمَثِّلِينَ بِهَا، فَبِحَسَبِ مَا هُمْ عَلَيْهِ تَكُونُ أَمْثَالُهُمْ. فَلِهَاتَيْنِ الْعِلَّتَيْنِ وَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَمْثَالِ الْخَاصَّةِ وَأَمْثَالِ الْعَامَّةِ.
** وَرُبَّمَا أَلَّفَ الْمُتَخَصِّصُ مَثَلًا عَامِّيًّا أَوْ تَشْبِيهًا رَكِيكًا؛ لِكَثْرَةِ مَا يَطْرُقُ سَمْعَهُ مِنْ مُخَالَطَةِ الْأَرَاذِلِ فَيَسْتَرْسِلُ فِي ضَرْبِهِ مَثَلًا فَيَصِيرُ بِهِ مَثَلًا،
** كَاَلَّذِي حُكِيَ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّ الرَّشِيدَ سَأَلَهُ يَوْمًا عَنْ أَنْسَابِ بَعْضِ الْعَرَبِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ: أَسْقَطَ اللَّهُ جَنْبَيْك أَتَخَاطَبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْخِطَابِ؟ فَكَانَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ، مَعَ قِلَّةِ عِلْمِهِ أَعْلَمَ بِمَا يُسْتَعْمَلُ مِنْ الْكَلَامِ فِي مُحَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ مِنْ الْأَصْمَعِيِّ الَّذِي هُوَ وَاحِدُ عَصْرِهِ وَقَرِيعُ دَهْرِهِ.
** وَلِلْأَمْثَالِ مِنْ الْكَلَامِ مَوْقِعٌ فِي الْأَسْمَاعِ وَتَأْثِيرٌ فِي الْقُلُوبِ لَا يَكَادُ الْكَلَامُ الْمُرْسَلُ يَبْلُغُ مَبْلَغَهَا، وَلَا يُؤَثِّرُ تَأْثِيرَهَا؛ لِأَنَّ الْمَعَانِيَ بِهَا لَائِحَةٌ، وَالشَّوَاهِدَ بِهَا وَاضِحَةٌ، وَالنُّفُوسَ بِهَا وَامِقَةٌ، وَالْقُلُوبَ بِهَا وَاثِقَةٌ، وَالْعُقُولُ لَهَا مُوَافِقَةٌ. فَلِذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَجَعَلَهَا مِنْ دَلَائِلِ رُسُلِهِ وَأَوْضَحَ بِهَا الْحُجَّةَ عَلَى خَلْقِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْعُقُولِ مَعْقُولَةٌ، وَفِي الْقُلُوبِ مَقْبُولَةٌ.
** وَلَهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: صِحَّةُ التَّشْبِيهِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهَا سَابِقًا وَالْكُلُّ عَلَيْهَا مُوَافِقًا.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يُسْرِعَ وُصُولُهَا لِلْفَهْمِ، وَيُعَجَّلَ تَصَوُّرُهَا فِي الْوَهْمِ، مِنْ غَيْرِ ارْتِيَاءٍ فِي اسْتِخْرَاجِهَا وَلَا كَدٍّ فِي اسْتِنْبَاطِهَا.
وَالرَّابِعُ: أَنْ تُنَاسِبَ حَالَ السَّامِعِ لِتَكُونَ أَبْلَغَ تَأْثِيرًا وَأَحْسَنَ مَوْقِعًا.
** فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الْأَمْثَالِ الْمَضْرُوبَةِ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ كَانَتْ زِينَةً لِلْكَلَامِ وَجَلَاءً لِلْمَعَانِي وَتَدَبُّرًا لِلْأَفْهَامِ . اهـ باختصار
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 26/ 2/ 1440 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
=================
113 ذكر أسماء المكثرين في رواية الحديث من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ممن روى فوق الألف.
سلسة الفوائد اليومية:
113 ذكر أسماء المكثرين في رواية الحديث من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ممن روى فوق الألف.
** الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الصحابة الأبرار – رضوان الله عليهم أجمعين –
** وهم : أبو هريرة , وابن عمر , وابن عباس , وأنس , وجابر , وأبو سعيد الخدري , وعائشة أم المؤمنين .
** وهؤلاء السبعة – بعد مجاوزتهم الألف – ما بين مقل ومكثر .
** فأولهم – وهو رئيسهم في الحفظ باتفاق – : أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ,
روى من الأحاديث:(5374)، وقيل : (5472)
** قال الإمام النووي في شرحه على مسلم (1/ 67):
** وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِوَايَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
** وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ خَمْسَةَ آلَافِ حَدِيثٍ وَثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وسبعين حديثا.
** وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَذَا الْقَدْرِ وَلَا مَا يُقَارِبهُ
** قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ .اهـ المراد
الثاني : أبوعبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما –
روي من الأحاديث ألفين وستمائة وثلاثين حديثا , (2630)
الثالث : أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري – رضي الله عنه –
روى من الأحاديث ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثا,(2286)
الرابع : عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق – رضي الله تعالى عنهما -،
روت من الأحاديث ألفين ومائتين وعشرة أحاديث ,(2210)
الخامس : أبو العباس عبد الله بن عبّاس – رضي الله تعالى عنهما -،
روي من الأحاديث ألفا وستمائة وستين حديثا,(1696)
السادس : أبو عبد الرحمن، أو أبو عبد الله، أو أبو محمَّد المدني، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما،
روي من الأحاديث ألفا وخمسمائة وأربعين حديثا.,(1540)
السابع : أبو سعيد الخدريّ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ،
روي من الأحاديث ألفا ومائة وسبعين حديثا ,(1170)
** وفي كتاب :(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث), (4/ 102):[الْمُكْثِرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ]
الرَّابِعَةُ: فِي الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِوَايَةً وَإِفْتَاءً.
** (وَالْمُكْثِرُونَ) مِنْهُمْ رِوَايَةً كَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَغَيْرُهُ، الَّذِينَ زَادَ حَدِيثُهُمْ عَلَى أَلْفٍ (سِتَّةُ) ، وَهُمْ:
** (أَنَسٌ) هُوَ ابْنُ مَالِكٍ،
** وَ(ابْنُ عُمَرَ) عَبْدُ اللَّهِ،
** وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ (الصِّدِّيقَةُ) ابْنَةُ الصِّدِّيقِ،
** وَ(الْبَحْرُ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ.
** وَسُمِّيَ بَحْرًا ; لِسَعَةِ عِلْمِهِ وَكَثْرَتِهِ،
** وَمِمَّنْ سَمَّاهُ بِذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَحَدُ التَّابِعِينَ مِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ، فَقَالَ فِي شَيْءٍ: وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ.
** وَ(جَابِرٌ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
** وَ(أَبُو هُرَيْرَةِ) ، وَهُوَ بِإِجْمَاعٍ حَسْبَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ (أَكْثَرُهُمْ) كَمَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَابْنُ حَنْبَلٍ، وَتَبِعَهُمَا ابْنُ الصَّلَاحِ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِتَرْتِيبِ مَنْ عَدَاهُ فِي الْأَكْثَرِيَّةِ.
** وَالَّذِي يَدُلُّ لِذَلِكَ مَا نُسِبَ لِبَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ مِمَّا أَوْدَعَهُ فِي مُسْنَدِهِ خَاصَّةً كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا لَا مُطْلَقًا ; فَإِنَّهُ رَوَى لِأَبِي هُرَيْرَةَ خَمْسَةَ آلَافٍ وَثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَسِتِّينَ،
** وَلِابْنِ عُمَرَ أَلْفَيْنِ وَسِتَّمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ،
** وَلِأَنَسٍ أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَسِتَّةً وَثَمَانِينَ،
** وَلَعَائِشَةَ أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَعَشَرَةً،
** وَلِابْنِ عَبَّاسٍ ألْفًا وَسِتَّمِائَةٍ وَسِتِّينَ،
** وَلِجَابِرٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ.
** وَلَهُمْ سَابِعٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ كَثِيرٍ، وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَرَوَى لَهُ بَقِيٌّ أَلْفًا وَمِائَةً وَسَبْعِينَ،
** وَقَدْ نَظَمَهُ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فَقَالَ:
أَبُو سَعِيدٍ نِسْبَةً لِخُدْرَةِ * * * سَابِعُهُمْ أُهْمِلَ فِي الْقَصِيدَةِ. اهـ المراد
** وهؤلاء السبعة المكثرون قد جمعهم السيوطي رحمه الله في ألفيته في علوم الحديث / ت ماهر الفحل (ص: 108)، فقال:
661 – وَالْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الأَثَرْ:
أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ
662 – وَأَنَسٌ وَالْبَحْرُ كَالْخُدْرِيِّ
وَجَابِرٌ وَزَوْجَةُ النَّبِيِّ .اهـ
** والبحر هو ابن عباس كما تقدم .
** وزوجة النبي هي عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين.
** وفي كتاب (منظومة مصباح الراوي في علم الحديث), (ص: 110):
** ونظمهم جميعا الجمال ابن ظهيرة في بيت فقال :
سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا
من الحديث عن المختار خير مضر
أبو هريرة ، سعد، جابر، أنس
صديقة ، وابن عباس كذا ابن عمر .
** ونظمهم مرتبا لهم من حيث الأكثرية الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي في كتابه : (مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه), (1/ 49) فقال :
** والمكثر من روى فوق الألف، وهم الذين جمعتهم مرتّبًا بقولي:
المُكْثِرُونَ في رِوَايةِ الخُبَر
مِنَ الصَّحَابَةِ الأكارِم الْغُرَرْ
أبو هُرَيْرَةَ يَليه ابْنُ عُمَرْ
فَأنَسٌ فَزَوْجَةُ الهادي الأَبَرْ
ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ
وَبَعْدَهُ الخُدْرِيُّ فَهْوَ الآخِرُ
** فأما أبو هريرة -رضي الله عنه- فروى (5374) حديثًا، اتفق الشيخان على (326) وانفرد البخاريّ (93) ومسلم (98) (1).
** وأما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فروى (2630) اتفقا على (170) وانفرد البخاريّ (81) ومسلم (31).
** وأما أنس بن مالك -رضي الله عنه-، فروى (2286)، اتفقا على (168) وللبخاريّ (83) ولمسلم (71).
** وأما عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي المرادة بقولي: “فزوجة الهادي الأبرّ”، فروت (2210) اتفقا على (174) وللبخاريّ (54) ولمسلم (68).
** وأما ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، فروى (1696)، اتفقا على (75) وللبخاري (28) ولمسلم (49).
** وأما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فروى (1540) اتفقا على (58) وللبخاريّ (26) ولمسلم (126).
** وأما أبو سعيد الخدريّ، وهو المراد بقولي “الخدريّ”، فروى (1170) اتفقا على (43) وللبخاريّ (26) ولمسلم (52). والله تعالى أعلم.
____
(1) هكذا في “سير أعلام النبلاء” 2/ 632 والذي في “خلاصة الخزرجي” أن المتفق عليه (325) وما للبخاريّ (79) وما لمسلم (93) فليحرر.
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 25/ 2/ 1440 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
==================
112 ذكر بعض المعلومات عن الذباب
سلسة الفوائد اليومية:
112 ذكر بعض المعلومات عن الذباب
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه :(فتح الباري), (10/ 250):
** الذُّبَاب بِضَمِّ الْمُعْجَمَة وَمُوَحَّدَتَيْنِ وَتَخْفِيف ،
** قَالَ أَبُو هِلَال الْعَسْكَرِيّ : الذُّبَاب وَاحِد وَالْجَمْع ذِبَّان كِغِرْبَان ،
** وَالْعَامَّة تَقُول ذُبَاب لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ ذُبَابَة بِوَزْنِ قُرَادَة ، وَهُوَ خَطَأ ، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم السِّجِسْتَانِيّ إِنَّهُ خَطَأ ،
** وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الذُّبَاب وَاحِدَة ذُبَابَة وَلَا تَقُلْ ذِبَّانَة ،
** وَنَقَلَ فِي ” الْمُحْكَم ” عَنْ أَبِي عُبَيْدَة عَنْ خَلَف الْأَحْمَر تَجْوِيز مَا زَعَمَ الْعَسْكَرِيّ أَنَّهُ خَطَأ ،
** وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الْجَمْع ذُبَّ .
** وَقَرَأْته بِخَطِّ الْبُحْتُرِيِّ مَضْبُوطًا بِضَمِّ أَوَّله وَالتَّشْدِيد .
قَوْلُهُ :(إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ )
** قِيلَ سُمِّيَ ذُبَابًا لِكَثْرَةِ حَرَكَتِهِ وَاضْطِرَابِهِ .
** وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَن ابن عُمَرَ مَرْفُوعًا : (عُمْرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً , وَالذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ ) ,وَسَنَدُهُ لَا بَأْس بِهِ .
** وَأخرجه بن عَدِيٍّ دُونَ أَوَّلِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ .
** قَالَ الْجَاحِظُ : كَوْنُهُ فِي النَّارِ لَيْسَ تَعْذِيبًا لَهُ بَلْ لِيُعَذَّبَ أَهْلُ النَّارِ بِهِ .
** قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : يُقَالُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الطُّيُورِ يَلَغُ إِلَّا الذُّبَابُ .
** وَقَالَ أَفْلَاطُونُ : الذُّبَابُ أَحْرَصُ الْأَشْيَاءِ , حَتَّى إِنَّهُ يُلْقِي نَفْسَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ , وَلَوْ كَانَ فِيهِ هَلَاكُهُ .
** وَيَتَوَلَّدُ مِنَ الْعُفُونَةِ .
** وَلَا جَفْنَ لِلذُّبَابَةِ ؛ لِصِغَرِ حَدَقَتِهَا , وَالْجَفْنُ يَصْقُلُ الْحَدَقَةَ , فَالذُّبَابَةُ تَصْقُلُ بِيَدَيْهَا فَلَا تَزَالُ تمسح عينيها .
** وَمن عَجِيب أمره : أَن رجعيه يَقَعُ عَلَى الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ أَبْيَضَ وَبِالْعَكْسِ .
** وَأَكْثَرُ مَا يَظْهَرُ فِي أَمَاكِنِ الْعُفُونَةِ , وَمَبْدَأُ خَلْقِهِ مِنْهَا ثُمَّ مِنَ التَّوَالُدِ .
** وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ الطُّيُورِ سِفَادًا , رُبَّمَا بَقِيَ عَامَّةَ الْيَوْمِ عَلَى الْأُنْثَى .
** وَيُحْكَى : أَنَّ بَعْضَ الْخُلَفَاءِ سَأَلَ الشَّافِعِيَّ لِأَيِّ عِلَّةٍ خُلِقَ الذُّبَابُ ؟! فَقَالَ : مَذَلَّةً لِلْمُلُوكِ , وَكَانَتْ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ ذُبَابَةٌ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : سَأَلَنِي وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ فَاسْتَنْبَطْتُهُ مِنَ الْهَيْئَةِ الْحَاصِلَةِ .
** وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَالِقِيُّ : ذُبَابُ النَّاسِ يَتَوَلَّدُ مِنَ الزِّبْلِ .
** وَإِنْ أُخِذَ الذُّبَابُ الْكَبِيرُ فَقُطِعَتْ رَأْسُهَا وَحُكَّ بِجَسَدِهَا الشَّعْرَةِ الَّتِي فِي الْجَفْنِ حَكًّا شَدِيدًا أَبْرَأَتْهُ , وَكَذَا دَاءُ الثَّعْلَبِ .
** وَإِنْ مُسِحَ لَسْعَةُ الزُّنْبُورِ بِالذُّبَابِ سَكَنَ الْوَجَعُ . اهـ
** وقال ابن القيم في كتابه القيم (زاد المعاد) ,(4/ 101):
** فصل فِي هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِصْلَاحِ الطَّعَامِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ، وَإِرْشَادِهِ إِلَى دَفْعِ مَضَرَّاتِ السُّمُومِ بِأَضْدَادِهَا .
** فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» .
** وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَحَدُ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَالْآخَرُ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ، فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ» .
** هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَمْرَانِ: أَمْرٌ فِقْهِيٌّ، وَأَمْرٌ طِبِّيٌّ،
** فَأَمَّا الْفِقْهِيُّ، فَهُوَ دَلِيلٌ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ جِدًّا عَلَى أَنَّ الذُّبَابَ إِذَا مَاتَ فِي مَاءٍ أَوْ مَائِعٍ، فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يُعْرَفُ فِي السَّلَفِ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ.
** وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِمَقْلِهِ، وَهُوَ غَمْسُهُ فِي الطَّعَامِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الطَّعَامُ حَارًّا. فَلَوْ كَانَ يُنَجِّسُهُ لَكَانَ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ، وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِصْلَاحِهِ،
** ثُمَّ عُدِّيَ هَذَا الْحُكْمُ إِلَى كُلِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالنَّحْلَةِ وَالزُّنْبُورِ، وَالْعَنْكَبُوتِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، إِذِ الْحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُومِ عِلَّتِهِ، وَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ سببه، فلما كَانَ سَبَبُ التَّنْجِيسِ هُوَ الدَّمُ الْمُحْتَقِنُ فِي الْحَيَوَانِ بِمَوْتِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ مَفْقُودًا فِيمَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ انْتَفَى الْحُكْمُ بِالتَّنْجِيسِ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ.
** ثُمَّ قَالَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ عَظْمِ الْمَيْتَةِ: إِذَا كَانَ هَذَا ثَابِتًا فِي الْحَيَوَانِ الْكَامِلِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الرُّطُوبَاتِ، وَالْفَضَلَاتِ، وَعَدَمِ الصَّلَابَةِ، فَثُبُوتُهُ فِي الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ عَنِ الرُّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ، وَاحْتِقَانِ الدَّمِ أَوْلَى، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ، فَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَوْلَى.
** وَأَوَّلُ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ، فَقَالَ: مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَنْهُ تَلَقَّاهَا الْفُقَهَاءُ-
** وَالنَّفْسُ فِي اللُّغَةِ: يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الدَّمِ، وَمِنْهُ نَفَسَتِ الْمَرْأَةُ- بِفَتْحِ النُّونِ- إِذَا حَاضَتْ، وَنُفِسَتْ- بِضَمِّهَا- إِذَا وَلَدَتْ.
** وَأَمَّا الْمَعْنَى الطِّبِّيُّ، فَقَالَ أبو عبيد: مَعْنَى امْقُلُوهُ: اغْمِسُوهُ ليخرج الشفاء بضمها مِنْهُ، كَمَا خَرَجَ الدَّاءُ، يُقَالُ لِلرَّجُلَيْنِ: هُمَا يَتَمَاقَلَانِ، إِذَا تَغَاطَّا فِي الْمَاءِ.
** وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الذُّبَابِ عِنْدَهُمْ قُوَّةً سُمِّيَّةً يَدُلُّ عَلَيْهَا الْوَرَمُ، وَالْحِكَّةُ الْعَارِضَةُ عَنْ لَسْعِهِ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السِّلَاحِ، فَإِذَا سَقَطَ فِيمَا يُؤْذِيهِ، اتَّقَاهُ بِسِلَاحِهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَابِلَ تِلْكَ السُّمِّيَّةَ بِمَا أَوْدَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي جَنَاحِهِ الْآخَرِ مِنَ الشِّفَاءِ، فَيُغْمَسُ كُلُّهُ فِي الْمَاءِ وَالطَّعَامِ، فَيُقَابِلُ الْمَادَّةَ السُّمِّيَّةَ الْمَادَّةُ النَّافِعَةُ، فَيَزُولُ ضَرَرُهَا، وَهَذَا طِبٌّ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ كِبَارُ الْأَطِبَّاءِ وَأَئِمَّتُهُمْ، بَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ، وَمَعَ هَذَا فَالطَّبِيبُ الْعَالِمُ الْعَارِفُ الْمُوَفَّقُ يَخْضَعُ لِهَذَا الْعِلَاجِ، وَيُقِرُّ لِمَنْ جَاءَ بِهِ بِأَنَّهُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَأَنَّهُ مُؤَيَّدٌ بِوَحْيٍ إِلَهِيٍّ خَارِجٍ عَنِ الْقُوَى الْبَشَرِيَّةِ.
** وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَطِبَّاءِ أَنَّ لَسْعَ الزُّنْبُورِ وَالْعَقْرَبِ إِذَا دُلِكَ مَوْضِعُهُ بِالذُّبَابِ نَفَعَ مِنْهُ نَفْعًا بَيِّنًا، وَسَكَّنَهُ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِلْمَادَّةِ الَّتِي فِيهِ مِنَ الشِّفَاءِ،
** وَإِذَا دُلِكَ بِهِ الْوَرَمُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رؤوس الذباب، أبرأه. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الجمعة 24/ 2 / 1440 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
====================
111 أهل السنة يدعون إلى صحة الاعتقاد وحسن العبادة والأخلاق , وهذا هو الدين القيم
سلسة الفوائد اليومية:
111 أهل السنة يدعون إلى صحة الاعتقاد وحسن العبادة والأخلاق , وهذا هو الدين القيم
** قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر عقيدته الواسطية بعدما ذكر أصول الإيمان عند أهل السنة:
** فَصْلٌ:
** ثُمَّ هُم مَّعَ هّذِهِ الأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ.
** وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالأَعْيَادِ مَعَ الأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا.
** وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ. وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ للأُمَّةِ.
** وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ؛ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا)) ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ،
وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بُالْحُمَّى وَالسَّهَرِ)) .
** وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ.
** وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ،
وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا)) .
** وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ.
** وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالإِحْسِانِ إلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ.
** وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ، وَالْخُيَلاءِ، وَالْبَغْيِ، وَالاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ.
** وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخْلاَقِ، َوَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَاِفِهَا.
** وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،
وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإسْلاَمِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم.
اهـ المراد
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 23/ 2/ 1440 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
====================
110 من كانت منيته بأرض دعته حاجة إلى الذهاب إليها فيموت فيها
سلسة الفوائد اليومية:
110 من كانت منيته بأرض دعته حاجة إلى الذهاب إليها فيموت فيها
** قال الله تعالى :
{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}
** عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
” مَفَاتِحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ:
لاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ،
وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ،
وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ،
وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ ” رواه البخاري
** عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً، أَوْ قَالَ: بِهَا حَاجَةً.
** رواه الترمذي وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
** وَأَبُو عَزَّةَ لَهُ صُحْبَةٌ وَاسْمُهُ يَسَارُ بْنُ عَبْدٍ، وَأَبُو الْمَلِيحِ اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الهُذَلِيُّ،
وَيُقَالُ: زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ. اهـ
** قال شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه القيم : الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (ص: 98):
** قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاه. اهـ
** وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله . كما في “صحيح الجامع” برقم [748].
** وفي كتاب : (تحفة الأحوذي), (6/ 300)
** (وَأَبُو عَزَّةَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ
** (اسْمُهُ يَسَارُ بْنُ عَبْدٍ) الْهُذَلِيُّ , صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ كَذَا فِي التَّقْرِيب
ِ
** وَصَرَّحَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ بِأَنَّهُ رَوَى حَدِيثَ الْبَابِ . اهـ
** وفي كتاب :(مرقاة المفاتيح), (1/ 184)
(إِذَا قَضَى اللَّهُ) أَيْ: أَرَادَ، أَوْ قَدَّرَ، أَوْ حَكَمَ .
(لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ) : وَهُوَ فِي غَيْرِهَا .
(جَعَلَ) أَيْ: أَظْهَرَ اللَّهُ .
(لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً) أَيْ: فَيَأْتِيهَا، وَيَمُوتُ فِيهَا , إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} .اهـ
** قال الشاعر :
مَشَيْنَاها خُطَىً كُتِبَتْ عَلَيْنَا
وَمَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خُطَىً مَشَاهَا
وَأَرْزَاقٌ لَـنَـا مُـتـَفَـرِّقَـاتٌ
فَـمَـنْ لَـمْ تَـأتِـهِ مـشيا أَتَـاهَـا
وَمَنْ كُتِبَتْ مَنِيَّتُهُ بِأَرْضٍ
فَلَيْسَ يَمُوْتُ فِي أرْضٍ سِوَاهَا
** وقال آخر:
إذا ما حمام المرء كان ببلدة
دعته إليها حاجة فيطير
** وَقَالَ أَعْشَى هَمْدَانَ ,
وهو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ :
لَا تَأسَيَنّ عَلَى شَيْء فَكُلّ فَتَى
إلَى مَنيّته سَيَّارُ فِي عَنَق
وَكُلّ مَنْ ظَنّ أَنَّ الموتَ يُخْطِئهُ
مُعَلَّلٌ بأعَاليل مِنَ الحَمـق
بـأيّمَا بَـلْـدَة تُـقْـدَر مَنِيَّتُـهُ
إنْ لَا يُسَيَّرْ إلَيها طَائعًا يُسَق
** انظر : تفسير ابن كثير ط العلمية (6/ 319)
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 10/ 8/ 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
====================
109 العلم النافع المقرون بالعمل الصالح يرفع صاحبه إلى أعلا مقام وأرفع مكان في الدنيا والآخرة
سلسة الفوائد اليومية:
109 العلم النافع المقرون بالعمل الصالح يرفع صاحبه إلى أعلا مقام وأرفع مكان في الدنيا والآخرة
** قال الله تعالى:{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
** وقال الله تعالى:{ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ}
** قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ رحمه الله : بِالْعِلْمِ. رواه أحمد وغيره , وإسناده صحيح.
** عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رواه البخاري
** وعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ،
** فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي،
** فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى،
** قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟
** قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا،
** قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟
** قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ،
** قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ». رواه مسلم
** وفي كتاب: (المفهم) , للقرطبي (7/ 78):
** وقوله : ((إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا))
** يعني : يُشرف ، ويكرم في الدنيا والآخرة ، وذلك بسبب الاعتناء به ، والعلم به ، والعمل بما فيه.
** “ويضع” : يعني : يحقِّر ويصغِّر في الدنيا والآخرة ، وذلك بسبب تركه ، والجهل به ، وترك العمل به. اهـ
** وفي كتاب : ( نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف )- للحبيشي – (1 / 171):
** وقال بعض الحكماء :
لم أجد رتبة أرفع ، ولا شيء أنفع ، ولا خيرا أجمع من العلم ، إذا قارنته سكينة .
** وإني رأيته يرفع وضيع الحسب إلى أرفع الرتب حتى تكون له الأشراف أتباعا والأخيار أشياعا .
** وأنشد بعضهم:
العلم زين ومحمود عواقبه
فمن ينله يكن من أسعد الناس
وهو المقدم والمختار بينهم
كالرأس ما في الفتى أعلا من الراس
** وأنشد آخر :
العلم زين وفخر لا خفاء به
من ناله نال أعلى عالي الرتب
يكسو الفتى حللا تبقى عليه وما
نال الفتى حلة أبهى من الأدب
** وفي ( ديوان الإمام الشافعي ) , (ص: 94) :
رَأَيْتَ العِلْمَ صَاحِبُهُ كَرِيـم
ولـو ولـدتهُ آباءٌ لئامُ
ولـيسَ يـزالُ يـرفعهُ إلى أن
يُعَظِّمَ أمرَهُ القَومُ الـكِرامُ
وَيَتَّبِـعُـونَهُ فِـي كـلِّ حَـالٍ
كراعي الضأنِ تتبعهُ السَّوامُ
فَلَولاَ العِلْمُ مَا سَعِدَتْ رِجَالٌ
ولا عرفُ الحلالُ ولا الحرامُ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 9/ 8/ 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
====================
108 بيان شيء من الحكمة في دعوة الناس إلى الله
سلسة الفوائد اليومية:
108 بيان شيء من الحكمة في دعوة الناس إلى الله
** قال الله تعالى :{ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ }
** وقال: { وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا } .
** وفي كتاب :(شرح الزرقاني على الموطأ) (4/ 683):
** قَالَ النَّوَوِيُّ[يعني في تعريف الحكمة]:
** فِيهَا أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ صَفَا لَنَا مِنْهَا :
** أَنَّهَا الْعِلْمُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ، مَعَ نَفَاذِ الْبَصِيرَةِ، وَتَهْذِيبِ النَّفْسِ، وَتَحْقِيقِ الْحَقِّ لِلْعَمَلِ، وَالْكَفِّ عَنْ ضِدِّهِ، وَالْحَكِيمُ مَا حَازَ ذَلِكَ، انْتَهَى مُلَخَّصًا.
** عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ» فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ . رواه مسلم .
** وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم .
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ” لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا “، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ ” رواه أحمد
** وفي صحيح البخاري (1/ 37)
(بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا)
127 – وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه : «حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ»
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ .
** وفي صحيح مسلم (1/ 11)
** عَنْ عَبْد اللهِ بْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه ، قَالَ: «مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً»
** وقال ابن القيم في كتابه القيم :(الفوائد), (ص: 169):
** العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا ؛ فإنهم لا يقدرون على تركها ، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ، فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة ، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة ؟! .
** فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله ؛ فإن القلوب مفطورة على محبته ،فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها .
** وقد قال يحيى بن معاذ : طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها
* العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة ، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة ؛ فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد ، ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن ؛ فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع ، * ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد ،
** وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة ،
** فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر ؛ فإن من البشم ما يقتل . اهـ
** ومن كتاب :(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم), (1/ 535):
[بَشِمَ] من الطعام بَشَماً،** يقال: الشِّبَعُ داعيَةُ البَشَم،
والبَشَمُ داعيةُ السُّقْم،
والسُّقْم داعيةُ الموت.اﻫ
** وفي كتاب (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) (2/ 447):
** فَصْلٌ مَنْزِلَةُ الْحِكْمَةِ
** وَمِنْ مَنَازِلِ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} مَنْزِلَةُ الْحِكْمَةِ.
** قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا}
** وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا}
** وَقَالَ عَنِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ} [آل عمران: 48] .
** الْحِكْمَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ نَوْعَانِ: مُفْرَدَةٌ. وَمُقْتَرِنَةٌ بِالْكِتَابِ.
** فَالْمُفْرَدَةُ: فُسِّرَتْ بِالنُّبُوَّةِ، وَفُسِّرَتْ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ.
** قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هِيَ عِلْمُ الْقُرْآنِ: نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ. وَمُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ. وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ. وَأَمْثَالِهِ.
** وَقَالَ الضَّحَّاكُ: هِيَ الْقُرْآنُ وَالْفَهْمُ فِيهِ.
** وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ وَالْفِقْهُ.
** وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: هِيَ الْإِصَابَةُ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.
** وَقَالَ النَّخَعِيُّ: هِيَ مَعَانِي الْأَشْيَاءِ وَفَهْمُهَا.
** وَقَالَ الْحَسَنُ: الْوَرَعُ فِي دِينِ اللَّهِ. كَأَنَّهُ فَسَّرَهَا بِثَمَرَتِهَا وَمُقْتَضَاهَا.
** وَأَمَّا الْحِكْمَةُ الْمَقْرُونَةُ بِالْكِتَابِ: فَهِيَ السُّنَّةُ. وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ.
** وَقِيلَ: هِيَ الْقَضَاءُ بِالْوَحْيِ. وَتَفْسِيرُهَا بِالسُّنَّةِ أَعَمُّ وَأَشْهَرُ.
** وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي الْحِكْمَةِ. قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَمَالِكٍ: إِنَّهَا مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالْعَمَلُ بِهِ. وَالْإِصَابَةُ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.
** وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِفَهْمِ الْقُرْآنِ، وَالْفِقْهِ، فِي شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وَحَقَائِقِ الْإِيمَانِ.
** وَالْحِكْمَةُ حِكْمَتَانِ: عِلْمِيَّةٌ، وَعَمَلِيَّةٌ.
** فَالْعِلْمِيَّةُ: الِاطِّلَاعُ عَلَى بَوَاطِنِ الْأَشْيَاءِ. وَمَعْرِفَةُ ارْتِبَاطِ الْأَسْبَابِ بِمُسَبِّبَاتِهَا، خَلْقًا وَأَمْرًا. قَدَرًا وَشَرْعًا.
** وَالْعِلْمِيَّةُ كَمَا قَالَ صَاحِبُ ” الْمَنَازِلِ ” وَهِيَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ.
** قَالَ: وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ.
** الدَّرَجَةُ الْأُولَى: أَنْ تُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ حَقَّهُ وَلَا تَعُدِّيَهُ حَدَّهُ، وَلَا تُعَجِّلَهُ عَنْ وَقْتِهِ، وَلَا تُؤَخِّرَهُ عَنْهُ.
** لَمَّا كَانَتِ الْأَشْيَاءُ لَهَا مَرَاتِبُ وَحُقُوقٌ، تَقْتَضِيهَا شَرْعًا وَقَدَرًا.
** وَلَهَا حُدُودٌ وَنِهَايَاتٌ تَصِلُ إِلَيْهَا وَلَا تَتَعَدَّاهَا.
** وَلَهَا أَوْقَاتٌ لَا تَتَقَدَّمُ عَنْهَا وَلَا تَتَأَخَّرُ –
** كَانَتِ الْحِكْمَةُ مُرَاعَاةَ هَذِهِ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ.
** بِأَنْ تُعْطَى كُلُّ مَرْتَبَةٍ حَقَّهَا الَّذِي أَحَقَّهُ اللَّهُ بِشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ.
** وَلَا تَتَعَدَّى بِهَا حَدَّهَا. فَتَكُونَ مُتَعَدِّيًا مُخَالِفًا لِلْحِكْمَةِ.
** وَلَا تَطْلُبُ تَعْجِيلَهَا عَنْ وَقْتِهَا فَتُخَالِفَ الْحِكْمَةَ.
** وَلَا تُؤَخِّرُهَا عَنْهُ فَتُفَوِّتَهَا.
** وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌّ لِجَمِيعِ الْأَسْبَابِ مَعَ مُسَبَّبَاتِهَا شَرْعًا وَقَدَرًا.
** فَإِضَاعَتُهَا تَعْطِيلٌ لِلْحِكْمَةِ بِمَنْزِلَةِ إِضَاعَةِ الْبَذْرِ وَسَقْيِ الْأَرْضِ.
** وَتَعَدِّي الْحَقِّ: كَسَقْيِهَا فَوْقَ حَاجَتِهَا، بِحَيْثُ يَغْرِقُ الْبَذْرُ وَالزَّرْعُ وَيَفْسُدُ.
** وَتَعْجِيلُهَا عَنْ وَقْتِهَا: كَحَصَادِهِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ وَكَمَالِهِ.
** وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ: إِخْلَالٌ بِالْحِكْمَةِ، وَتَعَدِّي الْحَدِّ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، خُرُوجٌ عَنْهَا أَيْضًا. وَتَعْجِيلُ ذَلِكَ قَبْلَ وَقْتِهِ: إِخْلَالٌ بِهَا. وَتَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِهِ: إِخْلَالٌ بِهَا.
** فَالْحِكْمَةُ إِذًا: فِعْلُ مَا يَنْبَغِي، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي، فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي.
** وَاللَّهُ تَعَالَى أَوْرَثَ الْحِكْمَةَ آدَمَ وَبَنِيهِ. فَالرَّجُلُ الْكَامِلُ: مَنْ لَهُ إِرْثٌ كَامِلٌ مِنْ أَبِيهِ، وَنِصْفُ الرَّجُلِ – كَالْمَرْأَةِ – لَهُ نِصْفُ مِيرَاثٍ، وَالتَّفَاوُتُ فِي ذَلِكَ لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.
** وَأَكْمَلُ الْخَلْقِ فِي هَذَا: الرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ.
** وَأَكْمَلُهُمْ أُولُو الْعَزْمِ.
** وَأَكْمَلُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
** وَلِهَذَا امْتَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ، وَعَلَى أُمَّتِهِ بِمَا آتَاهُمْ مِنَ الْحِكْمَةِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ}.
** وَقَالَ تَعَالَى: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}.
** فَكُلُّ نِظَامِ الْوُجُودِ مُرْتَبِطٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ.
** وَكُلُّ خَلَلٍ فِي الْوُجُودِ، وَفِي الْعَبْدِ فَسَبَبُهُ: الْإِخْلَالُ بِهَا.
** فَأَكْمَلُ النَّاسِ: أَوْفَرُهُمْ نَصِيبًا. وَأَنْقَصُهُمْ وَأَبْعَدُهُمْ عَنِ الْكَمَالِ: أَقَلُّهُمْ مِنْهَا مِيرَاثًا.
** وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ: الْعِلْمُ، وَالْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ.
** وَآفَاتُهَا وَأَضْدَادُهَا:
الْجَهْلُ، وَالطَّيْشُ، وَالْعَجَلَةُ.
** فَلَا حِكْمَةَ لِجَاهِلٍ، وَلَا طَائِشٍ، وَلَا عَجُولٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
** ومن الحكمة في الدعوة إلى الله نصيحة المقصر وحده برفق ولين ,
فإن ذلك أدعى لقبول النصيحة والانتفاع بها .
** ورحم الله الامام الشافعي حيث يقول :
تَعَمَّدني بِنُصحِكَ في اِنفِرادي
وَجَنِّبني النَصيحَةَ في الجَماعَه
فَإِنَّ النُصحَ بَينَ الناسِ نَوعٌ
مِنَ التَوبيخِ لا أَرضى اِستِماعَه
وَإِن خالَفتَني وَعَصِيتَ قَولي
فَلا تَجزَع إِذا لَم تُعطَ طاعَه
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الاثنين 7/ 8/ 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
====================
107 الترغيب في كثرة ذكر الله عز وجل
سلسة الفوائد اليومية:
107 الترغيب في كثرة ذكر الله عز وجل
** قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً }
** وقال الله تعالى : {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
** وقال الله تعالى : {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ}
** قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه : (الوابل الصيب من الكلم الطيب) (ص: 42)
وهو يعدد فوائد الذكر:
(الخامسة عشرة)
** أنه يورثه ذكر الله تعالى له كم قال تعالى: {فاذكروني أذكركم}
** ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفاً،
** وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» .اهـ
** وعَنِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“إنَّ ممَّا تذكرونَ مِنْ جلالِ الله؛ التسبيحُ والتهليلُ والتحميدُ، ينعطِفنَ حوْلَ العرْشِ، لهُنَّ دوِيٌّ كدويِّ النَّحْلِ، تُذَكَّر بصاحِبِها. أما يُحِبُّ أحدُكُمْ أنْ يكونَ لَهُ -أو لا يزال لَهُ- مَنْ يُذكَّر به”.
رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجه -واللفظ له-، والحاكم وقال: “صحيح على شرط مسلم”. [وصححه الألباني]
** وفي صحيح الترغيب والترهيب (2/ 205)
1497 – (11) [حسن لغيره]
** وعن جابرٍ رضي الله عنه رفعه إلى النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“ما عمل آدميٌّ عملاً أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى”.
قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:”ولا الجهاد في سبيل الله، إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع”.
رواه الطبراني في “الصغير” و”الأوسط”، ورجالهما رجال “الصحيح”.
** وقال الشاعر:
عَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ في كُلِّ لَحْظَةٍ
فَمَا خَابَ عَبْدٌ لِلْمُهَيْمِنِ يَذْكُرُ
** وقال آخر :
لَوْ يَعْلَمُ العَبْدُ مَا فِي الذِّكْرِ مِنْ شَرَفٍ
أَمْضَى الحَيَاةَ بِتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 1/ 8/ 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
====================
106 فضل شعبان, وكونه مقدمة لرمضان
سلسة الفوائد اليومية:
106 فضل شعبان, وكونه مقدمة لرمضان
** إن في اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليالي والأيام لآيات ظاهرة
وعبرا زاجرة وعظات كافية لمن تفكر في تقلب أحولها وسرعة انقضائها
** فإننا كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رجب , وها هو قد مضى وانقضى , ونحن اليوم نستقبل شهر شعبان ,
** فما أسرع مرور الليالي والأيام , فكل يوم وكل شهر وكل سنة وكل وقت يمر عليك محسوب من عمرك وعملك ويدنيك من أجلك ,
** فهل من معتبر , وهل متفكر , وهل من مشمر للأعمال الصالحة من صلاة وصيام وقراءة للقرآن وصدقة وصلة للأرحام وغير ذلك من أنواع البر والخير والإحسان استغلالا لما بقي من الأعمار قبل فوات الأوان وانتهاء الزمان .
** إن شهر شعبان شهر عظيم جعله الله بين شهرين عظيمين , وهما شهر رجب وشهر رمضان .
** وهو كالمقدمة بين يدي رمضان ؛ ولهذا يستحب فيه الإكثار من الصيام والقيام وقراءة القران وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى تعتاد النفوس على فعل الخيرات ,
فما يأتي رمضان إلا وقد استعدت له أتم الاستعداد .
** وفي كتاب ( لطائف المعارف ) , لابن رجب
(ص: 134):
** وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر:
أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة بل قد تمرن على
الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط.
** ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن
** روينا بإسناد ضعيف عن أنس قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان
** وقال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء .
** وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء .
** وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن .
** قال الحسن بن سهل:
قال شعبان: يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي؟ قال: جعلت فيك قراءة القرآن . اهـ
** وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان .
** عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ” كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ ” متفق عليه
** وعَنْها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ، بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ» رواه الإمام أحمد وغيره , [وصححه الألباني]
** والحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان
ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أُسَامَة بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ،
قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» [وحسنه الألباني]
** وفي كتاب ( لطائف المعارف ) , لابن رجب
(ص: 130):
(. . . وقد ظهر بما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان دون غيره من الشهور وفيه معان أخر:
** وقد ذكر منها النبي في حديث أسامة معنيين:
** أحدهما: أنه شهر “يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان” يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه .
** وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام وليس كذلك .
** وروى ابن وهب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أزهر بن سعد عن أبيه عن عائشة قالت: ذكر لرسول الله ناس يصومون رجبا؟ فقال: “فأين هم عن شعبان”.
** وفي قوله: “يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان” إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم.
** وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة , وأن ذلك محبوب لله عز وجل ,
** كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون: هي ساعة غفلة
** ولذلك فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الليلة فكن” ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل وإنما علل ترك ذلك لخشية المشقة على الناس ولما خرج على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: “ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم”
** وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له .
** ولهذا ورد في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة حتى قال أبو صالح: إن الله ليضحك ممن يذكره في السوق وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة . . .
** وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر: أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط . . . . الخ , )
وقد تقدم . اهـ
وفي (شرح النووي على مسلم), (8/ 37):
** فَإِنْ قِيلَ سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ فَكَيْفَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ فَالْجَوَابُ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِ إِلَّا فِي آخِرِ الْحَيَاةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِضُ فِيهِ أَعْذَارٌ تَمْنَعُ مِنْ إِكْثَارِ الصَّوْمِ فِيهِ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَغَيْرِهِمَا. اهـ
** وفي كتاب ( لطائف المعارف ) , لابن رجب (ص: 135)
يا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها.
مضى رجب وما أحسنت فيه
وهذا شهر شـعبان المبارك
فيا من ضيـع الأوقـات جـهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك
فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك
تدارك ما استطعت من الخطايا
بتوبة مخلص واجعـل مدارك
على طلب السلامة من جحيم
فخير ذوي الجرائم من تدارك
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 30/ 7 / 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
====================
105 لا يقال: شعبان الأكرم
سلسة الفوائد اليومية:
105 لا يقال : شعبان الأكرم
** وفي كتاب : ( معجم المناهي اللفظية) لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص: 308):
** (شعبان الأكرم)
** لا يعرف في السُّنَّة إثبات فضل لشهر شعبان إلا ما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من إكثار الصيام فيه.
** وأما حديث: ((فضل شعبان على سائر الشهور كفضلي على سائر الأنبياء)) فهو موضوع.
** قال ابن عاشور – رحمه الله تعالى -:
((ولعلَّ هذا الحديث هو الذي حمل الكُتاب على أن يُتْبِعُون اسم شعبان بوصف الأكرم، وهو فُضُوْلٌ زايد)) انتهى.
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 29/ 7 / 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
https://binthabt.al3ilm.net/11613
====================
104 من حسن كلام العرب: توكيد الكلام بإتباع بعض الكلمات بما يشابهها من الألفاظ في الوزن وأكثر الحروف
سلسلة الفوائد اليومية:
104 من حسن كلام العرب: توكيد الكلام بإتباع بعض الكلمات بما يشابهها من الألفاظ في الوزن وأكثر الحروف
(1) المراد بـ(الإِتباع) أن تتبع الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الوزن وأكثر الحروف، مثل قول العرب:(حسن بسن). و(عفريت نفريت) ونحوهما.
(2) ويصح في كلمة:(الإِتباع) فتح الهمزة وكسرها.
* فإن فتحت كانت جمعا مفردها:(تبع) بفتح التاء والباء، بمعنى التابع.
* وإن كسرت كانت مصدرا للفعل:(تبع)، بكسر الباء، بمعنى: جاء خلفه.
(3) والأكثر في (الإتباع) أن يكون بكلمة واحدة كما تقدم.
* وقد يكون بكلمتين نحو:(حسن بسن قسن) و(ثقة تقة نقة).
(4) والمراد من هذا الإتباع: تقوية المعنى أو تزيين اللفظ أو مجرد التلميح، أو السخرية، أو المدح، أو الذم، أو محض التَّصويت والتنغيم.
(5) اشترط بعضهم في (الإتباع) عدم توسط حرف العطف بين اللفظتين، فلا يقال:(هذا رجل حسن وبسن).
** واشترط بعض أخر عدم وجود معنى مستقل للفظة الثانية، أي أنها لا تنفرد بنفسها في تركيب آخر، فلا يقال:(هذا رجل بسن).
* فإن وجد حرف العطف، أو وجد للفظة الثانية معنى مستقل بنفسها في تركيب آخر، كان من باب التوكيد لا من باب الإتباع نحو:(حَيَّاك اللَّهُ وَبَيَّاكَ).
** قال أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ) في كتابه:(غريب الحديث)، (2/ 279):
(… وبعض النَّاس يرويهِ:(حارّ يارّ) وَأكْثر كَلَامهم بِالْيَاءِ.
** قَالَ الْكسَائي وَغَيره:(حَار) من الْحَرَارَة و(يارّ)إتباع كَقَوْلِهِم:
(عطشان نطشان)، و(جائع نائع)، و(حسن بسن)، وَمثله كثير فِي الْكَلَام.
** وَإِنَّمَا سمي إتباعا لِأَن الْكَلِمَة الثَّانِيَة إِنَّمَا هِيَ تَابِعَة للأولى على وَجه التوكيد لَهَا وَلَيْسَ يتَكَلَّم بهَا مُنْفَرِدَة فَلهَذَا قيل: إتباع.
** وَأما حَدِيث آدم عَلَيْهِ السَّلَام حِين قتل ابْنه فَمَكثَ مائَة سنة لَا يضْحك ثمَّ قيل لَهُ: حياك اللَّه وبياك فَقَالَ: وَمَا بياك قيل: أضْحكك.
وَقَالَ بعض النَّاس فِي بَيّاك: إِنَّمَا هُوَ إتباع وَهُوَ عِنْدِي [على -] مَا جَاءَ تَفْسِيره فِي الحَدِيث أَنه لَيْسَ بِاتِّبَاع؛ وَذَلِكَ أَن الإتباع لَا [يكَاد -] يكون بِالْوَاو وَهَذَا بِالْوَاو.
** وَمن ذَلِك قَول الْعَبَّاس [بْن عبد الْمطلب -] فِي زَمْزَم: [إِنِّي -] لَا أحلهَا لمغتسل وَهِي لشارب حِلّ وبِلّ. وَيُقَال أَيْضا: إِنَّه إتباع وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَذَلِك لمَكَان الْوَاو…الخ).
** وقال أبو الطيب الحلبي، اللغوي عبد الواحد بن علي
(المتوفى: 351هـ) في كتابه:(الإتباع)، (ص: 2):
(… وإنما قرنا الإتباع بالتوكيد لأن أهل اللغة اختلفوا،
** فبعض جعلوها واحداً، وأكثرهم اختاروا الفرق بينهما:
** فجعلوا الإتباع: مالا تدخل عليه الواو نحو قولهم:(عطشان نطشان)، و(شيطان ليطان).
** والتوكيد: ما دخل عليه الواو نحو قولهم:(هو في حلٍّ وبلٍّ)، و(أخذ في كلِّ فن وفنن).
** ونحن بحمد الله نذهب إلى أن الإتباع ما لم يختص به بمعنى يمكن إفراده به.
** والتوكيد: ما اختص بمعنى وجاز إفراده.
والدليل على صحة قولنا هذا أنَّهم يقولون:(هذا جائع نائع) فهو عندهم إتباع، ثم يقولون في الدُّعاء على الإنسان: (جُوعاً ونُوعاً) فيدخلون الواو وهو مع ذلك إتباع: إذ كان محالاً أن تكون الكلمة مَرَّةً إتباعاً ومرة غير إتباع فقد وضح أنَّ الاعتبار ليس بالواو وثبت ما حددناه به. اهـ المراد
** وقال السيوطي في كتابه:(المزهر)، (1/ 330)
** (… وقال قوم: هذه الألفاظُ تسمى تأكيدا وإتباعا.
** وزعم قوم: أن التأكيد غير الإتباع واخُتِلف في الفرق فقال قوم: الإتباع منها ما لم يحسن فيه واو نحو حَسن بَسَن وقَبِيح شَقِيح.
** والتأكيد يحسنُ فيه الواو نحو حِلّ وبِلّ.
** وقال قوم: الإتباع للكلمة التي يختص بها معنى ينفرد بها من غير حاجة إلى متبوع). اهـ
** وقال عباس حسن في كتابه:(النحو الوافي)، (3/ 469):
** نرى في بعض الأساليب الواردة عن العرب كلمة زائدة، لا تنفرد بنفسها في جملة، دون أن تسبقها – مباشرة في هذه الجملة كلمة أخرى مسموعة تماثلها في وزنها، وفي أكثر حروفها الهجائية ”
** أي: أنه ليس لهذه الكلمة المتأخرة الزائدة، المسموعة في الأسلوب الوارد استقلالٌ بنفسها في جملة ما، ولا استغناءٌ عن كلمة سابقة توافقها في وزنها وفي أكثر حروفها”.
** وأيضًا ليس لهذه الكلمة الزائدة المسموعة معنى تَجلبه، ولا حُكم إعرابيّ خاصّ بها تُوصف معه بأنها مبتدأ، أو فاعل، أو نعت، أو مفعول، أو غير ذلك..، أو أنها معربة أو مبنية؛
** فهي – لكل ما تقدم – خارجة عن نطاق الاستقلال بنفسها، وصوغها، خالية في معنى لغويّ تؤديه، وبعيدة من الاتّصاف بالإعراب أو البناء، أو التأثر بالعوامل.
** وإنما تزاد لمجرد التلميح، أو السخرية، أو المدح، أو محض التَّصويت والتنغيم. وتسمَّى هذه الكلمة الزائدة الواردة في الأسلوب السّماعيّ هي ونظائرها: “الأَتباع” – بفتح الهمزة – جمع: “تَبَع” – بمعنى التابع-
** ويراد به: كل لفظ مسموع، لا يستقل بنفسه في جملة،
** وإنما يجيء بعد كلمة تسبقه مباشرة “بغير فاصل”
** فيسايرها في وزنها، وفي ضبط آخرها، ويماثلها في أكثر حروفها، دون أنْ يكون له معنى خاص ينفرد به في هذه الجملة،
** ولا نصيبٌ في الإعراب أو البناء؛ مثل “بَسَن” في قولهم: “محمد حسَنٌ بَسَنٌ”. ومثل: “نَيْطان، ونِفْريت” في قولهم، اللصّ شيطانٌ نَيْطانٌ، أو: اللصّ عِفريتٌ نِفريتٌ…
** وعند إعراب هذا اللفظ الزائد نقول: إنه تابع للكلمة التي قبله مباشرة، أي: من أتباعها في الوزن، وضبط الآخر، والمشاركة في معظم الحروف الهجائية، دون أن يكون لهذه التبعية العارضة بوصفها السالف علاقة بالتوابع الأصلية الأربعة المعروفة “وهي: النعت، التوكيد، العطف بنوعيه، البدل” كما سبقت الإشارة؛ إذ لا يجري شيء من أوصاف هذه التوابع الأربعة الأصلية وأحكامها على التابع العارض المذكور فيما سبق؛ حيث يقتصر حكمه على أمر واحد، هو: أنه مثل الكلمة التي قبله مباشرة في وزنها، وأكثر حروفها، وضبط آخرها، دون بقية أحكامها النحوية، أو غير النحوية…. اهـ المراد
(6) يفرق بين التابع والتأكيد: أن التابع يُشترط فيه: أن يكون على وزن متبوعه مثل: ” حسن بسن ” و” شيطان ليطان “، ونحوهما.
** أما التأكيد مع المؤكد فلا يشترط ذلك فيه، مثل: ” جاء زيد نفسه “.
(7) يفرق بين التابعٍ والمرادف: أن التابع لا يفيد شيئا غير تقوية الأول، فلا يفيد بدون المتبوع.
أما اللفظان المترادفان: فإن كل واحد منهما يفيد المعنى لو انفرد؛ لأنه مثل مرادفه في الرتبة، مثل: ” الليث والأسد”.
(8) (الإِتباع) ليس خاصا بكلام العرب، بل قد شاركتهم الْعَجم في ذلك.
** قال السيوطي في كتابه: (الإتباع)، (ص: 88):
** قَالَ ابْن فَارس فِي فقه اللُّغَة: للْعَرَب الإتباع، وَهُوَ أَن تتبع الْكَلِمَة الْكَلِمَة على وَزنهَا، أَو رويها إشباعاً وتوكيداً.
** وَقد شاركت الْعَجم الْعَرَب فِي هَذَا الْبَاب.اهـ المراد
وانظر: (الصاحبي في فقه اللغة العربية)، لابن فارس (ص: 209)
و(البلغة الى أصول اللغة) لأبي الطيب محمد صديق خان (ص: 120)
و(المزهر في علوم اللغة وأنواعها)، (1/ 324)
(9) ذكر جملة من الألفاظ من باب الإتباع.
** قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ) في كتابه:(المدهش)، (ص: 37):
** وَمن عاداتهم ـ (أي العرب) ـ تَكْرِير الْكَلَام وَفِي الْقُرْآن {فَبِأَي آلَاء رَبكُمَا تُكَذِّبَانِ}
** وَقد يُرِيدُونَ تَكْرِير الْكَلِمَة ويكرهون إِعَادَة اللَّفْظ فيغيرون بعض الْحُرُوف وَذَلِكَ يُسمى:(الِاتِّبَاع) فَيَقُولُونَ:
** وَمن عاداتهم ـ (أي العرب) ـ تَكْرِير الْكَلَام وَفِي الْقُرْآن {فَبِأَي آلَاء رَبكُمَا تُكَذِّبَانِ}
** وَقد يُرِيدُونَ تَكْرِير الْكَلِمَة ويكرهون إِعَادَة اللَّفْظ فيغيرون بعض الْحُرُوف وَذَلِكَ يُسمى:(الِاتبَاع) فَيَقُولُونَ:
** (أُسْوَانُ أَتْوَانُ) أَي حَزِين، وَ (شَيْء تَافِهٌ نَافِهٌ)، وَ (انه ثَقِفٌ لَقِفٌ)،
و(جَايِعٌ نَايِعٌ)، و(حِلٌّ وبِلٌّ)، و(حَيَّاك اللَّهُ وَبَيَّاكَ)، و(حَقِيرٌ نَقِيرٌ)،
وَ (عَيْنٌ حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ) أَي: عَظِيمَة، و(نضر مُضر)، و(سَمْجٌ لَمْجٌ)،
و(سيغ ليغ)، و(شَكِسٌ لَكِسٌ)، وَ (شَيْطَانٌ لَيْطَانٌ)، و(تفرقوا شَذَرٌ مَذَرٌ، وَشَغَرٌ بَغَرٌ)، وَ (يَوْم عَكٌّ لَكٌّ)، إِذا كَانَ حارا
** و(عَطْشَانُ نَطْشَانُ) و(عِفْرِيتٌ نِفْرِيتٌ)، وَ (كَثِيرٌ بَثِيرٌ) و(كز لز)، وَ (كن أَن)، و(حار جَار يار)، و(قَبِيحٌ لَقِيحٌ شَقِيحٌ)، و(ثِقَةٌ تِقَةٌ نِقَةٌ)، وَ (هُوَ أَشَقٌّ أَمَقٌّ حَبِقٌ) للطويل، وَ (حَسَنٌ بَسَنٌ قَسَنٌ)، وَ (فعلت ذَلِك على رَغْمِهِ وَدَغْمِهِ وشَغْمِهِ)، وَ (مررت بهم أَجْمَعِينَ اكتعين أبصعين). اهـ
(10) ذكر تفسير بعض هذه الكلمات.
** (أُسْوَانُ أَتْوَانُ)
** أي حزين متردد يَذْهب ويجيء من شدة الحزن. اهـ من كتاب:
(المزهر) للسيوطي (1/ 326)
** وَ (شَيْء تَافِهٌ نَافِهٌ)
** للشِّيءِ إِذا كانَ قليلاً حقيراً. اهـ من كتاب:
(الإتباع) لأبي الطيب الحلبي، (ص: 93)
** وَ (إنه ثَقِفٌ لَقِفٌ)
** وَرَجُلٌ ثَقِفٌ لَقِفٌ وثَقْفٌ لَقْف أَي خَفِيف حاذِق،
** وَقِيلَ: سريعُ الفَهْم لِما يُرمى إِلَيْهِ مِنْ كَلَامٍ بِاللِّسَانِ وَسَرِيعُ الأَخذ لِمَا يُرْمَى إِلَيْهِ بِالْيَدِ،
** وَقِيلَ: هُوَ إِذَا كَانَ ضَابِطًا لِمَا يَحْويه قَائِمًا بِهِ،
** وَقِيلَ: هُوَ الْحَاذِقُ بصِناعته. اهـ من كتاب: (لسان العرب) (9/ 320)
** و(جَائِعٌ نَائِعٌ)
** يُقالُ:(رَجُلٌ جَائِعٌ نَائِعٌ)،
** والنَّائعُ زَعَمُوا: المُتمايلَ مِنْ ضَعفِ الجُوعِ، مِنْ قَولِكَ: نَاعَ الغُصْنُ، إِذا مالَ،
** قالَ الرَّاجِزُ:
مَيَّالةٌ مِثلُ القَضيبِ النائِعِ
** وبعضُهُم يَقولُ: النَّائعُ العَطْشانُ ولا نَعْلَمُهُمْ يَقولونَ: رَجُلٌ نَائِعٌ مَفرداً، ويُقالُ في الدُّعاءِ على الرَّجُلِ: جُوعاً لَهُ ونُوعاً!. اهـ من كتاب:
(الإتباع)، لأبي الطيب الحلبي، (ص: 92)
** وفي كتاب:(الزاهر في معاني كلمات الناس) (2/ 47):
554 – وقولهم: فلان جائعٌ نائعٌ
** قال أبو بكر: في النائع قولان:
** قال أكثر أهل اللغة: النائع هو الجائع، وقالوا: هذا إتباع، كقولهم:(شيطان ليطان)، و(حَسَن بَسَن)، و(عطشان نطشان).
** وقال بعضهم: النائع: العطشان. واحتج بقول الشاعر: (347)
(لَعَمْرُ بني شهاب ما أقاموا *** صدورَ الخيلِ والأسَلَ النياعا)
** فالأسل: أطراف الأسِنة، والنياع: العِطاش إلى الدَّم. اهـ من كتاب:
(الزاهر في معاني كلمات الناس)، (2/ 47)
** و(حِلٌّ بِلٌّ)
** و(البِلُّ)، بِالْكَسْرِ: الشِّفاءُ من قَوْلهم:(بَلَّ الرجُلُ مِن مَرضِه): إِذا بَرأ، وَبِه فَسَّر أَبُو عبيد حَدِيث زَمْزم:( لَا أُحِلُّها لِمُغْتَسِلٍ، وَهِي لِشارِبٍ حِلٌّ وبِلٌّ).
** قِيل: البِلُّ هُنَا: المُباحُ، نقلَه ابنُ الأثِير، وغيرُه من أئمّة الغَرِيب.
ويُقال:(حِلٌّ وبلٌّ) أَي حَلالٌ ومُباحٌ. أَو هُوَ إتْباعٌ وَيمْنَعُ مِن جَوازِه الواوُ،
** وَقَالَ الأصمَعِي: كنت أرى أنّ(بِلّاً) إتْباعٌ، حتّى زَعم المُعْتَمِرُ بن سُليمان أَن:(بِلاًّ) فِي لُغة حِمْير: مُباحٌ، وكَرَّر لاخْتِلَاف اللَّفْظ، توكيداً.
** قَالَ أَبُو عبيد: وَهُوَ أَوْلَى لأنّا قَلَّما وجدنَا الإتْباعَ بواو العَطْف. اهـ
(تاج العروس) (28/ 107)
** و(حَيَّاك اللَّهُ وَبَيَّاكَ)
** ويُدْعَى للرَّجُلِ فيقال:(حَيَّاك اللهُ وبَيَّاكَ)! قالَ الأصمعيُّ: (بَيَّاكَ) أَضْحَكَكَ، وقالَ أبو عُبيدة: بَيَّاكَ: مَلَّكَكَ، وقالَ أبو زَيد وابن الأَعرابيّ يُقال: اعْتمدَكَ بالتحيةِ. اهـ
** (الإتباع)لأبي الطيب الحلبي، (ص: 24)
** و(حَقِيرٌ نَقِيرٌ)
** وَقَالَ يَعْقُوب: قَالَ الغنوي: عنز نقرة، وتيس نقر، وَلم أر كَبْشًا نقراً، وَهُوَ ظلع يَأْخُذ الْغنم، ثمَّ قيل لكل حقير متهاون بِهِ: حقر نقر، وحقير نقير، وحقر نقر،
** وَيجوز أَن يُرَاد بِهِ النقير الذي فِي النواة، فَيكون مَعْنَاهُ حَقِيرًا متناهياً فِي الحقارة، وَالْمذهب الأول أَجود. اهـ من كتاب: (الإتباع) لأبي علي القالي (ص: 78)
** وَ (عَيْنٌ حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ)
** وقالوا:(عَينٌ حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ، أَيْ: عَظيمةٌ، والبَدرةُ الكاملةُ التامةُ، ومنهُ سُمِّي البدرُ لتمامِهِ. اهـ ** (الإتباع)لأبي الطيب الحلبي (ص: 26)
** و(خَضِرٌ مَضِرٌ)
وَيَقُولُونَ:(ذهب دَمه خضرًا مضراً)، و(خضرا مضراً)، أى بَاطِلا،
** فالخضر: الْأَخْضَر، وَيُقَال: مَكَان خضر، وَيُمكن أَن يكون مُضر لُغَة فِي نضر،
** وَيكون معنى الْكَلَام: أَن دَمه بَطل كَمَا يبطل الْكلأ الَّذِي يحصده كل من قدر عَلَيْهِ، أَو يُمكن أَن يكون خضر من قَوْلهم: عشب أَخْضَر، إِذا كَانَ رطبا، وَمُضر: أَبيض، لِأَن المضر إِنَّمَا سمى مضراً لبياضه، وَمِنْه مضيرة الطبيخ، فَيكون مَعْنَاهُ أَن دَمه بَطل طرياً، فَكَأَنَّهُ لما لم يثأر بِهِ فيراق لأَجله الدَّم بقى أَبيض. اهـ من كتاب: (الإتباع) لأبي علي القالي (ص: 78)
** وفي كتاب: (الإتباع والمزاوجة)، لابن فارس (ص: 45)
** ويقولون:(دَمٌ خَضِرٌ مَضِرٌ)، وذلكَ إذا طُلَّ فَذَهَبَ.
** وبعضُ العَرَبِ يقول:(هو لك خَضِراً مَضِراً)، أي: هنيئاً مريئاً. اهـ
** و(سَمْجٌ لَمْجٌ)
** (سمج): سَمُجَ الشيءُ، بِالضَّمِّ: قَبُحَ، يَسْمُجُ سَماجَةً إِذا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَلاحَةٌ، وَهُوَ سَمِيجٌ لَمِيجٌ، وسَمْجٌ لَمْجٌ. وَقَدْ سَمَّجَه تَسْمِيجاً إِذا جَعَلَهُ سَمْجاً؛. اهـ من كتاب:
(لسان العرب) (2/ 300)
** وَيَقُولُونَ (سمج لمج)، فاللمج: الْكثير الْأكل الَّذِي يلمج كل مَا وجده، أَي يَأْكُلهُ. اهـ من كتاب:(الإتباع) لأبي علي القالي (ص: 79)
** و(سيغ ليغ)
** و(سَيْغٌ لَيْغ)، و(سائِغٌ لائغ) وهو [الطعام] الذي يَسُوغ سهلا في الحَلْق. اهـ من كتاب:(المزهر في علوم اللغة وأنواعها) (1/ 327)
** وفي كتاب: (مجمل اللغة) لابن فارس (ص: 799)
** (ليغ): [يقال] : سيغٌ ليغٌ: إتباع، وهو السَّهْل الخُلُق. اهـ
** و(شَكِسٌ لَكِسٌ)
** وَيَقُولُونَ:(شكس لكس)، فـ(الشكس): السَّيئ الْخلق، و(اللكس): العسير [قَليل الانْقِيادِ]. اهـ من كتاب: (الإتباع) لأبي علي القالي (ص: 78)
** وَ (شَيْطَانٌ لَيْطَانٌ)
** وهُوَ الَّذي يَلْزَقُ بالشَّرِّ مِنْ قولِكَ: مَا يَلِيطُ بي هذا: أَيْ مَا يَلزَقُ. اهـ من كتاب:
(الإتباع) لأبي الطيب الحلبي، (ص: 75)
** وفي كتاب: (الإتباع) لأبي علي القالي (ص: 72)
** وَيَقُولُونَ:(شَيْطَان ليطان)، فـ(ليطان): مَأْخُوذ من قَوْلهم: لَاطَ حَبَّة بقلبي يلوط ويليط، أى لصق،
** وَيُقَال: للْوَلَد فِي الْقلب لوطة، أى حب لازق،
** وَيَقُولُونَ: هُوَ ألوط بقلبي مِنْك وأليط، أَي ألزق،
** وَيُقَال: مَا يليط هَذَا بقلبي، وَمَا يلتاط، أَي مَا يلصق،
** وَيُقَال: ألاط القَاضِي فلَانا بفلان، أَي ألحقهُ بِهِ،
** فَمَعْنَى قَوْلهم:(شَيْطَان ليطان)، شَيْطَان لصوق. اهـ
** و(تفرقوا شَذَرٌ مَذَرٌ، وَشَغَرٌ بَغَرٌ)
** وَكَذَلِكَ:(تَفَرَّقَ الْقَوْمُ شَغَرَ بَغَر، وشَذَرَ مَذَرَ) أَي فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الإِقبال. اهـ من كتاب: (لسان العرب) (4/ 418)
** وَ (يَوْم عَكٌّ أَكٌّ)
** ويُقال:(يومٌ عكيكٌ أكيكٌ)، و(يومٌ عَكٌّ أكٌّ): إِذا كانَ شَديدَ الحَرِّ.
** و:(الأَكيكُ) بمعنَى العكيكِ، إلاَّ أَنَّهُ لا يُفْرَدُ،
** قالَ الرَّاجز:
يَومٌ عَكيكٌ، يَعْصِرُ الجُلودَا *** يَتْرُكُ حُمْرانَ الرِّجالِ سُودا
ولَيلةٌ غامِدة غُمودا *** سَوداءُ تُغْشِي النَّجْمَ والفُرْقودا.
اهـ من كتاب: (الإتباع) لأبي الطيب الحلبي، (ص: 8)
** و(عَطْشَانُ نَطْشَانُ)
** و(عَطْشان نَطْشَان): إِتباع لَهُ لَا يُفْرد. اهـ من كتاب: (لسان العرب) (6/ 319)
** وفي كتاب: (الإتباع) لأبي علي القالي (ص: 71)
** وَيَقُولُونَ: عَطْشَان نَطْشَان فنَطْشان مَأْخُوذ من قَوْلهم مَا بِهِ نَطيش أَي مَا بِهِ حركةٌ فَمَعْنَاه عَطْشَانٌ قلِقٌ. اهـ
** و(عِفْرِيتٌ نِفْرِيتٌ)
** أَبُو عُبيد: رَجُل عِفْرٌ نِفْرٌ، وعِفْريَةٌ نِفْرِيَةٌ، وعِفْريتٌ نِفْريتٌ، وعُفَارِيَةٌ نُفَاريَةٌ، إِذا كَانَ خَبِيثاً مارداً. اهـ من كتاب: (تهذيب اللغة) (15/ 152)
** وَ (كَثِيرٌ بَثِيرٌ)
** و:(إِنَّهُ لَكَثِيرٌ بَثِيرٌ بَذِيرٌ بَجيرٌ)، كُلُّهُ إتبَاعٌ، و(البَثِيرُ) من قَولِهم: ماءٌ بَثْرٌ: أيْ كثيرٌ؛ إِلاّ أَنَّهُ لا يُقالُ: شَيءٌ بَثِيْرٌ أَي كثيرٌ إِلا عَلى وَجهِ الإِتْباعِ. اهـ من كتاب:
(الإتباع) لأبي الطيب الحلبي (ص: 13)
** و(كز لز)
** و:(كَزٌّ لَزٌّ)، إِتباعٌ لَهُ، قَالَ أَبو زَيْدٍ:(إِنه لَكَزٌّ لَزٌّ)، إِذا كَانَ مُمْسِكًا. اهـ من كتاب:
(لسان العرب) (5/ 405)
** وفي كتاب: (الإتباع) لأبي علي القالي (ص: 83)
** وَيَقُولُونَ: كز لز، فاللز: اللاصق بالشي، من قَوْلهم: لززت الشَّيْء بالشَّيْء، إِذا أَلْصَقته بِهِ وقرنته إِلَيْهِ، وَالْعرب تَقول: هُوَ لزاز شَرّ، ولزيز شَرّ، ولز شَرّ. اهـ
** و(حار جَار يار)
** قالَ أبو مَالكٍ يُقالُ: حَارٌّ يَارٌّ جَارٌّ، ويُقالُ: رَجُلٌ حَرَّانُ يَرَّانُ جَرَّانُ: إِذا أَصابتْهُ مَصيبَةٌ. اهـ من كتاب: (الإتباع)لأبي الطيب الحلبي، (ص: 35)
** و(قَبِيحٌ لَقِيحٌ شَقِيحٌ)
** وَيَقُولُونَ:(قَبِيح شقيح)، فالشقيح مَأْخُوذ من قَوْلهم:(شقيح الْبُسْر) إِذا تَغَيَّرت خضرته بحمرة أَو صفرَة، وَهُوَ حِينَئِذٍ اقبح مَا يكون، وَتلك البسرة تسمى شقحة، وَحِينَئِذٍ يُقَال: أشقح النّخل، فَمَعْنَى قَوْلهم: قَبِيح شقيح، متناهى الْقبْح،
** وَيُمكن أَن يكون بِمَعْنى مشقوح، من قَول الْعَرَب: لأشقحنك شقح الْجَوْز بالجندل، أَي لأكسرنك، فَيكون مَعْنَاهُ قبيحاً مكسوراً.
** وَقَالَ اللحياني: شقيح لقيح، فالشقيح هَا هُنَا: المكسور على مَا ذكرنَا،
** واللقيح: مَأْخُوذ من قَوْلهم: لقحت النَّاقة، ولقح الشّجر، ولقحت الْحَرْب، فَمَعْنَاه: مكسور حَامِل للشر. اهـ من كتاب: (الإتباع) لأبي علي القالي (ص: 74)
** و(ثِقَةٌ تِقَةٌ نِقَةٌ)
** (و) قَالُوا: (ثِقَةٌ} نِقَةٌ) وَهُوَ (إتْباعٌ) كأنَّهم حَذَفُوا وَاو {نِقْوَة، حَكَى ذلكَ ابنُ الأعْرابي. اهـ من كتاب:(تاج العروس)، (40/ 125)
** وَ (هُوَ أَشَقٌّ أَمَقٌّ حَبِقٌ) للطويل
** [شَقِقَ]: الأَشَقُّ: الطويل. يقال: فرس أشق، والأنثى شقّاء.
قال الأصمعي: سمعت عقبة بن رؤبة يصف فرساً فقال:
أَشَقّ أَمَقّ حَبَقّ.
** وقال بعضهم: الأشق من الخيل: الذي يميل في أحد شقيه عند عدوه. اهـ من كتاب:
** (شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم)، لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى: 573هـ)، (6/ 3345)
** وفي كتاب:(تهذيب اللغة)، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي، (المتوفى:370هـ)، (7/ 22):
** (خبق): أَبُو عبيد عَن الأصمعيِّ قَالَ: الْخِبِقُّ: الطَّوِيل.
** ورَوَى غيرهُ عَنهُ أنَّه قَالَ: سَمِعتُ عُقبَةَ بنَ رُؤبَةَ يصفُ فَرَساً فَقَالَ: أَشَقُّ أَمَقُّ خِبَقُّ.
** قَالَ: وَقيل: (خِبَقُّ) إتْباعٌ للأشق الأَمَقِّ.
** وَالْقَوْل: أَنه يُفْرَدُ بالنعت للطويل.
** أَبُو العبَّاس عَن ابْن الأعرابيِّ قَالَ: خُبَيْقٌ تصغيرُ خَبْقٍ، وَهُوَ الطَّول، وَرجل خِبِقٌّ: طَوِيل.
** وَقَالَ غيرُه: يُقَال:(حَبَقَ وخَبَقَ) إِذا ضَرِطَ. اهـ
** وَ(حَسَنٌ بَسَنٌ قَسَنٌ)
مَعْنَاه: حسن كَامِل الْحسن.
** وَ (فعلت ذَلِك على رَغْمِهِ وَدَغْمِهِ وشَغْمِهِ)
** يُقالُ في الدُّعَاءِ عَلى الرَّجُلِ:(لا باركَ اللهُ فيهِ ولا تَاركَ ولا دَارَكَ)!.
** ودُعَاءٌ آخَرُ:(أَرغَمَهُ اللهُ وأَدْغَمهُ)! (ولهُ مِنّي مَا يُرْغِمُهُ ويَدْغِمُهُ)، ويَقولونَ:(رَغْمَاً دَغْمَاً)!؛ و(فَعلتُ ذَاكَ عَلى رَغْمِهِ ودَغْمِهِ). اهـ من كتاب:(الإتباع) لأبي الطيب الحلبي، (ص: 41)
** وقال في (ص: 58)
** ويُسَبُّ الرَّجُلُ فَيُقالُ:(رَغْماً دَغْماً شِنّغْماً! (وفَعَلْتُ ذَاك عَلى رَغْمِهِ ودَغْمِهِ وشَنَّغْمِهِ؛). اهـ
** وفي كتاب :(المخصص)، لابن سيده (4/ 89):
(أدغمه الْأَمر): سَاءَهُ وأرغمه، وَمن دُعَائِهِمْ: رَغْماً دَغْماً شِنَّغْماً، ويروى بِالْعينِ غير مُعْجمَة،
** وَ (مررت بهم أَجْمَعِينَ أكتعين أبصعين). اهـ
** و (رأَيت الْقَوْمَ أَجمعين أَكْتَعِين أَبْصَعِينَ أَبتعين)، تُوكَّدُ الْكَلِمَةُ بِهَذِهِ التواكِيدِ كُلِّهَا،
** وَلَا يُقَدَّمُ (كُتَعُ) عَلَى جُمَعَ فِي التأْكيد، وَلَا يُفْرَدُ لأَنه إِتباع لَهُ،
** وَيُقَالُ إِنه مأْخوذ مِنْ قَوْلِهِمْ: (أَتى عَلَيْهِ حَوْلٌ كَتِيعٌ) أَي تامٌّ. اهـ من كتاب:
(لسان العرب) (8/ 305)
** وفي (شرح الكافية الشافية)، لابن مالك (3/ 1172):
** وقد يجاء بعد “أجمع”1 بـ”أكتع”.
** وبعد “جمعاء” بـ”كتعاء”.
** وبعد “أجمعين” بـ”أكتعين”.
** وبعد “جمع” بـ”كتع”.
** وقد يجاء بعد “أكتع” و”كتعاء” و”أكتعين” و”كتع”.بـ”أبصع” و”بصعاء” وأبصعين” و”بصع”.
** وزاد الكوفيون بعد “أبصع” و”بصعاء” و”أبصعين” و”بصع”: “أبتع” و”بتعاء” و “أبتعين” و”بتع”.
** ولا يجاء بـ”أكتع” وأخواته -غالبا- إلا بعد “أجمع”. وأخواته على الترتيب.
** وشذ قول بعضهم: “أجمع أبصع”.
** وإنما حق “أبصع” إن يجيء بعد “أكتع”.
** وأشذ من “أجمع أبصع”1 قول بعضهم: “جمع بتع”.
** وإنما حق “أبتع” و”بتعاء” و”أبتعين” و”بتع” أن يجاء بهن آخرًا….الخ). اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الجمعة 6/ 3 / 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
==========================
103 من أعظم ما يسأل العبد ربه: العفو والعافية في الدنيا والآخرة
سلسلة الفوائد اليومية:
من أعظم ما يسأل العبد ربه
العفو والعافية في الدنيا والآخرة
** عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَدْعُو بِهِ، فَقَالَ: ” سَلِ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ” قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَدْعُو بِهِ، قَالَ: فَقَالَ: ” يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ” رواه أحمد وغيره, وصححه الألباني.
** عَنْ مُعَاذ بْن رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الأَوَّلِ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: اسْأَلُوا اللَّهَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْرًا مِنَ العَافِيَةِ. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
** تحفة الأحوذي (9/ 348)
** قَوْلُهُ (أسْأَلُهُ اللَّهَ) أَيِ أَطْلُبُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
(سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ) فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بِالدُّعَاءِ بِالْعَافِيَةِ بَعْدَ تَكْرِيرِ الْعَبَّاسِ سُؤَالَهُ بِأَنْ يُعَلِّمَهُ شَيْئًا يَسْأَلُ اللَّهَ بِهِ دَلِيلٌ جَلِيٌّ بِأَنَّ الدُّعَاءَ بِالْعَافِيَةِ لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَدْعِيَةِ وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ شَيْءٌ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي يُدْعَى بِهِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
** وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقُ مَعْنَى (الْعَافِيَةِ): أَنَّهَا دِفَاعُ اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ.
** فَالدَّاعِي بِهَا قَدْ سَأَلَ رَبَّهُ دِفَاعَهُ عَنْ كُلِّ مَا يَنْوِيهِ.
** وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْزِلُ عَمَّهُ الْعَبَّاسَ مَنْزِلَةَ أَبِيهِ وَيَرَى لَهُ مِنَ الْحَقِّ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ فَفِي تَخْصِيصِهِ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَقَصْرِهِ عَلَى مُجَرَّدِ الدُّعَاءِ بِالْعَافِيَةِ تَحْرِيكٌ لِهِمَمِ الرَّاغِبِينَ عَلَى مُلَازَمَتِهِ وَأَنْ يَجْعَلُوهُ مِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَوَسَّلُونَ بِهِ إِلَى رَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَسْتَدْفِعُونَ بِهِ فِي كُلِّ مَا يُهِمُّهُمْ.
** ثُمَّ كَلَّمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ:(سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)
** فَكَانَ هَذَا الدُّعَاءُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ قَدْ صَارَ عُدَّةً لِدَفْعِ كُلِّ ضُرٍّ وَجَلْبِ كُلِّ خَيْرٍ.
** وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ جِدًّا.
** قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي (عِدَّةِ الْحِصْنِ الْحَصِينِ): لَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم دعاءه بِالْعَافِيَةِ، وَوَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفظا ومعنى من نحو من خَمْسِينَ طَرِيقًا. اهـ
** قال الشاعر، وهو منصور الفقيه:
رأيت البلاء كقطر السَّماء *** وما تنبت الأرض من ناميه
فلا تسألنّ إذا ما سألت *** إلهك شيئاً سوى العافية
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 4/ 3 / 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
==========================
102 الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ
سلسلة الفوائد اليومية:
الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ
** إن من أعظم القواعد الشرعية والسنن الربانية التي لا تتخلف ولا تتغير قاعدة:(الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ)، وهي أن يجازي الله العبد من جنس عمله في الخير والشر؛ ليعرف العباد عدل الله وحكمته ورحمته، وليرغبوا في فعل الطاعات ويحذروا من ارتكاب المعاصي والمنكرات؛ فإن الْجَزَاءً مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.
** قال الله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ}
** وفي الحيث: [يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»] رواه مسلم (4/ 1994) برقم:(2577) عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رضي الله عنه.
** وقد دلت الأدلة الكثيرة المتكاثرة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة العظيمة.
** فمن ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}
** أي: إن تنصروا دين الله وشريعته بالعمل بها، فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات، ينصركم الله على أنفسكم، وأعدائكم من شياطين الجنّ والإنس، فإن الجزاء من جنس العمل.
** وقوله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ}
** وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ}.
** وقوله تعالى: {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}
** وقوله تعالى: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا}
** وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ”
** وقوله تعالى:”وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ}
** وقَوْله تَعَالَى {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}
** وقوله تعالى:{إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . . . ) الحديث رواه مسلم (4/ 2074)برقم:(2699)
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً “
** وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرْ لَهُ ” رواه أحمد وصححه الألباني
** قال ابن القيم في كتابه:(إعلام الموقعين),(1/ 150):
** وَلِذَلِكَ كَانَ الْجَزَاءُ مُمَاثِلًا لِلْعَمَلِ مِنْ جِنْسِهِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ،
فَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ،
** وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
** وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
** وَمَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
** وَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ،
** وَمَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّ اللَّهُ بِهِ،
** وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ،
** وَمَنْ خَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ نُصْرَتُهُ فِيهِ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ نُصْرَتُهُ فِيهِ،
** وَمَنْ سَمَحَ سَمَحَ اللَّهُ لَهُ،
** وَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ،
** وَمَنْ أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ،
** وَمَنْ أَوْعَى أَوْعَى عَلَيْهِ،
** وَمَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ عَفَا اللَّهُ لَهُ عَنْ حَقِّهِ،
وَمَنْ تَجَاوَزَ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ،
** وَمَنْ اسْتَقْصَى اسْتَقْصَى اللَّهُ عَلَيْهِ؛
** فَهَذَا شَرْعُ اللَّهِ وَقَدَرُهُ وَوَحْيُهُ وَثَوَابُهُ وَعِقَابُهُ كُلُّهُ قَائِمٌ بِهَذَا الْأَصْلِ، وَهُوَ إلْحَاقُ النَّظِيرِ بِالنَّظِيرِ، وَاعْتِبَارُ الْمِثْلِ بِالْمِثْلِ. اهـ المراد
** وما أحسن هذه الأبيات- وتنسب للأمام الشافعي,رحمه الله تعالى:
عِفُّواْ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ في المحْرَمِ *** وَتَجَنَّبُواْ مَا لاَ يَلِيقُ بِمُسْلِمِ
مَنْ يَزْنِ في بَيْتٍ بألفَي درهمٍ *** في بَيْتِهِ يُزْنَى بِدُونِ دَرَاهِمِ
مَنْ يَزْنِ يُزْنَ بِهِ وَلَوْ بجِدَارِهِ *** إِنْ كُنْتَ يَا هَذَا لَبِيبَاً فَافْهَمِ
إِنَّ الزِّنَا دَيْنٌ فإِنِ اقْرَضْتهُ *** كَانَ الوَفَا مِن أَهْلِ بَيْتِكَ فَاعْلَمِ
** وقال آخر:
وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا *** وَلَا ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبلَى بِظَالِمٍ
** وقال آخر:
اصبر على الظلم و لا تنتصر*** فالظلم مردود على الظالم
** وقال آخر:
و كم من حافر حفرة لامرئ*** سيصرعه البغي فيما احتفر
** وقال آخر:
قضى الله أن البغي يصرع أهله *** و أن على الباغي تدور الدوائر
ومن يحتفر بئراً ليوقع غيره *** سيوقع في البئر الذي هو حافر
** وقال آخر:
ومن يبغ أو يسعى إلى الناس ظالما*** يقع غير شك لليدين وللفم
** وأنشد الأزدي:
وقِّر مشايخ أهل العلم قاطبة * * * حتى تُوقَّرَ إن أفضى بك الكبرُ
واخدم أكابرهم حتى تنال به * * * مثلاً بمثلٍ إذا ما شارف العُمُرُ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 29/ 2 / 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
==========================
101 ذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الطب
سلسلة الفوائد اليومية:
ذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الطب
** (ذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الطب)
** قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ}
** وقال تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ (*) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
** وقال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}
** وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعبة رضي اللَّهُ عَنْهُ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه.
** وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»
رواه مسلم وغيره.
** وفي (شرح النووي على مسلم),(1/ 64):
** فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) ضَبَطْنَاهُ (يُرَى) بِضَمِّ الْيَاءِ وَ(الْكَاذِبِينَ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ عَلَى الْجَمْعِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي اللَّفْظَتَيْنِ.
** قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الرِّوَايَةُ فِيهِ عِنْدنَا (الْكَاذِبِينَ) عَلَى الْجَمْعِ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حَدِيثُ سَمُرَةَ (الْكَاذِبَيْنِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ على التثنية، واحتج به على أن الراوي له يُشَارِكَ الْبَادِئَ بِهَذَا الْكَذِبِ ثُمَّ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ (الْكَاذِبَيْنِ أَوِ الْكَاذِبِينَ) عَلَى الشَّكِّ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ.
** وَذَكَرَ بَعْضُ الأئمة جواز فتح الياء من (يُرَى) وَهُوَ ظَاهِرٌ حَسَنٌ
** فَأَمَّا مَنْ ضَمَّ الْيَاءَ فَمَعْنَاهُ يَظُنُّ، وَأَمَّا مَنْ فَتَحَهَا فَظَاهِرٌ وَمَعْنَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ،
** وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى يَظُنُّ أَيْضًا فَقَدْ حُكِيَ رَأَى بِمَعْنَى ظَنَّ.
** وَقُيِّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَأْثَمُ إِلَّا بِرِوَايَتِهِ مَا يَعْلَمُهُ أَوْ يَظُنُّهُ كَذِبًا،
** أَمَّا مَا لَا يَعْلَمُهُ وَلَا يَظُنُّهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَتِهِ وَإِنْ ظَنَّهُ غَيْرُهُ كَذِبًا أَوْ عَلِمَهُ.
** وَأَمَّا فِقْهُ الْحَدِيثِ: فَظَاهِرٌ، فَفِيهِ تَغْلِيظُ الْكَذِبِ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ وَأَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُ مَا يَرْوِيهِ فَرَوَاهُ كَانَ كَاذِبًا، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَاذِبًا وَهُوَ مُخْبِرٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ.
** وَسَنُوَضِّحُ حَقِيقَةَ الْكَذِبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ
** قال ابن قيم الجوزية في كتابه: (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) (ص: 43):
** فَصْلٌ-5-
** وَسُئِلْتُ: هَلْ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ بِضَابِطٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْظَرَ فِي سَنَدِهِ؟
** فَهَذَا سُؤَالٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ وَإِنَّمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ تَضَلَّعَ فِي مَعْرِفَةِ السَّنَنِ الصَّحِيحَةِ وَاخْتَلَطَتْ بِلَحْمِهِ وَدَمِّهِ وَصَارَ لَهُ فِيهَا مَلَكَةٌ وَصَارَ لَهُ اخْتِصَاصٌ شَدِيدٌ بِمَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ وَمَعْرِفَةِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ وَيُخْبِرُ عَنْهُ وَيَدْعُو إِلَيْهِ وَيُحِبُّهُ وَيَكْرَهُهُ وَيُشْرِعُهُ لِلأُمَّةِ بحيث كَأَنَّهُ مُخَالِطٌ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَاحِدٍ مِنَ أَصَحَابِهِ.
** فَمِثْلُ هَذَا يَعْرِفُ مِنْ أَحْوَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ وَكَلامِهِ وَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ وَمَا لا يَجُوزُ مَا لا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ
** وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُتَّبِعٍ مَعَ مَتْبُوعِهِ فَإِنَّ لِلأَخَصِّ بِهِ الْحَرِيصَ عَلَى تَتَبُّعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ وَمَا لا يَصِحُّ مَا لَيْسَ لِمَنْ لا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهَذَا شَأْنُ الْمُقَلِّدِينَ مَعَ أَئِمَّتِهِمْ يَعْرِفُونَ أَقْوَالَهُمْ وَنُصُوصَهُمْ وَمَذَاهِبَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
** وقال أيضا المنار في (ص: 51)
فَصْلٌ-7-
وَمِنْهَا: 2-تَكْذِيبُ الْحِسِّ لَهُ كَحَدِيثِ:
** “الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ”.
** “وَالْبَاذِنْجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ”. قَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُمَا فَإِنَّ هَذَا لَوْ قَالَهُ يُوحَنِّسُ أَمْهَرُ الأَطِبَّاءِ لسخر النَّاسُ مِنْهُ وَلَوْ أُكِلَ الْبَاذِنْجَانُ للحمى والسوداء الغالبة وَكَثِيرٍ مِنَ الأَمْرَاضِ لَمْ يَزِدْهَا إِلا شِدَّةً وَلَوْ أَكَلَهُ فَقِيرٌ لِيَسْتَغْنَى لَمْ يُفِدْهُ الْغِنَى أَوْ جَاهِلٌ لِيَتَعَلَّمَ لَمْ يُفِدْهُ الْعِلْمُ.
** وقال أيضا المنار في (ص: 64)
فَصْلٌ-14-
وَمِنْهَا: 9-أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق.
كحديث “الهريسة تشد الظهر”.
** وكحديث “أكل السمك يوهن الجسد”.
** وَحَدِيثِ “الَّذِي شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْبَيْضَ والبصل”.
** وحديث “أتاني جبريل بهريسة من الْجَنَّةِ فَأَكَلْتُهَا فَأُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلا فِي الجماع”.
** وَحَدِيثِ “الْمُؤْمِنُ حُلْوٌ يحب الحلاوة”.
** وَرَوَاهُ الْكَذَّابُ الأَشَرُّ بِلَفْظٍ آخَرَ “الْمُؤْمِنُ حُلْوِيٌّ والكافر خمري”.
** وَحَدِيثِ “كُلُوا التَّمْرَ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدود”.
** وَحَدِيثِ “أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ التمر”.
** وَحَدِيثِ “مَنْ لَقَّمَ أَخَاهُ لُقْمَةً حُلْوَةً صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَارَةَ الموقف”.
** وَحَدِيثِ “مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً مِنْ مَجْرَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا غُفِرَ لَهُ”.
** وَحَدِيثِ “النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ يُذْهِبُ البركة”.
** وَحَدِيثِ “إِذَا طَنَّتْ أُذُنُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ وَلْيَقُلْ: ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرَنِي بِخَيْرٍ” وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي طَنِينِ الأُذُنِ فَهُوَ كِذْبٌ. اهـ المراد
**((تنبيه)): الْهَرِيسَةُ عند العرب: طَعَامٌ يُتَّخَذُ مِنَ الْحَبُّ الْمَدْقُوق وَاللَّحْمِ، وَأَطْيَبُهُ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَلَحْمِ الدِّيكِ.
وعند المتأخرين: نَوع من الْحَلْوَى يصنع من الدَّقِيق وَالسمن وَالسكر.
** انظر: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)، (2/ 637)
و(المعجم الوسيط)، (2/ 981)
و(عون المعبود وحاشية ابن القيم)، (1/ 99)
** وهذه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة من كتاب:(ضعيف الجامع الصغير وزيادته)
3753 – (عليكم بالأترج فإنه يشد الفؤاد).
** (ضعيف) (رواه الديلمي في ” مسند الفردوس “) عن عبد الرحمن بن دلهم معضلا.
3754 -(عليكم بألبان الإبل والبقر فإنها ترم من الشجر كله وهو دواء من كل داء).
** (ضعيف) (رواه ابن عساكر) عن طارق بن شهاب.
3758 – (عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها دواء من اثنين وسبعين داء وخمسة أدواء: من الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس).
** (ضعيف) (رواه الطبراني وابن السني أبو نعيم) عن صهيب.
وفي كتاب:(التيسير بشرح الجامع الصغير), (2/ 140):
** (عَلَيْكُم بالحجامة فِي جوز القمحدوة) بِفَتْح الْقَاف وَالْمِيم وَسُكُون الْمُهْملَة وَضم الدَّال الْمُهْملَة وَفتح الْوَاو نقرة الْقَفَا
** (فَإِنَّهَا دَوَاء من اثْنَيْنِ وَسبعين دَاء وَخَمْسَة أدواء من الْجُنُون والجذام والبرص ووجع الأضراس)
أَي وَخَمْسَة أدواء زِيَادَة على ذَلِك فَذكر خَمْسَة وعد أَرْبعا فَكَأَن الْخَامِسَة سَقَطت من بعض الروَاة أَو من بعض النساخ. اهـ
3760 – (عليكم بالحناء فإنه ينور رءوسكم ويطهر قلوبكم ويزيد في الجماع وهو شاهد في القبر).
** (ضعيف) (رواه ابن عساكر) عن واثلة.
3761 – (عليكم بالزبيب فإنه يكشف المرة ويذهب بالبلغم ويشد العصب ويذهب بالعياء ويحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب بالهم).
** (موضوع) (رواه أبو نعيم) عن علي.
3764 – (عليكم بالسواك فنعم الشيء السواك, يذهب بالحفر وينزع البلغم ويجلو البصر ويشد اللثة ويذهب بالبخر ويصلح المعدة ويزيد في درجات الجنة ويحمد الملائكة ويرضي الرب ويسخط الشيطان).
** (ضعيف) (رواه عبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا) عن أنس.
3765 – (عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن).
** (ضعيف) (رواه البيهقي والحاكم) عن ابن مسعود.
3772 – (عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ وعليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيا). (ضعيف) (الطبراني) عن واثلة.
3773 – (عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ).
** (موضوع) (رواه البيهقى فى شعب الإيمان) عن عطاء مرسلا.
3776 – (عليكم بالكحل فإنه ينبت الشعر ويشد العين).
** (موضوع) (رواه البغوي في مسند عثمان) عن جابر.
3784 – (عليكم بزيت الزيتون فكلوه وادهنوا به فإنه ينفع من الباسور).
** (موضوع) (رواه ابن السني) عن عقبة بن عامر.
3785 – (عليكم بسيد الخضاب الحناء يطيب البشرة ويزيد في الجماع).
** (ضعيف) (رواه ابن السني وأبو نعيم) عن أبي رافع.
3794 – (عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه مصحة من الباسور).
** (ضعيف) (رواه الطبراني وأبو نعيم) عن عقبة بن عامر.
4606 – (كان يكره الكي والطعام الحار ويقول: عليكم بالبارد فإنه ذو بركة ألا وإن الحار لا بركة له).
** (موضوع) (رواه أبو نعيم في الحلية) عن أنس.
1637 – (إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم).
** (ضعيف جدا) (رواه الطبراني) عن أم سلمة.
2756 – (الحجامة في الرأس شفاء من سبع إذا ما نوى صاحبها: من الجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة يجدها في عينيه).
** (ضعيف) (رواه الطبراني وأبو نعيم) عن ابن عباس.
2759 – (الحجامة يوم الأحد شفاء).
** (موضوع) (رواه الديلمي في ” مسند الفردوس “) عن جابر و(عبد الملك بن حبيب في الطب النبوي) عن عبد الكريم الحضرمي معضلا.
2969 – (درهم حلال يشترى به عسل ويشرب بماء المطر شفاء من كل داء).
** (ضعيف جدا) (رواه الديلمي في ” مسند الفردوس “) عن أنس.
3360 – (السواك شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت).
** (ضعيف) (رواه الديلمي في ” مسند الفردوس “) عن عائشة.
3904 – (غبار المدينة شفاء من الجذام).
** (ضعيف) (رواه أبو نعيم في الطب) عن ثابت بن قيس بن شماس.
3951 – (فاتحة الكتاب شفاء من كل داء).
** (موضوع) (رواه البيهقى فى شعب الإيمان) عن عبد الملك بن عمير مرسلا.
4202 – (كلوا الزيت وادهنوا به فإن فيه شفاء من سبعين داء منها الجذام).
** (ضعيف) (رواه أبو نعيم في الطب) عن أبي هريرة.
5518 – (من تداوى بحرام لم يجعل الله فيه شفاء).
** (ضعيف) (رواه أبو نعيم في الطب) عن أبي هريرة.
1139 – (أكل السفرجل يذهب بطخاء القلب).
** (ضعيف) (رواه القالي في أماليه) أنس.
4002 – (في السواك عشر خصال: يطيب الفم ويشد اللثة ويجلو البصر ويذهب البلغم ويذهب الحفر ويوافق السنة ويفرح الملائكة ويرضي الرب ويزيد في الحسنات ويصحح المعدة).
** (ضعيف) (رواه أبو الشيخ في الثواب أبو نعيم في كتاب السواك) عن ابن عباس.
4201 – (كلوا التين فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم لقلت هي التين وإنه يذهب بالبواسير وينفع من النقرس).
** (ضعيف) (رواه ابن السني أبو نعيم فر) عن أبي ذر.
2374 – (البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا).
** (ضعيف) (رواه ابن عساكر) عن بعض عمات النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شاذ لا يصح.
وفي كتاب:(كشف الخفاء) لأبي الفداء إسماعيل بن محمد العجلوني (2/ 518):
** وباب فضل العدس والباقلاء والجبن والجوز والباذنجان والرمان
والزبيب؛ لم يصح فيه شيء.
** وإنما وضع الزنادقة في هذه الأبواب أحاديث وأدخلوها في كتب المحدثين شينًا للإسلام – خذلهم الله.
** وباب فضل اللحم، وأن أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم؛ لم يثبت فيه شيء.
** وباب النهي عن قطع اللحم بالسكين؛ لم يثبت فيه شيء.
** وباب فضل الهريسة؛ لم يثبت فيه شيء، والجزء المشهور في ذلك؛ مجموع مفترى.
** وباب النهي عن أكل الطين؛ لم يثبت فيه شيء.
** وباب الأكل في السوق؛ لم يثبت فيه شيء.
** وباب فضائل البطيخ؛ لم يثبت فيه شيء، وأحاديث كتاب البطيخ؛ مجموعها باطل وموضوع،
** والثابت من تلك الجملة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ.
** وباب فضائل النرجس والمردقوش والبنفسج والبان؛ لم يثبت فيه حديث، وحديث “من شم الورد”، وحديث “خلق الورد من عرقي”، وأمثال هذا؛ كلها موضوعة باطلة.
** وباب فضائل الديك الأبيض؛ لم يثبت فيه شيء والحديث المسلسل المشهور فيه: “الديك الأبيض صديقي”؛ باطل موضوع.
** وباب فضائل الحناء؛ ليس فيه شيء صحيح. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 27/ 2 / 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
==========================
100 خذ من الأمور أيسرها واترك ما عسر منها
سلسلة الفوائد اليومية:
خذ من الأمور أيسرها واترك ما عسر منها
** عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا» متفق عليه
** عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الأَدْرَعِ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ الْيُسْرَ وَكَرِهَ لَهَا الْعُسْرَ قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ. رواه الطبراني وصححه الألباني.
** عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَرِ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
** وفي كتاب:(مجمع الحكم والأمثال) لأحمد قبش (8/ 325):
قال: أبو سليمان الغنوي
فـسـلِ الـفـقـيـهَ تـكـنْ فـقـيـهـاً مـثـلـهُ *** لا خـيـرَ فـي عـلـمٍ بـغـيـر تـدبـرِ
وإِذا تـعـسـرتِ الأمـورُ فـأرجـهـا *** وعـليـكَ بـالأمـرِ الـذي لم يَعْسُرِ
** وفي كتاب:(الاستيعاب في معرفة الأصحاب)، لابن عبد البر
(1/ 373):
وكان عمرو بن معد يكرب شاعراً محسناً، ومما يستحسن من شعره قوله:
إِذَا لَـمْ تَـسْـتَـطِـعْ شَـيْـئًا فَـدَعْهُ*** وَجَـاوِزْهُ إِلَـى مَا تَسْتَطِيعُ
** وفي كتاب:(وفيات الأعيان) -لابن خلكان (2/ 247)
ويحكى عنه [يعني: الخليل بن أحمد الفراهيدي] أنه قال: كان يتردد إلىّ شخص يتعلم العروض وهو بعيد الفهم، فأقام مدة ولم يعلق على خاطره شيء منه، فقلت له يوماً: قطع هذا البيت:
إِذَا لَـمْ تَـسْـتَـطِـعْ شَـيْـئًا فَـدَعْهُ *** وَجَـاوِزْهُ إِلَـى مَا تَسْتَطِيعُ
فشرع معي في تقطيعه على قد معرفته، ثم نهض ولم يعد يجيء إلي، فعجبت من فطنته لما قصدته في البيت مع بعد فهمه. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 24/ 2 / 1439 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
==========================
99 ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وَبُعُوثِهِ وَسَرَايَاهُ
سلسلة الفوائد اليومية:
99 ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وَبُعُوثِهِ وَسَرَايَاهُ
** قال ابن القيم في كتابه القيم :(زاد المعاد)، (1/ 125):
[فَصْلٌ فِي غَزَوَاتِهِ وَبُعُوثِهِ وَسَرَايَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
** غَزَوَاتُهُ كُلُّهَا وَبُعُوثُهُ وَسَرَايَاهُ كَانَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فِي مُدَّةِ عَشْرِ سِنِينَ، فَالْغَزَوَاتُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ،
** وَقِيلَ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ،
** وَقِيلَ: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ،
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ،
** قَاتَلَ مِنْهَا فِي تِسْعٍ: بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَالْخَنْدَقِ، وَقُرَيْظَةَ، وَالْمُصْطَلِقِ، وَخَيْبَرَ، وَالْفَتْحِ، وَحُنَيْنٍ، وَالطَّائِفِ.
** وَقِيلَ: قَاتَلَ فِي بَنِي النَّضِيرِ، وَالْغَابَةِ، وَوَادِي الْقُرَى مِنْ أَعْمَالِ خَيْبَرَ.
** وَأَمَّا سَرَايَاهُ وَبُعُوثُهُ، فَقَرِيبٌ مِنْ سِتِّينَ،
** وَالْغَزَوَاتُ الْكِبَارُ الْأُمُّهَاتُ سَبْعٌ: بَدْرٌ، وَأُحُدٌ، وَالْخَنْدَقُ، وَخَيْبَرُ، وَالْفَتْحُ، وَحُنَيْنٌ، وَتَبُوكُ.
** وَفِي شَأْنِ هَذِهِ الْغَزَوَاتِ نَزَلَ الْقُرْآنُ:
** فَسُورَةُ (الْأَنْفَالِ) سُورَةُ بَدْرٍ، وَفِي أُحُدٍ آخِرُ سُورَةِ (آلِ عِمْرَانَ) مِنْ قَوْلِهِ: {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ) تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ} [آل عمران: 121] [آلِ عِمْرَانَ 121] إِلَى قُبَيْلِ آخِرِهَا بِيَسِيرٍ،
** وَفِي قِصَّةِ الْخَنْدَقِ، وَقُرَيْظَةَ، وَخَيْبَرَ صَدْرُ (سُورَةِ الْأَحْزَابِ) ،
** وَسُورَةُ (الْحَشْرِ) فِي بَنِي النَّضِيرِ،
** وَفِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ سُورَةُ (الْفَتْحِ) وَأُشِيرَ فِيهَا إِلَى الْفَتْحِ،
** وَذُكِرَ الْفَتْحُ صَرِيحًا فِي سُورَةِ (النَّصْرِ).
** وَجُرِحَ مِنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أُحُدٌ،
** وَقَاتَلَتْ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مِنْهَا فِي بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ،
** وَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَزَلْزَلَتِ الْمُشْرِكِينَ وَهَزَمَتْهُمْ، وَرَمَى فِيهَا الْحَصْبَاءَ فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَهَرَبُوا،
** وَكَانَ الْفَتْحُ فِي غَزْوَتَيْنِ: بَدْرٍ، وَحُنَيْنٍ.
** وَقَاتَلَ بِالْمَنْجَنِيقِ مِنْهَا فِي غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ الطَّائِفُ،
وَتَحَصَّنَ فِي الْخَنْدَقِ فِي وَاحِدَةٍ، وَهِيَ الْأَحْزَابُ أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 29/ 1 / 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
==========================
98 مدح الشعر الحسن وذم القبيح منه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بشاعر، ولا ينبغي له ذلك
سلسلة الفوائد اليومية:
98 مدح الشعر الحسن وذم القبيح منه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بشاعر، ولا ينبغي له ذلك
** الشعر كلام موزون مقفى، وهو كغيره من منثور الكلام حسنه حسن، وقبيحه قبيح.
** قال تعالى: {وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ*وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ*إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ}
** وقال تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ*وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ*وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ*تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ}
** وقال تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ}
** وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً» خ
** وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا» رواه أبو داود وغيره، [وصححه الألباني]
** وفي كتاب:(النهاية في غريب الحديث والأثر)، (1/ 419):
(هـ) وَفِيهِ «إنَّ مِنَ الشِّعْر لحُكْمًا» أَيْ إِنَّ مِنَ الشِعر كَلَامًا نَافِعًا يَمْنَعُ مِنَ الْجَهْلِ والسَّفَه، ويَنهَى عَنْهُمَا.
قِيلَ: أَرَادَ بِهَا الموَاعِظ وَالْأَمْثَالَ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا النَّاسُ.
والحُكْم: العلْمُ وَالْفِقْهُ وَالْقَضَاءُ بِالْعَدْلِ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَكَمَ يَحْكُم. ويُروَى «إِنَّ مِنَ الشِّعر لَحِكْمَة» وَهِيَ بِمَعْنَى الحُكْم. اهـ
** وفي كتاب:(فيض القدير)، (2/ 524):
2457 -(إن من البيان سحرا) أي إن بعض البيان سحرا لأن صاحبه يوضح المشكل ويكشف بحسن بيانه عن حقيقته فيستميل القلوب كما يستمال بالسحر فلما كان في البيان من صنوف التركيب وغرائب التأليف ما يجذب السامع إلى حد يكاد يشغله عن غيره شبه بالسحر الحقيقي قال صعصعة: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بحجته من صاحبه فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق.
(وإن من الشعر حكما) جمع حكمة أي قولا صادقا مطابقا للحق موافقا للواقع وذلك ما كان منه من قبيل المواعظ وذم الدنيا والتحذير من غرورها ونحو ذلك.
فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن جنس البيان وإن كان محمودا ففيه ما يذم للمعنى السابق وجنس الشعر وإن كان مذموما ففيه ما يحمد لاشتماله على الحكمة وعبر بمن إشارة إلى أن بعضه ليس كذلك وفيه رد على من كره مطلق الشعر وأصل الحكمة المنع وبها سمي اللجام لأنه يمنع الدابة. اهـ
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:
[البحر الطويل]
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ
وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ» مسلم
** وعَنْ الشَّرِيدِ بن سويد الثقفي، رضي الله عنه قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هِيهْ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهْ» ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهْ» حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ. خ
** وعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه، قال: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ، فَعَثَرَ، فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ:
«هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ … وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ» متفق عليه
** وفي (شرح النووي على مسلم)، (12/ 118):
** قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(أنا النبي لا كذب أنا بن عَبْدِ الْمُطَّلِبْ)
** قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: قَالَ الْمَازِرِيُّ: أَنْكَرَ بَعْضُ النَّاسِ كَوْنَ الرَّجَزِ شِعْرًا لِوُقُوعِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {ومَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي له}، وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَخْفَشِ وَاحْتُجَّ بِهِ عَلَى فَسَادِ مَذْهَبِ الْخَلِيلِ فِي أَنَّهُ شِعْرٌ.
** وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا: بِأَنَّ الشِّعْرَ هُوَ مَا قُصِدَ إِلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُوقِعَهُ مَوْزُونًا مُقَفًّى يَقْصِدُهُ إِلَى الْقَافِيَةِ.
** وَيَقَعُ فِي أَلْفَاظِ الْعَامَّةِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَوْزُونَةِ، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ: إِنَّهَا شِعْرٌ، وَلَا صَاحِبُهَا شَاعِرٌ،
** وَهَكَذَا الْجَوَابُ عَمَّا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْمَوْزُونِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَنْ تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ}، ** وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا لَا يُسَمِّيهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ شِعْرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُقْصَدْ تَقْفِيَتُهُ وجعله شعرا.
** قَالَ: وَقَدْ غَفَلَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَأَوْقَعَهُ ذَلِكَ فِي أَنْ قَالَ: الرِّوَايَةُ (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ حِرْصًا مِنْهُ عَلَى أَنْ يُفْسِدَ الرَّوِيَّ فَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الِاعْتِذَارِ، وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي عَنِ الْمَازِرِيِّ.
** قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ السَّعْدِيُّ الصَّقَلِّيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْقَطَّاعِ فِي كتابه:(الشافي في علم القوافي):
قد رأي قَوْمٍ مِنْهُمُ الْأَخْفَشُ وَهُوَ شَيْخُ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ بَعْدَ الْخَلِيلِ أَنَّ مَشْطُورَ الرَّجَزِ وَمَنْهُوكَهُ لَيْسَ بِشِعْرٍ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ)،
** وَقَوْلِهِ صَلَّى الله عليه وسلم:(هل أنت إلا أصبع دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ) ,
** وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(أَنَا النَّبِيُّ لَا كذب أنا بن عبد المطلب) وأشباه هذا،
** قال بن الْقَطَّاعِ: وَهَذَا الَّذِي زَعَمَهُ الْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُ غَلَطٌ بَيِّنٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّاعِرَ إِنَّمَا سُمِّيَ شَاعِرًا لِوُجُوهٍ:
** مِنْهَا: أَنَّهُ شَعَرَ الْقَوْلَ وَقَصَدَهُ وَأَرَادَهُ وَاهْتَدَى إِلَيْهِ وَأَتَى بِهِ كَلَامًا مَوْزُونًا عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَبِ مُقَفًّى.
** فَإِنْ خَلَا مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ أَوْ بَعْضِهَا لَمْ يَكُنْ شِعْرًا، وَلَا يَكُونُ قَائِلُهُ شَاعِرًا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَلَامًا مَوْزُونًا عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَبِ وَقَصَدَ الشِّعْرَ، أَوْ أَرَادَهُ وَلَمْ يُقَفِّهِ لَمْ يُسَمَّ ذَلِكَ الْكَلَامُ شِعْرًا، وَلَا قَائِلُهُ شَاعِرًا بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَالشُّعَرَاءِ.
** وَكَذَا لَوْ قَفَّاهُ وَقَصَدَ بِهِ الشِّعْرَ وَلَكِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ مَوْزُونًا لَمْ يَكُنْ شِعْرًا ** وَكَذَا لَوْ أَتَى بِهِ مَوْزُونًا مُقَفًّى لَكِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الشِّعْرَ لَا يَكُونُ شِعْرًا، ** وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَأْتُونَ بِكَلَامٍ مَوْزُونٍ مُقَفًّى غَيْرَ أَنَّهُمْ مَا قَصَدُوهُ وَلَا أَرَادُوهُ وَلَا يُسَمَّى شِعْرًا.
** وَإِذَا تُفُقِّدَ ذَلِكَ وُجِدَ كَثِيرًا فِي كَلَامِ النَّاسِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السُّؤَّالِ: اخْتِمُوا صَلَاتَكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ، وَأَمْثَالُ هَذَا كَثِيرَةٌ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الْمَوْزُونَ لَا يَكُونُ شِعْرًا إِلَّا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ الْقَصْدُ وَغَيْرُهُ مِمَّا سَبَقَ.
** وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْصِدْ بِكَلَامِهِ ذَلِكَ الشِّعْرَ وَلَا أَرَادَهُ فَلَا يُعَدُّ شِعْرًا وَإِنْ كَانَ مَوْزُونًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ المراد
** وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» مسلم
** وفي (شرح النووي على مسلم)، (15/ 14):
** قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ:(يَرِيهِ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مِنَ الْوَرْيِ، وَهُوَ دَاءٌ يُفْسِدُ الْجَوْفَ، وَمَعْنَاهُ: قَيْحًا يَأْكُلُ جَوْفَهُ وَيُفْسِدُهُ.
** قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِهَذَا الشِّعْرِ شِعْرٌ هُجِيَ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
** قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً: هَذَا تَفْسِيرٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَذْمُومَ مِنَ الْهِجَاءِ أَنْ يَمْتَلِئَ مِنْهُ دُونَ قَلِيلِهِ،
** وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَلِمَةَ الواحدة من هجاء النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوجِبَةٌ لِلْكُفْرِ.
** قَالُوا: بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ الشِّعْرُ غَالِبًا عَلَيْهِ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَشْغَلُهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَذْمُومٌ مِنْ أَيِّ شِعْرٍ كَانَ
** فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ فَلَا يَضُرُّ حِفْظُ الْيَسِيرِ مِنَ الشِّعْرِ مَعَ هَذَا؛ لِأَنَّ جَوْفَهُ لَيْسَ مُمْتَلِئًا شِعْرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
** وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهَةِ الشِّعْرِ مُطْلَقًا قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَإِنْ كَانَ لَا فُحْشَ فِيهِ، وَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(خُذُوا الشَّيْطَانَ)،
** وَقَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً: هُوَ مُبَاحٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فُحْشٌ وَنَحْوُهُ.
** قَالُوا: وَهُوَ كَلَامٌ، حَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ.
** وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْرَ ,وَاسْتَنْشَدَهُ وَأَمَرَ بِهِ حَسَّانَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ,
** وَأَنْشَدَهُ أَصْحَابُهُ بِحَضْرَتِهِ فِي الْأَسْفَارِ وَغَيْرِهَا
** وَأَنْشَدَهُ الْخُلَفَاءُ وَأَئِمَّةُ الصَّحَابَةِ وَفُضَلَاءُ السَّلَفِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا الْمَذْمُومَ مِنْهُ وَهُوَ الْفُحْشُ وَنَحْوُهُ.
** وَأَمَّا تَسْمِيَةُ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَهُ يَنْشُدُ:(شَيْطَانًا) فَلَعَلَّهُ كَانَ كَافِرًا أَوْ كَانَ الشِّعْرُ هُوَ الْغَالِبُ عليه أَوْ كَانَ شِعْرُهُ هَذَا مِنَ الْمَذْمُومِ ** وَبِالْجُمْلَةِ فَتَسْمِيَتُهُ:(شَيْطَانًا) إِنَّمَا هُوَ فِي قَضِيَّةِ عَيْنٍ تَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالَاتُ الْمَذْكُورَةُ وَغَيْرُهَا وَلَا عُمُومَ لَهَا فَلَا يُحْتَجُّ بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
** قَوْلُهُ:(يَسِيرُ بِالْعَرْجِ) هُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالْجِيمِ وَهِيَ قَرْيَةٌ جَامِعَةٌ مِنْ عَمَلِ الْفَرْعِ عَلَى نَحْوِ ثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ. اهـ
** قال السيوطي في كتابه: (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)
(2/ 398)
** النوع التاسع والأربعون
** (معرفة الشعر والشعراء)
** قال ابن فارس في فقه اللغة: الشعرُ كلام موزونٌ مقفى، دال على معنى، ويكون أكثرَ من بيت.
** وإنما قلنا هذا لأنه جائز اتفاق سطر واحد بوزن يشبه وزنَ الشعر عن غير قصد، فقد قيل: إنَّ بعض الناس كَتَبَ في عُنوان كتاب:
(للإمام المسيِّب بن زُهَيْرٍ … من عِقَالِ بن شَبَّة بن عِقال) فاستوى هذا في الوزن الذي يسمى الخفيف، ولعل الكاتب لم يقصِد به شعرا.
** وقد ذكر نَاسٌ في هذا كلمات من كتاب الله تعالى: كَرِهْنَا ذِكْرَها،
** وقد نزه الله سبحانه كتابَه عن شَبَهِ الشعر، كما نزَّه نبيه صلى الله عليه وسلم عن قوله.
** فإن قال قائل: فما الحكمةُ في تنزيه الله تعالى نَبيّه عن الشعر؟
** قيل له: أولُ ما في ذلك حكم الله تعالى بأنَّ {الشُّعَرَاءَ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} ، وأنَّهُمْ {في كلِّ وَادٍ يَهيمُونَ وأنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ} .
ثم قال: {إلاَّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات}، ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن كان أفضلَ المؤمنين إيمانا، وأكثر الصالحين عملا للصالحات) فلم يكن ينبغي له الشِّعر بحال، لأن للشعر شرائط لا يسمَّى الإنسان بغيرها شاعرا،
** وذلك أن إنسانا لو عمل كلاما مستقيما موزونا، يتحرَّى فيه الصدق من غير أن يُفْرِط، أو يتعدى أو يَمين، أو يأتي فيه بأشياء لا يمكن كونها بَتَّة لما سماه الناس شاعرا، ولكان ما يقوله مَخْسولاً ساقطا.
** وقد قال بعض العقلاء -وسئل عن الشعر- فقال: إن هَزل أضْحك، وإن جَدَّ كذب.
** فالشاعر بين كذب وإضحاك وإذ كان كذا فقد نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن هاتين الخَصلتين وعن كل أمر دَنِيّ.
** وبعد فإنا لا نكاد نرى شاعرا إلا مادحا ضارعا، أو هاجيا ذا قَذَع، وهذه أوصافٌ لا تصلح لنبي.
** فإن قال: فقد يكونُ من الشعر الحكمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من البيان لسِحْراً، وإن من الشِّعْر لحكمة) أو قال: حُكْماً ** قيل له: إنما نزه الله نبيه عن قيل الشعر لما ذكرناه، فأما الحكمةُ فقد آتاه الله من ذلك القِسْمَ الأجزل، والنصيبَ الأوفر في الكتاب والسُّنَّة.
** ومعنى آخر في تنزيهه عن قيل الشعر: أن أهل العَرُوض مُجْمِعُون على أنه لا فرق بين صناعة العَرُوض وصناعة الإيقاع، إلاّ أن صناعة الإيقاع تقسيم الزمان بالنَّغَم وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب، الإيقاع، والإيقاعُ ضرب من الملاهي لم يصلح ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أنَا من دَدٍ ولا دَدٌ مِني).
** ثم قال ابن فارس: والشعر ديوان العرب، وبه حفظت الأنساب وعُرِفت المآثر، ومنه تُعُلِّمت اللغة، وهو حُجَّة فيما أشكل من غريب كتاب الله، وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحابته والتابعين، وقد يكون شاعرٌ أشعر، وشِعْرٌ أحلى وأظرف فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة حتى يتباعد ما بينهما في الجودة فلا وبكلٍّ يُحتج، وإلى كل يُحتاج،
** فأما الاختيارُ الذي يراه الناس للناس فشهوات كلٌّ يستحسن شيئا.
** والشعراء أُمَراء الكلام، يَقْصرون الممدود، ويَمُدُّون المقصور، ويُقَدِّمون ويؤخرون، ويومِئون ويشُيرون، ويختلسون ويُعيرون ويَسْتعيرون.
** فأما لحنٌ في إعراب، أو إزالة كلمة عن نَهج صواب فليس لهم ذلك.
** وقال ابن رشيق في العمدة: العرب أفضل الأمم، وَحِكْمَتُها أشرف الحِكَم كفضل اللسان على اليد.
** وكلام العرب نوعان: منظوم ومنثور لكل نوع منهما ثلاث طبقات: جيدة ومتوسطة ورديئة، فإذا اتفقت الطبقتان في القَدْر، وتساوتا في القيمة ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية لأن كل منظوم أحسنُ من كل منثور من جنسه في معترف العادة ألا ترى أن الدُّرَّ وهو أخو اللفظ ونسيبُه، وإليه يقاس وبه يشبه إذا كان منظوما يكون أظهر لحسنه، وأصْونَ له.
** وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تَبَدَّد في الأسماع، وتَدَحْرَجَ في الطباع، ولم يستقر منه إلا المفرطة في اللطف فإذا أخذه سِلْكُ الوَزْنِ وعِقْد القافية تألفت أشْتاته، وازدوجت فرائده، وأمن السرقة والغَصب.
** وقد أجمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثر، وأقل جيدا محفوظا، وأن الشعرَ أقلُّ، وأكثر جيدا محفوظا لأن في أدناه من زينة الوزن والقافية ما يقارب به جَيِّد المنثور.
** وكان الكلامُ كله منثورا، فاحتاجت العرب إلى الغِناء بمكارم أخلاقها، وطَيِّب أعراقها، وذكرِ أيامها الصالحة، وأوطانها النازحة، وفُرسَانها الأَنجاد، وسمحائها الأجواد لتهز نفوسها إلى الكرم، وتدل أبناءها على حسن الشيم فتوهموا أعاريض فعملوها موازين للكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا، لأنهم قد شَعروا به أي فَطِنوا له.
** وقال: ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يُحفظ من المنثور عُشْره ولا ضاع من الموزون عشره.
** فإن احتج أحد على تفضيل النثر على الشعر بأن القرآن منثور وقد قال تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاه الشِّعرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ}،
** قيل له: إن الله بعث رسوله آية وحجة على الخلْق، وجعل كتابه منثورا ليكون أظهر برهانا بفضله على الشعر الذي من عادة صاحبه أن يكون قادرا على ما يحب من الكلام، وتحدَّى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل مثله، فأعجزهم ذلك فكما أن القرآن أعجَز الشعراء وليس بِشِعْر، كذلك أعجزَ الخطباء وليس بخُطبة، والمترسلين وليس بترسل، وإعجازُه الشعراء أشدُّ برهانا ألا ترى العرب كيف نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعر لَمَّا غُلِبوا وتبين عجزهم فقالوا: هو شاعر لمَا في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته، وأنه يقع منه ما لا يُلحَق والمنثور ليس كذلك، فمن هنا قال تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} أي لتقوم عليكم الحجة ويصح قِبَلكم الدليل.
** قال ابنُ رشيق: وكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنَّأتها بذلك وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبْن بالمزَاهِر كما يصنعن في الأعراس، وتتباشر الرجال والولْدَان لأنه حِماية لأعراضهم، وذَبٌّ عن أحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادَةٌ لِذِكْرِهِمْ وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ فيهم، أو فرس تُنتج.
** وقال محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء: لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من القبائل العرب، وكان الشِّعْر في الجاهلية عند العرب ديوانَ علمهم، ومنتهى حكمتهم، به يأخذون وإليه يصيرون.
** قال ابن عوف عن ابن سِيرين: قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: كان الشِّعْرُ علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب، وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولَهَتْ عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح، واطمأنَّ العرب بالأمصار، راجعوا رواية الشعر، فلم يَئِلُوا إلى ديوان مُدَوَّن، ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب مَنْ هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقلَّ ذلك وذهب عنهم منه كثير،
** وقد كان عند آل النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول، وما مُدِح به هو وأهل بيته، فصار ذلك إلى بني مروان أو صار منه.
** قال يونس بن حبيب: قال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلُّه ولو جاءكم وافرا لجاءكم عِلْمٌ وشِعر كثير.
** قال محمد بن سلام الجُمَحي: ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلةُ ما بأيدي الرواة المصحِّحين لطرفة وعَبيد اللَّذين صحَّ لهما قصائد بقدر عشر وإن لم يكن لهما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتَّقْدِمة، وإن كان ما يروي من الغث لهما فليسا يستحقان مكانهما على أفواه الرواة، ويروى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير، غير أن الذي نالهما من ذلك أكثر، وكانا أقدم الفحول، فلعل ذلك لذلك. فلما قل كلامهما حمل عليهما حملا كثيرا. اهـ
(فائدتان: الأولى):
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه:(فتح الباري)، (1/ 9):
** وَقَدِ اسْتَقَرَّ عَمَلُ الْأَئِمَّةِ الْمُصَنِّفِينَ عَلَى افْتِتَاحِ كُتُبِ الْعِلْمِ بِالْبَسْمَلَةِ، وَكَذَا مُعْظَمُ كُتُبِ الرَّسَائِلِ.
** وَاخْتَلَفَ الْقُدَمَاءُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْكِتَابُ كُلُّهُ شِعْرًا.
** فَجَاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مَنْعُ ذَلِكَ.
** وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُكْتَبَ فِي الشِّعْرِ:(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).
** وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ جَوَازُ ذَلِكَ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ الْخَطِيبُ هُوَ الْمُخْتَارُ. اهـ
(الثانية):
** من كتاب (في تاريخ الأدب الجاهلي)، (ص: 287)، لعلي الجندي:
** (. . . فطريق الشعر طويل وشاق يحتاج إلى موهبة وكفاءات ومؤهلات، والشعراء يختلفون في الجودة والمكانة،
** وبعضهم يجعل الشعراء أربعة أنواع:
- شاعر خنذيذ، وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره.
- شاعر مفلق، وهو الذي لا رواية له، لكنه مجيد.
- شاعر فقط، وهو فوق الرديء بدرجة.
- شعرور، وهو لا شيء.
** ومن أطراف ما قيل في ذلك شعرًا:
الشعراء فاعلمنّ أربعَهْ***فَشَاعِرٌ يجري ولاَ يُجْرَى مَعَهْ
وشاعرٌ يخوض وسطَ المعمعَهْ***وشاعرٌ لا تشتهي أن تَسْمَعَهْ
وشاعر لا تستحي أن تَصْفَعَهْ. اهـ
(تنبيه):
** الحديث الذي ذكره السيوطي ? ما أنَا من دَدٍ ولا دَدٌ مِني).
رواه البيهقي في كتاب:(الآداب)، (ص: 258) برقم:(630)
من حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي عنه مرفوعا بلفظ: «لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلَا دَدٌ مِنِّي» ,
** وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم: (4673)
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 28 / 1/ 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
97 تأليف الكتب: أنواعه وأسبابه
سلسلة الفوائد اليومية:
97 تأليف الكتب: أنواعه وأسبابه
قال العلامة أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري القِنَّوجي(المتوفى:1307هـ) في كتابه:(أبجد العلوم) (ص:107):
اعلم أن كتب العلم كثيرة؛ لاختلاف أغراض المصنفين في الوضع والتأليف، ولكن تنحصر من جهة المعنى في قسمين:
الأول: إما أخبار مرسلة، وهي كتب التواريخ، وإما أوصاف وأمثال ونحوها قيدها النظم، وهي دواوين الشعر.
والثاني: قواعد علوم وهي تنحصر من جهة المقدار في ثلاثة أصناف:
الأول: مختصرات تجعل تذكرة لرؤوس المسائل ينتفع بها المنتهي للاستحضار، وربما أفادت بعض المبتدئين الأذكياء لسرعة هجومهم على المعاني من العبارات الدقيقة.
والثاني: مبسوطات تقابل المختصرات، وهذه ينتفع بها للمطالعة.
والثالث: متوسطات وهذه نفعها عام.
ثم إن التأليف على سبعة أقسام:
لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها وهي:
إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه.
أو شيء ناقص يتممه.
أو شيء مغلق يشرحه.
أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه.
أو شيء متفرق يجمعه.
أو شيء مختلط يرتبه
أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه.
اهـ المراد
وفي كتاب:(أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض),(3/ 34) لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبي العباس المقري التلمساني (المتوفى: 1041هـ):
ورأيت بخط بعض الأكابر ما نصه: المقصود بالتأليف سبعة:
شيء لم يسبق إليه فيؤلف،
أو شيء ألف ناقصا فيكمل،
أو خطأ فيصحح،
أو مشكل فيشرح،
أو مطول فيختصر،
أو مفترق فيجتمع،
أو منثور فيرتب.
وقد نظمها بعضهم فقال:
ألا فاعلمن أنّ التآليف سبعة
لكلّ لبيب في النّصيحة خالصِ
فشرحُ لإغلاق وتصحيح مُخطئ
وإبداعُ حِبْرٍ مُقْدِمٍ غير ناكصِ
وترتيب مَنثورٍ وجمع مُفَرَّقِ
وتقصير تطويلٍ وتتميم ناقصِ.
اهـ
ونظمها بعضهم في بيت واحد فقال:
في سبعة حصروا مقاصد العقلا
من التآليف فاحـفظها تنل أمـلا
أبدع، تمام، بيان، لاختصارك في
جمع، ورتب، وأصلح يا أخي الخللا
والله الموفق.
كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الاثنين 26/ 1 / 1438 هـ
ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
96 ذكر مواليد بعض أئمة النحو ووفياتهم
سلسلة الفوائد اليومية:
96 ذكر مواليد بعض أئمة النحو ووفياتهم
قال السيوطي في كتابه: (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)
(2/ 392):
النوع الثامن والأربعون
(معرفة المواليد والوفيات)
أبو الأسود الدؤلي:
قال أبو الطيب: قال أبو حاتم: ولد في الجاهلية،
وقال غيره: مات في طاعون الجارف سنة تسع وستين.
أبو عمرو بن العلاء:
[[ولد بالحجاز، سنة سبعين، وقيل: اثْنَتَيْنِ وَسبعين.]]
مات سنة أربع.
وقيل: سنة تسع وخمسين، ومائة بطريق الشام.
عيسى بن عُمَر الثَّقَفِي:
مات سنة تسع وأربعين وقيل: سنة خمسين ومائة.
يونس بن حبيب الضبَّي:
ولد سنة تسعين، ومات سنة اثنين وثمانين ومائة.
الخليل بن أحمد:
[[ولد في البصرة سنة مائة.]]
مات سنة خمس وسبعين ومائة،
وقيل: سنة سبعين، وقيل: سنة ستين، وله أربع وسبعون سنة.
الأصمعي:
ولد سنة ثلاث وعشرين ومائة، ومات في صفر سنة ست عشرة، وقيل: خمس عشرة ومائتين.
سيبويه:
[[ولد سيبويه بقرية من قرى شيراز، يقال لها: “البيضاء” من عَمَل فارِس، سنة أربعين ومائة
وقيل: ثمان وأربعين ومائة]]
مات بِشِيرَاز، وقيل: بالبيضا سنة ثمانين ومائة، وعمره اثنتان وثلاثون سنة، قاله الخطيب البغدادي.
وقيل: نَيَّف على الأربعين.
وقيل مات بالبصرة سنة إحدى وستين.
وقيل: سنة ثمان وثمانين.
وقال ابن الجوزي: مات بساوَة سنة أربع وتسعين.
قُطْرُب:
مات سنة ست ومائتين.
أبو الحسن الأخفش:
مات سنة عشر، وقيل خمس عشرة، وقيل إحدى وعشرين ومائتين.
الكِسائي:
[[ولد في حدود سنة عشرين ومئة.]]
مات بالرِّي سنة تسع وثمانين ومائة، جزم به أبو الطيب ,
وقيل سنة اثنتين وثمانين،
وقيل سنة ثلاث وثمانين،
وقيل سنة اثنتين وتسعين.
الفراء:
[[بالكوفة سنة 144 للهجرة]]
مات بطريق مكة سنة سبع ومائتين، وله سبع وستون سنة.
أبو عمر الجَرْمي:
مات سنة خمس وعشرين ومائتين.
المازني:
[[ولد بمكة سنة 70 للهجرة]]
مات سنة تسع أو ثمان وأربعين ومائتين، كذا قال الخطيب.
وقال غيره: سنة ثلاثين.
المبرِّد:
ولد سنة عشر ومائتين، ومات سنة اثنتين،
وقيل: خمس وثمانين ومائتين.
ثعلب:
ولد سنة مائتين، ومات في جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين.
الزَّجَّاج:
[[ولد ببغداد سنة 241 للهجرة]]
مات سنة إحدى عشرة وثلثمائة.
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس:
[[ولد بمصر سنة 260 للهجرة تقريبا]]
مات غريقا في النيل سنة سبع، أو ثمان وثلاثين وثلثمائة.
أبو علي الحسين بن أحمد الفارسي:
[[ولد في فسا (من أعمال فارس) سنة 288 للهجرة]]
مات سنة سبع وسبعين وثلثمائة.
محمد بن سعيد السِّيرافي الفالي:
ولد قبل السبعين ومائتين، ومات ببغداد في رجب سنة ثمان وستين وثلثمائة.
أبو محمد بن دَرَسْتَويْه:
ولد سنة ثمان وخمسين ومائتين، ومات سنة سبع وأربعين وثلثمائة.
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي:
[[تلميذ الشيخ أبي إسحاق الزّجاج إِبْرَاهِيم بْن السّري المتقدم ذكره، نسب إِلَيْهِ للزومه إياه، ولد بنهاوند]]
مات بطبَرية سنة تسع وثلاثين، وقيل: أربعين وثلثمائة.
أبو الفتح عثمان بن جني:
ولد قبل الثلاثين وثلثمائة، ومات سنة اثنتين وتسعين.
علي بن عيسى الرماني:
ولد سنة ست وسبعين ومائتين، ومات سنة أربع وثمانين وثلثمائة.
ابن بابشاذ النحوي:
مات سنة تسع وستين وأربعمائة.
الكمال بن الأنبار:
[[ولد سنة 531 للهجرة]]
مات سنة سبع وسبعين وخمسمائة.
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري:
ولد سنة سبع وستين وأربعمائة، ومات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.
ابن الشَّجَري:
ولد سنة خمسين وأربعمائة، ومات سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة.
جمال الدين بن مالك:
ولد سنة ستمائة، ومات في شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة.
الرضي الشاطبي:
ولد سنة إحدى وستمائة، ومات بالقاهرة المُعزية سنة أربع وثمانين.
أبو حَيَّان الإمام أثير الدين:
ولد سنة أربع وخمسين وستمائة، ومات في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة.
والله الموفق.
كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
السبت 24 / 1/ 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
95 ذكر ألقاب بعض أئمة اللغة والنحو، وسبب تلقيبهم
سلسلة الفوائد اليومية:
95 ذكر ألقاب بعض أئمة اللغة، وسبب تلقيبهم
** قال السيوطي في كتابه: (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)
(2/ 364)
الفصل الثالث: في معرفة الألقاب وأسبابها.
** وهي قسمان: [القسم الأول: أئمة اللُّغة والنحو]
** (عَنْبسة الفيل):
** [[اسمه: عنبسة بن مَعْدان مولى مَهْرَة، وهو المعروف بالفيل.]]
** قال الزمخشري في ربيع الأبرار: لقب بذلك لأن مَعْدان أباه كان يروض فيلا للحجاج.
** قلت: فينبغي أن يكون اللقب لأبيه لا له.
** (سيبويه):
** [[اسمه: عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب , ويكنى أبا بشر]].
** لَقب إمام النحو، وهو لفظ فارسي، معناه رائحة التفاح.
** قيل: كانت أمه ترقصه بذلك في صغره،
** وقيل: كان من يلقاه لا يزال يَشَمُّ منه رائحة الطِّيب، فسمي بذلك،
** وقيل: كان يعتاد شم التفاح،
** وقيل: لُقِّب بذلك لِلَطَافَتِه لأن التفاح من لطيف الفواكة.
** البَطَلْيَوْسِي في شرح الفصيح: الإضافة في لغة العجم مقلوبة كما قالوا: سيبويه، والسيب التفاح، وويْه رائحته والتقدير رائحة التفاح.
** (قُطْرُب):
** [[اسمه: محمد بن المستنير أبو علىّ المعروف بقطرب.]]
** لازم سيبويه، وكان يُدْلج إليه فإذا خرج رآه على بابه، فقال له: ما أنت إلا قُطْرُبُ ليل فلقب به.
** (المبرِّد):
** [[اسمه: محمد بن يزيد , أبو العباس المبرد.]]
** قال السِّيرافي: لما صنف المازني كتابه الألف واللام سأل المبرِّد عن دقيقِه وعويصهِ، فأجابه بأحسن جواب، فقال له: قم فأنت المبرِّد (بكسر الراء) أي المثْبِت للحق ,
** فغيَّره الكوفيون، وفتحوا الراء.
** (ثعلب):
** [[اسمه: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار ، أبو العباس النحوىّ الشيبانىّ مولاهم المعروف بثعلب.]]
** إمام الكوفيين اسمه أحمد بن يحيى.
** (الأخفش): جماعة يأتون في نوع المتفق والمفترق.
[[لقب لأحد عشر نحويا , والمراد به عند الإطلاق: أبو الحسن سَعِيدُ بنُ مَسْعَدَةَ]].
** (السِّكِّيت):
** والد أبي يوسف يعقوب بن السِّكِّيت.
** قال الحافظ أبو بكر الشِّيرازي في كتاب الألقاب: قال علي بن إبراهيم القطان القَزويني: سئل ثعلب: هل رأيت السِّكيت فقال: نعم، وكان لي أخا أو شبيها بالأخ.
** وكان سكِّيتاً كما سمي.
** (شبة):
** والد عمر بن شبة، اسمه يزيد , وإنما لقب شَبّة لأن أمه كان ترقصه وتقول:
(يا بِأَبي وشبَّا… وعاش حتى دبا) // الرجز //
ذكره الشِّيرازي في الألقاب.
** (نِفْطَوَيْهِ): اسمه إبراهيم بن محمد بن عرفة، لقب بذلك تشبيها بالنِّفط لدَمَامَتِه وأدمته، وجعل على مثال سيبيويه في النحو إليه.
** قال الزَّمْلكانيّ في شرح المفصل: نِفْطَوَيْه يجوز فتح نونه، والأكثر كسرها.
** وقال ياقوت الحموي: قد جعله ابن بسام بضم الطاء وسكون الواو وفتح الياء.
** (النبَّاح):
** [[اسمه: اسمه صالح بن إسحاق , ويكنى أبا عمر , وهو مولى لجرم بن زمان , وجرم من قبائل اليمن.]]
** قال ابن دَرَسْتويه في شرح الفصيح: كان أبو عمر الجَرْمي يلقب النباح لكثرة مناظرته في النحو وصياحه.
** (سُبُّخْت):
** هو لقب لأبي عبيدة مَعْمر بن المُثَنَّى , أنشد ثعلب:
(فخذ من سلح كيسان… ومن أظفار سبخت) // الهزج //
** (أبو القُنْدَيْن):
** لقب الأصمعي، قال أبو حاتم: قيل له ذلك لكبر خُصْييه.
ذكره ابن سيده في المحكم.
** [[واسم الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علىّ بن أصمع , منسوب إلى جدّه أصمع , ويكنى أبا سعيد.]]
** (مُعاذ الهَرّاء):
** [[اسمه: معاذ بن مسلم الهراء، أبو مسلم.]]
** قال في الصِّحاح: قيل له ذلك، لأنه كان يبيع الثياب الهَرَوية.
تنبيه:
انتهى بتصرف مع زيادة ما بين المكوفين .
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 20/ 1 / 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
94 ذكر بعض كنى الحيوانات التي كنتها بها العرب
سلسلة الفوائد اليومية:
94 ذكر بعض كنى الحيوانات التي كنتها بها العرب
** قال السيوطي في كتابه: (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)
(1/ 394)
** النوع السادس والثلاثون
** (معرفة الآباء والأمهات…)
** أبو الحِسْل الّضبِّ، والحِسل ولده.
** أبو الحصَيْن، وأبو الحِنْبِص، وأبو خالد: الثعلب.
** وأبو جعدة، وأبو جعادة، وأبو عَسْلة، وأبو مَذْقَة، وأبو ثمامة: الذئب.
** أبو خَدْرة: طائر بالحجاز.
** أبو الحارث، وأبو فِراس، وأبو الأبطال، وأبو جرو، وأبو الأخياس، وأبو التأمور، وأبو الجراء، وأبو حفص الخدر، وأبو رزاح، وأبو الزَّعفران، وأبو شِبل، وأبو ليث، وأبو لبد، وأبو الغَريف، وأبو محراب، وأبو محطم، وأبو الخنحس، وأبو الوليد، وأبو الهَيْصم، وأبو العباس: كُنْية الأسد.
** وأبو الأبرد، وأبو الأسود، وأبو جَلْعَد، وأبو جَهْل، وأبو خطار، وأبو رَقاش: النمر.
** أبو الأبَد: النسر.
** وأبو الأثقال، وأبو الأشحج: البَغْل.
** وأبو الأخبار، وأبو روح: الهُدْهُد.
** وأبو الأخذ: الباشق.
** وأبو الأخطل: البِرْذَون.
** وأبو الأشعث: البازي.
** وأبو الأشيم، وأبو حُسبان: العقاب.
** وأبو أيوب: الجَمَل، وأبو بحر: السَّرطان.
** وأبو بَحير: التَّيْس.
** وأبو البختري: الحية.
** وأبو برائل، وأبو حماد: الديك.
** وأبو بُريد: العَقعَق.
** وأبو ثقل: الضَّبُع.
** وأبو جاعرة: الغداف من الغِرْبان.
** وأبو الجَرّاح، وأبو حدر، وأبو زاجر: الغراب.
** وأبو الجلاح، وأبو جُهينة، وأبو حُميد: الدب.
** وأبو حاتم، وأبو خالد: الكلب.
** وأبو الحجاج: العُقاب والفِيل.
** وأبو الحرماز وأبو دَغْفَل: الفيل.
** وأبو الحُسن: الطَّاووس.
** وأبو الحسين: الغَزَال.
** وأبو حيان: الفَهْد.
** وأبو خبيب، وأبو راشد: القِرد.
** وأبو خداش: السِّنَّور، والأرنب.
** وأبو دُلَف: الخِنْزير.
** وأبو زُرعة: الخِنزير، والثور.
** وأبو زفير: الأوز.
** وأبو زِياد، وأبو صابِر: الحِمار.
** وأبو شُجاع وأبو طالِب: الفَرَس.
** وأبو طامِر وأبو عدي: البُرْغُوث.
** وأبو عاصِم: الزُّنبور.
** وأبو العرمض: الجاموس.
** وأبو عِكْرِمة: الحمام.
** وأبو العَوّام: السَّمَك.
** وأبو يعقوب: العُصْفور.
** وأم حِلْس وأم تَوْلَب، وأم الهِنْبِر: الأتان.
** والهِنْبِر: هو الجَحْش.
** أم عَوْف: الجَرَادة.
** أم الهِنْبِر في لغة فَزَارة: الضبع، وهي تكنى: أم رعال، بالراء، [ وأم عامر ].
** أم عِرْيَط: العقرب.
** أم رَاشِد: كنية الفأرة.
** وأم حَفْصة، وأم إحدى وعشرين: الدجاجة.
** وأم أدْرَاص: اليَرْبوع وولد اليَرْبوع يقال له الدِّرص والجمع أدراص.
** أم قَشْعَم: العنكبوت.
** وأم الأشعث: الشاة.
** وأم الأسود: الخنفساء.
** وأم تَوْبة: النملة.
** وأم ثلاثين: النعامة.
** وأم حَفْصَة: الدجاجة والبطة والرَّخمة.
** وأم خِدَاش: الهِرَّة.
** وأم خِشَف: الظبية.
** وأم شِبل: اللبوة.
** وأم طِلْحَة: القملة.
** وأم عافية وأم عثمان: الحية.
** وأم عيسى: الزرافة.
** وأم يَعْفور: الكلْبة.
** اهـ بتصرف.
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 16/ 1 / 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
93 أطول سند في الأمهات الست
سلسلة الفوائد اليومية:
93 أطول سند في الأمهات الست
** أطول سند وقع في الأمهات الست سند عشاري، أي أن بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة رواة.
أخرجه بهذا الطول النسائي والترمذي.
** قال الإمام أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النسائي في سننه (2/ 171):
996 -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنُ يِسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ امْرَأَةٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ»
** قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا.
** وقال في كتابه:(عمل اليوم والليلة)، (ص:424) بعد أن ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد: لَا أعرف فِي الحَدِيث الصَّحِيح إسنادا أطول من هَذَا.
** [وقال الألباني: صحيح]
** وقال الإمام الترمذي في سننه / ت شاكر (5/ 167):
2896 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ القُرْآنِ؟ مَنْ قَرَأَ: اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ ”
** [وقال الألباني: صحيح]
** وأخرج الإمام البخاري في صحيحه حديثا واحدا بسند تساعي، وهو أطول سند عنده.
** قال الإمام البخاري في صحيحه (9/ 61):
7135 – حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا»، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخُبْثُ».
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه:(فتح الباري)، (13/ 107):
** وَهَذَا السَّنَدُ كُلُّهُ مَدَنِيُّونَ، وَهُوَ أَنْزَلُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ بِدَرَجَتَيْنِ،
** وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَطْوَلُ سَنَدًا فِي الْبُخَارِيِّ؛ فَإِنَّهُ تُسَاعِيٌّ.
** وَغَفَلَ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ: فِيهِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ صَحَابِيَّاتٍ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ فِيهِ ثَلَاثَةٌ كَمَا قَدَّمْتُ إِيضَاحَهُ فِي أَوَائِلِ الْفِتَنِ فِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَيْلٌ لِلْعَرَبِ)،
** وَذَكَرْتُ هُنَاكَ الِاخْتِلَافَ عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي زِيَادَةِ حَبِيبَةَ بِنْتِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي الْإِسْنَادِ. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 15 / 11/ 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
92 ذكر بعض الألفاظ المولدة الدخيلة في كلام العرب
سلسلة الفوائد اليومية:
92 ذكر بعض الألفاظ المولدة الدخيلة في كلام العرب
** قال السيوطي في كتابه: (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)، (1/242):
** النوع الحادي والعشرون
** (معرفة المولد)
** وهو ما أحْدثه المولَّدون الذين لا يُحْتجّ بألفاظهم والفرق بينه وبين المصنوع أن المصنوع يُورده صاحبه على أنه عربي فصيح وهذا بخلافه.
** وفي مختصر العين للزبيدي: المولد من الكلام المحدَث.
** وفي ديوان الأدب للفارابي يقال: هذه عربية وهذه مولَّدة.
** ومن أمثلته: قال في الجمهرة: (الحُسْبان) الذي ترمى به هذه السهامُ الصغار مولد.
** وقال: كان الأصمعي يقول: (النّحْريرُ) ليس من كلام العرب وهي كلمة مولدة.
……………
** وقال ابن دُريد في الجمهرة: قال الأصمعي: (المَهْبُوت): طائر يُرْسَل على غير هداية وأحسبها مَولّدة.
** وقال: (أخُّ) كلمةٌ تقال عند التأوه، وأحسبها مُحْدَثة.
** وفي ذيل الفصيح للموفق البغدادي: يقال عند التألم: (أَحّ) بحاء مهملة وأما (أخُّ) فكلام العجم.
** وقال ابن دريد: (الكابوسُ) الذي يقعُ على النائم أحسبه مولدا.
** وقال الجوهري في الصحاح: (الطَّرَش) أهونُ الصمم يقال هو مولد.
……………
** وقال عبد اللطيف البغدادي في ذيل الفصيح: (الفطْرَة) لفظٌ مولد.
وكلام العرب (صدقة الفطر) مع أن القياس لا يدفعه، كالفرقة والنّغْبَة لمقدار ما يُؤخذ من الشيء.
** وقال: أجمع أهل اللغة على أن (التَّشْويش) لا أصل له في العربية وأنه مولد وخطَّؤوا الليث فيه.
** قال: وقولهم: (سِتّي) بمعنى سيدتي مولد ولا يقال: (سِتّ) إلا في العدد.
** وقال: (فلانٌ قرابتي) لم يسمع، إنما سمع: قريبي أو ذو قَرَابتي.
** وجزم بأنَّ (أطْرُوشُ) مولد.
** وفي شرح الفصيح للمرزوقي: قال الأصمعي: إن قولهم: (كَلْبة صارِف) بمعنى مُشْتَهية للنكاح ليس في كلام العرب وإنما ولده أهل الأمصار.
** قال: وليس كما قال، فقد حكى هذه اللفظة أبو زيد وابن الأعرابي والناس.
** وفي الروضة للإمام النووي في باب الطلاق: أن (القَحْبة) لفظة مولدة ومعناها البغي.
** وفي القاموس: (القَحْبة): الفاجرة: وهي السعال لأنها تَسْعُل وتُنَحْنِحُ أي تَرْمُزُ به، وهي مولدة.
** وفي تحرير التنبيه للنووي: (التفرج) لفظة مولدة لعلها من انفراج الغم وهو انكشافه.
……………
** وفي فقه اللغة للثعالبي: يقال للرجل الذي إذا أكل لا يُبقي من الطعام ولا يَذَر: (قَحْطِي) وهو من كلام الحاضرة دون البادية.
** قال الأزهري: أظنُّه يُنْسَب إلى القَحْط لكَثْره أكله كأنه نجا من القَحْط.
** وفيه: (الغَضَارَة) مولَّدة لأنها من خَزَف، وقِصَاعُ العرب من خشَب.
……………
** وقال أبو عبيد في الغريب المصنف: (الجَبَريّة) خلاف القَدَرية، وكذا في الصحاح، وهو كلام مولد.
** وقال المبرد في الكامل: جمع الحاجة (حاجٌ)، وتقديره فعله كما تقول: هامة وهام وساعة وساع.
** فأما قولهم في جمع حاجةٍ: (حَوَائج) فليس من كلام العرب على كثرته على أَلْسِنة المولَّدين ولا قياسَ له.
** وفي الصحاح: كان الأصمعي يُنْكِرُ جمع حاجة على حوائج، ويقول مولد.
** وفي شرح المقامات لسلامة الأنباري: قيل: (الطُّفَيْلي) لغة مُحدَثَة لا توجد في العتيق من كلام العرب.
** كان رجل بالكوفة يقال له طُفَيل يأْتي الولائم من غير أن يُدْعَى إليها فَنُسِب إليه.
** وفيه: قولهم للغَبيِّ والحَرِيف: (زَبُون) كلمة مولدة ليست من كلام أهل البادية.
** وفي شرح المقامات للمطرزي: (الزَّبُون): الغبي الذي يُزْبَن ويُغْبَن. وفي أمثال المولدين: الزَّبُون يفرح بلاَ شيء.
** وقال المطرزي أيضا في الشرح المذكور: (المخرقة) افتعال الكذب وهي كلمة مولدة وكذا في الصحاح.
……………
** وفي شرح الفصيح للبطليوسي: قد اشتقوا من بغداد فعلا فقالوا:
(تَبَغْدَدَ فلان).
** قال ابن سيده: هو مولد وفيه أيضا: (القَلَنْسُوَة) تقول لها العامة الشاشية، وتقول لصانعها (الشواشي)، وذلك من توليد العامة.
** وقال ابن خالويه في كتاب: (ليس): (الحوَامِيم) ليس من كلام العرب إنما هو من كلام الصبيان تقول: (تعلمنا الحواميم)، وإنما يقال:
(آل حاميم)
** كما قال الكميت: (من الطويل)
(وَجَدْنَا لَكُمْ في آل حاميمَ آية)
ووافقه في الصحاح.
** وقال الموفق البغدادي في ذيل الفصيح: يقال: (قرأتُ آلَ حاميم، وآل طاسين)، ولا تقل: (الحواميم).
……………
** وقال محمد بن المعلى الأزدي في كتاب المشاكهة: في اللغة العامة تقول لحديث يستطال: (بَسْ)، والْبَسُّ: الخلط،
** وعن أبي مالك: البس: (القطع)
** ولو قالوا لمحدثه (بسا) كان جيدا بالغا بمعنى المصدر، أي: بس كلامك بسا، أي: اقطعه قطعا
** وأنشد: (من الوافر):
يحدِّثنا عبيد ما لَقينا
فبسك يا عبيد من الكلام
** وفي كتاب العين: (بَسْ) بمعنى حَسْب.
** قال الزبيدي في استدراكه: (بَسْ)بمعنى: حَسْب، غير عربية.
……………
** وقال ابن دُريد في الجمهرة: (شُنْطَف) كلمةٌ عامية ليست بعربية مَحْضَة.
** قال: (وخمنت الشيء): قلت فيه: الحدس أحسبه، مولدا، حكاه عنه في المحكم.
** وفي كتاب: (المقصور والممدود) للأندلسي: (الكيمياء) لفظة مولدة يُراد بها الحِذْق.
** وقال السخاوي في (سِفر السعادة): (الرَّقيع) من الرجال: الواهن المغفل، وهي كلمة مولدة، كأنهم سموه بذلك لأن الذي يُرْقَع من الثياب الواهي الخَلَق.
** وفي القاموس: (الكُسُّ) للْحَرِ ليس من كلامهم إنما هو مولد.
** وقال سلامة الأنباري في شرح المقامات: (الكُسّ والسُّرْم) لغتان مولدتان وليستا بعربيتين، وإنما يقال: فرج ودبر.
** قلت: في لفظة (الكُس) ثلاثة مذاهب لأهل العربية:
** أحدها هذا،
** والثاني: أنه عربي، ورجَّحه أبو حيان في تذكرته، ونقله عن الأسنوي في المهمات، وكذا الصغاني في كتاب: (خلْق الإنسان)، ونقله عنه الزركشي في: (مهمات المهمات).
** والثالث: أنه فارسي معرب، وهو رأي الجمهور، منهم المطرزي في: (شرح المقامات).
** وقد نقلت كلامهم في الكتاب الذي ألَّفْته في (مراسم النكاح).
** وفي القاموس: (الفُشَار) الذي تستعمله العامة بمعنى الهذيان ليس من كلام العرب.
** وفي (المقصور والممدود) للقالي: قال الأصمعي: يقال: صلاة الظهر، ولم أسمع (الصلاة الأولى)، وإنما هي مولدة،
قال: وقيل لأعرابي فصيح: (الصلاة الأولى).
فقال: ليس عندنا إلا صلاة الهاجرة.
** وفي الصحاح: (كُنْهُ الشيء): نِهايتُه ولا يشتق منه فعل،
** وقولهم: (لا يَكتَنِهه الوصفُ) بمعنى: لا يبلغ كُنْهَه، كلام مولد.
** (فائدة)
** في أمالي ثعلب: سُئِل عن التغيير: فقال هو كلُّ شيء مولد.
** وهذا ضابط حسن، يقتضي أن كلَّ لفظ كان عربيَّ الأصل ثم غيرته العامة بهَمْزِ أو تَرْكه أو تسكينٍ أو تحريك أو نحو ذلك مولد،
** وهذا يجتمع منه شيء كثير.
** وقد مشى على ذلك الفارابي في ديوان الأدب، فإنه قال في الشَّمْع والشمْعة بالسكون: إنه مولد وإن العربي بالفتح.
** وكذا فعَل في كثير من الألفاظ.
… الخ) اهـ
** قال أبو عبد الله وفقه الله:
** ليس كل ما ذكر هنا أنه مولد متفقا عليه عند علماء أهل اللغة، فبعضها عربي فصيح وليس بمولد، كلفظة: (حوائج)؛ فإنه قد ورود بها السماع نثرًا وشعرًا:
** ففي صحيح البخاري (الطبعة الهندية) (ص: 2708):
** عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا، فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: «قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»
** والأحاديث التي ذكرت فيها لفظة: (حوائج) كثيرة.
** وفي كتاب: (لسان العرب)، (2/ 243):
** وَكَانَ الأَصمعي يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ هُوَ مولَّد؛
** قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وإِنما أَنكره لِخُرُوجِهِ عَنِ الْقِيَاسِ، وإِلَا فَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ؛ وَيَنْشُدُ:
نَهارُ المَرْءِ أَمْثَلُ، حِينَ تُقْضَى
حَوائِجُهُ، مِنَ اللَّيْلِ الطَّويلِ
** قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: إِنما أَنكره الأَصمعي لِخُرُوجِهِ عَنْ قِيَاسِ جَمْعِ حَاجَةٍ؛
** قَالَ: وَالنَّحْوِيُّونَ يَزْعُمُونَ أَنه جَمْعٌ لِوَاحِدٍ لَمْ يُنْطَقْ بِهِ، وَهُوَ حَائِجَةٌ.
** قَالَ: وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنه سُمِعَ (حائِجَةٌ) لُغَةٌ فِي الحاجةِ.
** قَالَ: وأَما قَوْلُهُ إِنه مُوَلَّدٌ فإِنه خطأٌ مِنْهُ؛ لأَنه قَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي أَشعار الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ.
** فَمِمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ……
** وَمِمَّا جَاءَ فِي أَشعار الْفُصَحَاءِ قَوْلُ أَبي سَلَمَةَ الْمُحَارِبِيِّ:
ثَمَمْتُ حَوائِجِي ووَذَأْتُ بِشْراً
فبِئْسَ مُعَرِّسُ الرَّكْبِ السِّغابُ
** قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: ثَمَمْتُ أَصلحت؛
** وَفِي هَذَا الْبَيْتِ شَاهِدٌ عَلَى أَن حَوَائِجَ جَمْعُ حَاجَةٍ،
** قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَمْعُ حَائِجَةٍ لُغَةٌ فِي الحاجةِ؛
** وَقَالَ الشَّمَّاخِ:
تَقَطَّعُ بَيْنَنَا الحاجاتُ إِلَّا
حوائجَ يَعْتَسِفْنَ مَعَ الجَريء
……
** وَقَالَ سِيبَوَيْهِ فِي: (كِتَابِهِ): فِيمَا جَاءَ فِيهِ تَفَعَّلَ واسْتَفْعَلَ، بِمَعْنًى، يُقَالُ: (تَنَجَّزَ فلانٌ حوائِجَهُ، واسْتَنْجَزَ حوائجَهُ).
…… الخ) اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 14 / 11/ 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
91 توافق اللغات على بعض الكلمات، وليس في القران شيء بغير لغة العرب
سلسلة الفوائد اليومية:
91 توافق اللغات على بعض الكلمات، وليس في القران شيءٌ بغير لغةِ العرب
** قال السيوطي في كتابه: (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)
(1/ 209)
** النوع الثامن عشر
** معرفة توافق اللغات
** قال الجمهور: ليس في كتاب اللَّه -سبحانه- شيءٌ بغير لغةِ العرب لقوله تعالى: { إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيّاً }.
وقوله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبيٍّ مُبين}.
** وادَّعى ناسٌ أن في القرآن ما ليس بلغةِ العرب حتى ذكروا لغةَ الروم، والقِبط، والنَّبط.
** قال أبو عبيدة: ومَن زعم ذلك فقد أكْبَرَ القول.
** قال: وقد يُوافق اللفظُ اللفظَ، ويقاربه ومعناهما واحدٌ وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها.
** قال: فمن ذلك الإسْتَبْرَق، وهو الغليظُ من الدِّيباج، وهو استبره، بالفارسية أو غيرها.
** قال: وأهلُ مكة يسمُّون المِسْح الذي يَجعَل فيه أصحاب الطعام البر (البِلاَس) وهو بالفارسية (بلاس) فأمالوها وأعربوها، فقاربت الفارسيةَ العربية في اللفْظ.
** ثم ذكر أبو عبيدة (البالِغاء) وهي الأكارع.
** وذكر (القَمَنْجَر) الذي يُصلح القسي.
** وذكر (الدَّسْت، والدَّشْت، والخِيم، والسَّخت).
** ثم قال: وذلك كلُّه من لغات العرب، وإن وافَقه في لفظه ومعناه شيء من غير لغاتهم.
** قال ابن فارس في فقه اللغة: وهذا كما قاله أبو عبيدة.
** وقال الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه: ما وقع في القرآن من نحو: (المشكاة، والقسطاس، والإستبرق، والسجيل)،
ولا نُسَلِّم أنها غيرُ عربية، بل غايتُه أن وَضْع العرب فيها وافق لغة أخرى كالصابون والتنور فإن اللغات فيها متفقة.
** قلت: والفرق بين هذا النوع وبين المعَرَّب أن المعرَّب له اسم في لغة العرب غير اللفظ الأعجمي الذي استعملوه بخلاف هذا.
** وفي الصحاح: (الدشت): الصحراء قال الشاعر: // من الرجز //
(سُودِ نِعَاجٍ كَنِعَاجِ الدَّشْتِ)
وهو فارسيٌ أو اتفاقٌ وقعَ بين اللغتين.
** وقال ابنُ جني في الخصائص يقال: إن (التنُّور) لفظةٌ اشترَك فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم، وإن كان كذلك فهو ظريف.
** وعلى كل حال فهو فَعوّل أو فعنول؛ لأنه جنسٌ.
** ولو كان أعجميا لا غير جاز تمثيلُه لِكَوْنه جنسا ولاَحقاً بالمعرب، فكيف وهو أيضا عربي لكونه في لغة العرب غير منقول إليها وإنما هو وِفاق وقع، ولو كان منقولا إلى اللغة العربية من غيرها لوَجب أن يكون أيضا وِفاقاً بين جميع اللغات غيرها ومعلومٌ سعة اللغات غير العربية، فإن جاز أن يكون مشتركا في جميع ما عدا العربية جاز أيضا أن يكون وِفاقاً فيها.
** قال: ويَبْعُدُ في نفسي أن يكون الأصلُ للغة واحدة ثم نُقِل إلى جميع اللغات لأنَّا لا نعرفُ له في ذلك نظيرا
** وقد يجوزُ أيضا أن يكون وِفاقاً وقع بين لغتين أو ثلاث أو نحو ذلك ثم انْتَشر بالنَّقل في جميعها.
** قال: وما أقرب هذا في نفسي لأنا لا نعرفُ شيئا من الكلام وقَع الاتفاقُ عليه في كل لغةٍ وعند كل أمة هذا كلُّه إذا كان في جميع اللغات هكذا، وإن لم يكن كذلك كان الخَطْبُ فيه أيسر.
انتهى.
** وقال الثعالبي في فقه اللغة: فصل في أسماء قائمة في لغتي العرب والفُرس على لفظٍ واحد: التنور الخمير الزمان الدِّين الكنز الدينار الدرهم. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 11/ 1 / 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
90 أسماء الأيام والشهور في الجاهلية
سلسلة الفوائد اليومية:
90 أسماء الأيام والشهور في الجاهلية
** قال السيوطي في كتابه: (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)
, (1/ 174)
** أسماء الأيام في الجاهلية.
** قال في الجمهرة: أسماء الأيام في الجاهلية:
** السبت: شِيَار.
** والأحد: أَوّلُ.
** والاثنين: أَهْونَ، وأوْهَد.
** والثلاثاء: جُبَار.
** والأربعاء: دِبُار.
** والخميس: مُؤْنِس.
** والجمعة: عروبة.
** [[قلت: في كتاب: (جمهرة اللغة)، (3/ 1311):
** وَقَالَ بعض شعراء الْجَاهِلِيَّة:
أُؤَمِّلُ أَنْ أَعِيشَ وأَنَّ يَوْمِي *** بأَوَّلَ أَوْ بَأَهْوَنَ أَوْ جُبَارِ
أَوِ التَّالي دُبَارَ؛ فإن أَفُتْهُ *** فَمُؤْنِسَ أو عَرُوبةً أو شِيَارِ. اهـ]]
** (أسماء الشهور)
** وأسماء الشهور في الجاهلية:
** المحرم: وهو المُؤْتَمِر.
** وصفر: وهو ناجِر.
** وشهر ربيع الأول: وهو خَوَّان، وقالوا: خُوَّان.
** وربيع الآخر: وهو وَبْصَان.
** وجمادى الأولى: الحَنِين.
** وجمادى الآخرة: ربَّى.
** ورجب: الأَصَمّ.
** وشعبان: عادل.
** ورمضان: ناتِق.
** وشوَّالَ: وَعِلْ.
** وذو القعدة: ورنة.
** وذ الحجة: بُرَك.
** وقال الفراء في كتاب: (الأيام والليالي):
** (خُوَّانَ) من العرب من يخفِّفه، ومنهم من يشدده.
** والتثنية: (خوانان)، والجمع: (أخونه).
** و(ربصان)، منهم مَنْ يقُول: (بوصان)، على القَلْب،
** ومنهم مَنْ يُسقط الواو ويقول: (بُصَان)، مَضموم مخفف.
** (والحَنِينَ)، منهم مَنْ يفتح حاءه، ومنهم مَنْ يَضمّه.
** قال: و(جمادى الآخرة)، يسمى: (وَرْنَةَ)، ساكن الراء،
** ومنهم مَنْ يقول: (رِنة)، كزِنة.
** قال: (وذو القعدة)، يسمى: (هُوَاعاً).
** وقال ابن خالَويه: اختلف في (جمادى الآخرة)، فقال قُطْرب وابن الأنباري وابن دريد: هو رُبَّى بالباء.
** وقال أبو عمر الزاهد: هذا تصحيف إنما هو رنى.
** وقال أبو موسى الحامض: رِنَة.
** وقال القالي: في المقصور والَممدود: قال ابنُ الكلبي: كانت عاد تسمي جمادى الأولى: ربى، وجمادى الآخرة: حَنِيناً.
** وفي الصحاح: يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سمَّوْها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق شهرُ رمضان أيامَ رَمَضَ الحر فسُمِّي بذلك. اهـ بزيادة ما بين المعكوفين.
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الجمعة 9/ 1 / 1438 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط:
https://binthabt.al3ilm.net/11613
=======================
89 بيان الحكمة الداعية إلى وضْع اللغة
سلسلة الفوائد اليومية:
بيان الحكمة الداعية إلى وضْع اللغة
** قال السيوطي في كتابه: (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)، (1/ 32):
** -المسألة الثالثة- في بيان الحكمة الداعية إلى وضْع اللغة:
** قال الكِيَا الهَرَّاسي في تعليقه في أُصول الفقه:
** وذلك أن الإنسانَ لمَّا لم يكن مكتفيا بنفسه في معاشه ومُقِيمات معاشه لم يكن له بدٌّ من أن يسترفد المعاونة من غيره ولهذا اتَّخَذ الناسُ المدنَ ليجتمعوا ويتعاونوا.
** وقيل: إن الإنسان هو المتمدن بالطبع والتوحُّش دَأْبُ السباع ولهذا المعنى توزَّعَت الصنائع وانْقَسَمَت الحِرَف على الخَلْق فكلُّ واحدٍ قصَر وقتَه على حِرْفة يشتغل بها؛ لأن كلَّ واحد من الخَلْق لا يمكنُه أن يقوم بجُمْلَة مَقَاصِده فحينئذ لا يخْلُو من أن يكونَ محلُّ حاجته حاضرة عنده أو غائبة بعيدة عنه.
** فإن كانت حاضرة بين يديه أمكنه الإشارة إليها، وإن كانت غائبة فلا بدَّ له من أن يدلَّ على محل حاجاته وعلى مَقْصوده وغَرضه فوضعوا الكلامَ دلالة ووجدوا اللسانَ أسرعَ الأعضاءِ حركة وقبولا للترداد.
** وهذا الكلام إنما هو حرفٌ وصوتٌ فإن تركه سدى غفلا امتدَّ وطال وإن قطعه تقطَّع فقطَّعوه وجزؤوه على حركات أعضاءِ الإنسان التي يخرج منها الصوت وهو من أقصى الرِّئة إلى منتهى الفم فوجدوه تسعة وعشرين حرفا لا تزيد على ذلك.
** ثم قسَّموها على الحلْق والصَّدْر والشَّفَةِ واللثَّة.
** ثم رَأَوْا أن الكفاية لا تقعُ بهذه الحروف التي هي تسعةٌ وعشرون حرفا ولا يحصل له المقصود بإفرادها فركبوا منها الكلامَ ثُنائيّاً وثلاثيا ورباعيا وخماسيا هذا هو الأصل في التركيب وما زاد على ذلك يُستَثْقَل فلم يضعوا كلمة أصلية زائدة على خمسة أحرف إلا بطريق الإلْحاق والزيادة لحاجة.
** وكان الأصلُ أن يكون بإزاءِ كل معنى عبارةٌ تدلُ عليه غير أنه لا يمكنُ ذلك؛ لأَن هذه الكلمات متناهيةٌ،
** وكيف لا تكون متناهية ومَوَارِدها ومَصَادرها متناهية فدعت الحاجةُ إلى وضع الأسماء المشتَركة فجعلوا عبارة واحدة لمسَمَّيَاتٍ عِدَّة كالعَيْنِ والجَوْن واللون.
** ثم وضعوا بإزاء هذا على نقيضه كلماتٍ لمعنى واحد؛ لأن الحاجةَ تدعو إلى تأكيد المعْنى والتحريض والتقرير، فلو كُرّرَ اللفظ الواحد لسَمُجَ ومُجَّ.
** ويقال: الشيء إذا تكرر تكرَّج.
** والطِّباعُ مجبولةٌ على مُعَاداة المُعَادات فخالفوا بين الألفاظ والمعنى واحد.
** ثم هذا ينقسم إلى ألفاظ متواردة وألفاظ مترادفة:
** فالمتواردة: كما تسمى الخمر: عقارا، وصهباء، وقهوة، وسلسالا، والسبعُ: ليثا، وأسدا، وضِرْغاماً.
** والمترادفة: هي التي يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد كما يقال: أصلح الفاسد، ولم الشعث، ورتق الفتق، وشعب الصدع.
** وهذا أيضا مما يَحْتَاجُ إليه البليغ في بلاغته فيقال: خطيبٌ مِصْقَع، وشاعر مُفْلِق، فَبِحُسْنِ الألفاظ واختلافها على المعنى الواحد ترصع المعاني في القلوب وتَلْتَصِق بالصدور.
** ويزيد حسنُه وحَلاوته وطَلاَوته بضَرْب الأمثلة به والتشبيهات المجازية، وهذا ما يَسْتَعْمِلُه الشعراء والخطباء والمترسِّلون.
** ثم رأوا أنه يضيقُ نِطاقُ النُّطق عن استعمال الحقيقة في كل اسمٍ فعدَلوا إلى المجاز والاستعارات.
** ثم هذه الألفاظ تنقسم إلى مشتركة وإلى عامَّة مطلقة وتسمى مستغرقة وإلى ما هو مفرد بإزاء مفرد وسيأتي بيان ذلك.
** وقال الإمام فخر الدين وأتباعه: السببُ في وضع الألفاظ أن الإنسان الواحد وحدَه لا يستقلُّ بجميع حاجاته بل لا بدَّ من التعاون ولا تعاونَ إلا بالتَّعارف ولا تعارفَ إلا بأسباب كحركات أو إشاراتٍ أو نقوش أو ألفاظٍ توضع بإزاء المقاصد، وأَيْسَرُها وأفيدُها وأعمُّها الألفاظ:
** أمَّا أنها أيسر: فِلأَنَّ الحروفَ كيفيَّاتٌ تَعْرِضُ لأصواتٍ عارضة للهواء الخارج بالتنفس الضروري الممدود من قبل الطبيعة دون تكلُّف اختياري.
** وأما أنها أفيدُ: فلأَنها موجودةٌ عند الحاجة معدومةٌ عند عَدَمها.
** وأما أنها أعمُّها فليس يمكن أن يكونَ لكل شيءٍ نَقْشٌ كذات الله تعالى والعلوم، أو إليه إشارة كالغائبات.
** ويمكن أن يكونَ لكل شيءٍ لفظٌ.
فلما كانت الألفاظُ أيسرَ وأفيدَ وأعمَّ صارت موضوعة بإزاء المعاني. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 8 / 1 / 1438 هـ.
88 فضل شهر الله المحرم، ويوم عاشوراء
سلسلة الفوائد اليومية:
فضل شهر الله المحرم، ويوم عاشوراء
** الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، أعز عباده المؤمنين وأذل أعداءه الكافرين من يهود ونصارى ومشركين،
** وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصاحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
** أما بعد: فنحمد الله الكريم المنان، ذا الفضل والجود والإحسان، الذي مد في أعمارنا وأخر في آجالنا حتى أدركنا هذا العام الجديد،
** فهذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة يجب علينا أن نشكر الله عليها، وأن نستغل ما بقي من أعمارنا في طاعة الله ربنا جل جلاله، فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات رغبة في ثوابه، وترك المعاصي والمنكرات رهبة من عقابه.
** جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ»، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ»
[قال الألباني: صحيح لغيره]
** وجاء في سنن النسائي وغيره من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ» صححه الألباني.
** فالعاقل اللبيب هو الذي يغتنم حياته ويستغل أوقاته في انتهاز الفرص والمواسم الإيمانية والنفحات الربانية التي تقربه من الله ورحمته وجنته، وتباعده من غضبه وسخطه وناره.
** جاء في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنْهما قال:
قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِرَجلٍ وهو يَعِظُه:
“اغْتَنِمْ خَمْساً قبلَ خَمْسٍ: شبابَكَ قبلَ هَرمِكَ، وصِحَّتَك قبل سَقْمِكَ، وغِناكَ قبْلَ فقْرِكَ، وفَراغَك قَبْلَ شُغْلِكَ، وحياتَك قَبْلَ مَوْتِكَ”. صححه الألباني.
** أيها الأخوة: إن الله افتتح شهور العام بشهر حرام وهو شهر الله المحرم الذي هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي عظمها وشرفها ونهانا أن نظلم فيهن أنفسنا كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}
** وظلم النفس نوعان: ترك الواجبات، وارتكاب المحرمات.
** وقد بين النبي صلى عليه وسلم فضل هذا الشهر الكريم، وذلك بأن أضافه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الإضافة تقتضي التشريف والتكريم،
** وأخبر أن الصيام فيه من أفضل الأعمال فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم-: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ».
** وفي كتاب: (شرح السيوطي) لسنن النسائي،(3/ 206):
** قال الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي: ما الحكمة في تسمية المحرم شهر الله، والشهور كلها لله؟
** يحتمل أن يقال: إنه لما كان من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، وكان أول شهور السنة أضيف إليه إضافة تخصيص.
** ولم يصح إضافة شهر من الشهور إلى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا شهر الله المحرم. اهـ.
** وقال السيوطي في كتابه:[الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج] – (3 / 251):
** أقول: سئلت: لم خص المحرم بقولهم: شهر الله دون سائر الشهور، مع أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان؟
** ووجدت ما يجاب به: أن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور، فإن أسماءها كلها على ما كانت عليه في الجاهلية.
** وكان اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول، والذي بعده صفر الثاني فلما جاء الإسلام سماه الله المحرم، فأضيف إلى الله بهذا الاعتبار
** وهذه الفائدة لطيفة رأيتها في الجمهرة.
** قال القرطبي: إنما كان صوم المحرم أفضل الصيام من أجل أنه أول السنة المستأنفة فكان استفتاحها بالصوم الذي هو أفضل الأعمال…الخ).
** وفي (شرح النووي على صحيح مسلم)، (4 / 185):
** قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَل الصِّيَام بَعْد رَمَضَان شَهْر اللَّه الْمُحَرَّم) تَصْرِيح بِأَنَّهُ أَفْضَل الشُّهُور لِلصَّوْمِ،
** وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَاب عَنْ إِكْثَار النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْم شَعْبَان دُون الْمُحْرِم، وَذَكَرنَا فِيهِ جَوَابَيْنِ:
** أَحَدهمَا: لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ فَضْلَهُ فِي آخِر حَيَاته، أي قبل التمكن من صومه)
** وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار، مَنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
اهـ
** وأعظم يوم في هذا الشهر العظيم هو يوم عاشوراء الذي خصه الله بمزيد فضل وعظيم أجر، ونصر فيه أولياءه المؤمنين، وهزم أعداءه الكافرين.
** وسنتكلم على هذا اليوم العظيم في هذه النقاط التالية:
(1) فضله:
** إن لهذا اليوم فضلا عظيما وأجرا كبيرا، ومما يدل على فضله:
(أ) –أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراه غاية التحري لما له من المكانة، ففي صحيح البخاري من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.
** فقوله: (يتحرى) من التحري، وهو المبالغة في طلب الشيء،
(ب) – أنه كان يرغب الصحابة الكرام في صيامه ترغيبا حثيثا، ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا، ولم ينهنا، ولم يتعاهدنا عنده)
** قوله: (يحثنا عليه) أي يحضنا
** وقوله: (ويتعاهدنا عنده) أي يراعي حالنا عند عاشر المحرم هل صمنا فيه أو لم نصم ]
(ج) -أنه كان يخبرهم أن صيامه سبب في تكفير سنة ماضية ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادةَ رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبيَّ عن صيام يومِ عاشورا فقال: ((أحتسبُ على اللهِ أن يكفرَ السنةَ التي قبله))،
** وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يومٍ واحد تكفيرَ ذنوبِ سنةٍ كاملة، والله ذو الفضل العظيم.
** (فائدة):
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه: (فتح الباري)- (6 / 286):
**… وَظَاهِره أَنَّ صِيَام يَوْم عَرَفَة أَفْضَل مِنْ صِيَام يَوْم عَاشُورَاء،
** وَقَدْ قِيلَ فِي الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ: إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاء مَنْسُوبٌ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام، وَيَوْمَ عَرَفَة مَنْسُوبٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ. اهـ
** وفي كتاب: (حاشية الجمل (8 / 317) لسليمان بن عمر، المعروف بالجمل (المتوفى: 1204هـ):
** إنَّمَا كَانَ عَرَفَةُ بِسَنَتَيْنِ وَعَاشُورَاءُ بِسَنَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَوْمٌ مُحَمَّدِيٌّ، وَالثَّانِيَ يَوْمٌ مُوسَوِيٌّ، وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ فَكَانَ يَوْمُهُ بِسَنَتَيْنِ. اهـ.
** وتكفير الذنوب الحاصل بصيام يوم عاشوراء المراد به الصغائر،
** أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة.
** قال النووي رحمه الله في: (المجموع شرح المهذب)، (6/ 382):
** يُكَفِّرُ (صيام يوم عرفة) كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ، وَتَقْدِيرُهُ: يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إلا الْكَبَائِرَ،…
** ثم قال رحمه الله: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَإِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ… كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ.
** فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنْ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ وَرُفِعَتْ لَهُ بِهِ دَرَجَاتٌ، وَذَلِكَ كَصَلَوَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصِّبْيَانِ وَصِيَامِهِمْ وَوُضُوئِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عِبَادَاتِهِمْ.
** وَإِنْ صَادَفَ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغَائِرَ، رَجَوْنَا أَنْ تُخَفِّفَ مِنْ الْكَبَائِرِ. اهـ
** وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: (الفتاوى الكبرى)، (5/ 342):
** وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط، وكذا الحج، … الخ).
(2) الحكمة من صيام هذا اليوم: شكر الله جل وعلا:
** جاء في الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: ((فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ))، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
** وجاء في سنن ابن ماجه بلفظ: ((فصامه موسى شكرا)).
** قوله: (يوم صالح) أي وقع فيه خير وصلاح.
** قوله: (فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ) أي أولى بالفرح والابتهاج بنجاته مِنْكُمْ.
** قال الشيخ ابن عثيمين في كتابه:(شرح رياض الصالحين)- (1 / 1443):
** فقال: (نحن أولى بموسى منكم)، لماذا؟
** لأن النبي والذين معه أولى الناس بالأنبياء السابقين {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين}
** فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بموسى من اليهود؛ لأن اليهود كفروا به، وكفروا بعيسى، وكفروا بمحمد. اهـ المراد
(3) حُكْمُ صيام يوم عاشورا:
** اتفق العلماءُ على أن صيامَه من مستحب وليس من بواجب.
** عَنْ عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
** قال ابن عبد البر في كتابه: (الاستذكار)، (3/ 327):
** لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَيْسَ بِفَرْضٍ صِيَامُهُ. اهـ
** وفي: (شرح النووي على مسلم) (8/ 4):
** (اتَّفَقَ العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ
** وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حِينَ شُرِعَ صَوْمُهُ قَبْلَ صَوْمِ رَمَضَانَ… الخ) اهـ المراد
(4) استحباب صوم يوم التاسع قبله مخالفة لليهود.
** عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»
قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَوَاهُ مُسلم
(5) مراتبُ صيامِهِ:
** قال ابن القيمِ في كتابه: (زاد المعاد) (2/ 72):
** فَمَرَاتِبُ صَوْمِهِ ثَلَاثَةٌ:
** أَكْمَلُهَا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ يَوْمٌ وَبَعْدَهُ يَوْمٌ،
** وَيَلِي ذَلِكَ أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ،
** وَيَلِي ذَلِكَ إِفْرَادُ الْعَاشِرِ وَحْدَهُ بِالصَّوْمِ.
** وَأَمَّا إِفْرَادُ التَّاسِعِ فَمِنْ نَقْصِ فَهْمِ الْآثَارِ، وَعَدَمِ تَتَبُّعِ أَلْفَاظِهَا وَطُرُقِهَا، وَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. اهـ
** وفي: (فتح الباري) لابن حجر – (6 / 280):
(… وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَحِيح مُسْلِم ” لَئِنْ عِشْت إِلَى قَابِل لَأَصُومَن التَّاسِعَ ” يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ:
** أَحَدهمَا: أَنَّهُ أَرَادَ نَقْلَ الْعَاشِرِ إِلَى التَّاسِعِ،
** وَالثَّانِي: أَرَادَ أَنْ يُضِيفَهُ إِلَيْهِ فِي الصَّوْم،
** فَلَمَّا تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَيَانِ ذَلِكَ كَانَ الِاحْتِيَاطُ صَوْمَ الْيَوْمَيْنِ،
** وَعَلَى هَذَا فَصِيَام عَاشُورَاء عَلَى ثَلَاث مَرَاتِب:
** أَدْنَاهَا أَنْ يُصَامَ وَحْدَهُ، وَفَوْقَهُ أَنْ يُصَام التَّاسِعُ مَعَهُ، وَفَوْقَهُ أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ وَالْحَادِي عَشَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
** (مسألة: حكم إفراد عاشوراء بالصيام):
** هل يجوز صيام اليوم العاشر فقط؟
** قال شيخ الإسلام في: (الفتاوى الكبرى)، (5/ 378):
** وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَلَا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ. اهـ المراد
** وفي: (فتاوى اللجنة الدائمة) – 1 (10/ 401):
** السؤال الثاني من الفتوى رقم (13700)
** س2: هل يجوز صيام عاشورا يوما واحدا فقط؟
** ج2: يجوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»
** قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يعني مع العاشر).
** وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ
** (مسألة أخرى: حكم إفراد عاشوراء بالصيام إذا وافق يوم سبت أو يوم جمعة):
** في: (فتاوى اللجنة الدائمة) – 2 (9/ 313)
** س1: أنا شاب كنت مواظبا على صيام داود عليه السلام،
** لكن وجد من يقول لي: إذا وافق صومك يوم السبت أو يوم الجمعة فلا تفردهما بالصيام، وهذا قول الشيخ الألباني حفظه الله، كما قالوا،
** وبقيت أصوم وأنا في حالة اضطراب،
** فأرجو إفادتي بحكم إفراد يوم السبت ويوم الجمعة بالصوم إذا كان في صيام داود أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء؟
** ج1: من صام صيام داود عليه السلام فلا حرج عليه في صيام يوم الجمعة أو يوم السبت إذا وافق ذلك صيامه الذي يصومه،
** وكذلك لا مانع من صيامهما إذا وافق ذلك يوم عرفة أو يوم عاشوراء،
** مع العلم بأن الحديث الخاص بالنهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا غير صحيح. اهـ
(6) لا يجوز تخصيص يوم عاشوراء بعبادة غير الصيام.
** وفي كتاب: (الفتاوى الكبرى)، لشيخ الإسلام (1/ 194):
15 – 15 – مَسْأَلَةٌ:
** وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، عَمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ الْكُحْلِ، وَالِاغْتِسَالِ، وَالْحِنَّاءِ وَالْمُصَافَحَةِ، وَطَبْخِ الْحُبُوبِ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ، وعزوا ذَلِكَ إلَى الشَّارِعِ:
** فَهَلْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ ** وَإِذَا لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ فِعْلُ ذَلِكَ بِدْعَةً أَمْ لَا؟
** وَمَا تَفْعَلُهُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مِنْ الْمَأْتَمِ وَالْحُزْنِ وَالْعَطَشِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ، وَقِرَاءَةِ الْمَصْرُوعِ، وَشَقِّ الْجُيُوبِ.
** هَلْ لِذَلِكَ أَصْلٌ، أَمْ لَا؟
** الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
** لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا اسْتَحَبَّ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا غَيْرِهِمْ.
** وَلَا رَوَى أَهْلُ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، لَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الصَّحَابَةِ، وَلَا التَّابِعِينَ، لَا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا، لَا فِي كُتُبِ الصَّحِيحِ، وَلَا فِي السُّنَنِ، وَلَا الْمَسَانِيدِ،
** وَلَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى عَهْدِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ.
** وَلَكِنْ رَوَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ مِثْلَ مَا رَوَوْا أَنَّ مَنْ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ مِنْ ذَلِكَ الْعَامِ، وَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَمْرَضْ ذَلِكَ الْعَامِ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.
** وَرَوَوْا فَضَائِلَ فِي صَلَاةِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ،
** وَرَوَوْا أَنَّ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ تَوْبَةَ آدَمَ، وَاسْتِوَاءَ السَّفِينَةِ عَلَى الْجُودِيِّ، وَرَدَّ يُوسُفَ عَلَى يَعْقُوبَ، وَإِنْجَاءَ إبْرَاهِيمَ مِنْ النَّارِ، وَفِدَاءَ الذَّبِيحِ بِالْكَبْشِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
** وَرَوَوْا فِي حَدِيثٍ مَوْضُوعٍ مَكْذُوبٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ}.
** وَرِوَايَةُ هَذَا كُلِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذِبٌ،… الخ).
اهـ المراد
** وفي كتاب: (الموضوعات)، لابن الجوزي (2/ 199):
** بَاب فِي ذكر عَاشُورَاءَ:
** قَدْ تمذهب قوم من الْجُهَّال بِمذهب أَهْل السّنة، فقصدوا غيظ الرافضة، فوضعوا أَحَادِيث فِي فضل عَاشُورَاءَ، وَنحن برَاء من الْفَرِيقَيْنِ.
** وَقَدْ صَحَّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر بِصَوْم عَاشُورَاءَ، إِذْ قَالَ: إِنَّهُ كَفَّارَة سنة، فَلم يقنعوا بِذَلِكَ حَتَّى أطالوا وأعرضوا وترقوا فِي الْكَذِب.
** فَمن الْأَحَادِيث الَّتِي وضعُوا: … الخ). اهـ
((والخلاصة)):
** أنه ينبغي لنا أن نفرح بهذا الخير العظيم والأجر العميم الذي يسر الله به، وأن نحث عليه أبنائنا وأزواجنا وإخواننا وجيراننا وغيرهم من المسلمين، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
** ونحن – والله وبالله وتالله – لا نستغني عن الحسنة الواحدة، فذنوبنا كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله، كما قال الله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «… يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، …).
** فلنسارع ولنسابق إلى هذه الحسنات والأعمال الصالحات التي ترفع درجاتنا وتكفر عنا سيئاتنا.
** قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}
** وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني.
** ولنكن – في حب الخير والمسابقة إليه والحث عليه – مقتدين بالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، والتابعين لهم بإحسان.
** عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ، الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ» فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ ”
متفق عليه
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 7 / 1 / 1438 هـ
(86) الحقوق الزوجية / الحلقة الرابعة / وصايا للزوجين
سلسلة الفوائد اليومية:
الحقوق الزوجية / الحلقة الرابعة / وصايا للزوجين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصبحه أجمعين.
أما بعد: فهذه بعض الوصايا النافعة للزوجين الكريمين، التي إذا امتثلاها سعدا – بإذن الله – في الدنيا والآخرة.
** الوصية الأولى:
** الوصية بتقوى الله جل وعلا؛ فإنها خير وصية نتوصى بها،
** إذ هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين،
** ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده،
** ووصية عباد الله الصالحين بعضهم بعضا.
** قال الله تعالى: {وَللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا}
** وعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» رواه أحمد وغيره، [وحسنه الألباني]
** وفي كتاب: (جامع العلوم والحكم) ت الأرنؤوط (1/ 406):
(… وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى رَجُلٍ: أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّتِي لَا يَقْبَلُ غَيْرَهَا، وَلَا يَرْحَمُ إِلَّا أَهْلَهَا، وَلَا يُثِيبُ إِلَّا عَلَيْهَا، فَإِنَّ الْوَاعِظِينَ بِهَا كَثِيرٌ، وَالْعَامِلِينَ بِهَا قَلِيلٌ، جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ مِنَ الْمُتَّقِينَ…). اهـ
** فعلى الزوجين أن يتقيا الله في جميع أمورهما، وأن يعامل كل واحد منهما الآخر معاملة ترضي الله.
** فإن قصر أحد الزوجين في أداء الواجب الذي عليه فلا يقصر الطرف الآخر.
** قال الله تعالى: {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}
** قال تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»
رواه أبو داود (3/ 290)، وقال الألباني: [حسن صحيح]
** فمثلا: إذا علمت الزوجة أن زوجها زنى، فلا تقل: وأنا سأذهب وأزني مثله، أو قصر الزوج في حقها أو سبها أو منعها بعض حاجاتها، تقول: وأنا سأعاقبه، فتمنعه حقه أو تضيع ماله، أو نحو ذلك
** الوصية الثانية:
** الحرص الشديد على تحقيق التوحيد، وذلك بأن يعتمدا كل الاعتماد على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار،
** وأن يبتعدا كل البعد عن كل الشركيات والخرافات،
** فلا عزائم ولا تمائم، ولا حتليت، ولا ملح للجن، ولا جنبية أو عطيف (حجاب من الجن)، ولا ذبح للجن عند دخول الزوجة، ولا غير ذلك من الشركيات والخرافات التي يعملها كثير من الناس رجلا ونساء؛ فالنفع والضر، والسعادة والشقاوة، والصحة والمرض، والإنجاب والعقم، كله من عند الله سبحانه وتعالى.
كما قال الله – على لسان إبراهيم الخليل -: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ}
** وقال تعالى: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}
** وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “…
** وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ “.
رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
** الوصية الثالثة:
** الوصية بطلب العلم النافع علم الكتاب والسنة الذي يعرف كلا من الزوجين بحقوق الآخر.
** قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)
** و(الْهُدَى): هو الْعِلْمِ النافع و(دِينُ الْحَقِّ): هو الْعَمَلِ الصالح.
** وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) متفق عليه
** فبالعلم تبنى الأسر والمجتمعات والدول بناء قويا، وبه تعرف الأحكام من الحلال والحرام.
** فخير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل.
** وفي كتاب: (شرح السنة) للبغوي (1/ 279):
** وَقَالَ قَتَادَةُ: بَابٌ مِنَ الْعِلْمِ يَحْفَظُهُ الرَّجُلُ لِصَلاحِ نَفْسِهِ، وَصَلاحِ مَنْ بَعْدَهُ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ حَوْلٍ.
** وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْفِقْهِ. اهـ المراد
** قال الشاعر:
العلم يبني بيوتا لا أساس لها *** والجهل يهدم بيوت العز والشرف
** الوصية الرابعة:
** الحرص الشديد على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
** قال الله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}
** وعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ” رواه البخاري
** فكثير من الزوجات لا يصلين في وقت العرس، بحجة أنها مشغولة بأمور العرس والزينة ونحو ذلك.
** وكثير من الأزواج لا يصلون في الشهر الأول من الزواج الذي يسمونه بشهر العسل، الذي حقه أن يسمى: (شهر الغفلة والبعد عن الله جل وعلا).
** فالبيت الذي لا يصلي أهله بيت خراب ودمار وشقاء ونكد؛ لأنه يكون – حينئذ – مأوى للشياطين.
** قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى}
** وقال تعالى عن نبيه إسماعيل عليه السلام: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا}
** بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الزوجين أن يتعاونا على قيام الليل، فكيف بالفرائض.
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ» رواه أحمد وغيره، وقال الشيخ الألباني: (حسن صحيح)، وقال شيخنا الوادعي: (هذا حديث حسن).
** وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ»
رواه أبو داود وغيره [وصححه الألباني]
** وهكذا ينبغي لهما أن يتعاونا على المحافظة على النوافل القبلية والبعدية، وصلاة الضحى؛ فإن فيها الأجر العظيم والنفع العميم.
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ اللَّهَ قَالَ: …
** وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ،
** وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ،
** فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا،
** وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، … ” رواه البخاري
** وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: ” اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَكَ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ” رواه أحمد وغيره، [وصححه الشيخان: الألباني والوادعي]
** وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» رواه مسلم.
** الوصية الخامسة:
** القناعة.
** وذلك أن يقنع كل منهما بالآخر: بصورته، وطوله أو قصره، ونحافته أو سمنه، وقليله أو كثيره، وغير ذلك.
** فإن في ذلك الراحة والطمأنينة والرضا بما كتبه الله للعبد.
** قال الله تعالى: {وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى}.
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ»
متفق عليه.
** وفي كتاب: (المفهم)، (9/ 62):
** قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((ليس الغنى عن كثرة العرض))- بفتح العين والراء -، وهو: حُطام الدنيا ومتاعها…).
** ومعنى هذا الحديث: أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح، هو غنى النفس، وبيانه: أنه إذا استغنت نفسه كفّت عن المطامع، فعزّت وعظمت، فجعل لها من الحظوة والنزاهة والتشريف والمدح أكثر ممن كان غنيًا بماله، فقيرًا بحرصه وشرهه، فإن ذلك يورطه في رذائل الأمور، وخسائس الأفعال، لبخله ودناءة همّته، فيكثر ذامُّه من الناس، ويصغر قدره فيهم؛ فيكون أحقر من كل حقير، وأذل من كل صغير. اهـ
** وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ» رواه مسلم.
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ،…) رواه أحمد وغيره، [وحسنه الألباني]
** وهذه قصة واقعية في القناعة وعدمها، وفيها لنا العظة والعبرة،
وهي قصة إسماعيل عليه السلام – في حديث طويل – عندما كبر وتزوج.
** عن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قال:…
وَشَبَّ الغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ،
** فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ [يعني: من قبيلة جرهم]، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ،
** فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا،
** ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ،
** قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ،
** فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟
** قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ،
** قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ،
** قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا،
** وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا،
** قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ اللَّحْمُ، قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ المَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَاءِ،
** قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ».
** قَالَ: فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ،
** قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ، قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ، قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ العَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ،…الخ
الحديث) أخرجه البخاري (4/ 142) برقم: (3364)
** أيها الزوجان الكريمان: ليعلم كل منكما أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، وأن النقص فينا حاصل ولا بد، فهذا طويل، وهذا قصير، وهذا سمين، وهذا نحيف، وهذا حسن، وهذا قبيح، وهذا كريم، وهذا بخيل، وهذا طيب، وهذا خبيث،… الخ.
** فالتفاوت حاصل في الشكل والأخلاق، فليس في هذه الدنيا شيء حسن إلا ويوجد ما هو أحسن منه.
** قال الشاعر:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها *** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
** وقال آخر:
مــن الــذي مـا سـاء قـــط *** ومــن لـه الـحسـنـى فــقــط
** فإذا كان الكمال معدوما فلا تبحث عن المعدوم وتترك الموجود، فتبقى في عيشة ضنكة؛ لأنك لم تتمتع بالموجود ولم تحصل على المفقود.
** فالذي ينبغي لكل عاقل لبيب يبحث عن السعادة أن ينظر في المحاسن الموجودة في صاحبه فيملأ بها عينيه ويديه، ويحمد الله عليها، ويغض الطرف عن النقائص، فإن الحياة لا تكون إلا هكذا،
** ولنكن جميعا مثل النحلة، لا تقع إلا على الشيء الطيب، ولنحذر أن نكون مثل الذباب، لا يقع إلا على الشيء الرديء.
** ومما يدل على هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ».
** وفي: (شرح النووي على مسلم) (10/ 58):
** (يَفْرَكُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ بَيْنَهُمَا.
** قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: فَرِكَهُ بِكَسْرِ الراء يفركه بفتحها إِذَا أَبْغَضَهُ،
وَالْفَرْكُ – بِفَتْحِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ -: الْبُغْضُ،
… بل الصَّوَابُ أَنَّهُ نَهْيٌ، أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ باختصار
** وفي كتاب: (المفهم) للقرطبي (13/ 66):
** وقوله: ((لا يَفْرك مؤمن مؤمنة))؛ أي: لا يبغضها بغضًا كليًّا يحمله على فراقها؛ أي: لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئها لحسنها، ويتغاضى عما يكره لِمَا يحب. اهـ المراد
** الوصية السادسة:
** الصبر والحلم وكظم الغيظ، فإنه من صفات عباد الله المتقين.
** قال تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}
** وقال تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ}
** وقال تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}
** وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال:… وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» متفق عليه
** فالصبر من أعظم الأمور التي تجعل الحياة الزوجية مستمرة، وذلك حين أن يصبر الزوج على سوء أخلاق زوجته، وتصبر الزوجة على فقر زوجها أو مرضه أو سوء أخلاقه.
** فإذا أخطأ أحد الزوجين على الآخر بسب أو شتم أو سوء تصرف أو نحو ذلك فعلى الطرف الثاني أن يقابل ذلك بالصبر والتحمل، خاصة في حال الغضب حيث يخرج الشخص عن توازنه فتصدر منه الألفاظ الجارحة والكلمات غير الموزونة والتصرفات غير المعقولة، نسأل الله العافية.
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ» متفق عليه.
[[(الشديد) القوي الحقيقي.
(بالصرعة) الذي يغلب الرجال ويصرعهم.
(يملك نفسه) يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمل بمقتضى غضبه]]
** والناظر في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مع أزواجه يعلم مدى صبره وسعة صدره وحلمه عليهن، فإن الواحدة منهن كانت تراجعه وتهجره إلى الليل وغير ذلك من الأمور التي لا يتحملها كثير من الناس.
** ففي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قال عُمَر بْن الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (… دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ، وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى…). اهـ باختصار
[[(نغلب النساء) يكون رأينا هو المقدم ولا تراجعنا أزواجنا في شيء. (فطفق) أي فشرع.
(تراجعني) أي ترد علي الجواب.
(تهجره) أي تترك مخاطبته والعشرة معه.
(أن يغضب) أي أن لا يغضب.
(لا تستكثري) أي لا تكثري عليه في الطلب.
(جَارَتُكِ) أي ضرتك.
(أوسم) أي أحسن وأجمل، والوسامة: الجمال]].
** عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ» ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ. رواه البخاري
(بصحفة) إناء كالقصعة المبسوطة.
(فانفلقت) تكسرت.
(فلق) قطع جمع فلقة.
** عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَزِيرَةٍ قَدْ طَبَخْتُهَا لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ ـ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ـ: كُلِي، فَأَبَتْ، فَقُلْتُ: لَتَأْكُلِنَّ أَوْ لَأُلَطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَأَبَتْ، فَوَضَعْتُ يَدِي فِي الْخَزِيرَةِ، فَطَلَيْتُ وَجْهَهَا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ بِيَدِهِ لَهَا، وَقَالَ لَهَا: «الْطَخِي وَجْهَهَا»، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَمَرَّ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ، فَقَالَ: «قُومَا فَاغْسِلَا وُجُوهَكُمَا»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا زِلْتُ أَهَابُ عُمَرَ لِهَيْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رواه أبو يعلى برقم (4476), وحسنه الشيخان.
** وفي كتاب: (النهاية في غريب الحديث والأثر)،
لابن الأثير (2/28):
الْخَزِيرَةُ: لَحْمٌ يَقَطَّع صِغَارًا ويُصَبُّ عَلَيْهِ ماءٌ كَثِير، فَإِذَا نَضِج ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقيق، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَة.
وَقِيلَ: هِيَ حَساً مِنْ دَقِيقٍ ودَسَم.
وَقِيلَ: إِذَا كَانَ مِنْ دَقيق فَهِيَ حَرِيرَة، وَإِذَا كَانَ مِنْ نُخَالة فَهُوَ خَزِيرَةٌ. اهـ
** وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَهِيَ غَضْبَى» ثُمَّ قَالَتْ: حَسْبُكَ إِذَا قَلَبَتْ لَكَ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ ذُرَيْعَتَيْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دُونَكِ فَانْتَصِرِي، فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا قَدْ يَبِسَتْ رِيقُهَا فِي فَمِهَا، فَمَا رَدَّتْ عَلَيَّ شَيْئًا، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ» رواه ابن ماجة وغيره، وصححه الشيخان.
** أيها الزوجان الكريمان: إن عدم الصبر سبب كبير في تفكك الأسرة، وهدم الحياة الزوجية، فكم من رجل أو امرأة أقام الدنيا ولم يقعدها بسبب كلمة تافهة، أو تصرف سيء، أو نحو ذلك من الأمور التي يمكن تحملها والتجاوز عنها.
** فالذي ينبغي أن يوطن كل واحد من الزوجين نفسه على الصبر والتحمل ومعالجة الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة.
** ذكر بعض الأمثلة على الصبر على شظف العيش.
** عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي «إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلاَلِ، ثُمَّ الهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ»، فَقُلْتُ يَا خَالَةُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: ” الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهِمْ، فَيَسْقِينَا ” متفق عليه
** بل أحيانا لا يوجد إلا الماء فقط.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلَّا المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي، فَقَالَ: هَيِّئِي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلاَنِ، فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ، أَوْ عَجِبَ، مِنْ فَعَالِكُمَا» فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ} [الحشر: 9]. متفق عليه
** وذكر عن بعض نساء السلف أنها كانت إذا خرج زوجها من منزله للعمل وطلب الرزق تقول له: ” اتق الله، وإياك والكسبَ الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر، ولا نصبر على النار “.
** الوصية السابعة:
الإيثار:
** وهو من المعاني العظيمة، والأخلاق الكريمة، التي قام عليها المجتمع المؤمن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
** قال الله تعالى في شأن الأنصار الكرام الكرماء: {وَالّذِينَ تَبَوّءُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةً مّمّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
** فينبغي للزوجين أن يؤثر كل واحد منهما الآخر على نفسه، فيقدم حقه على حق نفسه، ويحب له من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره له من الشر ما يكرهه لنفسه، فتبقى الحياة الزوجية حينئذ حياة طيبة مستمرة قوية ناجحة.
** الوصية الثامنة:
** المشاورة وتبادل الرأي.
** قال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه أبو داود وغيره، وصححه الشيخان.
** والمشاورة من أعظم آداب الصحبة والمعاشرة، فهي من صفات المؤمنين، كما قال الله عز وجل: {وَالّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبّهِمْ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىَ بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}
** وبالشورى تبنى الأسر السعيدة، حيث يتشاور الزوجان في الأمور التي تعود عليهما بالنفع والسعادة كـ (ترتيب حياتهما الزوجية، وتدبير أمورهما المنزلية، و تربية أبنائهما تربية سوية، ونحو ذلك).
** وقد كان الصحابة الكرام يستشيرون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أمورهم الخاصة والعامة.
** فعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها، أنها قالت: ذَكَرْتُ لَهُ للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ»، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ. رواه مسلم.
** وفي (شرح النووي على مسلم)، (10/ 97):
(أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ) فِيهِ تَأْوِيلَانِ مَشْهُورَانِ:
أَحَدُهمَا: أَنَّهُ كَثِيرُ الْأَسْفَارِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ كَثِيرُ الضَّرْبِ لِلنِّسَاءِ، وَهَذَا أَصَحُّ بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذِهِ (أَنَّهُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ).
** وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْدَ الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ.
** وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الْغِيبَةَ تُبَاحُ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ:
أَحَدُهَا الِاسْتِنْصَاحُ، وَذَكَرْتُهَا بِدَلَائِلِهَا فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ ثُمَّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ….
(وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ) هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ، وَفِي هَذَا جَوَازُ ذِكْرِهِ بِمَا فِيهِ لِلنَّصِيحَةِ كَمَا سَبَقَ فِي ذِكْرِ أَبِي جَهْمٍ. اهـ
** وقد كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشاور بعض نسائه في بعض أموره.
** ففي صحيح البخاري(18928) في قصة صلح الحدبية:
” فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا»،
قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ،
فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا،… الحديث ”
** وفي (فتح الباري لابن حجر)، (5/ 347):
** وَفِيهِ فَضْلُ الْمَشُورَةِ…
** وَجَوَازُ مُشَاوَرَةِ الْمَرْأَةِ الْفَاضِلَةِ
** وَفَضْلُ أُمِّ سَلَمَةَ وَوُفُورُ عَقْلِهَا حَتَّى قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: (لَا نَعْلَمُ امْرَأَةً أَشَارَتْ بِرَأْيٍ فَأَصَابَتْ إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ)، كَذَا قَالَ،
** وَقَدِ اسْتَدْرَكَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بِنْتَ شُعَيْبٍ فِي أَمْرِ مُوسَى
** الوصية التاسعة:
التواضع.
** التواضع وصف نبيل وخُلُقٌ جميل، حث عليه ديننا الإسلامي ورغب
فيه،
** قال تعالى آمرا نبيه بالتواضع: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
** وعَنْ عِيَاضِ المُجَاشِعي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» رواه مسلم
** فالتواضع من الأخلاق الكريمة التي ترفع قدر صاحبها وتحببه إلى الناس وتجعل له في قلوبهم المكانة الطيبة.
** ولقد كان التواضع سمة بارزة للنبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مع القريب والبعيد والصغير والكبير،
** فكان صلى الله عليه وسلم رقيقَ القلب رحيمًا خافضَ الجناحِ للمؤمنين ليّن الجانب لهم،
** يحمِل الكلَّ، ويكسِب المعدوم، ويعين على نوائبِ الدّهر،
** ويركب الحمارَ ويردفَ عليه،
** ويسلّم على الصبيان،
** ويبدأ من لقيَه بالسلام،
** يجيب دعوةَ من دعاه ولو إلى ذراعٍ أو كُراع،
** ولما سئِلت عَائِشَة رضي الله عنها: مَا كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يَصْنَعُ فِى بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِى مِهْنَةِ أَهْلِهِ – تَعْنِى خِدْمَةَ أَهْلِهِ – فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. رواه البخاري
** فينبغي لكل من الزوجين أن يتواضع كل منهما للآخر، وذلك بإلقاء السلام وحسن الكلام ولين الجانب ومشاركة الرجل – أحيانا – في الأمور المنزلية،
** وترك الكبر والفخر بالمال أو الجمال أو الحسب أو العلم أو الفهم أو غير ذلك من الأمور التي تسبب البغض والكراهية مما يؤدي إلى ضعف الحياة الزوجية أو زوالها عياذا بالله.
** قال الشاعر:
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر *** على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه *** على طبقات الجو وهو وضيع
** وقال آخر:
إن كريم الأصل كالغصن كلما *** يزداد من خير تواضع وانحنى
** الوصية العاشرة:
** استعمال الألفاظ الحسنة والكلمات الطيبة.
** قال الله تعالى: {وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا}
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (… وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ…) متفق عليه
** فينبغي للزوجين أن يستعملا الألفاظ الطيبة واللطيفة والرقيقة التي تدل على المحبة والاحترام والتقدير مثل:
** النداء بالكنية نحو: يا أبا فلان و يا أم فلان،
** والترخيم نحو: يا فاطمُ يا عائشُ
** والأوصاف الجميلة، نحو: يا زوجي الحبيب أو العزيز أو الغالي، و يا زوجتي الحبيبة أو العزيزة أو الغالية، ونحو ذلك.
** وعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا: يَا عَائِشَ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ.
** فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا أَرَى، تُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. متفق عليه
** وعَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَ الْحَبَشَةُ الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ فَقَالَ لِي: يَا حُمَيْرَاءُ أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ: ” نَعَمْ، فَقَامَ بِالْبَابِ وَجِئْتُهُ فَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى عَاتِقَهُ فَأَسْنَدْتُ وَجْهِي إِلَى خَدِّهِ “… الحديث) رواه النسائي، وصححه الألباني.
** (والحميراء) تصغير (حمراء) يراد بها البيضاء، والعرب تطلق لفظ الأحمر على البياض.
** وفي كتاب: (حلية الأولياء) لأبي نعيم, (5/ 198):
عن امْرَأَة سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنها قَالَتِ:
” مَا كُنَّا نُكَلِّمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا تُكَلِّمُوا أُمَرَاءَكُمْ: أَصْلَحَكَ اللهُ، عَافَاكَ اللهُ ”
** الوصية الحادي عشرة:
** أن يتعرف كل من الزوجين على طباع الآخر، فيعرف ما يحبه فيعمله، وما يكرهه فيتركه.
** ومما يدل على هذا قِصَّةُ زَوَاجِ شُرَيْحٍ الْقَاضِي، وهي:
** قَالَ الشُّعَبيّ: قَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي: يَا شُعَبيّ؛ عَلَيْكُمْ بِنِسَاءِ بَني تَمِيم؛ فَإِنَّهُنِّ النِّسَاء، قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاك 00؟
** قَال: انْصَرَفْتُ مِنْ جِنَازَةٍ ذَاتَ يَوْم، فَمَرَرْتُ بِدُورِ بَني تَمِيم، فَإِذَا امْرَأَةٌ جَالِسَةٌ في سَقِيفَة ـ أَيْ في مِظَلَّةٍ كَالخَيْمَة ـ عَلَى وِسَادَة، وَبجُوَارِهَا جَارِيَةٌ رَؤُودَة ـ أَيْ شَابَّةٌ غَضَّةٌ نَاعِمَةٌ ـ غَيْدَاءُ فَاضَ بِوَجْهِهَا مَاءُ الشَّبَابِ الأَغْيَدِ
وَلهَا ذُؤَابَةٌ عَلَى ظَهْرِهَا، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الجَوَارِي،
** فَاسْتَسْقَيْتُ ـ وَمَا بى مِن عَطَش ـ
** فَقَالَتْ: أَيُّ الشَّرَابِ أَعْجَبُ إِلَيْك: اللَّبَنُ أَمِ المَاء 00؟
** قُلْت: أَيُّ ذَلِكَ تَيَسَّرَ لَكُمْ؛
** قَالَتْ: اسْقُواْ الرَّجُلَ لَبَنَاً؛ فَإِنيِّ أَرَاهُ غَرِيبَاً، فَلَمَّا شَرِبْتُ نَظَرْتُ إِلى الجَارِيَةِ فَأَعْجَبَتْني، فَقُلْتُ مَن هَذِهِ 00؟
** قَالَتِ ابْنَتي، قُلْتُ أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَة 00؟
** قَالَتْ بَلْ فَارِغَة، قُلْتُ أَتُزَوِّجِينِيهَا 00؟
** قَالَتْ نَعَمْ إِنْ كُنْتُ لَهَا كُفْئَاً، عَمُّهَا فُلاَنٌ فَاقْصِدْهُ في بَني تَمِيم 0
فَانْصَرَفْتُ إِلى مَنْزِلي لأَقِيلَ فِيه، فَامْتَنَعَتْ مِنيِّ الْقَائِلَة،
** فَأَرْسَلْتُ إِلى إِخْوَاني مِنَ الْقُرَّاء، وَوَافَيْتُ مَعَهُمْ صَلاَةَ الْعَصْر، فَإِذَا عَمُّهَا جَالِس، فَقَالَ أَبَا أُمَيَّة 00؟ مَا حَاجَتُك 00؟
** قُلْتُ إِلَيْك، قَالَ وَمَا هِيَ 00؟
** قُلْتُ: ذُكِرَتْ لي بِنْتُ أَخِيكَ زَيْنَب، فَجِئْتُ لخِطْبَتِهَا؛ فَقَالَ مَا بِهَا عَنْكَ رَغْبَة، فَزَوَّجَيِنهَا،
** فَمَا بَلَغَتْ مَنزِلي حَتىَّ نَدِمْتُ وَقُلْت: تَزَوَّجْتُ إِلى أَغْلَظِ الْعَرَبِ قُلُوبَاً وَأَجْفَاهَا،
** ثُمَّ عُدْتُ إِلى رُشْدِي فَقُلْت: بَلْ أَجْمَعُهَا إِليّ؛ فَإِنْ رَأَيْتُ مَا أَحْبَبْتُ وَإِلاَ طَلَّقْتُهَا 00
** ثمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: يَا هَذِهِ؛ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا أُدْخِلَتِ المَرْأَةُ عَلَى الرَّجُل؛ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا رَكْعَتَينِ وَيَسْأَلَ اللهَ مِن خَيرِهَا وَخَيرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْه، وَيَتَعَوَّذَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْه؛
** فَتَوَضَّأْتُ فَتَوَضَّأَتْ بِوُضُوئِي، وَصَلَّيْتُ فَصَلَّتْ بِصَلاَتي،
** فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاَةَ قَالَتْ لي: إِنيِّ امْرَأَةٌ غَرِيبَةٌ وَأَنْتَ رَجُلٌ غَرِيبٌ لاَ عِلْمَ لي بِأَخْلاَقِك، فَبَيِّنْ لي مَا تحِبُّ فَأَفْعَلَه، وَمَا تَكْرَهُ فَأَجْتَنِبَه،
** فَقُلْتُ: قَدِمْتِ عَلَى أَهْلِ دَارٍ؛ زَوْجُكِ سَيِّدُهُمْ، وَأَنْتِ سَيِّدَةُ نِسَائِهِمْ، أُحِبُّ كَذَا وَأَكْرَهُ كَذَا، وَمَا رَأَيْتِ مِن حَسَنَةٍ فَبُثِّيهَا، وَمَا رَأَيْتِ مِنْ سَيِّئَةٍ فَاسْتُرِيهَا،
** قَالَتْ: أَخْبرْني عَن أَخْتَانِك، مَنْ مِنهُمْ تُحِبُّ أَنْ يَزُورَكَ وَمَنْ لاَ تُحِبّ 00؟
** فَقُلْتُ: إِنيِّ رَجُلٌ قَاضٍ؛ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَمَلُّوني،
** قَالَتْ: فَمَنْ تحِبُّ مِنْ جِيرَانِكَ أَنْ يَدْخُلَ دَارَكَ فَآذنَ لَه، وَمَنْ تَكْرَهُهُ مِنهُمْ فَلاَ آذَنَ لَه 00؟
** قُلْتُ: بَنُو فُلاَنٍ قَوْمٌ صَالحُون، وَبَنُو فُلاَنٍ قَوْمُ سَوْءٍ 0
** فَأَقَمْتُ عِنْدَهَا ثَلاَثَاً ثُمَّ خَرَجْتُ إِلى مجْلِسِ الْقَضَاءِ في الْيَوْمِ الثَّالِث،
فَكُنْتُ لاَ أَرَى يَوْمَاً إِلاَّ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي قَبْلَه،
** حَتىَّ إِذَا مَا كَانَ رَأْسُ الحَوْلِ دَخَلْتُ بَيْتي فَإِذَا فِيهِ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ تَأْمُرُ وَتَنهَى؛ قُلْتُ مَن هَذِهِ يَا زَيْنَب 00؟
** قَالَتْ هَذِهِ أُمِّي؛ قُلْتُ حَيَّاكِ اللهُ يَا أُمَّ زَيْنَب،
** قَالَتْ: كَيْفَ حَالُكَ مَعَ أَهْلِكَ يَا أَبَا أُمَيَّة 00؟
** قُلْتُ بخَيرٍ وَالحَمْدُ لله، قَالَتْ كَيْفَ وَجَدْتَ زَوْجَك 00؟
** قُلْتُ خَيرَ امْرَأَة، قَالَتْ: إِنَّ المَرْأَةَ لاَ تُرَى في حَالٍ أَسْوَأَ خُلُقَاً مِنهَا في حَالَين: إِذَا حَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، وَإِذَا وَلَدَتْ لَهُ غُلاَمَاً، فَإِنْ رَابَكَ مِنهَا شَيْءٌ فَعَلَيْكَ بِالسَّوْط، فَإِنَّ الرِّجَالَ مَا حَازَتْ وَاللهِ بُيُوتُهُمْ شَرَّاً مِنَ المَرْأَةِ المُدَلَّلَة،
** قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّكِ قَدْ أَدَّبْتِ فَأَحْسَنْتِ الأَدَب،
** قَالَتْ: أَتُحِبُّ أَنْ يَزُورَكَ أَصْهَارُك 00؟
** قُلْتُ مَتى شَاءواْ؛ فَكَانَتْ كُلَّ حَوْلٍ تَأْتِينَا وَتُوصِي تِلْكَ الْوَصِيَّةَ ثمَّ تَنْصَرِف،
** وَمَكَثْتُ مَعَ زَيْنَبَ عِشْرِينَ سَنَة، فَمَا غَضِبْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَة، وَكُنْتُ لَهَا فِيهَا ظَالِمَاً،
** ثمَّ أَنْشَأَ يَقُول:
رَأَيْتُ رِجَالاً يَضْرِبُونَ نِسَاءهُمْ *** فَشُلَّتْ يَمِيني يَوْمَ أَضْرِبُ زَيْنَبَا
فَأَحْبَبْتُهَا حَتىَّ رَأَيْتُ عُيُوبَهَا *** محَاسِنَ زَادَتْهَا لِقَلْبي تحَبُّبَا
وَمَا عَذَّبَتْني بِالعُيُوبِ كَغَيْرِهَا *** وَلَكِنَّني اسْتَعْذَبْتُ فِيهَا التَّعَذُّبَا
** انظر كتاب: أخبار القضاة) 2/ 205، لمحمد بن خلف الملقب
ب(وكيع) و (تاريخ دمشق) لابن عساكر (23 / 53)
** الوصية الثانية عشرة:
** شكر كل منهما الآخر على ما يقدمه من الجهد والخدمة وأسباب الراحة.
** كأن يقول له: جزاك الله خيرا، أو بارك الله فيك، أو قواك الله، أو أسعدتنا أسعدك الله، أو الله يبقك لنا، أو نحو لك من الألفاظ الحسنة والدعوات الطيبة التي تدل على الشكر والتقدير والاعتراف بالفضل لصاحبه.
** وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
** وفي (تحفة الأحوذي)، (6/ 156):
(فَقَالَ لِفَاعِلِهِ) أَيْ بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْ إِثَابَتِهِ أَوْ مُطْلَقًا
(جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا) أَيْ خَيْرَ الْجَزَاءِ أَوْ أَعْطَاكَ خَيْرًا مِنْ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
(فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) أَيْ بَالَغَ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ وَأَنَّهُ مِمَّنْ عَجَزَ عَنْ جَزَائِهِ وَثَنَائِهِ فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللَّهِ لِيَجْزِيَهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى.
** قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا قَصُرَتْ يَدَاكَ بِالْمُكَافَأَةِ فَلْيَطُلْ لِسَانُكَ بِالشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ. اهـ
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ»
رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
** وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكَرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ» رواه النسائي في السنن الكبرى (8/ 239)، [وصححه الألباني]
** الوصية الثالثة عشرة:
الحذر كل الحذر من كل ما ينغص ويكدر أو يزيل الحياة الزوجية، مثل:
** التهديد بالطلاق.
** التهديد بالزواج.
** نقل الخلافات الزوجية إلى الجيران أو إلى الأهل؛ فإنهم يوسعونها أكثر وأكثر، إلا عند العجز عن حلها.
** ترك الغيرة المذمومة التي تنتهي بالشك في عفاف صاحبه وتخوينه
(بدون أي برهان).
** فينبغي لكل من الزوجين أن يرعى صاحبه ويكرمه ويحافظ على أمانته فيه ويشعره بالأمان ولا يتخونه، أو يطلب عثراته بالتجسس عليه. وتخوينه.
** فقد جاء عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ»
متفق عليه، وهذا لفظ مسلم
** الابتعاد بالكلية عن الأجهزة الحديثة المدمرة كـ (الدشوشات والإنترنت والوتساب والفيس بك…) وغيرها من الأجهزة التي خربت ودمرت كثيرا من الأفراد والأسر والمجتمعات، فقربت الشر والفساد بكل صوره وأشكاله، وسهلت الوصول إليه تسهيلا كثيرا؛ بغية انتشار الفحش والرذيلة وهدم الأخلاق الكريمة.
** فإذا احتاج الشخص إلى استعمال هذه الأجهزة لمصلحة راجحة فليستعملها بحذر بالغ.
** الابتعاد عن كل أسباب الغفلة كـ(سماع الغناء وآلات اللهو والطرب واللعب المحرم، كلعب الورق، والنرد، والشطرنج، والكيرم، والضومنة، والبلياردو, ونحوها من ألعاب اللهو والغفلة المحرمة.
** الابتعاد عن التصوير المحرم، وإخراج صور ذوات الأروح من البيوت؛ فإنها تمنع الملائكة من دخول البيوت.
** وأخيرا أقول:
** أيها الزوج الكريم، وفقك الله وأسعدك:
عامل زوجتك معاملة ترضي الله سبحانه وتعالى، مقتديا في ذلك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في معاملته لزوجاته، فهو القائل:
“خَيْرُكُمْ خيركم لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي”
رواه الترمذي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما،
وقال الألباني [صحيح لغيره].
** أيتها الزوجة الكريمة، وفقك الله وأسعدك:
عاملي زوجك معاملة ترضي الله سبحانه وتعالى، مقتدية في ذلك بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهن من النساء الصالحات.
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 29 / 12/ 1438 هـ
(87) الفرق بين الفراسة والظن، والفراسة -بكسر الفاء- والفراسة بفتحها
سلسلة الفوائد اليومية:
الفَرْق بَين الفِرَاسَة وَالظَّن، والفِراسة -بكسر الفاء- والفَراسة بفتحها
** قال ابن القيم في كتابه: (الروح)(ص: 238):
فصل:
** وَالْفرق بَين الفِرَاسَة وَالظَّن:
** أَن الظَّن يخطئ ويصيب وَهُوَ يكون مَعَ ظلمَة الْقلب ونوره وطهارته ونجاسته وَلِهَذَا أَمر تَعَالَى باجتناب كثير مِنْهُ وَأخْبر أَن بعضه إِثْم
** وَأما الفِرَاسَة فَأثْنى على أَهلهَا ومدحهم فِي قَوْله تَعَالَى {إِن فِي ذَلِك لآيَات للمتوسمين}
** قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَغَيره أَي للمتفرسين.
** وَقَالَ تَعَالَى {يَحْسبهُم الْجَاهِل أَغْنِيَاء من التعفف تعرفهم بِسِيمَاهُمْ}
** وَقَالَ تَعَالَى وَلَو نشَاء لأريناهم فَلَعَرَفْتهمْ بِسِيمَاهُمْ ولتعرفنهم فِي لحن القَوْل}
** فالفِرَاسَة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وَقرب من الله فَهُوَ ينظر بِنور الله الَّذِي جعله فِي قلبه.
** وَفِي التِّرْمِذِيّ وَغَيره من حَدِيث أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: اتَّقوا فِرَاسَة الْمُؤمن فَإِنَّهُ ينظر بِنور الله. اهـ
** وفي كتاب:(النهاية في غريب الحديث والأثر)(3/ 428):
** (فَرَسَ)
** (س) فِيهِ «اتَّقُوا فِرَاسَة الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظر بِنُورِ اللَّهِ»
** يُقَالُ بمعْنَيَيْن:
** أحَدُهما: مَا دَلَّ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا يوُقِعُه اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلوب أَوْلِيَائِهِ، فيَعْلَمون أَحْوَالَ بَعْضِ النَّاسِ بِنَوْعٍ مِنَ الْكَرَامَاتِ وَإِصَابَةِ الظَّنّ والحَدْس،
** وَالثَّانِي: نَوع يُتَعَلَّم بِالدَّلَائِلِ وَالتَّجَارِبِ والخَلْق وَالْأَخْلَاقِ، فَتُعْرف بِهِ أحوالُ النَّاسِ، وللنَّاس فِيهِ تَصانيفُ قَديمة وحَدِيثة. اهـ المراد
** وقال أيضا في كتابه: (الجواب الكافي)(ص: 178):
وهو يعدد مَنَافِعَ غَضِّ الْبَصَرِ:
أَحَدُهَا: … الثَّانِيَةُ: … الثَّالِثَةُ: … الرَّابِعَةُ: … الْخَامِسَةُ: …
السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يُورِثُ فِرَاسَةً صَادِقَةً يُمَيَّزُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ،
** وَكَانَ شُجَاعٌ الْكِرْمَانِيُّ يَقُولُ: مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشُّبَهَاتِ، وَاغْتَذَى بِالْحَلَالِ، لَمْ تُخْطِئْ لَهُ فِرَاسَةٌ.
** وَكَانَ شُجَاعًا لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ.
** وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَجْزِي الْعَبْدَ عَلَى عَمَلِهِ بِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ،
** وَمَنْ تَرَكَ لِلَّهِ شَيْئًا عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ،
** فَإِذَا غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، عَوَّضَهُ اللَّهُ بِأَنْ يُطْلِقَ نُورَ بَصِيرَتِهِ، عِوَضًا عَنْ حَبْسِ بَصَرِهِ لِلَّهِ، وَيَفْتَحُ عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ، وَالْمَعْرِفَةِ وَالْفِرَاسَةِ الصَّادِقَةِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي إِنَّمَا تُنَالُ بِبَصِيرَةٍ،
** فَقَالَ تَعَالَى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ}.
** فَوَصَفَهُمْ بِالسَّكْرَةِ الَّتِي هِيَ فَسَادُ الْعَقْلِ،
** وَالْعَمَهِ الَّذِي هُوَ فَسَادُ الْبَصِيرَةِ.
** فَالتَّعَلُّقُ بِالصُّوَرِ يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْلِ، وَعَمَهَ الْبَصِيرَةِ، وَسُكْرَ الْقَلْبِ،
** كَمَا قَالَ الْقَائِلٌ:
سَكْرَانُ سُكْرُ هَوًى وَسُكْرُ مُدَامَةٍ *** وَمَتَّى إِفَاقَةُ مَنْ بِهِ سُكْرَانِ
** وَقَالَ الْآخَرُ:
قَالُوا جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ *** الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ
الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ *** وَإِنَّمَا يُصْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحِينِ. اهـ.
** (تنبيه): حديث: (اتَّقوا فراسة الْمُؤمن) ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (4/ 299) برقم: (1821)
** ويغني عنه حديث أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ للَّهِ عِبَادًا يَعْرِفُونَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، [وحسنه الألباني]
** (فائدة):
** الفرق بين ” الفِراسة ” بكسر الفاء و” الفَراسة ” بفتحها.
** (الفِرَاسَة) -بالكسر-: الاسم من التَفَرُّس وهُوَ التَّوَسُّم، تقول منه: رَجُلٌ فارِسُ النَّظَر، أَي ذُو بصر وَتَأمل.
** و(الفَرَاسَة) -بالفتح-: الاسم مِنَ الفُرُوسِيَّة، وهي الحِذْقُ برُكُوبِ الخَيْلِ وأَمْرِهَا ورَكْضها والثَّبَات عَلَيْهَا، تقول منه: رَجُلٌ فارسٌ حسَنُ الفُرُوسِيَّة، أي ذو حَذِقَ بأمْرِ الخَيْلِ.
** وقد يجتمعان في رجل واحد فيكون ذلك نورا على نور.
** وفي كتاب: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)، للجوهري (3/ 958):
** و(الفِرَاسَة) بالكسر: الاسم من قولك: (تَفَرَّسْتُ فيه خيراً).
** وهو يَتَفَرَّسُ، أي يتثبَّت وينظر. تقول منه: (رجلٌ فارِسُ النظر).
** وفي الحديث: ” (اتَّقوا فِراسَةَ المؤمنِ) “.
** و(الفَراسَةُ) بالفتح: مصدر قولك: (رَجلٌ فارِسٌ على الخيل بيِّن الفَراسَةِ والفُروسَةِ والفُروسيَّةِ).
** وقد فَرُسَ بالضم يَفْرُسُ فُروسَةً وفَراسَةً، أي حَذِقَ أمر الخيل. اهـ
** (فائدة أخرى لطيفة):
** قال ابن أبي حاتم في كتابه: (آداب الشافعي ومناقبه)، (ص: 96):
** بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ فِرَاسَةِ الشَّافِعِيِّ وَفِطْنَتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ:
** أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا َأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ: سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ، يَقُولُ:
** قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: ” خَرَجْتُ إِلَى الْيَمَنِ فِي طَلَبِ كُتُبِ الْفِرَاسَةِ، حَتَّى كَتَبْتُهَا وَجَمَعْتُهَا،
** ثُمَّ لَمَّا حَانَ انْصِرَافِي، مَرَرْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي طَرِيقِي وَهُوَ مُحْتَبٍ بِفِنَاءِ دَارِهِ، أَزْرَقَ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِئِ الْجَبْهَةِ، سِنَاطٍ،
** فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ مِنْ مَنْزِلٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
** قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا النَّعْتُ أَخْبَثُ مَا يَكُونُ فِي الْفِرَاسَةِ.
** فَأَنْزَلَنِي، فَرَأَيْتُ أَكْرَمَ رَجُلٍ، بَعَثَ إِلَيَّ بِعَشَاءٍ وَطِيبٍ، وَعَلَفٍ لِدَابَّتِي، وَفِرَاشٍ وَلِحَافٍ،
** فَجَعَلْتُ أَتَقَلَّبُ اللَّيْلَ أَجْمَعَ مَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكُتُبِ؟ إِذْ رَأَيْتُ هَذَا النَّعْتَ فِي هَذَا الرَّجُلِ، فَرَأَيْتُ أَكْرَمَ رَجُلٍ، فَقُلْتُ: أَرْمِي بِهَذِهِ الْكُتُبِ “.
** فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، قُلْتُ لِلْغُلامِ: أَسْرِجْ، فَأَسْرَجَ، فَرَكِبْتُ وَمَرَرْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ وَمَرَرْتَ بِذِي طُوًى، فَسَلْ عَنْ مَنْزِلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ.
** فَقَالَ لِيَ الرَّجُلُ: أَمَولًى لأَبِيكَ أَنَا؟! قُلْتُ: لا.
** قَالَ: فَهَلْ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي نِعْمَةٌ؟! فَقُلْتُ: لا.
** فَقَالَ: أَيْنَ مَا تَكَلَّفْتُ لَكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟
** قَالَ: اشْتَرَيْتُ لَكَ طَعَامًا بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِدَامًا بِكَذَا، وَعِطْرًا بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ، وَعَلَفًا لِدَابَّتِكَ بِدِرْهَمَيْنِ، وَكِرَاءُ الْفِرَاشِ وَاللِّحَافِ دِرْهَمَانِ.
** قَالَ: قُلْتُ: يَا غُلامُ أَعْطِهِ، فَهَلْ بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ.
** قَالَ: كِرَاءُ الْمَنْزِلِ، فَإِنِّي وَسَّعْتُ عَلَيْكَ، وَضَيَّقْتُ عَلَى نَفْسِي،
** قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَغَبَطْتُ نَفْسِي بِتِلْكَ الْكُتُبِ،
** فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: هَلْ بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ؟
** قَالَ: امْضِ، أَخْزَاكَ اللَّهُ، فَمَا رَأَيْتُ قَطُّ شَرًّا مِنْكَ.
** أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فِي كِتَابِي عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ” اشْتَرَيْتُ لِلشَّافِعِيِّ طِيبًا بِدِينَارٍ،
** فَقَالَ لِي: مِمَّنِ اشْتَرَيْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ ذَلِكَ الأَشْقَرِ الأَزْرَقِ،
** فَقَالَ: أَشْقَرُ أَزْرَقُ، رُدَّهُ، رُدَّهُ “
** أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ بِزِيَادَةٍ،
** قَالَ: ” سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَا جَاءَنِي خَيْرٌ قَطُّ مِنْ أَشْقَرَ “.
اهـ المراد
** وفي كتاب: (تاج العروس)، (13/ 479):
(ق ن ج ر)
** (القُنْجُورُ)، كـ(زُنْبُورٍ)، بالجِيم، أَهمله الجوهريُّ،
** وَقَالَ ابنُ الأَعرابيّ: هُوَ الرَّجُلُ الصَّغِيرُ الرَأْسِ الضَّعِيفُ العَقْلِ،
هَكَذَا نَقله الصاغانيّ وصاحبُ اللّسَان.
** وَقَالَ أَهل الفِراسَة: إِنّ صِغَرَ الرَّأْسِ يَدُلّ على ضَعْفِ الرَّأْي. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الجمعة 2 / 1/ 1439 هـ
(85) ذكر أول شيخ بدأ البخاري صحيحه به، وأخر شيخ ختمه به
سلسة الفوائد اليومية
- أول شيخ بدأ البخاري صحيحه به هو: (الْحُمَيْدِيّ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر)، فقال رحمه الله:
1- حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»
فتح الباري لابن حجر (1/ 2) –
قَوْله: (حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيّ)
هُوَ أَبُو بَكْر عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر بْن عِيسَى، مَنْسُوب إِلَى حُمَيْدِ بْن أُسَامَة بَطْن مِنْ بَنِي أَسَد بْن عَبْد الْعُزَّى بْن قُصَيّ، رَهْط خَدِيجَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَجْتَمِع مَعَهَا فِي أَسَد وَيَجْتَمِع مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُصَيّ.
وَهُوَ إِمَام كَبِير مُصَنِّف، رَافَقَ الشَّافِعِيّ فِي الطَّلَب عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ وَطَبَقَته وَأَخَذَ عَنْهُ الْفِقْه وَرَحَلَ مَعَهُ إِلَى مِصْر، وَرَجَعَ بَعْد وَفَاته إِلَى مَكَّة إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَا سَنَة تِسْع عَشْرَة وَمِائَتَيْنِ.
فَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ امْتَثَلَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَدِّمُوا قُرَيْشًا) فَافْتَتَحَ كِتَابَهُ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ؛ لِكَوْنِهِ أَفْقَهَ قُرَشِيٍّ أَخَذَ عَنْهُ.
وَلَهُ مُنَاسَبَةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ مَكِّيٌّ كَشَيْخِهِ فَنَاسَبَ أَنْ يُذْكَرَ فِي أَوَّلِ تَرْجَمَةِ بَدْءِ الْوَحْيِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَهُ كَانَ بِمَكَّةَ،
وَمِنْ ثَمَّ ثَنَّى بِالرِّوَايَةِ عَنْ مَالِكٍ لِأَنَّهُ شَيْخُ أَهْلِ الْمَدِينَةَ، وَهِيَ تَالِيَةٌ لِمَكَّةَ فِي نُزُولِ الْوَحْيِ وَفِي جَمِيع الْفضل،
وَمَالك وبن عُيَيْنَةَ قَرِينَانِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْلَاهُمَا لَذَهَبَ الْعِلْمُ من الْحجاز. اهـ
- وآخر شيخ ختم به صحيحة هو: (أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ) فقال رحمه الله:
7563- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ “
فتح الباري لابن حجر (13/ 540):
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَآخِرُهُ مُوَحَّدَةٌ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ؛ لِأَنَّهُ أَعْجَمِيٌّ، وَقِيلَ: بَلْ عَرَبِيٌّ فَيَنْصَرِفُ،
وَهُوَ لَقَبٌ، وَاسْمُهُ: مَجْمَعٌ، وَقِيلَ: مَعْمَرٌ، وَقِيلَ: عُبَيْدُ اللَّهِ
وَكُنْيَةُ: أَحْمَدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ الصَّفَّارُ الْحَضْرَمِيُّ نَزِيلُ مِصْرَ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: آخِرُ مَا لَقِيتُهُ بِمِصْرَ سنة سبع عشرَة.
وأرخ بن حبَان وَفَاته فِيهَا.
وَقَالَ بن يُونُسَ مَاتَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانَ عَشْرَةَ
قُلْتُ: وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ (عَلِيِّ بْنِ إِشْكَابٍ)، وَلَا (مُحَمَّدِ بْنِ إِشْكَابٍ) قَرَابَةٌ. اهـ
والله الموفق.
كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
السبت 25 / 12/ 1438 هـ.
(84) الحقوق الزوجية / الحلقة الثالثة / حقوق الزوجة
سلسلة الفوائد اليومية
(84) فائدة اليوم بعنوان:
(الحقوق الزوجية / الحلقة الثالثة / حقوق الزوجة)
** قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
** قال الله تعالى: {وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
** وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” أكْمَلُ المؤمِنينَ إيماناً أحْسَنُهم خُلُقاً، وخيارُكُم خيارُكُم لِنسائِهمْ “.
** رواه الترمذي وغيره، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
** وفي (تفسير ابن كثير) ط العلمية (1/ 459):
** وَقَوْلُهُ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
** أَيْ وَلَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ،
** فَلْيُؤَدِّ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى الْآخَرِ، مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ،
** كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم، قال فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»
** وَفِي حَدِيثِ بِهَزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا؟
قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذا اكتسبت، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»
** وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِيَ الْمَرْأَةُ، لِأَنَّ اللَّهَ يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
** ورواه ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، الخ كلامه) اهـ المراد.
** وقال أيضا في (2/ 212):
** وقوله تعالى: {وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
** أَيْ طَيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا، فَافْعَلْ أَنْتَ بِهَا مِثْلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [الْبَقَرَةِ: 228]
** وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»
** وَكَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمِيلُ الْعِشْرَةِ دَائِمُ الْبِشْرِ، يُدَاعِبُ أَهْلَهُ، وَيَتَلَطَّفُ بِهِمْ ويُوسِعُهُمْ نَفَقَتَهُ، وَيُضَاحِكُ نِسَاءَهُ حَتَّى إِنَّهُ كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يَتَوَدَّدُ إِلَيْهَا بِذَلِكَ،
** قَالَتْ: سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَحْمِلَ اللَّحْمَ، ثُمَّ سَابَقْتُهُ بَعْدَ مَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ «هَذِهِ بِتِلْكَ»
** وَيَجْتَمِعُ نِسَاؤُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَبِيتُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْكُلُ مَعَهُنَّ الْعَشَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى مَنْزِلِهَا،
** وَكَانَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ عَنْ كَتِفَيْهِ الرِّدَاءَ وَيَنَامُ بِالْإِزَارِ،
** وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ يَسْمُرُ مَعَ أَهْلِهِ قَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، يُؤَانِسُهُمْ بِذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
** وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الْأَحْزَابِ: 21]
** وَأَحْكَامُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الْأَحْكَامِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اهـ
** وقبل أن ندخل في تفاصيل حقوق الزوجة على زوجها نذكر بنعمة الله العظيمة على المرأة المسلمة في هذا الدين العظيم، فنقول – وبالله التوفيق -:
(**) لقد كانت المرأة قبل الإسلام – أماً كانت أو بنتاً أو أختاً أو زوجةً أو عمةً أو خالةً – مستعبدةً، مملوكةً، مهانةً, ولم يكن لها أي حق من الحقوق.
(**) بل كان العرب يكرهونها غاية الكره، ويدفنونها – وهي حية – خشية الفقر والعار، كما قال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}
** وقال شاعرهم:
ومن غاية المجد والمكرمات *** بقاء البنين وموت البنات
** وقال أخر:
تَهْوَى حَيَاتِي وَأَهْوَى مَوْتَهَا شَفَقًا *** وَالْمَوْتُ أَكْرَمُ نَزَّالٍ عَلَى الْحُرَمِ
** وقال عقيل بن علفة المري لما خطبت عنه ابنته الجرباء:
إِنِّي وَإِنْ سِيقَ إِلَيَّ الْمَهْرُ * * * عَبْدٌ وَأَلْفَانِ وَذَوْدٌ عَشْرُ
أَحَبُّ أَصْهَارِي إِلَيَّ الْقَبْرُ
(**) وبعضهم كان يتركها تعيش، ولكن كيف هذه العيشة؟!
(**) إنها عيشة الذل والمهانة،
(**) فليس لها حق الإرث،
(**) ولا يؤخذ رأيها في أي شيء،
(**) وليس لطلاقها عدد معين،
(**) ولا لتعدد الزوجات عدد معين،
(**) وكانت تعد من ضمن الموروثات، فإذا مات زوجها جاء ابنه – من غيرها -، أو جاء أحد ورثته؛ فألقى ثوبه عليها وقال: ورثت امرأته كما ورثت ماله، وتصير في حوزته، ويصير أحق بها من كل الناس – حتى من أهلها وأبويها – فإن شاء تزوجها من غير صداق، وإن شاء زوجها بمن لا ترغب فيه رغم أنفها، وأخذ صداقها لنفسه.
** وفي: (صحيح البخاري)، (6/ 44):
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قَالَ: «كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ»
(**) وإذا مات زوجها فإنها تحد عليها شر حداد وأقبحه.
** وفي: (صحيح البخاري)، (7/ 59):
5336 – قَالَتْ زَيْنَبُ، وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ»
5337 – قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ، وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: «كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ [ص:60] إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً، فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ» سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: «تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا» وأخرجه مسلم أيضا (2/ 1124).
** وفي: (شرح النووي على مسلم) (10/ 114):
** قَوْلُهُ: (دَخَلَتْ حِفْشًا) هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ بَيْتًا صَغِيرًا حَقِيرًا قَرِيبَ السمك
** قوله: (ثم تؤتى بدابة حمار أوشاة أو طير فَتَفْتَضُّ بِهِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ فتفتض بالفاء والضاد.
** قال بن قُتَيْبَةَ: سَأَلْتُ الْحِجَازِيِّينَ عَنْ مَعْنَى الِافْتِضَاضِ فَذَكَرُوا أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ كَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ، وَلَا تَمَسُّ مَاءً، وَلَا تُقَلِّمُ ظُفْرًا، ثُمَّ تَخْرُجُ بَعْدَ الْحَوْلِ بِأَقْبَحِ مَنْظَرٍ، ثُمَّ تَفْتَضُّ أَيْ تَكْسِرُ مَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْعِدَّةِ بِطَائِرٍ تَمْسَحُ بِهِ قُبُلَهَا وَتَنْبِذُهُ فَلَا يَكَادُ يَعِيشُ مَا تَفْتَضُّ بِهِ.
** وَقَالَ مَالِكٌ: مَعْنَاهُ تَمْسَحُ بِهِ جلدها.
** وقال بن وَهْبٍ: مَعْنَاهُ تَمْسَحُ بِيَدِهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ.
** وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَمْسَحُ بِهِ ثُمَّ تَفْتَضُّ أَيْ تَغْتَسِلُ، وَالِافْتِضَاضُ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الْعَذْبِ لِلْإِنْقَاءِ وَإِزَالَةِ الْوَسَخِ حَتَّى تَصِيرَ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً كَالْفِضَّةِ.
** وَقَالَ الْأَخْفَشُ: مَعْنَاهُ تَتَنَظَّفُ وَتَتَنَقَّى مِنَ الدَّرَنِ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْفِضَّةِ فِي نَقَائِهَا وَبَيَاضِهَا.
** وَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ: أَنَّ الْأَزْهَرِيَّ قَالَ: رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (تُقْبَصُ) بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْقَبْضِ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ.اهـ
** فلما جاء الله بالإسلام رفع عنها هذه المظالم، فأعطاها جميع حقوقها، ورد لها جميع اعتباراتها.
** فجعلها شريكة للرجل في مبدأ الإنسانية، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى}
** وشريكة له في الثواب والعقاب، قال الله تعالى: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا َ}
** وحرم سبحانه وتعالى جعل المرأة من جملة المورثات، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} وقد تقدم الكلام عليها.
** بل جعلها وارثة من مال قريبها أو زوجها، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، الأية}
وقال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)}
** وجعل الصداق حقا لها، وأمر بإعطائها إياه كاملا إلا ما سمحت به عن طيب نفس، قال الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}
** وجعلها راعية في بيت زوجها، أميرة على أولادها.
** عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،…
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ،…،
أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.
** فالإسلام قد اعتنى بالمرأة عناية عظيمة، واهتم بها اهتماما كبيرا، ورفع من شأنها، وأعطاها حقوقها كاملة وافية، بل إنه أوصى بها جميع أفراد الرجال أن يرفقوا بها، وأن يحسنوا إليها، وأن يحافظوا عليها، سواء كانت زوجة أو أما أو بنتا أو أختا؛ وذلك لضعفها واحتياجها لمن يقوم بشأنها.
** وعَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ رضي الله عنه أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ،… الحديث) رواه الترمذي وغيره [وحسنه الألباني]
** وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (عَوَانٌ عِنْدَكُمْ)، يَعْنِي: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.
** فهذه الوصية العظيمة حضرها وسمعها الآلاف المؤلفة من الناس.
** وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ:
«… وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» متفق عليه.
** إن المرأة في قديم الزمان – عند أعداء الإسلام – كانت تعتبر حيوانا لا روح له.
** ولما أرادوا إنصافها في المؤتمر الفرنسي الذي عقد سنة 586 م
كان جهد ما قرروه لها: أنها إنسان وليست بحيوان، خلقت لخدمة الرجل فقط.
** ومن الطريف أن نذكر أن القانون الإنجليزي حتى عام 1805 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات (نصف شلن ليرة سورية).
** وقد حدث منذ بضعة أعوام أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع. اهـ بتصرف من كتاب: (تحفة العروس) صـ (223)، لمحمود بن مهدي الاستانبولي.
** فلتحمد المرأة ربها الذي أنعم عليها بهذا الدين العظيم الذي شرفها وكرمها، وأمر ببرها، والإحسان إليها، والإنفاق عليها؟!
** وبعد هذه المقدمة السريعة نذكر تفاصيل حقوق الزوجة على زوجها.
** ((الحق الأول)):
** المهر.
** قال الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}
** وقال: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}
** وقال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}
** والمهر ليس له تحديد في القلة والكثرة.
** وهو حق للزوجة، فلا يجوز لأحد – أبا كان أو زوجا أو أخا – أن يأخذه عليها إلا إذا رضيت.
** ((الحق الثاني)):
** الوليمة.
فإنها من الحقوق الواجبة على الرجل – على حسب قدرته -.
** عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» متفق عليه
** عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: «مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ – أَوْ أَفْضَلَ – مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ»،
فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: بِمَا أَوْلَمَ؟ قَالَ: «أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ» متفق عليه
** [قوله: (حتى تركوه)، يعني حتى شبعوا وتركوه لشبعهم]
** عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ، وَتَمْرٍ» رواه أبو داود وغيره، [وصححه الألباني]، وهو في الصحيحين ضمن قصة.
** وفي: (شرح النووي على مسلم)، (9/ 218):
(أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)
** دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُوسِرِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ شَاةٍ.
** وَنَقَلَ الْقَاضِي الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِقَدْرِهَا الْمُجْزِئِ، بَلْ بِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنَ الطَّعَامِ حَصَلَتِ الْوَلِيمَةُ.
** وَقَدْ ذكر مسلم بعد هذا في وَلِيمَةِ عُرْسِ صَفِيَّةَ أَنَّهَا كَانَتْ بِغَيْرِ لَحْمٍ، وَفِي وَلِيمَةِ زَيْنَبَ أَشْبَعَنَا خُبْزًا وَلَحْمًا.
** وَكُلُّ هذا جائز تحصل به الوليمة لكن يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ عَلَى قَدْرِ حَالِ الزَّوْجِ… الخ) اهـ
** ((الحق الثالث)):
(النفقة):
** وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كانت الزوجة عنده، أو مطلقة طلاقا رجعيا، أو مطلقة طلاقا بائنا لكنها حامل أو قائمة على أبنائه.
** فمن الكتاب قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا}
** وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
** وقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}
** ومن السنة حديث جابر الطويل، وفيه: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، …) رواه مسلم.
** وحَدِيثِ بِهَزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا؟
قَالَ «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذا اكتسبت، … الحديث» رواه أبو داود وغيره، (2/ 245)، [وقال الألباني: حسن صحيح ]
** وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم.
** قال ابن قدامة في كتاب: (المغني)، (8/ 195):
** وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، فَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَات عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، إذَا كَانُوا بَالِغِينَ، إلَّا النَّاشِزَ مِنْهُنَّ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَغَيْرُهُ. ** وَفِيهِ ضَرْبٌ مِنْ الْعِبْرَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَحْبُوسَةٌ عَلَى الزَّوْجِ، يَمْنَعُهَا مِنْ التَّصَرُّفِ وَالِاكْتِسَابِ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، كَالْعَبْدِ مَعَ سَيِّدِهِ. اهـ
** وانظر كتاب: (الإشراف على مذاهب العلماء)، لابن المنذر
(5/ 154)
** شروط استحقاق الزوجة للنفقة:
(1) أن يكون العقد صحيحا.
(2) أن تسلم نفسها لزوجها.
(3) أن تمكنه من الاستمتاع بها استمتاعا كاملا.
(4) ألا تمتنع من الانتقال معه حيث يريد.
** ومعنى بـ (المعروف)، [[أَيْ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِنَّ فِي بَلَدِهِنَّ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا إِقْتَارٍ، بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ فِي يَسَارِهِ، وَتَوَسُّطِهِ وَإِقْتَارِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً}
** وإذا قصر الزوج في النفقة الواجبة مع يساره جاز للزوجة أن تأخذ من ماله بدون إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف، لحديث عائشة الآتي.
** عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» متفق عليه
** ((الحق الرابع)):
السكن:
** وهو أن يهيئ الزوجُ لزوجته مسكناً على قدر سعته وقدرته.
** قال الله تعالى: {أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم}
** قال ابن قدامة في كتاب: (المغني)، (8/ 200):
فَصْلٌ:
** وَيَجِبُ لَهَا مَسْكَنٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}.
** فَإِذَا وَجَبَتْ السُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ، فَلِلَّتِي فِي صُلْبِ النِّكَاحِ أَوْلَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19].
** وَمِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَسْكَنٍ، وَلِأَنَّهَا لَا تَسْتَغْنِي عَنْ الْمَسْكَنِ لِلِاسْتِتَارِ عَنْ الْعُيُونِ، وَفِي التَّصَرُّفِ، وَالِاسْتِمْتَاعِ، وَحِفْظِ الْمَتَاعِ، وَيَكُونُ الْمَسْكَنُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6].
** وَلِأَنَّهُ وَاجِبٌ لَهَا لِمَصْلَحَتِهَا فِي الدَّوَامِ، فَجَرَى مَجْرَى النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ. اهـ
** ((الحق الخامس)):
حسن معاشرتها:
** قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
** قال ابن كثير في (تفسيره)، ط العلمية (2/ 212):
** وقوله تعالى: {وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أَيْ طَيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا، فَافْعَلْ أَنْتَ بِهَا مِثْلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
** وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»
** وَكَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمِيلُ الْعِشْرَةِ، دَائِمُ الْبِشْرِ،، يُدَاعِبُ أَهْلَهُ، وَيَتَلَطَّفُ بِهِمْ، ويُوسِعُهُمْ نَفَقَتَهُ، وَيُضَاحِكُ نِسَاءَهُ، حَتَّى إِنَّهُ كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يَتَوَدَّدُ إِلَيْهَا بِذَلِكَ،
** قَالَتْ: سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَحْمِلَ اللَّحْمَ، ثُمَّ سَابَقْتُهُ بَعْدَ مَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ «هَذِهِ بِتِلْكَ»
** وَيَجْتَمِعُ نِسَاؤُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَبِيتُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْكُلُ مَعَهُنَّ الْعَشَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى مَنْزِلِهَا،
** وَكَانَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ عَنْ كَتِفَيْهِ الرِّدَاءَ وَيَنَامُ بِالْإِزَارِ،
** وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ يَسْمُرُ مَعَ أَهْلِهِ قَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، يُؤَانِسُهُمْ بِذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
** وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. اهـ
** ومن حسن معاشرتها بِالْمَعْرُوفِ:
(1) جماعها بالمعروف، وعدم غيابه عنها طويلا؛ فإن هذا الغياب الطويل قد يعرضها للفتنة.
(2) إكرامها وإكرام أهلها.
(3) معاملتها بالرفق واللين.
(4) تقديم الهدية لها.
(5) مزاحها مزحا معقولا بحيث لا يسقط هيبته.
(6) يتغافل عن بعض الأمور التي ليس لها كبير شأن.
(7) لا يستأثر بالطعام الطيب دونها.
(8) يراعيها في حال حيضها من الناحية الصحية.
(9) احتمال الأذى منها؛ لأنها ناقصة عقل ودين.
** قال ابن القيم رحمه الله في كتابه: (روضة المحبين ونزهة المشتاقين)، (ص: 215):
** وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟
** فقالت طائفة: لا يجب عليه ذلك؛ فإنه حق له، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه، بمنزلة من استأجر دارا إن شاء سكنها وإن شاء تركها.
** وهذا من أضعف الأقوال، والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده.
** أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليها،
** فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها فهو حق على الزوج بنص القرآن ** وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف،
** ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة.
** ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردا عليه.
** والله سبحانه وتعالى إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيره فقال تعالى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
** وقالت طائفة: يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة؛ ليستقر لها بذلك الصداق،
** وهذا من جنس القول الأول، وهذا باطل من وجه آخر؛ فإن المقصود إنما هو المعاشرة بالمعروف، والصداق دخل في العقد تعظيما لحرمته، وفرقا بينه وبين السفاح، فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق
** وقالت طائفة ثالثة: يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص أربعة أشهر، وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه، فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة.
** وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح؛ فإنه غير المعروف الذي لها وعليها.
** وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرا منه سبحانه للأزواج فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال بمهم فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلا أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا في كل أربعة أشهر مرة.
** وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف، بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف، فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد،
** قالوا: وعليه أن يشبعها وطئا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتا،
** وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره
** وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال هذا الدواء، ورغب فيه، وعلق عليه الأجر، وجعله صدقة لفاعله فقال: “وفي بضع أحدكم صدقة”
** ومن تراجم النسائي على هذا: الترغيب في المباضعة، ثم ذكر هذا الحديث
** ففي هذا كمال اللذة، وكمال الإحسان إلى الحبيبة، وحصول الأجر، وثواب الصدقة، وفرح النفس وذهاب أفكارها الرديئة عنها، وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظها، وخفة الجسم واعتدال المزاج، وجلب الصحة ودفع المواد الرديئة،
** فإن صادف ذلك وجها حسنا، وخلقا دمثا، وعشقا وافرا، ورغبة تامة، واحتسابا للثواب، فذلك اللذة التي لا يعادلها شيء ولا سيما إذا وافقت كمالها؛ فإنها لا تكمل حتى يأخذ كل جزء من البدن بقسطه من اللذة، فتلتذ العين بالنظر إلى المحبوب، والأذن بسماع كلامه، والأنف بشم رائحته، والفم بتقبيله، واليد بلمسه، وتعتكف كل جارحة على ما تطلبه من لذتها وتقابله من المحبوب،
** فإن فقد من ذلك شيء لم تزل النفس متطلعة إليه متقاضية له، فلا تسكن كل السكون؛ ولذلك تسمى المرأة سكنا لسكون النفس إلينا قال الله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}؛
** ولذلك فضل جماع النهار على جماع الليل،
** ولسبب آخر طبيعي وهو أن الليل وقت تبرد فيه الحواس وتطلب حظها من السكون، والنهار محل انتشار الحركات كما قال الله تعالى {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً}، وقال الله تعالى {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ}
** وتمام النعمة في ذلك فرحة المحب برضاء ربه تعالى بذلك، واحتساب هذه اللذة عنده، ورجاء تثقيل ميزانه، ولذلك كان أحب شيء إلى الشيطان أن يفرق بين الرجل وبين حبيبه ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام… الخ) اهـ
** وفي (تفسير ابن كثير) ط العلمية (1/ 455):
** قد ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ فِي مُنَاسَبَةِ تَأْجِيلِ الْمُولِي بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، الْأَثَرَ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ عبد الله بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ من الليل، فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه… وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فو الله لَوْلَا اللَّهُ أَنِّي أُرَاقِبَهْ… لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ
فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَمْ أَكْثَرَ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَحْبِسُ أَحَدًا مِنَ الْجُيُوشِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
** وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا زِلْتُ أَسْمَعُ حَدِيثَ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا إِذْ مَرَّ بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها، تَقُولُ:
تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهْ… وَأَرَّقَنِي أن لا ضَجِيعَ أُلَاعِبُهْ
أُلَاعِبُهُ طُورًا وَطُورًا كَأَنَّمَا… بَدَا قَمَرًا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهْ
يُسَرُّ بِهِ مَنْ كَانَ يَلْهُو بِقُرْبِهِ… لَطِيفُ الْحَشَا لَا يحتويه أقاربه
فو الله لَوْلَا اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ… لَنُقِضَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ
وَلَكِنَّنِي أَخْشَى رَقِيبًا مُوَكَّلًا… بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه
مخافة ربي والحياء يصدني… وإكرام بعلي أن تنال مراكبه
** ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ ذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ نَحْوَهُ،
** وَقَدْ رَوَى هَذَا مِنْ طَرْقٍ وَهُوَ من المشهورات. اهـ
** ((فائدة)):
** قال شيخنا أبو عمار محمد بن عبد الله باموسى حفظه الله تعالى في كتابه: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والأشعار ص:(408):
** وهذه الأبيات في سندها انقطاع؛ لأنها من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ المكي عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنها فهي منقطعة.
“تهذيب التهذيب ” (8/25)، و ” تحفة التحصل ” للعراقي (ص: 173)
** وقد رويت هذه الأبيات من طرق أخرى كلها لا تصح.
** وقد ضعف هذه الأبيات:
(1) الحافظ ابن حجر في ” التلخيص الحبير” (3/219-220).
(2) العلائي في ” جامع التحصيل ” (ص: 210). اهـ
** ((تبيه)):
كتاب:(إسعاف الأخيار) كتاب قيم ننصح بقراءته والاستفادة منه، فقد بذل فيه الشيخ جهدا كبيرا في بيان الأحاديث والآثار والأشعار المشهورة بين الناس أنها صحيحة وليست كذلك.
** ((الحق السادس)):
** أن يعلمها ما ينفعها من أمور دينها ودنياها.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}
** وفي (تفسير البغوي) – طيبة (8/ 169):
** قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ} قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيْ بِالِانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ تعالى عنه وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ.
{وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} يَعْنِي: مُرُوهُمْ بِالْخَيْرِ وَانْهُوهُمْ عَنِ الشَّرِّ وَعَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ تَقُوهُمْ بِذَلِكَ نَارًا {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}. اهـ
** وفي (تفسير ابن كثير) ط العلمية (5/ 213):
** أَيْ مُرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تَدَعُوهُمْ هَمْلًا، فَتَأْكُلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
** وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. ** وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وابن ماجة واللفظ له. اهـ
** وعَنْ مَالِك بْن الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه، قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا – أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا – سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، -… الخ) رواه البخاري
** وأهم ما يعلمها: أمر التوحيد والعقيدة، وأحكام الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والحجاب، والإحسان إلى الجيران، وغير ذلك من مكارم الأخلاق.
** ((الحق السابع)):
** عدم ظلمها، فلا يأخذ مالها، ولا يسبها، ولا يحتقرها أو يحتقر أهلها.
** قال الله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}
** وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا * وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً.
** وفي (تفسير ابن كثير) ط العلمية (2/ 258):
** وقوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} أَيْ إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده مِنْهَا مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا وَلَا هِجْرَانُهَا.
** وَقَوْلُهُ: {إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً} تَهْدِيدٌ لِلرِّجَالِ إِذَا بَغَوْا عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، فَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيَّ الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. اهـ
** وَفِي حَدِيثِ بِهَزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا؟
قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذا اكتسبت، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رواه أبو داود،
وقال الشيخ الألباني: [حسن صحيح]
** ((الحق الثامن)):
** عدم إفشاء سرها، خاصة سر الفراش.
** عَنْ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: ” لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ: مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ” فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ: ” فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانُ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ”
رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني.
** قال المناوي في كتابه: (فيض القدير)، (4/ 315):
** والقصد بالحديث التحذير من ذلك وبيان أنه من أمهات المحرمات الدالة على الدناءة وسفساف الأخلاق. اهـ
** وقال القرطبي في كتابه: (المفهم)، (13/ 25):
** ومقصود هذا الحديث [[يعني حديث «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»]]
هو: أن الرجل له مع أهله خلوة، وحالة يَقْبُحُ ذِكرُها، والتحدُّث بها، وتحمل الغَيْرة على سترها،
** ويلزم من كشفها عار عند أهل المروءة والحياء. فإن تكلم بشيء من ذلك، وأبداه، كان قد كشف عورة نفسه وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان، وكشفها للأسماع والآذان؛ إذ كل واحد منهما يحصل به الاطلاع على العورة، ولذلك قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((لا تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجها، حتى كأنّه ينظر إليها))،
** فإن دعت حاجة إلى ذِكْر شيء من ذلك، فليذكره مبهمًا، غير مُعَيّنٍ، بحسب الحاجة والضرورة، كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((فعلتُه أنا وهذه))، وكقوله: ((هل أعرستم الليلة؟))، وكقوله: ((كيف وجدت أهلك؟))
** والتصريح بذلك وتفصيله ليس من مكارم الأخلاق، ولا من خصال أهل الدين.
اهـ بزيادة ذكر حديث أَبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – الذي بين المعكوفين، وهو من الأحاديث التي ضعفت في صحيح مسلم؛
[[لأن في سنده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في “التقريب”
** وقال الذهبي في “الميزان”: “ضعفه يحيى بن معين والنسائي
** وقال أحمد: أحاديثه مناكير”.
** ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال: “فهذا مما استنكر لعمر”]]
اهـ من كتاب: (آداب الزفاف في السنة المطهرة)، (ص: 142)
** ((الحق التاسع)):
** أن يعدل بينها وبين ضراتها _ إن كان له أكثر من زوجة _ في المبيت والعطاء.
** قال الله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}
** وفي (تفسير البغوي) – إحياء التراث (1/ 709):
** قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ،}أَيْ: لَنْ تَقْدِرُوا أَنْ تُسَوُّوا بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْحُبِّ وَمَيْلِ الْقَلْبِ، {وَلَوْ حَرَصْتُمْ}عَلَى الْعَدْلِ، {فَلا تَمِيلُوا}، أَيْ: إِلَى الَّتِي تُحِبُّونَهَا، كُلَّ الْمَيْلِ فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ، أَيْ: لَا تُتْبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ أَفْعَالَكُمْ، فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ، أي فتدعوا الأخرى كالمعلّقة لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ.
** وَقَالَ قَتَادَةُ: كَالْمَحْبُوسَةِ، وَفِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «كَأَنَّهَا مَسْجُونَةٌ». اهـ
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» رواه أحمد وغيره، [وصححه الألباني ]
** قال الصنعاني في كتابه: (سبل السلام)، (2/ 238):
{فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}، وَالْمُرَادُ: الْمَيْلُ فِي الْقَسْمِ وَالْإِنْفَاقِ، لَا فِي الْمَحَبَّةِ؛ لِمَا عَرَفْت مِنْ أَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ،
** وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: (كُلَّ الْمَيْلِ) جَوَازُ الْمَيْلِ الْيَسِيرِ، وَلَكِنَّ إطْلَاقَ الْحَدِيثِ يَنْفِي ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ تَقْيِيدُ الْحَدِيثِ بِمَفْهُومِ الْآيَةِ. اهـ
** ((الحق العاشر)):
** عدم منعها من الخروج إلى المسجد إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنةٌ، خاصة إذا كان خروجها لتعلم أحكام دينها التي تحتاج إليها.
** عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ»
متفق عليه.
** وعَنِه رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا»
قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ،
قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ: فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ،
وَقَالَ: ” أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ ” رواه مسلم.
** وعَنِه رضي الله عنه، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
** وفي كتاب: (شرح النووي على مسلم) (4/ 161):
** قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)
** هَذَا وَشَبَهُهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ الْمَسْجِدَ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ مَأْخُوذَةً مِنَ الأحاديث وهو:
** أن لا تَكُونَ مُتَطَيِّبَةً، وَلَا مُتَزَيِّنَةً، وَلَا ذَاتَ خَلَاخِلَ يُسْمَعُ صَوْتُهَا، وَلَا ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ، وَلَا مُخْتَلِطَةً بِالرِّجَالِ، وَلَا شَابَّةً وَنَحْوَهَا مِمَّنْ يُفْتَتَنُ بِهَا، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ مَا يَخَافُ بِهِ مَفْسَدَةً وَنَحْوَهَا
** وَهَذَا النَّهْيُ عَنْ مَنْعِهِنِّ مِنَ الْخُرُوجِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ وَوُجِدَتِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ،
** فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ حَرُمَ الْمَنْعُ إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوطُ. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 22 / 12/ 1438 هـ.
سلسلة الفوائد اليومية: (83) فائدة اليوم بعنوان: من حكمة الله الحكيم تفضيل بعض المخلوقات على بعض
** قال الله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}
** وقال: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}
** وقال: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ}
** وعَنْ وَاثِلَةَ بْن الْأَسْقَعِ، رَضِيَ اللهُ عَنْه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» رواه مسلم
** قال ابن القيم في كتابه القيم: ( زاد المعاد) , (1/ 40)
** إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْخَلْقِ وَالِاخْتِيَارِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ}،
** وَالْمُرَادُ بِالِاخْتِيَارِ هَاهُنَا: الِاجْتِبَاءُ وَالِاصْطِفَاءُ، فَهُوَ اخْتِيَارٌ بَعْدَ الْخَلْقِ.
** وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ هَذَا الْخَلْقِ، رَأَيْتَ هَذَا الِاخْتِيَارَ وَالتَّخْصِيصَ فِيهِ دَالًّا عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَأَنَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَلَا شَرِيكَ لَهُ يَخْلُقُ كَخَلْقِهِ، وَيَخْتَارُ كَاخْتِيَارِهِ، وَيُدَبِّرُ كَتَدْبِيرِهِ،
** فَهَذَا الِاخْتِيَارُ وَالتَّدْبِيرُ وَالتَّخْصِيصُ الْمَشْهُودُ أَثَرُهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ رُبُوبِيَّتِهِ، وَأَكْبَرِ شَوَاهِدِ وَحْدَانِيَّتِهِ، وَصِفَاتِ كَمَالِهِ، وَصِدْقِ رُسُلِهِ، فَنُشِيرُ مِنْهُ إِلَى يَسِيرٍ يَكُونُ مُنَبِّهًا عَلَى مَا وَرَاءَهُ دَالًّا عَلَى مَا سِوَاهُ.
** فَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ سَبْعًا فَاخْتَارَ الْعُلْيَا مِنْهَا فَجَعَلَهَا مُسْتَقَرَّ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ، وَاخْتَصَّهَا بِالْقُرْبِ مِنْ كُرْسِيِّهِ وَمِنْ عَرْشِهِ، وَأَسْكَنَهَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، فَلَهَا مَزِيَّةٌ وَفَضْلٌ عَلَى سَائِرِ السَّمَاوَاتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قُرْبُهَا مِنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
** وَهَذَا التَّفْضِيلُ وَالتَّخْصِيصُ مَعَ تَسَاوِي مَادَّةِ السَّمَاوَاتِ مِنْ أَبْيَنِ الْأَدِلَّةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَأَنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ.
** وَمِنْ هَذَا تَفْضِيلُهُ سُبْحَانَهُ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ عَلَى سَائِرِ الْجِنَانِ، وَتَخْصِيصُهَا بِأَنْ جَعَلَ عَرْشَهُ سَقْفَهَا، …
** وَمِنْ هَذَا اخْتِيَارُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُصْطَفَيْنَ مِنْهُمْ عَلَى سَائِرِهِمْ، كَجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، …
** وَكَذَلِكَ اخْتِيَارُهُ سُبْحَانَهُ لِلْأَنْبِيَاءِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا،
** وَاخْتِيَارُهُ الرُّسُلَ مِنْهُمْ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أبي ذر الَّذِي رَوَاهُ أحمد، وَابْنُ حِبَّانَ فِي ” صَحِيحِهِ “،
** وَاخْتِيَارُهُ أُولِي الْعَزْمِ مِنْهُمْ، وَهُمْ خَمْسَةٌ الْمَذْكُورُونَ فِي سُورَةِ (الْأَحْزَابِ) وَ (الشُّورَى) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} ، وَقَالَ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} ،
** وَاخْتَارَ مِنْهُمُ الْخَلِيلَيْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا وَسَلَّمَ.
** وَمِنْ هَذَا اخْتِيَارُهُ سُبْحَانَهُ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ أَجْنَاسِ بَنِي آدَمَ،
** ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ خُزَيْمَةَ،
** ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ وَلَدِ كِنَانَةَ قُرَيْشًا،
** ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ،
** ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
** وَكَذَلِكَ اخْتَارَ أَصْحَابَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِينَ،
** وَاخْتَارَ مِنْهُمُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ،
** وَاخْتَارَ مِنْهُمْ أَهْلَ بَدْرٍ، وَأَهْلَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ،
** وَاخْتَارَ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ أَكْمَلَهُ، وَمِنَ الشَّرَائِعِ أَفْضَلَهَا، وَمِنَ الْأَخْلَاقِ أَزْكَاهَا وَأَطْيَبَهَا وَأَطْهَرَهَا.
** وَاخْتَارَ أُمَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، …
** وَظَهَرَ أَثَرُ هَذَا الِاخْتِيَارِ فِي أَعْمَالِهِمْ، وَأَخْلَاقِهِمْ، وَتَوْحِيدِهِمْ، وَمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، وَمَقَامَاتِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ، …
** وَمِنْ تَفْضِيلِ اللَّهِ لِأُمَّتِهِ وَاخْتِيَارِهِ لَهَا أَنَّهُ وَهَبَهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ مَا لَمْ يَهَبْهُ لِأُمَّةٍ سِوَاهَا، …
** وَمِنْ هَذَا اخْتِيَارُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْأَمَاكِنِ وَالْبِلَادِ خَيْرَهَا وَأَشْرَفَهَا، وَهِيَ الْبَلَدُ الْحَرَامُ، …
** وَقَدْ ظَهَرَ سِرُّ هَذَا التَّفْضِيلِ وَالِاخْتِصَاصِ فِي انْجِذَابِ الْأَفْئِدَةِ وَهَوَى الْقُلُوبِ وَانْعِطَافِهَا وَمَحَبَّتِهَا لِهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، فَجَذْبُهُ لِلْقُلُوبِ أَعْظَمُ مِنْ جَذْبِ الْمِغْنَاطِيسِ لِلْحَدِيدِ، فَهُوَ الْأَوْلَى بِقَوْلِ الْقَائِلِ:
محَاسِنُهُ هَيُولَى كُلِّ حُسْنٍ *** وَمِغْنَاطِيسُ أَفْئِدَةِ الرِّجَالِ
…
** وَمِنْ هَذَا تَفْضِيلُهُ بَعْضَ الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ عَلَى بَعْضٍ، فَخَيْرُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، …
** وَمِنْ ذَلِكَ تَفْضِيلُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ،
** وَتَفْضِيلُ عَشْرِهِ الْأَخِيرِ عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِي،
** وَتَفْضِيلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى أَلْفِ شَهْرٍ. …
** وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اخْتَارَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ أَطْيَبَهُ، وَاخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ وَارْتَضَاهُ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يُحِبُّ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَلَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ وَالْكَلَامِ وَالصَّدَقَةِ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَالطَّيِّبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ مُخْتَارُهُ تَعَالَى. اهـ المراد باختصار
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 18 / 12/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية: (82) فائدة اليوم بعنوان: الحث على كثرة ذكر الله، ومن حافظ على كل ذكر في وقته كان من الذاكرين الله كثيرا والذكرات
** قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً}
** وقال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
** وقال تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ، …) متفق عليه.
** وعن أَبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبيّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ ». متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
** وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الطبراني وغيره، وحسنه الألباني.
((فائدة))
** قال الإمام النووي -رحمه الله- في كتابه: (الأذكار) ط ابن حزم (ص: 41):
** وسئل الشيخ الإِمام أبو عمرو ابن الصَّلاح -رحمه الله- عن الْقَدْرِ الذي يصيرُ به من {الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} ؟
** فقال: إذا واظبَ على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً، وفي الأوقات والأحوال المختلفة، ليلاً ونهاراً، كان من {الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}، والله أعلم. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 15 / 12/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية: (81) فائدة اليوم بعنوان: (فضل يوم عرفة)
** يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة.
** وهو يوم عظيم، اختاره الله جل وعلا وفضله على غيره من الأيام.
** قال الله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}
** وهو ركن أساسي لفريضة الحج، لحديث عَبْد الرَّحْمَنِ بْن يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
” الحج عرفةَ “. رواه النسائي في سننه (5/264) [وصححه الألباني]
** فمَن فاته الوقوف بعرفة فقد فاتَه الحج.
** فمن فضائل هذا اليوم العظيم:
(1) أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتمّ النعمة.
** قال تعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}
** عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة: 3]
** قَالَ عُمَرُ: « قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ » متفق عليه
** قوله: (رجلا من اليهود) هو كعب الأحبار قال ذلك قبل أن يسلم.
** قوله: (معشر) المراد به: الجماعة الذين شأنهم واحد.
** قوله: (عيدا) أي: يوم سرور وفرح وتعظيم،
** سمي بذلك؛ لأنه يعود كل عام فيعود معه بفرح وسرور جديد.
** قوله: (أي آية) هي التي تعنيها، وهي الآية الثالثة من المائدة.
** قوله: (أكملت لكم دينكم) وذلك بإرساخ قواعده وبيانها وإظهاره على الأديان كلها.
** قوله: (وأتممت عليكم نعمتي) وذلك بالهداية والتوفيق والنصر على الكفر وأهله وهدم معالم الجاهلية.
** قوله: (قد عرفنا ذلك اليوم والمكان) أشار عمر رضي الله عنه إلى أن يوم نزولها يوم عيد عند المسلمين، فقد نزلت يوم الجمعة وهو يوم عيد لنا، ويوم عرفة الذي يتحقق العيد بأوله.
(2) أنه يوم عيد لأهل الإسلام.
** عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ » رواه أبو داود وغيره، [وصححه الألباني]
** وعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: لَوْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا،
** قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: « فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ » رواه الترمذي, [ وقال الألباني: صحيح الإسناد ]
(3) أن صيامه يكفر ذنوب سنتين: سنة ماضية وسنة قادمة.
** عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
« سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَة » رواه مسلم.
** قال ابن علان في كتابه: (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)، (7/ 59)
قوله: (قال: يكفر السنة الماضية) أي: التي آخرها سلخ ذي الحجة.
(والباقية) أي: الآتية، وأولها المحرم حملاً على المعنى المتعارف في السنة،
** والمكفر صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله،
** والمراد بغفران ما سيأتي. إما العصمة عن ملابسته، أو وقوعه مغفوراً إن وقع. اهـ
(فائدة):
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه: (فتح الباري)- (4/ 249)
** وَظَاهِرُهُ أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.
** وَقَدْ قِيلَ فِي الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ: إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْسُوبٌ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ مَنْسُوبٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلِذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ. اهـ
** وفي كتاب: (حاشية الجمل) – (2/ 348) لسليمان بن عمر، المعروف بالجمل (المتوفى: 1204هـ)
(قَوْلُهُ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ… إلَخْ)
** إنَّمَا كَانَ عَرَفَةُ بِسَنَتَيْنِ وَعَاشُورَاءُ بِسَنَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَوْمٌ مُحَمَّدِيٌّ، وَالثَّانِيَ يَوْمٌ مُوسَوِيٌّ، وَنَبِيُّنَا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ – صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ – فَكَانَ يَوْمُهُ بِسَنَتَيْنِ اهـ
** وتكفير الذنوب الحاصل بصيام يوم عرفة وغيره من الأعمال الصالحة المراد به الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة.
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم.
** قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى الكبرى (5/ 344):
** وَتَكْفِيرُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَعَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ لِلصَّغَائِرِ فَقَطْ، وَكَذَا الْحَجُّ. اهـ المراد
(4) أنه يوم لمغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف.
** عَنِ عَائِشَة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مَنْ يَوْم عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ ليَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ المَلائِكَةَ. فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ؟ “. رواه مسلم
** وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(… وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ، يَقُولُ: هَؤُلاءِ عِبَادِي، جَاءُوا شُعْثًا شُفَعَاءَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَمَغْفِرَتِي، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ، وَكَعَدَدِ الْقَطْرِ، وَكَزَبَدِ الْبَحْرِ، لَغَفَرْتُهَا، أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ » (رواه الطبراني وغيره وحسنه الألباني).
** قال الحافظ ابن رجب في كتابه: (لطائف المعارف) (ص: 279):
** وقد يجتمع في يوم واحد عيدان كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النحر فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا لاجتماع عيدين فيه، وقد كان ذلك، اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة فكان يوم الجمعة وفيه نزلت هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً} [المائدة: 3]. اهـ
** قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم: (زاد المعاد)، (1/ 59):
** فَإِنْ قِيلَ: فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، أَوْ يَوْمُ عَرَفَةَ؟
** فَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي ” صَحِيحِهِ ” مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ »)
** وَفِيهِ أَيْضًا حَدِيثُ أوس بن أوس («خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ »).
** قِيلَ: قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَفْضِيلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى يَوْمِ عَرَفَةَ مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيثِ،
** وَحَكَى الْقَاضِي أبو يعلى رِوَايَةً عَنْ أحمد أَنَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
** وَالصَّوَابُ: أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْعَامِ، وَكَذَلِكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ،
** وَلِهَذَا كَانَ لِوَقْفَةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ مَزِيَّةٌ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ.
أَحَدُهَا: اجْتِمَاعُ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَيَّامِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ سَاعَةٌ مُحَقَّقَةُ الْإِجَابَةِ، وَأَكْثَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَأَهْلُ الْمَوْقِفِ كُلُّهُمْ إِذْ ذَاكَ وَاقِفُونَ لِلدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ.
الثَّالِثُ: مُوَافَقَتُهُ لِيَوْمِ وَقْفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الرَّابِعُ: أَنَّ فِيهِ اجْتِمَاعَ الْخَلَائِقِ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِلْخُطْبَةِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ اجْتِمَاعَ أَهْلِ عَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَيَحْصُلُ مِنَ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَمَوْقِفِهِمْ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ مَا لَا يَحْصُلُ فِي يَوْمٍ سِوَاهُ.
الْخَامِسُ: أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ عِيدٍ لِأَهْلِ عَرَفَةَ؛ وَلِذَلِكَ كُرِهَ لِمَنْ بِعَرَفَةَ صَوْمُهُ، وَفِي النَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: («نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ»)،
وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ مهدي بن حرب العبدي لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، وَمَدَارُهُ عَلَيْهِ،
وَلَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أم الفضل ” « أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ ».
** وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ اسْتِحْبَابِ فِطْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الخرقي وَغَيْرِهِ،
** وَقَالَ غَيْرُهُمْ – مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن تيمية -: الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ عِيدٌ لِأَهْلِ عَرَفَةَ، فَلَا يُسْتَحَبُّ صَوْمُهُ لَهُمْ، قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي ” السُّنَنِ ” عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: («يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ مِنًى، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ»).
** قَالَ شَيْخُنَا: وَإِنَّمَا يَكُونُ يَوْمُ عَرَفَةَ عِيدًا فِي حَقِّ أَهْلِ عَرَفَةَ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَجْتَمِعُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَكَانَ هُوَ الْعِيدَ فِي حَقِّهِمْ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ، فَقَدِ اتَّفَقَ عِيدَانِ مَعًا.
السَّادِسُ: أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِيَوْمِ إِكْمَالِ اللَّهِ تَعَالَى دِينَهُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِتْمَامِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، كَمَا ثَبَتَ فِي ” صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ” عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: («جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ تَقْرَءُونَهَا فِي كِتَابِكُمْ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ وَنَعْلَمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] [الْمَائِدَةِ: 3]
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَنَحْنُ وَاقِفُونَ مَعَهُ بِعَرَفَةَ»).
السَّابِعُ: أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِيَوْمِ الْجَمْعِ الْأَكْبَرِ، وَالْمَوْقِفِ الْأَعْظَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
فَإِنَّ الْقِيَامَةَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»)
** وَلِهَذَا شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ يَوْمًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ، فَيَذْكُرُونَ الْمَبْدَأَ وَالْمَعَادَ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَادَّخَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ فِيهِ كَانَ الْمَبْدَأُ وَفِيهِ الْمَعَادُ، وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي فَجْرِهِ سُورَتَيِ (السَّجْدَةِ) وَ (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، مِنْ خَلْقِ آدَمَ، وَذِكْرِ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ، وَدُخُولِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَكَانَ يُذَكِّرُ الْأُمَّةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِمَا كَانَ فِيهِ وَمَا يَكُونُ، فَهَكَذَا يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ بِأَعْظَمِ مَوَاقِفِ الدُّنْيَا – وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ – الْمَوْقِفَ الْأَعْظَمَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ، وَلَا يَتَنَصَّفُ حَتَّى يَسْتَقِرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي مَنَازِلِهِمْ.
الثَّامِنُ: أَنَّ الطَّاعَةَ الْوَاقِعَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَكْثَرُ مِنْهَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ حَتَّى إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْفُجُورِ يَحْتَرِمُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهُ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ تَجَرَّأَ فِيهِ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَجَّلَ اللَّهُ عُقُوبَتَهُ وَلَمْ يُمْهِلْهُ، وَهَذَا أَمْرٌ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُمْ وَعَلِمُوهُ بِالتَّجَارِبِ، وَذَلِكَ لِعِظَمِ الْيَوْمِ وَشَرَفِهِ عِنْدَ اللَّهِ، وَاخْتِيَارِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ لِلْوَقْفَةِ فِيهِ مَزِيَّةً عَلَى غَيْرِهِ.
التَّاسِعُ: أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِيَوْمِ الْمَزِيدِ فِي الْجَنَّةِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي وَادٍ أَفْيَحَ، وَيُنْصَبُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ، فَيَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَيَتَجَلَّى لَهُمْ فَيَرَوْنَهُ عِيَانًا، وَيَكُونُ أَسْرَعُهُمْ مُوَافَاةً أَعْجَلَهُمْ رَوَاحًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ أَقْرَبَهُمْ مِنَ الْإِمَامِ، فَأَهْلُ الْجَنَّةِ مُشْتَاقُونَ إِلَى يَوْمِ الْمَزِيدِ فِيهَا لِمَا يَنَالُونَ فِيهِ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَهُوَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، فَإِذَا وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ لَهُ زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ وَاخْتِصَاصٍ وَفَضْلٍ لَيْسَ لِغَيْرِهِ.
الْعَاشِرُ: أَنَّهُ يَدْنُو الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: («مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ») وَتَحْصُلُ مَعَ دُنُوِّهِ مِنْهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةُ الْإِجَابَةِ الَّتِي لَا يَرُدُّ فِيهَا سَائِلًا يَسْأَلُ خَيْرًا فَيَقْرُبُونَ مِنْهُ بِدُعَائِهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَيَقْرُبُ مِنْهُمْ تَعَالَى نَوْعَيْنِ مِنَ الْقُرْبِ، أَحَدُهُمَا: قُرْبُ الْإِجَابَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَالثَّانِي: قُرْبُهُ الْخَاصُّ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ، وَمُبَاهَاتُهُ بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، فَتَسْتَشْعِرُ قُلُوبُ أَهْلِ الْإِيمَانِ هَذِهِ الْأُمُورَ فَتَزْدَادُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِهَا، وَفَرَحًا وَسُرُورًا وَابْتِهَاجًا، وَرَجَاءً لِفَضْلِ رَبِّهَا وَكَرَمِهِ،
** فَبِهَذِهِ الْوُجُوهِ وَغَيْرِهَا فُضِّلَتْ وَقْفَةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِهَا.
** وَأَمَّا مَا اسْتَفَاضَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ بِأَنَّهَا تَعْدِلُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَجَّةً، فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 8 / 12/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية: (82) فائدة اليوم بعنوان: الحث على كثرة ذكر الله، ومن حافظ على كل ذكر في وقته كان من الذاكرين الله كثيرا والذكرات
** قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً}
** وقال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
** وقال تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ، …) متفق عليه.
** وعن أَبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبيّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ ». متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
** وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الطبراني وغيره، وحسنه الألباني.
((فائدة))
** قال الإمام النووي -رحمه الله- في كتابه: (الأذكار) ط ابن حزم (ص: 41):
** وسئل الشيخ الإِمام أبو عمرو ابن الصَّلاح -رحمه الله- عن الْقَدْرِ الذي يصيرُ به من {الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} ؟
** فقال: إذا واظبَ على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً، وفي الأوقات والأحوال المختلفة، ليلاً ونهاراً، كان من {الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}، والله أعلم. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 15 / 12/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية: (81) فائدة اليوم بعنوان: (فضل يوم عرفة)
** يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة.
** وهو يوم عظيم، اختاره الله جل وعلا وفضله على غيره من الأيام.
** قال الله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}
** وهو ركن أساسي لفريضة الحج، لحديث عَبْد الرَّحْمَنِ بْن يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
” الحج عرفةَ “. رواه النسائي في سننه (5/264) [وصححه الألباني]
** فمَن فاته الوقوف بعرفة فقد فاتَه الحج.
** فمن فضائل هذا اليوم العظيم:
(1) أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتمّ النعمة.
** قال تعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}
** عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة: 3]
** قَالَ عُمَرُ: « قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ » متفق عليه
** قوله: (رجلا من اليهود) هو كعب الأحبار قال ذلك قبل أن يسلم.
** قوله: (معشر) المراد به: الجماعة الذين شأنهم واحد.
** قوله: (عيدا) أي: يوم سرور وفرح وتعظيم،
** سمي بذلك؛ لأنه يعود كل عام فيعود معه بفرح وسرور جديد.
** قوله: (أي آية) هي التي تعنيها، وهي الآية الثالثة من المائدة.
** قوله: (أكملت لكم دينكم) وذلك بإرساخ قواعده وبيانها وإظهاره على الأديان كلها.
** قوله: (وأتممت عليكم نعمتي) وذلك بالهداية والتوفيق والنصر على الكفر وأهله وهدم معالم الجاهلية.
** قوله: (قد عرفنا ذلك اليوم والمكان) أشار عمر رضي الله عنه إلى أن يوم نزولها يوم عيد عند المسلمين، فقد نزلت يوم الجمعة وهو يوم عيد لنا، ويوم عرفة الذي يتحقق العيد بأوله.
(2) أنه يوم عيد لأهل الإسلام.
** عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ » رواه أبو داود وغيره، [وصححه الألباني]
** وعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: لَوْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا،
** قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: « فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ » رواه الترمذي, [ وقال الألباني: صحيح الإسناد ]
(3) أن صيامه يكفر ذنوب سنتين: سنة ماضية وسنة قادمة.
** عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
« سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَة » رواه مسلم.
** قال ابن علان في كتابه: (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)، (7/ 59)
قوله: (قال: يكفر السنة الماضية) أي: التي آخرها سلخ ذي الحجة.
(والباقية) أي: الآتية، وأولها المحرم حملاً على المعنى المتعارف في السنة،
** والمكفر صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله،
** والمراد بغفران ما سيأتي. إما العصمة عن ملابسته، أو وقوعه مغفوراً إن وقع. اهـ
(فائدة):
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه: (فتح الباري)- (4/ 249)
** وَظَاهِرُهُ أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.
** وَقَدْ قِيلَ فِي الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ: إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْسُوبٌ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ مَنْسُوبٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلِذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ. اهـ
** وفي كتاب: (حاشية الجمل) – (2/ 348) لسليمان بن عمر، المعروف بالجمل (المتوفى: 1204هـ)
(قَوْلُهُ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ… إلَخْ)
** إنَّمَا كَانَ عَرَفَةُ بِسَنَتَيْنِ وَعَاشُورَاءُ بِسَنَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَوْمٌ مُحَمَّدِيٌّ، وَالثَّانِيَ يَوْمٌ مُوسَوِيٌّ، وَنَبِيُّنَا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ – صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ – فَكَانَ يَوْمُهُ بِسَنَتَيْنِ اهـ
** وتكفير الذنوب الحاصل بصيام يوم عرفة وغيره من الأعمال الصالحة المراد به الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة.
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم.
** قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى الكبرى (5/ 344):
** وَتَكْفِيرُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَعَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ لِلصَّغَائِرِ فَقَطْ، وَكَذَا الْحَجُّ. اهـ المراد
(4) أنه يوم لمغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف.
** عَنِ عَائِشَة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مَنْ يَوْم عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ ليَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ المَلائِكَةَ. فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ؟ “. رواه مسلم
** وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(… وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ، يَقُولُ: هَؤُلاءِ عِبَادِي، جَاءُوا شُعْثًا شُفَعَاءَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَمَغْفِرَتِي، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ، وَكَعَدَدِ الْقَطْرِ، وَكَزَبَدِ الْبَحْرِ، لَغَفَرْتُهَا، أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ » (رواه الطبراني وغيره وحسنه الألباني).
** قال الحافظ ابن رجب في كتابه: (لطائف المعارف) (ص: 279):
** وقد يجتمع في يوم واحد عيدان كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النحر فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا لاجتماع عيدين فيه، وقد كان ذلك، اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة فكان يوم الجمعة وفيه نزلت هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً} [المائدة: 3]. اهـ
** قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم: (زاد المعاد)، (1/ 59):
** فَإِنْ قِيلَ: فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، أَوْ يَوْمُ عَرَفَةَ؟
** فَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي ” صَحِيحِهِ ” مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ »)
** وَفِيهِ أَيْضًا حَدِيثُ أوس بن أوس («خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ »).
** قِيلَ: قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَفْضِيلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى يَوْمِ عَرَفَةَ مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيثِ،
** وَحَكَى الْقَاضِي أبو يعلى رِوَايَةً عَنْ أحمد أَنَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
** وَالصَّوَابُ: أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْعَامِ، وَكَذَلِكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ،
** وَلِهَذَا كَانَ لِوَقْفَةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ مَزِيَّةٌ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ.
أَحَدُهَا: اجْتِمَاعُ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَيَّامِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ سَاعَةٌ مُحَقَّقَةُ الْإِجَابَةِ، وَأَكْثَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَأَهْلُ الْمَوْقِفِ كُلُّهُمْ إِذْ ذَاكَ وَاقِفُونَ لِلدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ.
الثَّالِثُ: مُوَافَقَتُهُ لِيَوْمِ وَقْفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الرَّابِعُ: أَنَّ فِيهِ اجْتِمَاعَ الْخَلَائِقِ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِلْخُطْبَةِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ اجْتِمَاعَ أَهْلِ عَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَيَحْصُلُ مِنَ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَمَوْقِفِهِمْ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ مَا لَا يَحْصُلُ فِي يَوْمٍ سِوَاهُ.
الْخَامِسُ: أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ عِيدٍ لِأَهْلِ عَرَفَةَ؛ وَلِذَلِكَ كُرِهَ لِمَنْ بِعَرَفَةَ صَوْمُهُ، وَفِي النَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: («نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ»)،
وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ مهدي بن حرب العبدي لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، وَمَدَارُهُ عَلَيْهِ،
وَلَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أم الفضل ” « أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ ».
** وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ اسْتِحْبَابِ فِطْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الخرقي وَغَيْرِهِ،
** وَقَالَ غَيْرُهُمْ – مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن تيمية -: الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ عِيدٌ لِأَهْلِ عَرَفَةَ، فَلَا يُسْتَحَبُّ صَوْمُهُ لَهُمْ، قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي ” السُّنَنِ ” عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: («يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ مِنًى، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ»).
** قَالَ شَيْخُنَا: وَإِنَّمَا يَكُونُ يَوْمُ عَرَفَةَ عِيدًا فِي حَقِّ أَهْلِ عَرَفَةَ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَجْتَمِعُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَكَانَ هُوَ الْعِيدَ فِي حَقِّهِمْ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ، فَقَدِ اتَّفَقَ عِيدَانِ مَعًا.
السَّادِسُ: أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِيَوْمِ إِكْمَالِ اللَّهِ تَعَالَى دِينَهُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِتْمَامِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، كَمَا ثَبَتَ فِي ” صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ” عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: («جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ تَقْرَءُونَهَا فِي كِتَابِكُمْ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ وَنَعْلَمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] [الْمَائِدَةِ: 3]
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَنَحْنُ وَاقِفُونَ مَعَهُ بِعَرَفَةَ»).
السَّابِعُ: أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِيَوْمِ الْجَمْعِ الْأَكْبَرِ، وَالْمَوْقِفِ الْأَعْظَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
فَإِنَّ الْقِيَامَةَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»)
** وَلِهَذَا شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ يَوْمًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ، فَيَذْكُرُونَ الْمَبْدَأَ وَالْمَعَادَ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَادَّخَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ فِيهِ كَانَ الْمَبْدَأُ وَفِيهِ الْمَعَادُ، وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي فَجْرِهِ سُورَتَيِ (السَّجْدَةِ) وَ (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، مِنْ خَلْقِ آدَمَ، وَذِكْرِ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ، وَدُخُولِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَكَانَ يُذَكِّرُ الْأُمَّةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِمَا كَانَ فِيهِ وَمَا يَكُونُ، فَهَكَذَا يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ بِأَعْظَمِ مَوَاقِفِ الدُّنْيَا – وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ – الْمَوْقِفَ الْأَعْظَمَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ، وَلَا يَتَنَصَّفُ حَتَّى يَسْتَقِرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي مَنَازِلِهِمْ.
الثَّامِنُ: أَنَّ الطَّاعَةَ الْوَاقِعَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَكْثَرُ مِنْهَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ حَتَّى إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْفُجُورِ يَحْتَرِمُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهُ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ تَجَرَّأَ فِيهِ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَجَّلَ اللَّهُ عُقُوبَتَهُ وَلَمْ يُمْهِلْهُ، وَهَذَا أَمْرٌ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُمْ وَعَلِمُوهُ بِالتَّجَارِبِ، وَذَلِكَ لِعِظَمِ الْيَوْمِ وَشَرَفِهِ عِنْدَ اللَّهِ، وَاخْتِيَارِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ لِلْوَقْفَةِ فِيهِ مَزِيَّةً عَلَى غَيْرِهِ.
التَّاسِعُ: أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِيَوْمِ الْمَزِيدِ فِي الْجَنَّةِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي وَادٍ أَفْيَحَ، وَيُنْصَبُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ، فَيَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَيَتَجَلَّى لَهُمْ فَيَرَوْنَهُ عِيَانًا، وَيَكُونُ أَسْرَعُهُمْ مُوَافَاةً أَعْجَلَهُمْ رَوَاحًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ أَقْرَبَهُمْ مِنَ الْإِمَامِ، فَأَهْلُ الْجَنَّةِ مُشْتَاقُونَ إِلَى يَوْمِ الْمَزِيدِ فِيهَا لِمَا يَنَالُونَ فِيهِ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَهُوَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، فَإِذَا وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ لَهُ زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ وَاخْتِصَاصٍ وَفَضْلٍ لَيْسَ لِغَيْرِهِ.
الْعَاشِرُ: أَنَّهُ يَدْنُو الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: («مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ») وَتَحْصُلُ مَعَ دُنُوِّهِ مِنْهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةُ الْإِجَابَةِ الَّتِي لَا يَرُدُّ فِيهَا سَائِلًا يَسْأَلُ خَيْرًا فَيَقْرُبُونَ مِنْهُ بِدُعَائِهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَيَقْرُبُ مِنْهُمْ تَعَالَى نَوْعَيْنِ مِنَ الْقُرْبِ، أَحَدُهُمَا: قُرْبُ الْإِجَابَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَالثَّانِي: قُرْبُهُ الْخَاصُّ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ، وَمُبَاهَاتُهُ بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، فَتَسْتَشْعِرُ قُلُوبُ أَهْلِ الْإِيمَانِ هَذِهِ الْأُمُورَ فَتَزْدَادُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِهَا، وَفَرَحًا وَسُرُورًا وَابْتِهَاجًا، وَرَجَاءً لِفَضْلِ رَبِّهَا وَكَرَمِهِ،
** فَبِهَذِهِ الْوُجُوهِ وَغَيْرِهَا فُضِّلَتْ وَقْفَةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِهَا.
** وَأَمَّا مَا اسْتَفَاضَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ بِأَنَّهَا تَعْدِلُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَجَّةً، فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 8 / 12/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية: (80) فائدة اليوم بعنوان: ( فضائل عشر ذي الحجة )
** إن من حكمة الله الحكيم الله أنه لما خلق الخلق لم يجعلهم على حد سواء بل فاضل بينهم، فجعل بعضهم أفضل من بعض.
سلسلة الفوائد اليومية: (79) فائدة اليوم بعنوان: (لطيفة إسنادية، وهي: حديث اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة)
** قال الأمام أحمد رحمه الله في (مسنده) ط الرسالة (25/ 57):
15778 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ ” وصححه الألباني.
** وقال الحافظ المفسر ابن كثير في (تفسيره) ط / العلمية (2/ 144):
** وَقَدْ رُوِّينَا فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ حَدِيثًا فِيهِ الْبِشَارَةُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ بِأَنَّ رُوحَهُ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ تَسْرَحُ أَيْضًا فِيهَا، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَرَى مَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، وَتُشَاهِدُ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ لَهَا مِنَ الْكَرَامَةِ،
** وَهُوَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَزِيزٍ عَظِيمٍ، اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمُتَّبَعَةِ،
** فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ، رَوَاهُ عن مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْأَصْبَحِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجِرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ»
** قَوْلُهُ «يَعْلُقُ» أَيْ يَأْكُلُ،
** وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ «إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ تَكُونُ عَلَى شَكْلِ طَائِرٍ فِي الْجَنَّةِ» ** وَأَمَّا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ،
** فَهِيَ كَالْكَوَاكِبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَرْوَاحِ عُمُومِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا تَطِيرُ بِأَنْفُسِهَا،
** فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 22 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية: (78) فائدة اليوم بعنوان: (أركان الكفر أربعة، وهي: الكبر، والحسد، والغضب، والشهوة)
** قال ابن القيم في كتابه: (الفوائد)، (ص: 157):
فصل:
** أَرْكَان الْكفْر أَرْبَعَة: الْكبر والحسد وَالْغَضَب والشهوة.
** فالكبر يمنعهُ الانقياد.
** والحسد يمنعهُ قبُول النَّصِيحَة وبذلها.
** وَالْغَضَب يمنعهُ الْعدْل.
** والشهوة تَمنعهُ التفرّغ لِلْعِبَادَةِ.
** فَإِذا انْهَدم ركن الْكبر سهل عَلَيْهِ الانقياد.
** وَإِذا انْهَدم ركن الْحَسَد سهل عَلَيْهِ قبُول النصح وبذله.
** وَإِذا انْهَدم ركن الْغَضَب سهل عَلَيْهِ الْعدْل والتواضع.
** وَإِذا انْهَدم ركن الشَّهْوَة سهل عَلَيْهِ الصَّبْر والعفاف وَالْعِبَادَة.
** وَزَوَال الْجبَال عَن أماكنها أيسر من زَوَال هَذِه الْأَرْبَعَة عَمَّن بلي بهَا، وَلَا سِيمَا إِذا صَارَت هيئات راسخة وملكات وصفات ثَابِتَة؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيم لَهُ مَعهَا عمل الْبَتَّةَ، وَلَا تزكو نَفسه مَعَ قِيَامهَا بهَا، وَكلما اجْتهد فِي الْعَمَل أفسدته عَلَيْهِ هَذِه الْأَرْبَعَة.
** وكل الْآفَات مُتَوَلّدَة مِنْهَا، وَإِذا استحكمت فِي الْقلب أرته الْبَاطِل فِي صُورَة الْحق، وَالْحق فِي صُورَة الْبَاطِل، وَالْمَعْرُوف فِي صُورَة الْمُنكر، وَالْمُنكر فِي صُورَة الْمَعْرُوف، وَقربت مِنْهُ الدُّنْيَا، وبعدت مِنْهُ الْآخِرَة. ** وَإِذا تَأَمَّلت كفر الْأُمَم رَأَيْته ناشئا مِنْهَا، وَعَلَيْهَا يَقع الْعَذَاب، وَتَكون خفته وشدته بِحَسب خفتها وشدتها.
** فَمن فتحهَا على نَفسه فتح عَلَيْهِ أَبْوَاب الشرور كلهَا عَاجلا وآجلا، ** وَمن أغلقها على نَفسه أغلق عَنهُ أبوب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد وَالْإِخْلَاص وَالتَّوْبَة والإنابة وَقبُول الْحق ونصيحة الْمُسلمين والتواضع لله ولخلقه.
** ومنشأ هَذِه الْأَرْبَعَة من جَهله بربه وجهله بِنَفسِهِ؛ فَإِنَّهُ لَو عرف ربه بِصِفَات الْكَمَال ونعوت الْجلَال وَعرف نَفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر، وَلم يغْضب لَهَا، وَلم يحْسد أحدا على مَا أَتَاهُ الله؛ فَإِن الْحَسَد فِي الْحَقِيقَة نوع من معاداة الله؛ فَإِنَّهُ يكره نعْمَة الله على عَبده. وَقد أحبها الله وَأحب زَوَالهَا عَنهُ، وَالله يكره ذَلِك، فَهُوَ مضاد لله فِي قَضَائِهِ وَقدره ومحبته وكراهته؛ وَلذَلِك كَانَ إِبْلِيس عدوه حَقِيقَة؛ لِأَن ذَنبه كَانَ عَن كبر وحسد ** فَقلع هَاتين الصفتين بِمَعْرِفَة الله وتوحيده وَالرِّضَا بِهِ وَعنهُ والإنابة إِلَيْهِ.
** وَقلع الْغَضَب بِمَعْرِفَة النَّفس وَأَنَّهَا لَا تسْتَحقّ أَن يغْضب لَهَا وينتقم لَهَا؛ فَإِن ذَلِك إِيثَار لَهَا بِالرِّضَا وَالْغَضَب على خَالِقهَا وفاطرها.
** وَأعظم مَا تدفع بِهِ هَذِه الآفة أَن يعوّدها أَن تغْضب لَهُ سُبْحَانَهُ وترضى لَهُ، فَكلما دَخلهَا شَيْء من الْغَضَب وَالرِّضَا لَهُ خرج مِنْهَا مُقَابِله من الْغَضَب وَالرِّضَا لَهَا، وَكَذَا بِالْعَكْسِ.
** وَأما الشَّهْوَة فدواؤها صِحَة الْعلم والمعرفة بِأَن إعطاءها شهواتها أعظم أَسبَاب حرمانها إِيَّاهَا ومنعها مِنْهَا، وحميتها أعظم أَسبَاب اتصالها إِلَيْهَا، فَكلما فتحت عَلَيْهَا بَاب الشَّهَوَات كنت ساعيا فِي حرمانها إِيَّاهَا، وَكلما أغلقت عَنْهَا ذَلِك الْبَاب كنت ساعيا فِي إيصالها إِلَيْهَا على أكمل الْوُجُوه.
** فالغضب مثل السَّبع، إِذا أفلته صَاحبه بَدَأَ بِأَكْلِهِ.
** والشهوة مثل النَّار، إِذا أضرمها صَاحبهَا بدأت بإحراقه.
** وَالْكبر بِمَنْزِلَة مُنَازعَة الْملك ملكه، فَإِن لم يهلكك طردك عَنهُ.
** والحسد بِمَنْزِلَة معاداة من هُوَ أقدر مِنْك.
** وَالَّذِي يغلب شَهْوَته وغضبه يفرق الشَّيْطَان من ظله وَمن تغلبه شَهْوَته وغضبه يفرق من خياله. اهـ
** وقال أيضا في كتابه: (الفوائد)، (ص: 58):
أصول الخطايا كلها ثلاثة:
(1) الكبر: وهو الذي أصار ابليس الي ما أصاره.
(2) والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة
(3) والحسد: وهو الذي جرأ أحدا بني آدم علي أخيه.
** فمن وقى شر هذه الثلاثة فقد وقى الشر.
** فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 20 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية: (77) فائدة اليوم بعنوان: (((مَنْ، بفتح الميم) ترد في كلام العرب على أربعة أوجه، وقد يحتمل مثال واحد هذه الأوجه الأربعة))
** قال ابن هشام في كتابه: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)، (ص: 431):
(مَنْ) على أَرْبَعَة أوجه:
1 -شَرْطِيَّة، نَحْو: (من تكرمْ أكرمْ)، بسكون الفعلين، وقوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ}.
2 -واستفهامية، فتحتاج إِلَى جَوَاب، نَحْو: (من تكرمُ) برفع الفعل، وقوله تعالى: {مَنْ بَعَثنا منْ مَرْقَدِنَا}، {فَمن رَبكُمَا يَا مُوسَى}.
** وَإِذا قيل: (من يفعلُ هَذَا إِلَّا زيد) فَهِيَ (من) الاستفهامية، أشربت معنى النَّفْي، أي: (لا يفعلُ هَذَا إِلَّا زيد)، وَمِنْه قوله تعالى: {وَمن يغْفر الذُّنُوب إِلَّا الله}.
** وَلَا يتَقَيَّد جَوَاز ذَلِك بِأَن يتقدمها الْوَاو خلافًا لِابْنِ مَالك بِدَلِيل {من ذَا الَّذِي يشفع عِنْده إِلَّا بِإِذْنِهِ}.
3 -وموصولة، فِي نَحْو: (زارني من علمته) أي الذي علمته، وَمِنْه قوله تعالى: {ألم تَرَ أَن الله يسْجد لَهُ من فِي السَّمَاوَات وَمن فِي الأَرْض}.
4 -ونكرة مَوْصُوفَة، وَلِهَذَا دخلت عَلَيْهَا رب فِي قَوْل الشاعر:
(رُبَّ مَنْ أنضجْتُ غَيظاً قَلْبَهُ *** قَدْ تَمَنَّى لِيَ مَوْتاً لم يُطَعْ)
أي رُبَّ رجلٍ، أو شخص.
** ووصفت بالنكرة فِي نَحْو قَوْلهم: (مَرَرْتُ بمَنْ مُعْجِبٍ لك) بإِنْسَان مُعْجِبٍ لك.
((تَنْبِيه)):
** إذا قلت: (من يكرمني أكْرمه) احتملت (من) الْأَوْجه الْأَرْبَعَة:
** فَإِن قدرتها شَرْطِيَّة جزمت الْفِعْلَيْنِ.
** أَو مَوْصُولَة أَو مَوْصُوفَة رفعتهما.
** أو استفهامية رفعت الأول وجزمت الثَّانِي لِأَنَّهُ جَوَاب بِغَيْر الْفَاء.
** وَ(مَنْ) فِيهِنَّ مُبْتَدأ.
** وَخبر الاستفهامية الْجُمْلَة الأولى.
** وخبر الموصولة أَو الموصوفة الْجُمْلَة الثَّانِيَة.
** وخبر الشرطية الْجُمْلَة الأولى أَو الثَّانِيَة على خلاف فِي ذَلِك.
** وَتقول: (من زارني زرته) فَلَا تحسن الاستفهامية وَيحسن مَا عَداهَا. اهـ بتصرف وزيادة
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 20 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية: (76) فائدة اليوم بعنوان: (شر الشيطان محصور في ستة أمور)
** قال ابن القيم في كتابه: (بدائع الفوائد)، (2/ 260):
** ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها؛ إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه , ولكن ينحصر شره في ستة أجناس , لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر .
** الشر الأول:
شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه، وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى يناله منه فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه فإذا يئس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى:
** المرتبة الثانية من الشر:
وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس الدين، وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي باب الكفر والشرك، فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيا من دعاته، فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى:
** المرتبة الثالثة من الشر:
وهي الكبائر على اختلاف أنواعها فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها ولا سيما إن كان عالما متبوعا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه , ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس , ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى وهو نائب إبليس ولا يشعر ؛ فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم , هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه , كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به , وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء فإنها ظلم منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات , وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم وقصد لفضيحتهم والله سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس , فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى :
** المرتبة الرابعة:
وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم “إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض ” وذكر حديثا معناه: أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا واشتووا، ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه، فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى:
** المرتبة الخامسة:
وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها، فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى:
** المرتبة السادسة:
وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه , وقل من يتنبه لهذا من الناس فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة فإنه لا يكاد يقول : إن هذا الداعي من الشيطان ؛ فإن الشيطان لا يأمر بخير , ويرى أن هذا خير , فيقول : هذا الداعي من الله , وهو معذور , ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل , وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم , ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض , وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم , والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده .
** فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره، وليمنع الناس من الانتفاع به فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه ولا يفتر ولا يني، فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها أسر أو أصيب فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله.
** فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانك تزن به الناس وتزن به الأعمال فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق.
** والله المستعان وعليه التكلان ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الجمعة 19 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية : (75) فائدة اليوم بعنوان : (رباعيات طبية مفيدة من كلام ابن القيم رحمه الله )
** قال الإمام ابن القيم في كتابه: ( زاد المعاد )، (4/ 379):
فَصْلٌ :
** أَرْبَعَةٌ تَهْدِمُ الْبَدَنَ : الْهَمُّ، وَالْحُزْنُ، وَالْجُوعُ، وَالسَّهَرُ .
** وَأَرْبَعَةٌ تُفْرِحُ : النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ الْجَارِي، وَالْمَحْبُوبِ، وَالثِّمَارِ .
** وَأَرْبَعَةٌ تُظْلِمُ الْبَصَرَ : الْمَشْيُ حَافِيًا، وَالتَّصَبُّحُ وَالتَّمَسِّي بِوَجْهِ الْبَغِيضِ وَالثَّقِيلِ، وَالْعَدُوِّ، وَكَثْرَةُ الْبُكَاءِ، وَكَثْرَةُ النَّظَرِ فِي الْخَطِّ الدَّقِيقِ .
** وَأَرْبَعَةٌ تُقَوِّي الْجِسْمَ : لُبْسُ الثَّوْبِ النَّاعِمِ، وَدُخُولُ الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو الدسم، وَشَمُّ الرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ .
** وَأَرْبَعَةٌ تُيَبِّسُ الْوَجْهَ، وَتُذْهِبُ مَاءَهُ وَبَهْجَتَهُ وَطَلَاوَتَهُ :
الْكَذِبُ، وَالْوَقَاحَةُ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ، وَكَثْرَةُ الْفُجُورِ .
** وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَبَهْجَتِهِ : الْمُرُوءَةُ، وَالْوَفَاءُ، وَالْكَرَمُ، وَالتَّقْوَى .
** وَأَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الْبَغْضَاءَ وَالْمَقْتَ : الْكِبْرُ، وَالْحَسَدُ، والكذب، والنميمة .
** وَأَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الرِّزْقَ : قِيَامُ اللَّيْلِ، وَكَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ، وَتَعَاهُدُ الصَّدَقَةِ، وَالذِّكْرُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ .
** وَأَرْبَعَةٌ تَمْنَعُ الرِّزْقَ : نَوْمُ الصُّبْحَةِ، وَقِلَّةُ الصَّلَاةِ، وَالْكَسَلُ، وَالْخِيَانَةُ.
** وَأَرْبَعَةٌ تَضُرُّ بِالْفَهْمِ وَالذِّهْنِ : إِدْمَانُ أَكْلِ الْحَامِضِ وَالْفَوَاكِهِ، وَالنَّوْمُ عَلَى الْقَفَا، وَالْهَمُّ، وَالْغَمُّ .
** وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فِي الْفَهْمِ : فَرَاغُ الْقَلْبِ، وَقِلَّةُ التَّمَلِّي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَحُسْنُ تَدْبِيرِ الْغِذَاءِ بِالْأَشْيَاءِ الْحُلْوَةِ وَالدَّسِمَةِ، وَإِخْرَاجُ الْفَضَلَاتِ الْمُثْقِلَةِ لِلْبَدَنِ .
** وَمِمَّا يَضُرُّ بِالْعَقْلِ :إِدْمَانُ أَكْلِ الْبَصَلِ، وَالْبَاقِلَّا، وَالزَّيْتُونِ، وَالْبَاذِنْجَانِ، وَكَثْرَةُ الْجِمَاعِ، وَالْوَحْدَةُ، وَالْأَفْكَارُ، وَالسُّكْرُ، وَكَثْرَةُ الضَّحِكِ، وَالْغَمُّ .
** قَالَ بَعْضُ أَهْلِ النَّظَرِ: قُطِعْتُ فِي ثَلَاثِ مَجَالِسَ، فَلَمْ أَجِدْ لِذَلِكَ عِلَّةً إِلَّا أَنِّي أَكْثَرْتُ مِنْ أَكْلِ الْبَاذِنْجَانِ فِي أَحَدِ تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَمِنَ الزَّيْتُونِ فِي الْآخَرِ، وَمِنَ الْبَاقِلَّا فِي الثَّالِثِ . اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 17 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية : (74) فائدة اليوم بعنوان: (الْفرق بَين خشوع الْإِيمَان وخشوع النِّفَاق)
** قال ابن القيم في كتابه : ( الروح )، (ص: 232) :
فصل :
** وَالْفرق بَين خشوع الْإِيمَان وخشوع النِّفَاق :
** أَن خشوع الْإِيمَان هُوَ خشوع الْقلب لله بالتعظيم والإجلال وَالْوَقار والمهابة وَالْحيَاء فينكسر الْقلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل وَالْحب وَالْحيَاء وشهود نعم الله وجناياته هُوَ فيخشع الْقلب لَا محَالة فيتبعه خشوع الْجَوَارِح .
** وَأما خشوع النِّفَاق فيبدو على الْجَوَارِح تصنعا وتكلفا وَالْقلب غير خاشع .
** وَكَانَ بعض الصَّحَابَة يَقُول : أعوذ بِاللَّه من خشوع النِّفَاق،
قيل لَهُ : وَمَا خشوع النِّفَاق ؟ قَالَ : أَن يرى الْجَسَد خَاشِعًا وَالْقلب غير خاشع .
** فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شَهْوَته وَسكن دخانها عَن صَدره فإنجلى الصَّدْر وأشرق فِيهِ نور العظمة فَمَاتَتْ شهوات النَّفس للخوف وَالْوَقار الَّذِي حشي بِهِ وخمدت الْجَوَارِح وتوقر الْقلب وَاطْمَأَنَّ إِلَى الله وَذكره بِالسَّكِينَةِ الَّتِي نزلت عَلَيْهِ من ربه فَصَارَ مخبتا لَهُ والمخبت المطمئن .
** فَإِن الخبت من الأَرْض مَا اطْمَأَن فإستنقع فِيهِ المَاء .
** فَكَذَلِك الْقلب المخبت قد خشع وَاطْمَأَنَّ كالبقعة المطمئنة من الأَرْض الَّتِي يجْرِي إِلَيْهَا المَاء فيستقر فِيهَا،
** وعلامته : أَن يسْجد بَين يَدي ربه إجلالا وذلا وانكسارا بَين يَدَيْهِ سَجْدَة لَا يرفع رَأسه عَنْهَا حَتَّى يلقاه، فَهَذَا خشوع الْإِيمَان .
** وَأما الْقلب المتكبر فَإِنَّهُ قد اهتز بتكبره وَربا فَهُوَ كبقعة رابية من الأَرْض لَا يسْتَقرّ عَلَيْهَا المَاء .
** وَأما التماوت وخشوع النِّفَاق فَهُوَ حَال عِنْد تكلّف إسكان الْجَوَارِح تصنعا ومراءاة وَنَفسه فِي الْبَاطِن شَابة طرية ذَات شهوات وإرادات فَهُوَ يخشع فِي الظَّاهِر وحية الْوَادي وَأسد الغابة رابض بَين جَنْبَيْهِ ينْتَظر الفريسة . اهـ بتصرف
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 16 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية : (73) فائدة اليوم بعنوان: ( القصص الإسرائيلية – من حيث القبول والرد - على ثلاثة أقسام )
** قال شيخ الإسلام في كتابه: (مقدمة في أصول التفسير)، (ص: 42):
( … وَلَكِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْإِسْرَائِيلِيَّةَ تُذْكَرُ لِلِاسْتِشْهَادِ لَا لِلِاعْتِضَادِ .
** فَإِنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
** أَحَدُهَا مَا عَلِمْنَا صِحَّتَهُ مِمَّا بِأَيْدِينَا مِمَّا يَشْهَدُ لَهُ بِالصِّدْقِ فَذَاكَ صَحِيحٌ. ** وَالثَّانِي مَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ بِمَا عِنْدَنَا مِمَّا يُخَالِفُهُ .
** وَالثَّالِثُ مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ لَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَلَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، فَلَا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حِكَايَتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ،
** وَغَالِبُ ذَلِكَ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ تَعُودُ إِلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ .
** وَلِهَذَا يَخْتَلِفُ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي هَذَا كَثِيرًا .
** وَيَأْتِي عَنِ الْمُفَسِّرِينَ خِلَافٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ ،
** كَمَا يَذْكُرُونَ فِي مِثْلِ هَذَا أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْكَهْفِ ، ولون كلبهم، وعددهم،
** وَعَصَا مُوسَى مِنْ أَيِّ الشَّجَرِ كَانَتْ ،
** وَأَسْمَاءَ الطُّيُورِ الَّتِي أَحْيَاهَا اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ،
** وَتَعْيِينَ الْبَعْضِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْقَتِيلُ مِنَ الْبَقَرَةِ،
** وَنَوْعَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهَا مُوسَى،
** إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَبْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِي تَعْيِينِهِ تَعُودُ على المكلفين في دينهم ولا دنياهم .
** وَلَكِنَّ نَقْلَ الْخِلَافِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً } [الْكَهْفِ: 22]
** فَقَدِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى الْأَدَبِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَتَعْلِيمِ مَا يَنْبَغِي فِي مِثْلِ هَذَا،
** فَإِنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْهُمْ بِثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ضَعَّفَ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثِ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ بَاطِلًا لَرَدَّهُ كَمَا رَدَّهُمَا ، ثُمَّ أَرْشَدَ على أن الاطلاع عَلَى عِدَّتِهِمْ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا : { قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ } فَإِنَّهُ ما يعلم ذلك إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ،
فَلِهَذَا قَالَ : { فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً } أَيْ : لَا تُجْهِدْ نَفْسَكَ فِيمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ ، وَلَا تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا رَجْمَ الْغَيْبِ.
** فَهَذَا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ :
** أَنْ تَسْتَوْعِبَ الْأَقْوَالَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ ،
** وَأَنْ تُنَبِّهَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهَا وَتُبْطِلَ الْبَاطِلَ ،
** وَتَذْكُرَ فَائِدَةَ الْخِلَافِ وَثَمَرَتَهُ لِئَلَّا يَطُولَ الْنِزَاعُ وَالْخِلَافُ فِيمَا لَا فَائِدَةَ تَحْتَهُ، فَتَشْتَغِلُ بِهِ عَنِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ .
** فَأَمَّا مَنْ حَكَى خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقْوَالَ النَّاسِ فِيهَا فَهُوَ نَاقِصٌ إِذْ قَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ فِي الَّذِي تَرَكَهُ،
** أَوْ يَحْكِي الْخِلَافَ وَيُطْلِقُهُ وَلَا يُنَبِّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْأَقْوَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ أَيْضًا،
** فَإِنْ صَحَّحَ غَيْرَ الصَّحِيحِ عَامِدًا فَقَدْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ، أَوْ جَاهِلًا فَقَدْ أَخْطَأَ، ** وَكَذَلِكَ مَنْ نَصَبَ الْخِلَافَ فِيمَا لَا فَائِدَةَ تَحْتَهُ .
** أَوْ حَكَى أَقْوَالًا مُتَعَدِّدَةً لَفْظًا وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى قَوْلٍ أَوْ قَوْلَيْنِ مَعْنًى فَقَدْ ضَيَّعَ الزَّمَانَ وَتَكَثَّرَ بِمَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَهُوَ كَلَابِسِ ثوبي زور،
والله الموفق للصواب . اهـ
** وذكر هذه الفائدة بنصها الحافظ المفسر ابن كثير في (تفسيره)، ط. العلمية( 1 / 10)، ولكنه لم يعزها إلى شيخ الإسلام.
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 15 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية : (72) فائدة اليوم بعنوان : ( أحسن الطرق في تفسير القران )
** إن أحسن طرق تفسير القران الكريم هي :
( 1 ) تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر .
( 2) تفسير القرآن بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له .
( 3 ) تفسير القرآن بأقوال الصحابة – رضي الله عنهم – فإنهم أدرى بذلك حيث إنهم حضروا التنزيل وشاهدوا من القرائن والأحوال ما لم يعلمه غيرهم .
( 4) تفسير القرآن بأقوال التابعين الذين تعلموا على الصحابة وأخذوا عنهم .
( 5) تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة العربية .
** قال شيخ الإسلام في كتابه: (مقدمة في أصول التفسير)، (ص: 39):
** فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا أَحْسَنُ طُرُقِ التَّفْسِيرِ ؟
** فَالْجَوَابُ : إِنَّ أَصَحَّ الطُّرُقِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُفَسَّرَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ ، فَمَا أجمل في مكان فإنه قد بسط فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .
** فَإِنْ أَعْيَاكَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ ؛ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمُوَضِّحَةٌ لَهُ،
** بَلْ قَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى : كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مِمَّا فَهِمَهُ مِنَ الْقُرْآنِ .
** قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً } [النِّسَاءِ: 105] ،
** وَقَالَ تَعَالَى : { وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [النحل: 64]
** وَقَالَ تَعَالَى: { وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [النَّحْلِ: 44]
** وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » يَعْنِي السُّنَّةَ .
** وَالسُّنَّةُ أَيْضًا تَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ كَمَا يَنْزِلُ الْقُرْآنُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تُتْلَى كَمَا يُتْلَى الْقُرْآنُ .
** وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ الشافعي رحمه الله تعالى وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذَلِكَ ، …
** وَحِينَئِذٍ إِذَا لَمْ نَجِدِ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ رَجَعْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ ؛ فَإِنَّهُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ :
** لِمَا شَاهَدُوا مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي اخْتُصُّوا بِهَا،
** وَلِمَا لَهُمْ مِنَ الْفَهْمِ التَّامِّ وَالْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ،
** لَا سِيَّمَا عُلَمَاؤُهُمْ وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الرَّاشِدِينَ، وَالْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
** قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ نَزَلَتْ، وَأَيْنَ نَزَلَتْ .
** وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ .
** وَقَالَ الْأَعْمَشُ أَيْضًا عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ .
** وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَقْرِئُونَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يَخْلُفُوهَا حَتَّى يَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا .
** وَمِنْهُمُ الْحَبْرُ الْبَحْرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وترجمان القرآن ببركة دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حَيْثُ قَالَ: « اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»
** وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وحدثنا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ: نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ .
** ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ التُّرْجُمَانُ لِلْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ .
** ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ بُنْدَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بن عون عن الأعمش به كَذَلِكَ .
** فَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذِهِ الْعِبَارَةَ .
** وَقَدْ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ عَلَى الصَّحِيحِ وَعُمِّرَ بعده عبد الله بن عَبَّاسٍ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً، فَمَا ظَنُّكَ بِمَا كَسَبَهُ مِنَ الْعُلُومِ بَعْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ.
** وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ : اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَلَى الْمَوْسِمِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَرَأَ فِي خُطْبَتِهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ سُورَةَ النُّورِ فَفَسَّرَهَا تَفْسِيرًا لَوْ سَمِعَتْهُ الرُّومُ وَالتُّرْكُ وَالدَّيْلَمُ لَأَسْلَمُوا .
….
** [فَصْلٌ] إِذَا لَمْ تَجِدِ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ وَلَا وَجَدْتَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ التَّابِعِينَ :
** كَمُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ آيَةً فِي التَّفْسِيرِ كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا.
** وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ عُثْمَانَ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمَعَهُ أَلْوَاحُهُ قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: اكْتُبْ، حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ التَّفْسِيرِ كُلِّهِ.
** وَلِهَذَا كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِهِ،
** وَكَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ،
** فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تَبَايُنٌ فِي الْأَلْفَاظِ يَحْسَبُهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ اخْتِلَافًا فَيَحْكِيهَا أَقْوَالًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ أَوْ بِنَظِيرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنُصُّ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، والكل بمعنى واحد في أكثر الْأَمَاكِنِ فَلْيَتَفَطَّنِ اللَّبِيبُ لِذَلِكَ وَاللَّهُ الْهَادِي .
اهـ باختصار
** وذكر هذه الفائدة بنصها الحافظ ابن كثير في (تفسيره)، ط. العلمية( 1 / 8)، ولكنه لم يعزها إلى شيخ الإسلام.
** ذكر بعض الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبالآثار، وباللغة العربية .
** قال العلامة ابن عثيمين في كتابه : ( أصول في التفسير )، (ص: 25) :
( المرجع في تفسير القرآن )
** يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي :
أ- كلام الله تعالى: فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله، وهو أعلم بما أراد به.
** ولذلك أمثلة منها :
(1)- قوله تعالى: { أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } (يونس: 62)
** فقد فسر { أولياء الله } بقوله في الآية التي تليها: { الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ } (يونس: 63)
(2)- قوله تعالى: { وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ } (الطارق: 2)
** فقد فسر { الطارق } بقوله في الآية الثانية: { النَّجْمُ الثَّاقِبُ }
(الطارق: 3) .
(3)- قوله تعالى: { وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا } (النازعات: 30)
** فقد فسر { دحاها } بقوله في الآيتين بعدها: { أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا } (النازعات: 31) { وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا } (النازعات: 32) .
ب – كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى كلامه.
** ولذلك أمثلة منها:
(1)- قوله تعالى : { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } (يونس: الآية 26) ** ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى،
** فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب .
** ورواه جرير من حديث كعب بن عجرة في ” صحيح مسلم ”
عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه :
” فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل “، ثم تلا هذه الآية { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } (يونس: 26)
(2)- قوله تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } (لأنفال: الآية 60)
** فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي. رواه مسلم ، وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه .
ج- كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب .
** ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها:
(1)- قوله تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ } (النساء: الآية 43)
** فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه فسر الملامسة بالجماع .
د- كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم .
ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم.
** قال شيخ الإسلام ابن تيميه: إذا أجمعوا – يعني التابعين – على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو ألسنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك.
** وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤة، ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم، فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا .
هـ – ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ } ، (النساء: الآية 105)
** وقوله: { إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (الزخرف: 3)
** وقوله: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ }
(إبراهيم: الآية 4) .
** فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع، لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به .
** مثال ما اختلف فيه المعنيان، وقدم الشرعي :
** قوله تعالى في المنافقين: { وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً } (التوبة: الآية 84)
** فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب،
** وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر .
** ومثال ما اختلف فيه المعنيان، وقدم فيه اللغوي بالدليل:
** قوله تعالى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } (التوبة: الآية 103)
** فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم، صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: ” اللهم صل على آل أبي أوفي “.
** وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة : كالسماء والأرض ، والصدق ، والكذب ، والحجر ، والإنسان . اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 14 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية : (71) فائدة اليوم بعنوان : ( سوء الْخُلُقِ يَقُومُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ )
** قال ابن القيم في كتابه : ( مدارج السالكين )، (2/ 295) :
** وَمَنْشَأُ جَمِيعِ الْأَخْلَاقِ السَّافِلَةِ، وَبِنَاؤُهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ :
** الْجَهْلُ، وَالظُّلْمُ، وَالشَّهْوَةُ، وَالْغَضَبُ .
** فَالْجَهْلُ : يُرِيهِ الْحَسَنَ فِي صُورَةِ الْقَبِيحِ، وَالْقَبِيحَ فِي صُورَةِ الْحَسَنِ. وَالْكَمَالَ نَقْصًا وَالنَّقْصَ كَمَالًا.
** وَالظُّلْمُ : يَحْمِلُهُ عَلَى وَضْعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ .
* فَيَغْضَبُ فِي مَوْضِعِ الرِّضَا، وَيَرْضَى فِي مَوْضِعِ الْغَضَبِ .
* وَيَجْهَلُ فِي مَوْضِعِ الْأَنَاةِ، وَيَبْخَلُ فِي مَوْضِعِ الْبَذْلِ .
* وَيَبْذُلُ فِي مَوْضِعِ الْبُخْلِ، وَيُحْجِمُ فِي مَوْضِعِ الْإِقْدَامِ .
* وَيُقْدِمُ فِي مَوْضِعِ الْإِحْجَامِ، وَيَلِينُ فِي مَوْضِعِ الشِّدَّةِ .
* وَيَشْتَدُّ فِي مَوْضِعِ اللِّينِ، وَيَتَوَاضَعُ فِي مَوْضِعِ الْعِزَّةِ .
* وَيَتَكَبَّرُ فِي مَوْضِعِ التَّوَاضُعِ .
** وَالشَّهْوَةُ : تَحْمِلُهُ عَلَى الْحِرْصِ وَالشُّحِّ وَالْبُخْلِ، وَعَدَمِ الْعِفَّةِ وَالنَّهْمَةِ وَالْجَشَعِ، وَالذُّلِّ وَالدَّنَاءَاتِ كُلِّهَا .
** وَالْغَضَبُ : يَحْمِلُهُ عَلَى الْكِبْرِ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ، وَالْعُدْوَانِ وَالسَّفَهِ.
** وَيَتَرَكَّبُ مِنْ بَيْنِ كُلِّ خُلُقَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ : أَخْلَاقٌ مَذْمُومَةٌ .
** وَمِلَاكُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَصْلَانِ :
** إِفْرَاطُ النَّفْسِ فِي الضَّعْفِ، وَإِفْرَاطُهَا فِي الْقُوَّةِ.
** فَيَتَوَلَّدُ مِنْ إِفْرَاطِهَا فِي الضَّعْفِ : الْمَهَانَةُ وَالْبُخْلُ، وَالْخِسَّةُ وَاللُّؤْمُ، وَالذُّلُّ وَالْحِرْصُ، وَالشُّحُّ وَسَفْسَافُ الْأُمُورِ وَالْأَخْلَاقِ.
** وَيَتَوَلَّدُ مِنْ إِفْرَاطِهَا فِي الْقُوَّةِ : الظُّلْمُ وَالْغَضَبُ وَالْحِدَّةُ، وَالْفُحْشُ وَالطَّيْشُ. اهـ المراد، ويقرأ بقية كلامه الممتع والمفيد .
والله الموفق .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
السبت 13 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية :(70) فائدة اليوم بعنوان : ( حُسْنُ الْخُلُقِ يَقُومُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ )
** قال ابن القيم في كتابه : ( مدارج السالكين )،(2/ 294) :
فَصْلٌ
** الدِّينُ كُلُّهُ خُلُقٌ . فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ …
** وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ بَذْلُ النَّدَى، وَكَفُّ الْأَذَى، وَاحْتِمَالُ الْأَذَى.
** وَقِيلَ: حُسْنُ الْخُلُقِ: بَذْلُ الْجَمِيلِ، وَكَفُّ الْقَبِيحِ.
** وَقِيلَ: التَّخَلِّي مِنَ الرَّذَائِلِ، وَالتَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ .
** وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَقُومُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ لَا يُتَصَوَّرُ قِيَامُ سَاقِهِ إِلَّا عَلَيْهَا: الصَّبْرُ، وَالْعِفَّةُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالْعَدْلُ .
** فَالصَّبْرُ: يَحْمِلُهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَكَفِّ الْأَذَى، وَالْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ، وَعَدَمِ الطَّيْشِ وَالْعَجَلَةِ.
** وَالْعِفَّةُ: تَحْمِلُهُ عَلَى اجْتِنَابِ الرَّذَائِلِ وَالْقَبَائِحِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ،
** وَتَحْمِلُهُ عَلَى الْحَيَاءِ، وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ.
** وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْفَحْشَاءِ، وَالْبُخْلِ وَالْكَذِبِ، وَالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ.
** وَالشَّجَاعَةُ: تَحْمِلُهُ عَلَى عِزَّةِ النَّفْسِ، وَإِيثَارِ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ، وَعَلَى الْبَذْلِ وَالنَّدَى، الَّذِي هُوَ شَجَاعَةُ النَّفْسِ وَقُوَّتُهَا عَلَى إِخْرَاجِ الْمَحْبُوبِ وَمُفَارَقَتِهِ.
** وَتَحْمِلُهُ عَلَى كَظْمِ الْغَيْظِ وَالْحِلْمِ ؛ فَإِنَّهُ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ وَشَجَاعَتِهَا يُمْسِكُ عِنَانَهَا، وَيَكْبَحُهَا بِلِجَامِهَا عَنِ النَّزْغِ وَالْبَطْشِ. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ: الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » وَهُوَ حَقِيقَةُ الشَّجَاعَةِ، وَهِيَ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا الْعَبْدُ عَلَى قَهْرِ خَصْمِهِ.
** وَالْعَدْلُ: يَحْمِلُهُ عَلَى اعْتِدَالِ أَخْلَاقِهِ، وَتَوَسُّطِهِ فِيهَا بَيْنَ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ.
** فَيَحْمِلُهُ عَلَى خُلُقِ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ الَّذِي هُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ الذُّلِّ وَالْقِحَةِ.
** وَعَلَى خُلُقِ الشَّجَاعَةِ، الَّذِي هُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ الْجُبْنِ وَالتَّهَوُّرِ .
** وَعَلَى خُلُقِ الْحِلْمِ، الَّذِي هُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ الْغَضَبِ وَالْمَهَانَةِ وَسُقُوطِ النَّفْسِ.
وَمَنْشَأُ جَمِيعِ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ . اهـ المراد
والله الموفق .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الجمعة 12 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية : (69) فائدة اليوم بعنوان : ( معرفة سند علم النحو ، وطبقات النحويين )
** قال الأزهري في كتابه : ( شرح التصريح على التوضيح )، (1/ 5):
** وقد تضافرت الروايات على أن أول من وضع النحو أبو الأسود،
** وأنه أخذه أولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
** وكان أبو الأسود كوفي الدار، بصري المنشأ، ومات وقد أسن،
** واتفقوا على أن أول من وضع التصريف معاذ بن مسلم الهراء؛ بفتح الهاء وتشديد الراء، نسبة إلى بيع الثياب الهروية؛
** وكان تخرج بأبي الأسود؛ وأدب عبد الملك بن مروان،
** ثم خلف أبا الأسود خمسة نفر؛
** أولهم : عنبسة الفيل، كان اسم أبيه معدان، قتل فيلا لعبد الله بن عامر بن كريز فسمي معدان الفيل ؛ وسمي ابنه عنبسة الفيل.
** وثانيهم : ميمون الأقرن،
** وثالثهم يحيى بن يعمر العدواني،
** والرابع والخامس : ولدا أبي الأسود عطاء وأبو الحارث،
** ثم خلف هؤلاء عبد الله بن [أبي] إسحاق الحضرمي؛
** وعيسى بن عمر الثقفي؛
** وأبو عمرو بن العلاء؛
** ثم خلفهم الخليل بن أحمد الفراهيدي؛
** ثم سيبويه؛ والكسائي،
** ثم صار الناس بعد ذلك فريقين، كوفيا وبصريا،
** ثم خلف سيبويه أبو الحسن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة،
وخلف الكسائي الفراء.
** ثم جاء بعد ذلك صالح بن إسحاق الجرمي، وبكر بن عثمان المازني،
** ثم جاء بعدهما محمد بن يزيد المبرد،
** وجاء بعده أبو إسحاق الزجاج؛ وأبو بكر بن السراج؛ وابن درستويه؛ وأبو بكر محمد بن مبرمان،
** ثم جاء بعد هؤلاء أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي؛ وأبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ؛ وعلي بن عيسى الرماني؛
** ثم أبو الفتح بن جني؛
** ثم الشيخ عبد القاهر الجرجاني ؛
** ثم الزمخشري؛
** ثم ابن الحاجب؛
** ثم ابن مالك؛
** ثم ابن هشام . اهـ بزيادة ما بين المعكوفين
والله الموفق .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الخميس 11 / 11/ 1438 هـ
(68) سلسة الفوائد اليومية: فائدة اليوم بعنوان: ( معرفة الخصال الطيبة في الديك التي لا يوجد بعضها عند كثير من العقلاء )
** عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ »
** رواه أبو داود وغيره ، [وصححه الألباني]
** وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : أنَّ ديكاً صرخَ عند رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فسبَّهُ رجلٌ ،
” فنهى عن سبِّ الدِّيكِ “. رواه البزار بإسناد لا بأس به، والطبراني؛ إلا أنه قال فيه : ” لا تَلْعَنْه ، ولا تسبّه ؛ فإنه يدعو إلى الصلاة “.
** وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/ 62): [صحيح لغيره]
** وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (4/ 128) :
3303 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا »
** وفي هذا الحديث لطيفة إسنادية ، وهي :
** أن هذا الحديث أخرجه أيضا بهذا الإسناد:
** الإمام مسلم برقم : (2729)
** والإمام النسائي ( في الكبرى ) برقم : ( 10714 )
** والإمام أبو داود برقم : ( 5102 )
** والإمام الترمذي برقم : ( 3459 )
** وفي كتاب : ( فتح الباري ) ، لابن حجر (6/ 352) :
** قَوْلُهُ : ( عَنْ جَعْفَرَ بْنِ رَبِيعَةَ ) هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ
الْخَمْسَةُ أَصْحَابُ الْأُصُولِ عَلَى إِخْرَاجِهِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قُتَيْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
** قَوْلُهُ : ( إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ ، جَمْعُ دِيكٍ ، وَهُوَ ذَكَرُ الدَّجَاجِ .
** وَلِلدِّيكِ خَصِيصَةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ اللَّيْلِيِّ ؛ فَإِنَّهُ يُقَسِّطُ أَصْوَاتَهُ فِيهَا تَقْسِيطًا لَا يَكَادُ يَتَفَاوَتُ ، وَيُوَالِي صِيَاحَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَهُ لَا يَكَادُ يُخْطِئُ ، سَوَاءٌ أَطَالَ اللَّيْلُ أَمْ قَصُرَ .
** وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِاعْتِمَادِ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ فِي الْوَقْتِ .
** وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي سَأَذْكُرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، …
** قَالَ الدَّاوُدِيُّ : يُتَعَلَّمُ مِنَ الدِّيكِ خَمْسُ خِصَالٍ :
حُسْنُ الصَّوْتِ ، وَالْقِيَامُ فِي السَّحَرِ ، وَالْغَيْرَةُ ، وَالسَّخَاءُ ، وَكَثْرَةُ الْجِمَاعِ . اهـ
** وفي كتاب : ( تحفة العروس ، أو الزواج الإسلامي السعيد ) ، لمحمود مهدي الاستانبولي ، ( صـ 461) :
( دجاجة تتغزل بزوجها وتثني عليه )
(1) لقد شغفني زوجي حبا ، وتملك كل جارحة من جوارحي، ولو كان لي أن أقتطع من لحمي شطرا وأطعمه إياه لفعلت ، ولو كان لي أن أكسوه أجمل ثيابي لما ترددت .
(2) ولم لا أفعل كل ذلك ؟ إنه لمثال المروءة والكرم والحنو ،
** إن وقع على حبة سمينة دعانا إليها .
** وإن سقط على شربة ماء توقف واستقدمنا لنبدأ بالشرب قبله .
** وإن سمع صوتا مفزعا انتفخت أوداجه ، وتصلبت أعصابه ، وثار الدم في وجهه ، واستعد للقاء المكروه بنفسه ، ولو جاء المكروه من أكبر مخلوق وأقسى معتد لكان موقفه موقف المدافع الذاب عن حماه !
** فليت شعري أي مخلوق يقف منا هذا الموقف النبيل .
(3) وجماله فتنة لا مثيل لها ، وصورته سحر لا يشبهه شيء ،
** أود أحيانا أن ينقلب جسمي كله عينا واسعة الحدقة لتستمتع بجماله ،
** ولتغترف من حسنه ما شاء أن تفعل ،
** وكم أود أن ينقلب جسمي كله أذنا واسعة مرهفة لتتلقف صوته الجميل ، ولتستمتع إلى أناشيده الرائعة وغنائه العذب .
(4) أما ذلك العرف القرمزي اللين الذي يتدلى من مفرقه ، فقطعة فنية من صنع خالق عظيم قادر ،
** وأما ذلك العنق الطويل الوسيم الذي يشبه غصن المنثور وقت ازدهاره ،
** وأما ذلك الفم الجميل الدقيق الذي أودعه الله أعذب لسان ،
** وأما ذانك الجناحان الملونان بأجمل الألوان ،
** وأما تلك الساقان الدقيقتان ، وتلك الأصابع الزمردية ،
** وتلك الأظافر العاجية ، وتلك المشية المتهادية ،
** فصنع خالق جميل أحب الجمال فطبع خلقه بطابعه ، فجاؤوا أجمل مخلوقات من صنع أجمل خالق .
(5) ما أبهج صباحنا حين يخرج زوجنا من مخدعه ،
** ويمشي مشية المدل بجماله !
** ويصعد في أعلى مكان ،
** ويفتن في الإنشاد والشدو في صوت هو السحر الحلال !
** إنا لنخرج في الصباح ، ونقف ذاهلات من فرط ما نشعر به من روعة ونشوة ،
** وكم نتمنى أن يقف الزمان في تلك اللحظة ليستمر ذلك الصوت في نغماته . اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 10 / 11/ 1438 هـ
سلسلة الفوائد اليومية: (67) فائدة اليوم بعنوان : ( لطيفة إسنادية وهي : اتفاق الأئمة الخمسة على إخراج حديث بسند واحد )
** قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (4/ 128) :
3303 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :
« إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا »
** وأخرجه بهذا الإسناد أيضا :
** الإمام مسلم برقم : (2729)
** والإمام النسائي ( في الكبرى ) برقم : ( 10714 )
** والإمام أبو داود برقم : ( 5102 )
** والإمام الترمذي برقم : ( 3459 )
** وفي كتاب : ( فتح الباري ) ، لابن حجر (6/ 352) :
** قَوْلُهُ : ( عَنْ جَعْفَرَ بْنِ رَبِيعَةَ ) هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ
الْخَمْسَةُ أَصْحَابُ الْأُصُولِ عَلَى إِخْرَاجِهِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قُتَيْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 9 / 11/ 1438 هـ
(66) فائدة اليوم بعنوان : ( الحقوق الزوجية / الحلقة الثانية / حقوق الزوج )
** قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }
** و قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ }
** وفي : ( تفسير ابن كثير ) ، ط العلمية (1/ 459):
** وَقَوْلُهُ : { وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أَيْ فِي الْفَضِيلَةِ فِي الْخُلُقِ والخلق وَالْمَنْزِلَةِ وَطَاعَةِ الْأَمْرِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْقِيَامِ بِالْمَصَالِحٍ وَالْفَضْلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:{ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ } [النِّسَاءِ: 34] .
** وَقَوْلُهُ : { وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }أَيْ عَزِيزٌ فِي انْتِقَامِهِ مِمَّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ، حَكِيمٌ فِي أمره وشرعه وقدره .
** وقال أيضا في (2/ 256) :
يَقُولُ تَعَالَى: { الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ } أَيِ : الرَّجُلُ قَيِّمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَيْ : هُوَ رَئِيسُهَا ،وَكَبِيرُهَا،وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا ،وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعْوَجَّتْ،
{ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ } أَيْ : لِأَنَّ الرِّجَالَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ، ، وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَلِهَذَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ مُخْتَصَّةٌ بِالرِّجَالِ، وَكَذَلِكَ الْمُلْكُ الْأَعْظَمُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَكَذَا مَنْصِبُ الْقَضَاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ.
{ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ }أَيْ : مِنَ الْمُهُورِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْكُلَفِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَهُنَّ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهِ، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهَا وَالْإِفْضَالُ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ قَيِّمًا عَلَيْهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } [الْبَقَرَةِ: 228] ، . . . الخ كلامه ، رحمه الله . اهـ
** عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطِيعِي أَبَاكِ ،
فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، أوِ انْتَثَر مِنْخَراهُ صَديداً أوْ دَماً ثمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أدَّتْ حَقَّهُ )
قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُنْكِحوهُنَّ إلاَّ بإذْنِهِنَّ )
رواه ابن حبان وغيره ، وقال الشيخ الألباني [حسن صحيح]
وعن معاذ رضي الله عنه قال:، قال النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – :
” لوْ أَمْرتُ أحَداً أنْ يسجُدَ لأحَدٍ؛ لأمْرتُ المرأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها؛ مِنْ عِظَمِ حقِّه عَليْها، ولا تَجدُ امْرأَةٌ حلاوةَ الإيمان؛ حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زوْجِها، ولو سَألها نَفْسَها وهيَ على ظَهْرِ قَتَبٍ ” . رواه الحاكم وغيره ، وقال الشيخ الألباني [حسن صحيح]
** وفي كتاب : ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ، (4/ 11) :
** ( القَتَب ) للجَمل كالإِكاف لِغَيْرِهِ .
** وَمَعْنَاهُ الحثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطاوعة أزواجِهن، وَأَنَّهُ لَا يَسعُهُنّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا . اهـ
** والإكاف، ويقال: الوكاف: برذعة الحمار، وهي كالسرج للفرس.
** وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» رواه الطبراني في المعجم الكبير ، وصححه الألباني .
** وحقوق الزوج على زوجته كثيرة نذكر منها ما تيسر .
** (( الحق الأول )) :
** أن تطيعه إذا أمر .
** عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهَا قَالَ: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا أَعْجَزُ عَنْهُ قَالَ: «انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ »
رواه النسائي في السنن الكبرى (8/ 184) ، وصححه الألباني .
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ: « الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ » رواه النسائي في السنن الكبرى (5/ 161)، وقال الشيخ الألباني [حسن صحيح]
** وفي كتاب : ( الفتاوى الكبرى ) لشيخ الإسلام ابن تيمية (3/ 145):
وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْجَبَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ . اهـ المراد
** وطاعة المرأة زوجها من موجبات دخول الجنة .
** عن عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “إذا صلَّتِ المرَأةُ خَمْسَها، وصامَتْ شَهْرَها، وحَفِظَتْ فرْجَها، وأطاعَتْ زَوْجَها، قيلَ لها: ادْخُلي الجنَّةَ مِنْ أي أَبوابِ الجنَّةِ شِئْتِ”. رواه أحمد وغيره ، وقال الشيخ الألباني [حسن لغيره]
** وطاعة المرأة زوجها مشروطة بكونها في غير معصية الله ،
** فإن أمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع له ولا طاعة :
كأن يأمرها بترك الصلاة ، أو الفطر في رمضان ، أو خلع الحجاب ، أو مصافحة إخوانه ، أو يطلب منها جماعها في دبرها ، أو في أثناء حيضتها ، أو غير ذلك من المعاصي .
** عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » متفق عليه
** وقد بوب البخاري في صحيحه من كتاب النكاح (7/ 32) فقال :
بَابُ لاَ تُطِيعُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ .
** وساق بسنده إلى عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا،
فَقَالَ: « لاَ ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلاَتُ »
وأخرجه مسلم أيضا .
** ((الحق الثاني )) :
** أن تجيبه إذا دعاها إلى فراشه إذا لم يوجد مانع من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية .
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » رواه مسلم
** وعَنْه أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا » متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم .
** وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “اثْنانِ لا تُجاوِزُ صلاتُهما رُؤوسَهما: عبدٌ أبَق مِنْ مَواليه حتى يرجعَ، وامْرأَةٌ عَصَتْ زوْجَها حتى تَرْجعَ”.
رواه الطبراني وغيره ، وصححه الألباني .
** والمراد باللعن هنا : الدعاء عليها بالطرد من رحمة الله ،
فأي أمرأة عاقلة ترضى لنفسها أن تدعو عليها الْمَلَائِكَة بالطرد من رحمة الله ، ومن هذه التي تتحمل ذلك ؟!
** وفي كتاب 🙁 المفهم) ، للقرطبي (13/ 24):
** وقوله : (( ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها ، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها )) ؛
** دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها . ولا خلاف فيه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : {وللرجال عليهن درجة } ،
** والمرأة في ذلك بخلاف الرَّجل ، فلو دعت المرأة زوجها إلى ذلك لم يجب عليه إجابتها ، إلاَّ أن يقصد بالامتناع مضارَّتها ، فيحرم ذلك عليه.
** والفرق بينهما : أن الرَّجل هو الذي ابتغى بماله ، فهو المالك للبضع . والدرجة التي له عليها هي السلطنة التي له بسبب ملكه .
** وأيضًا : فقد لا ينشطُ الرَّجل في وقت تَدْعُوه ، فلا ينتشر، ولا يتهيأ له ذلك ، بخلاف المرأة .
** وقوله : (( الذي في السماء )) ؛
ظاهره : أن المراد به : الله تعالى ؛ ويكون معناه كمعنى قوله تعالى :
{ أأمنتم من في السماء } ، وقد تكلمنا عليه في كتاب الصلاة .
** ويحتمل أن يراد به هنا : الملائكة . كما قد جاء في الرواية الأخرى : (( إلا لعنتها الملائكة حتى تُصْبح )).اهـ
** وفي كتاب : ( سبل السلام ) للصنعاني (2/ 210):
إخْبَارٍ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إجَابَةُ زَوْجِهَا أَيْ إذَا دَعَاهَا لِلْجِمَاعِ لِأَنَّ قَوْلَهُ إلَى فِرَاشِهِ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ كَمَا فِي قَوْلِهِ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» ،
** وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ لَعْنُ الْمَلَائِكَةِ لَهَا إذْ لَا يَلْعَنُونَ إلَّا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَلَا يَكُونُ إلَّا عُقُوبَةً، وَلَا عُقُوبَةَ إلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ . اهـ المراد
** ولماذا استحقت المرأة هذا الوعيد الشديد ؟
** لأنها بامتناعها قد تضطر الزوج إلى البحث عن الحرام – عياذا بالله –
** ؛ فإن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة ؛
** ولأنها قد تتسبب بهذا الامتناع إلى هدم بناء الأسرة .
** ((الحق الثالث )) :
** أن تشكره ولا تكفره .
** عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكَرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ » رواه النسائي في السنن الكبرى (8/ 239) ، [وصححه الألباني]
** فدل هذا الحديث على وجوب شكر المرأة لزوجها المحسن إليها ، خاصة إذا كان قائما بأمورها التي لا تستغني عنها .
** ولا يقصد بالشكر هنا مجرد شكر اللسان فقط ، ثم تؤذيه بمساوئ أخلاقها وأفعالها ، بل يقصد به قيامها بحقه على أتم الوجوه وأكملها .
** فالحذر الحذر من كفران العشير ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك غاية التحذير ، وأخبر أن كفران العشير وكفران الإحسان سبب من أسباب دخول النار .
** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: ” يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ” متفق عليه
** ((الحق الرابع )) :
** أن تقر في البيت ، فلا تخرج إلا بإذنه .
** قال الله تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى }
** وفي ( تفسير ابن كثير ) ، ت سلامة (6/ 409):
** وَقَوْلُهُ: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أَيِ: الْزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ فَلَا تَخْرُجْنَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
** وَمِنِ الْحَوَائِجِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ بِشَرْطِهِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلات” وَفِي رِوَايَةٍ: “وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ” اهـ المراد
** وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ: أَقْرَبَ مِنْهَا في قعر بيتها)) .
رواه ابن حبان (8/ 156) [وصححه الألباني]
** وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَمْنَعْهَا “
** وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» رواه أبو داود (1/ 156) ، [وصححه الألباني]
** (والمِخْدع) بكسر الميم وضَمِّها وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة: هو الخزانة تكون في البيت. انظر (مختار الصحاح )،(ص: 88)
** (( الحق الخامس )) :
** لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه .
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « . . . وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، . . . ) متفق عليه
** وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : . . . وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، . . . ) رواه مسلم
** وفي ( فتح الباري لابن حجر ) ، (9/ 296):
** وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَفْتَاتُ عَلَى الزَّوْجِ بِالْإِذْنِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَهُوَ مَحْمُول على مَا لَا يُعلم رِضَا الزَّوْجِ بِهِ ،
** أَمَّا لَوْ عَلِمَتْ رِضَا الزَّوْجِ بِذَلِكَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا كَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِإِدْخَالِ الضِّيفَانِ مَوْضِعًا مُعَدًّا لَهُمْ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَمْ غَائِبًا فَلَا يَفْتَقِرْ إِدْخَالُهُمْ إِلَى إِذْنٍ خَاصٍّ لِذَلِكَ ،
** وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ إِذْنِهِ تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا
قَوْلُهُ ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) أَيِ الصَّرِيحِ ،
** وَهَلْ يَقُومُ مَا يَقْتَرِنُ بِهِ عَلَامَةُ رِضَاهُ مَقَامَ التَّصْرِيحِ بِالرِّضَا فِيهِ نَظَرٌ .
اهـ
** (( الحق السادس )) :
** لا تصوم النافلة – وزوجها حاضر – إلا بإذنه .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، . . . » متفق عليه
** وفي ( شرح النووي على مسلم ) ، (7/ 115):
** وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ )
** هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَالْمَنْدُوبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَنٌ مُعَيَّنٌ .
** وَهَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا .
** وَسَبَبُهُ أَنَّ الزَّوْجَ لَهُ حَقُّ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي كُلِّ الْأَيَّامِ ،
وَحَقُّهُ فِيهِ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَفُوتُهُ بِتَطَوُّعٍ وَلَا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي .
** فَإِنْ قِيلَ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهَا الصَّوْمُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيُفْسِدُ صَوْمُهَا .
** فَالْجَوَابُ ” أَنَّ صَوْمَهَا يَمْنَعُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْعَادَةِ لِأَنَّهُ يَهَابُ انْتَهَاكَ الصَّوْمِ بِالْإِفْسَادِ
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ) أَيْ مُقِيمٌ فِي الْبَلَدِ ،
** أَمَّا إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فَلَهَا الصَّوْمُ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الِاسْتِمْتَاعُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ . اهـ
** وفي ( سبل السلام ) ، (1/ 585):
** فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِحَقِّ الزَّوْجِ أقدم مِنْ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ ** وَأَمَّا رَمَضَانُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْها وَإِنْ كَرِهَ الزَّوْجُ ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَلَوْ صَامَتْ النَّفَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَتْ فَاعِلَةً لِمُحَرَّمٍ .اهـ
** (( الحق السابع )) :
** لا تنفق من ماله إلا بإذنه .
** عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ الطَّعَامُ، قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا. رواه أحمد وغيره [وصححه الألباني]
** وفي ( تحفة الأحوذي ) ، (3/ 276):
قَوْلُهُ (لَا تُنْفِقُ) نَفْيٌ ، وَقِيلَ نَهْيٌ (إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) أَيْ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً .
(قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا) يَعْنِي فَإِذَا لَمْ تَجُزِ الصَّدَقَةُ بِمَا هُوَ أَقَلُّ قَدْرًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ فَكَيْفَ تَجُوزُ بِالطَّعَامِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ .
اهـ
** وفي ( شرح النووي على مسلم ) (7/ 112):
وَالْإِذْنُ ضَرْبَانِ :
أَحَدُهُمَا الْإِذْنُ الصَّرِيحُ فِي النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ .
وَالثَّانِي الْإِذْنُ الْمَفْهُومُ مِنَ اطِّرَادِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ كَإِعْطَاءِ السَّائِلِ كِسْرَةً وَنَحْوَهَا مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ وَاطَّرَدَ الْعُرْفُ فِيهِ وَعُلِمَ بِالْعُرْفِ رِضَاءُ الزَّوْجِ وَالْمَالِكِ بِهِ فَإِذْنُهُ فِي ذَلِكَ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَهَذَا إِذَا عُلِمَ رِضَاهُ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ وَعُلِمَ أَنَّ نَفْسَهُ كَنُفُوسِ غَالِبِ النَّاسِ فِي السَّمَاحَةِ بِذَلِكَ وَالرِّضَا بِهِ ** فَإِنِ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ وَشَكَّ فِي رِضَاهُ ، أَوْ كَانَ شَخْصًا يَشُحُّ بِذَلِكَ وَعُلِمَ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ لَمْ يَجُزْ لِلْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا التَّصَدُّقُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِصَرِيحِ إِذْنِهِ .اهـ
** (( الحق الثامن )) :
** الإحسان في معاملته ، بالمداعبة والملاعبة والملاطفة والتزين ؛
** فإن الزوج في هذه الحياة يتحمل المشاق والمتاعب من أجل الحصول على القوت الضروري ،
** فيحتاج من زوجته أن تستقبله بالبشر والطلاقة والبسمة الطيبة والقلب الحنون والمنظر الحسن في نفسها وثيابها وبيتها والكلمات اللطيفة التي تخفف عنه هذه المتاعب .
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ: « الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ » رواه النسائي في السنن الكبرى (5/ 161)، وقال الشيخ الألباني [حسن صحيح]
** وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُعْطِيكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ»
رواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ، (13/ 160) ، وصححه الألباني .
** وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ»[ رواه النسائي وغيره ، وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح ]
** قال الشيخ الألباني رحمه الله في ( صحيح الترغيب والترهيب ) ، (2/ 407) :
** (الودود): هي التي تحب زوجها.
** (الولود): التي تكثر ولادتها.
** وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب، وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد،
** ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربها، إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض.
** قوله: “فإني مكاثر بكم الأمم” أي: مفاخر بسببكم سائر الأمم بكثرة أتباعي . والله أعلم. اهـ المراد
** ولتحذر الزوجة غاية الحذر من تعمد أذية زوجها ؛ فإن ذلك يسبب لها دعاء الحور العين عليها .
** عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.
رواه الترمذي وصححه الألباني .
** (( الحق التاسع )) :
** الاهتمام بحسن مظهره ، وهذا من حسن عشرتها له ، ومن أسباب جلب المحبة بينهما .
** (( الحق العاشر )) :
** الإحسان في معاملة أقاربه ، كأبويه وأخواته وعماته وخالاته ونحوهن ،
** وأما إخوانه وعمه وخاله وبنو عمه وبنو خاله ونحوهم من الأقارب الأجانب فتحسن إليهم بدون اختلاط بهم ، كأن تتصدق عليهم ، أو تصنع لهم طعاما أو تغسل لهم ثيابا وترسل بها مع زوجها أو أولادها ، ونحو ذلك .
** (( الحق الحادي عشر )) :
** الحرص على البقاء معه طول الحياة ، فلا تطلب الطلاق من غير سبب شرعي .
** عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ » رواه أحمد وغيره وصححه الألباني .
** وفي ( فيض القدير ) ، للمناوي (3/ 138):
** (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق) في رواية طلاقها (من غير ما بأس) بزيادة ( ما ) للتأكيد .
** و( البأس ) الشدة ، أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه .
** (فحرام عليها) أي ممنوع عنها (رائحة الجنة) أول ما يجد ريحها المحسنون المتقون لا أنها لا تجد ريحها أصلا فهو لمزيد المبالغة في التهديد وكم له من نظير .
** قال ابن العربي: هذا وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح لو صح .
** وقال ابن حجر: الأخبار الواردة في ترغيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سبب يقتضي ذلك كحديث ثوبان هذا .
اهـ
** (( الحق الثاني عشر )) :
** حفظ أسراره ، خاصة فيما يتعلق بأسرار الفراش .
** قال تعالى : { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ }
** وفي : ( تفسير البغوي ) – إحياء التراث (1/ 612) :
{ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ } ، أَيْ: حَافِظَاتٌ لِلْفُرُوجِ فِي غَيْبَةِ الْأَزْوَاجِ،
وَقِيلَ : حَافِظَاتٌ لِسِرِّهِمْ . اهـ
** وفي ( فيض القدير ) ، (2/ 538):
( . . . والظاهر أن المرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء سره كأن تقول هو سريع الإنزال أو كبير الآلة أو غير ذلك مما يتعلق بالمجامعة ولم أر من تعرض له . اهـ المراد
** عَنْ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: ” لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ: مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ” فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ: ” فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانُ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ”
رواه أحمد وغيره ، وحسنه الألباني .
** وقال جرير بن عطية يرثي امرأته في عفافها :
كانَت إِذا هَجَرَ الحَليلُ فِراشَها … خُزِنَ الحَديثُ وَعَفَّتِ الأَسرارُ
** (( الحق الثالث عشر )) :
** الحرص على تربية أولاده تربية حسنة ؛ فإنها أكثر اختلاطا بهم من أبيهم ،
** فتربيهم على طاعة الله عز وجل ، وطاعة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وطاعة الوالدين في غير معصية الله،
** وتربيتهم على العقيدة الصحيحة ، والشجاعة ، والتوكل على الله ، وأكل الحلال الطيب ، والصدق ، والأمانة ، ومراقبة الله في السر والعلن ، ومحبة الخير للناس ، وغير ذلك من محاسن الأخلاق وجميل الصفات .
** (( تحذير )) :
** بعض الأمهات الجاهلات يهملن أولادهن غاية الأهمال ،
** فلا تهتم بهم في أمر دين ولا دنيا ،
** فتجد الواحد من أولادها ضعيفا في بدنه لسوء التغذية ، ضعيفا في عقله لسوء التربية ،
** قد ملأت قلوبهم بالأهام ، والمخاوف ، والعقائد الباطلة ، والحكايات الخرافية ،
** تصور لهم الجن والعفاريت في كل زاوية من زوايا البيت ،
** فينشأ الولد – ذكرا كان أو أنثى – على هذه الحال السيئة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
** قال الشاعر:
عود بنيك على الاداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر
فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر
هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث العبر
** وقال الآخر :
إهمال تربية البنين جريمة *** عادت على الآباء بالنكبات
** وقال الآخر :
وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلاة
وهل يُرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات
** وقال الشاعر:
تلك العصا من تلكم العصية لا تلد الحية إلا حويّة
** وقد تقدم في حديث عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « . . . وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، . . . » متفق عليه .
** (( الحق الرابع عشر )) :
** الحداد عليه عند موته أربعة أشهر وعشرا .
** عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » متفق عليه .
** وفي كتاب : ( الاستذكار ) لابن عبد البر (6/ 230) :
** أَمَّا الْإِحْدَادُ : فَتَرْكُ الْمَرْأَةِ لِلزِّينَةِ كُلِّهَا من اللباس والطيب والحلي وَالْكُحْلِ وَمَا تَتَزَيَّنُ بِهِ النِّسَاءُ مَا دُمْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ ،
** يُقَالُ لَهَا حِينَئِذٍ امْرَأَةٌ حَادٌّ وَمُحِدٌّ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَحَدَّتْ تُحِدُّ فَهِيَ حَادٌّ وَمُحِدٌّ
** فَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ فِي الْقُرْآنِ وَالْإِحْدَادُ وَاجِبٌ بِالسُّنَّةِ المجتمع عليها
** وقد شذ الحسن عنها وَحْدَهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهَا
** وَمَعْنَى إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ تَرْكُ الزِّينَةِ الرَّاغِبَةِ إِلَى الْأَزْوَاجِ وَذَلِكَ لِبَاسُ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ لِلزِّينَةِ وَلِبَاسُ الرَّقِيقِ الْمُسْتَحْسَنِ مِنَ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَلَا تَلْبَسُ خَزًّا وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا مِنَ الْحُلِيِّ وَلَا تَمَسُّ أَحَدًا مِنْ طِيبٍ
** وَجَائِزٌ لَهُنَّ لِبَاسُ الْغَلِيظِ الْخَشِنِ مِنْ ثِيَابِ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَتَلْبِسُ الْبَيَاضَ كُلَّهُ وَالسَّوَادَ الَّذِي لَيْسَ بِزِينَةٍ وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ
** وَلَا بَأْسَ أَنْ تَدَّهِنَ مِنَ الْأَدْهَانِ بِمَا لَيْسَ بِطِيبٍ .
** وفي : ( شرح النووي على مسلم ) (10/ 112) :
((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
** فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيلِهِ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَفَاةٍ سَوَاءٌ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا وَالصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ وَالْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ . . . الخ ) .اهـ
** (( الحق الخامس عشر )) :
** متابعته في السكن ، فتسكن معه حيث سكن ، سواء كان هذا السكن رفيعا أو وضيعا ، واسعا أو ضيقا ، على حسب قدرة الزوج ، { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }.
** وقال الإمام الذهبي في كتابه ( الكبائر ) (ص: 174) :
** وَيَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تعرف أَنَّهَا كالمملوك للزَّوْج فَلَا تتصرف فِي نَفسهَا وَلَا فِي مَاله إِلَّا بِإِذْنِهِ
** وَتقدم حَقه على حَقّهَا وَحُقُوق أَقَاربه على حُقُوق أقاربها
** وَتَكون مستعدة لتمتعه بهَا بِجَمِيعِ أَسبَاب النَّظَافَة
** وَلَا تفتخر عَلَيْهِ بجمالها
** وَلَا تعيبه بقبح إِن كَانَ فِيهِ
** قَالَ الْأَصْمَعِي دخلت الْبَادِيَة فَإِذا امْرَأَة حسناء لَهَا بعل قَبِيح فَقلت لَهَا كَيفَ ترْضينَ لنَفسك أَن تَكُونِي تَحت مثل هَذَا فَقَالَت اسْمَع يَا هَذَا لَعَلَّه أحسن فِيمَا بَينه وَبَين الله خالقه فجعلني ثَوَابه ولعلي أَسَأْت فَجعله عقوبتي . اهـ
** وقال أيضا في نفس المصدر (ص: 175) :
** وَيجب على الْمَرْأَة أَيْضا دوَام الْحيَاء من زَوجهَا
** وغض طرفها قدامه
** وَالطَّاعَة لأَمره
** وَالسُّكُوت عِنْد كَلَامه
** وَالْقِيَام عِنْد قدومه
** والابتعاد عَن جَمِيع مَا يسخطه
** وَالْقِيَام مَعَه عِنْد خُرُوجه
** وَعرض نَفسهَا عَلَيْهِ عِنْد نَومه
** وَترك الْخِيَانَة لَهُ فِي غيبته فِي فرَاشه وَمَاله وبيته
** وَطيب الرَّائِحَة وتعاهد الْفَم بِالسِّوَاكِ وبالمسك وَالطّيب
** ودوام الزِّينَة بِحَضْرَتِهِ
** وَتركهَا الْغَيْبَة
** وإكرام أَهله وأقاربه
** وَترى الْقَلِيل مِنْهُ كثيراً . اهـ
** وقال الشاعر :
إذا رمتها كانت فراشا تقلني *** وعند فراغي خادم يتملق
** وأخيرا : أختم بهذه النصائح والتوجيهات ، لعل الله أن ينفع بها .
(1) كوني – أيتها الزوجة الكريمة – قنوعة بزوجك ، طويلا كان أو قصيرا ، حسنا أو قبيحا ، نحيفا أو سمينا .
(2) كوني قنوعة بحالتك ، من حيث العسر واليسر ، والغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والإنجاب وعدمه ، وغير ذلك ؛ فالقناعة كنز لا يفنى وهي علامة الراحة ، وعنوان السعادة .
** وإياك أن تمدي عينيك إلى ما متع الله به غيرك من النساء ، من لباس ، أو حلي ، أو زوج ، أو ولد ، أو بيت ، أو غير ذلك من زهرة الحياة الدنيا ، فيصيبك السخط والضجر واستحقار الخير الذي أعطاك الله ، وعندها يلحقك الشقاء والنكد والتعاسة – عياذا بالله – ،
فلا أنك تمتعت بالموجود ، ولا أنك حصلت على المفقود .
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ »
متفق عليه .
** وفي كتاب ” ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ، (9/ 62):
** قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ليس الغنى عن كثرة العرض ))-
بفتح العين والراء – ، وهو : حُطام الدنيا ومتاعها .
** فأما ” العَرْض “- بفتح العين وسكون الراء – ، فهو : ما خلا العقار والحيوان فيما يدخله الكيل والوزن ، هذا قول أبي عبيد في العَرَض والعَرْض .
** وفي كتاب العين : ” العَرَض ” : ما نيل من الدنيا ، ومنه قوله تعالى : { تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا } ، وجمعه : عُروض .
** ومعنى هذا الحديث : أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح ، هو غنى النفس ،
** وبيانه : أنه إذا استغنت نفسه كفّث عن المطامع ، فعزّت وعظمت ، فجعل لها من الحظوة والنزاهة والتشريف والمدح أكثر ممن كان غنيًا بماله ، فقيرًا بحرصه وشرهه ، فإن ذلك يورطه في رذائل الأمور ، وخسائس الأفعال ، لبخله ودناءة همّته ، فيكثر ذامُّه من الناس ، ويصغر قدره فيهم ؛ فيكون أحقر من كل حقير ، وأذل من كل صغير . اهـ
** عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ » رواه مسلم .
** وإليك – أختي الكريمة – هذه القصة التي فيها العظة والعبرة ،
وهي قصة إسماعيل عليه السلام عندما كبر وتزوج .
** عن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قال : . . .
وَشَبَّ الغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ،
** فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ [ يعني : من قبيلة جرهم ]، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ،
** فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا،
** ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ،
** قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ، ** فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟
** قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ،
** قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ،
** قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا،
** وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا،
** قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ اللَّحْمُ، قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ المَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَاءِ،
** قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ ».
** قَالَ: فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ،
** قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ، قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ، قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ العَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ، . . .الخ
الحديث ) أخرجه البخاري (4/ 142) برقم : ( 3364 )
(3) كوني دائما وأبدا زوجة جديدة في حياة زوجك ، وذلك بحسن التبعل والتأنث والتصنع والتجمل للزوج .
(4) كوني صابرة على زوجك وفية معه خاصة عند تغير الحال به إلى فقر ، أو ضعف ، أو كبر ، أو مرض ، أو نحو ذلك .
(5) كوني متواضعة لزوجك ، فلا تتكبري عليه بمال ، أو جمال ، أو حسب ، أو علم ، أو غير ذلك مما يسبب النفرة بينكما .
** بل أشعريه – من خلال أقوالك وأفعالك – أنك تحترميه وتقدريه ، وأنه رجل البيت ، وأنه لك كالأمير المطاع ؛ فإن هذا مما يزيد المحبة ويقوي روابط الأسرة .
** وساق أبو نعيم في كتابه : ( حلية الأولياء ) ، (5/ 198):
إلى امْرَأَة سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنها قَالَتِ :
” مَا كُنَّا نُكَلِّمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا تُكَلِّمُوا أُمَرَاءَكُمْ: أَصْلَحَكَ اللهُ، عَافَاكَ اللهُ ”
(6) لا تصفي امرأة لزوجك ؛ فإنه حرام ، وربما كان سببا في طلاقك .
** عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » رواه البخاري
** وفي ( فتح الباري ) ، لابن حجر (9/ 338):
قَوْلُهُ : ( لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ) زَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِ ( فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) .
قَوْلُهُ : ( فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) قَالَ الْقَابِسِيُّ : هَذَا أَصْلٌ لِمَالِكٍ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ ؛ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا النَّهْيِ خَشْيَةُ أَنْ يُعْجِبَ الزَّوْجَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى تَطْلِيقِ الْوَاصِفَةِ أَوْ الِافْتِتَانِ بِالْمَوْصُوفَةِ . اهـ المراد
(7) يجب على الأمهات أن يحسن تربية بناتهن ، وأن يعلمنهن حقوق الأزواج قبل حلول وقت الزواج ليكن على بصيرة من أمرهن ، كما كان يفعل ذلك نساء السلف – رضي الله عنهن – .
** ومما ذكره التاريخ من وصايا الأمهات لبناتهن وصية أمامة بنت الحارث زوجة عوف بن مسلم الشيباني لبنتها أم إياس بنت عوف بن مسلم قبل رحيلها إلى زوجها عمرو بن حجر ملك كندة ، ( وهذا كان قبل الإسلام ) فقالت لها :
** ” أي بنيّة، إن الوصية لو تركت لعقل وأدب، أو مكرمة في حسب لتركت ذلك منك، ولزويته عنك، ولكن الوصية تذكرة للعاقل، ومنبهة للغافل.
** أي بنية، إنه لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن الزوج، ولكن للرجال خلق النساء، كما لهن خلق الرجال.
** أي بنية، إنك قد فارقت الحِواء الذي منه خرجت، والوكر الذي منه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك ملكا، ** فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني خصالا عشرا، تكن لك دركا وذكرا؛
** فأما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب، وحسن السمع والطاعة رأفة الرب؛
** وأما الثالثة والرابعة فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك إلا طيب الريح؛ واعلمي، أي بنيّة، أن الماء أطيب الطيب المفقود، وأن الكحل أحسن الحسن الموجود.
** وأما الخامسة والسادسة فالتَّعهد لوقت وطعامه، والهدوّ عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النَّومة مغضبة؛
** وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير، والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير؛
** وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرّه لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره.
** واتّقي الفرح لديه إذا كان ترحا، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير، والثانية من التكدير،
** واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى تؤثري هواه على هواك، ورضاه على رضاك فيهما أحببت وكرهت.
والله يخير لك، ويصنع لك برحمته.
** قال: فلما حملت إليه غلبت على أمره، وولدت منه سبعة أملاك، ملكوا من بعده . اهـ
** انظر كتاب ( المعمرون والوصايا ) (ص: 37) لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني (المتوفى: 248هـ)
** و( العقد الفريد ) ، (7/ 89) لابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 328هـ)
** و ( جمهرة الأمثال ) ،(1/ 571) لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)
** و(تحفة العروس) صـ (91)، لمحمود بن مهدي الاستانبولي .
** ( والخلاصة ) :
احرص – أيتها الزوجة الموفقة – كل الحرص على كل ما يسعد زوجك ويدخل عليه السرور ،
وابتعد كل البعد عن كل ما يؤذيه ويدخل عليه الحزن .
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 4 / 11/ 1438 هـ
(65) فائدة اليوم بعنوان : ( الحقوق الزوجية / الحلقة الأولى )
** الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
** فنظرا لكثرة النكاح بين العيدين أحببت أن أكتب نبذة يسيرة عن النكاح وفضله، وبيان شيء من الحقوق الزوجية التي لو عرفت وطبقت لحصلت السعادة والراحة والطمأنينة في المجتمع .
** وقد جعلت هذه النبذة أربع حلقات وهي : مقدمة عن فضل النكاح ثم ذكر حقوق الزوج ثم ذكر حقوق الزوجة ثم نصيحة للزوجين .
** فأقول مستعينا بالله :
** إن الزواج نعمة عظيمة ومنة جسيمة، امتن الله به على العباد فقال جل من قائل : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }
** فعن طريق الزواج يحصل السكون، وهو الراحة والطمأنينة،
** وتحصل أيضا المودة، وهي المحبة والألفة والتوافق بين الزوجين،
** وتحصل به الرحمة والشفقة بينهما، وغير ذلك من المنافع والمصالح الكثيرة المتكاثرة التي لا يحصيها إلا الله .
** فإذا كان الزواج بهذه الأهمية فالواجب على كل من الزوجين أن يبذل غاية جهده في المحافظة على هذه النعمة العظيمة ورعايتها وحمايتها من كل ما يضعفها أو يزيلها بالكلية .
** وإذا سألنا وقلنا : كيف نستطيع أن نحافظ على الحياة الزوجية ؟
** فالجواب : أن ذلك ممكن وسهل جدا، وذلك إذا قام كل واحد من الزوجين بأداء الحق الذي عليه تجاه الأخر بصدق وإخلاص ومحبة ورغبة على قدر ما يستطيع :{ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } ، { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }
** أيها الزوج الكريم، أيتها الزوجة الكريمة، إن الزواج ليس مجرد متعة فقط، بل هو متعة ومسئولية عظيمة جدا .
** عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » متفق عليه .
** وفي ( شرح النووي على مسلم ) (12/ 213):
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ)
قَالَ الْعُلَمَاءُ : ( الرَّاعِي ) هُوَ الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ الْمُلْتَزِمُ صَلَاحَ مَا قَامَ عَلَيْهِ وَمَا هُوَ تَحْتَ نَظَرِهِ، فَفِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ نَظَرِهِ شَيْءٌ فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالْعَدْلِ فِيهِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ .اهـ
** وعَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ الجشمي رضي الله عنه أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، …
فَقَالَ: … أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ
عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.
رواه الترمذي [وحسنه الألباني]
** وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حيدة الْقُشَيْرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»، رواه أَبُو دَاوُدَ وغيره، وقال الألباني: حسن صحيح، وقال شيخنا الوادعي : هذا حديث حسن .
** قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ” ( وَلَا تُقَبِّحْ ) أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ “
** فمن هذه الأدلة وغيرها نعرف أن الله جل وعلا قد أوجب على كل واحد من الزوجين حقوقا تجاه الأخر يجب عليه أن يؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى .
** وسوف أبدأ بذكر حقوق الزوج على زوجته ؛ لأنه أعظم الحقين .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 28 / 10/ 1438 هـ
(64) فائدة اليوم بعنوان : ( الصبر عن الشهوات المحرمات سبب في نيل الدرجات العاليات )
** قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (23) سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ }
** وقال : { إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ }
** وقال : { أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا }
** وقال : { وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا }
** وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، « … وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » متفق عليه .
** وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ » متفق عليه .
أي : لا وصول لأحد إلى الْجَنَّةَ إِلَّا بفعل الْمَكَارِهِ من الطاعات، وَلا نجاة لأحد من النَّار إلا بِترك الشَّهَوَاتِ من المحرمات .
** وفي ( تفسير ابن كثير )، ط العلمية (8/ 297) :
** وَقَوْلُهُ تعالى: { وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا } أَيْ بِسَبَبِ صَبْرِهِمْ أَعْطَاهُمْ وَنَوَّلَهُمْ وَبَوَّأَهُمْ جَنَّةً وَحَرِيراً أَيْ مَنْزِلًا رَحْبًا وعيشا غيدا وَلِبَاسًا حَسَنًا.
** وَرَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ سُورَةُ هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ فَلَمَّا بَلَغَ الْقَارِئُ إِلَى قَوْلِهِ تعالى: { وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً } قَالَ: بِمَا صَبَرُوا عَلَى تَرْكِ الشَّهَوَاتِ فِي الدُّنْيَا .
** ثُمَّ أنشد يقول: [الطويل]
كَمْ قَتِيلٌ بِشَهْوَةٍ وَأَسِيرٌ *** أُفٍّ مِنْ مُشْتَهِي خِلَافَ الْجَمِيلِ
شَهَوَاتُ الْإِنْسَانِ تُوْرِثُهُ الذُّلَّ *** وَتُلْقِيهِ في البلاء الطويل
.اهـ
** وفي كتاب : ( الفوائد )، (ص: 139):
** فصل الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة فإنها :
** إما أن توجب ألما وعقوبة .
** وإما أن تقطع لذة أكمل منها .
** وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة .
** وأما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه .
** وأما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه .
** وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه .
** وأما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة .
** وأما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك .
** وأما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة .
** وإما أن تنسى علما ذكره ألذ من نيل الشهوة .
** وأما أن تشمت عدوا وتحزن وليا .
** وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة .
** وأما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول ؛ فان الأعمال تورث الصفات والأخلاق . اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 23 / 10/ 1438 هـ
(63) فائدة اليوم بعنوان : ( التحذير من الذنوب؛ فإنها سبب هلاك الأفراد والمجتمعات والشعوب )
** إن للذنوب عواقب وخيمة، وأضرارًا سيئة.
** إنها تجلب كل شر ونكد وبلاء.
** إنها تظلم القلب، وتضيق الصدر، وتكدر صفو العيش .
** إنها تجلب الفقر والذلة والمهانة، والأمراض والأسقام .
** إنها تزيل النعم وتجلب النقم.
** إنها تجلب العذاب الأليم، وتوصل صاحبها إلى دار الجحيم.
** فكم أهلكت من أمة، وكم أسقطت من دولة، وكم خلفت من آثار سيئة وأحوال مدمرة،
** وكل يوم وهي تتزايد وتتفاقم وتتوسع وتنتقل من سيء إلى أسوأ :
** فصار الناس في الظلام بعد أن كانوا في النور،
** وفي الخوف بعد أن كانوا في الأمن،
** وفي قلق واضطراب بعد أن كانوا في هدوء واطمئنان،
** وفي قلة بعد أن كانوا في كثرة،
** وفي فقر بعد أن كانوا في غنى،
** وفي ضيق بعد أن كانوا في سعة،
** وفي سكون بعد أن كانوا في حركة ونشاط،
** وتعطلت كثير من المدارس والأسواق والمزارع والمصانع،
** وقتلت الرجال ويتمت الأطفال ورملت كثير من النساء،
** وكثر الخراب والدمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
** قال الله تعالى : { وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ }
** وقال : { وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا }
** وقال : { وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) }
** وقال : { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ }
** وقال : { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (17) }
** وقال : { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ }
إلى قوله : { كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) }
** وقال : { فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }
** قال ابن القيم ـ رحمه الله في كتابه القيم 🙁 الجواب الكافي )، (ص: 42)ـ:
** فَممَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ، أَنَّ الذُّنُوبَ وَالْمَعَاصِيَ تَضُرُّ وَلَا بُدَّ،
** وأَنَّ ضَرَرَهَا فِي الْقَلْبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ عَلَى اخْتِلَافِ دَرَجَاتِهَا فِي الضَّرَرِ،
** وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا سَبَبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي،
** فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، دَارِ اللَّذَّةِ وَالنَّعِيمِ وَالْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ إِلَى دَارِ الْآلَامِ وَالْأَحْزَانِ وَالْمَصَائِبِ؟
** فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ وَطَرَدَهُ وَلَعَنَهُ،
وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ فَجَعَلَ صُورَتَهُ أَقْبَحَ صُورَةٍ وَأَشْنَعَهَا، وَبَاطِنَهُ أَقْبَحَ مِنْ صُورَتِهِ وَأَشْنَعَ،
وَبُدِّلَ بِالْقُرْبِ بُعْدًا، وَبِالرَّحْمَةِ لَعْنَةً، وَبِالْجَمَالِ قُبْحًا، وَبِالْجَنَّةِ نَارًا تَلَظَّى، وَبِالْإِيمَانِ كُفْرًا،
وَبِمُوَالَاةِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ أَعْظَمَ عَدَاوَةٍ وَمُشَاقَّةٍ،
وَبِزَجَلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ زَجَلَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالزُّورِ وَالْفُحْشِ،
وَبِلِبَاسِ الْإِيمَانِ لِبَاسَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ،
فَهَانَ عَلَى اللَّهِ غَايَةَ الْهَوَانِ، وَسَقَطَ مِنْ عَيْنِهِ غَايَةَ السُّقُوطِ، وَحَلَّ عَلَيْهِ غَضَبُ الرَّبِّ تَعَالَى فَأَهْوَاهُ، وَمَقَتَهُ أَكْبَرَ الْمَقْتِ فَأَرْدَاهُ،
فَصَارَ قَوَّادًا لِكُلِّ فَاسِقٍ وَمُجْرِمٍ، رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْقِيَادَةِ بَعْدَ تِلْكَ الْعِبَادَةِ وَالسِّيَادَةِ،
** فَعِيَاذًا بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِكَ وَارْتِكَابِ نَهْيِكَ .
** وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ حَتَّى عَلَا الْمَاءُ فَوْقَ رَأْسِ الْجِبَالِ؟
** وَمَا الَّذِي سَلَّطَ الرِّيحَ الْعَقِيمَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ،
وَدَمَّرَتْ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ دِيَارِهِمْ وَحُرُوثِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ، حَتَّى صَارُوا عِبْرَةً لِلْأُمَمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟
** وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ الصَّيْحَةَ حَتَّى قَطَعَتْ قُلُوبَهُمْ فِي أَجْوَافِهِمْ وَمَاتُوا عَنْ آخِرِهِمْ ؟
** وَمَا الَّذِي رَفَعَ قُرَى اللُّوطِيَّةِ حَتَّى سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ نَبِيحَ كِلَابِهِمْ، ثُمَّ قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ، فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا، فَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَتْبَعَهُمْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَمْطَرَهَا عَلَيْهِمْ،
فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ عَلَى أُمَّةٍ غَيْرِهِمْ، وَلِإِخْوَانِهِمْ أَمْثَالُهَا، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ؟
** وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ سَحَابَ الْعَذَابِ كَالظُّلَلِ، فَلَمَّا صَارَ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ نَارًا تَلَظَّى ؟
** وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ نَقَلَتْ أَرْوَاحَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ، فَالْأَجْسَادُ لِلْغَرَقِ، وَالْأَرْوَاحُ لِلْحَرْقِ ؟
** وَمَا الَّذِي خَسَفَ بِقَارُونَ وَدَارِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ ؟
** وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ، وَدَمَّرَهَا تَدْمِيرًا؟
** وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبِ يس بِالصَّيْحَةِ حَتَّى خَمَدُوا عَنْ آخِرِهِمْ؟
** وَمَا الَّذِي بَعَثَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وَقَتَلُوا الرِّجَالَ، وَسَبُوا الذُّرِّيَّةَ وَالنِّسَاءَ، وَأَحْرَقُوا الدِّيَارَ، وَنَهَبُوا الْأَمْوَالَ، ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَهْلَكُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ وَتَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا؟
** وَمَا الَّذِي سَلَّطَ عَلَيْهِمْ أَنْوَاعَ الْعُقُوبَاتِ، مَرَّةً بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَخَرَابِ الْبِلَادِ، وَمَرَّةً بِجَوْرِ الْمُلُوكِ، وَمَرَّةً بِمَسْخِهِمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ،
وَآخِرُ ذَلِكَ أَقْسَمَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ} [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: 167] .
** قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ قُبْرُصُ فُرِّقَ بَيْنَ أَهْلِهَا، فَبَكَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ جَالِسًا وَحْدَهُ يَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَا يُبْكِيكَ فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ، مَا أَهْوَنُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَضَاعُوا أَمْرَهُ، بَيْنَمَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَهُمُ الْمُلْكُ، تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى .
** وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ : « لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ » .
** وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ – يَقُولُ: « إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِي فِي أُمَّتِي عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أُنَاسٌ صَالِحُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: كَيْفَ يُصْنَعُ بِأُولَئِكَ؟ قَالَ: يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ » … الخ كلامه رحمه الله ). اهـ المراد
** والمخرج من هذه المصائب والفتن، والشدائد والمحن التي سببت هذه الأضرار العظيمة والأخطار الجسيمة، هو الرجوع الصادق إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح،
** ويكون ذلك بالإقلاع عن الذنب،
** والندم على فعله،
** والعزم الأكيد على عدم الرجوع إليه،
وإرجاع الحقوق إلى أصحابها .
كما قال تعالى قال : { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }
** وقال : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ }
** وقال : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
** وقال : { مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا } .
** قال العلامة السعدي ـ رحمه الله تعالى في تفسيره ( تيسير الكريم الرحمن ) (ص: 414) ـ :
{ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ } من النعمة والإحسان ورغد العيش
{ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها.
** وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة،
{ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا } أي: عذابا وشدة وأمرا يكرهونه، فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم . اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 19 / 10/ 1438 هـ
(62) فائدة اليوم بعنوان : ( حسن الظن بالله يحتاج إلى عمل، وإلا كان غرورا )
** قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم 🙁 الجواب الكافي )،
(1/ 86) :
فصل :
** فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأنّ حسن الظن إن حمل على العمل، وحثَّ عليه، وساق إليه، فهو صحيح. وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي، فهو غرور.
** وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه حاديًا له على الطاعة، زاجرًا له عن المعصية، فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاءً، ورجاؤه بطالةً وتفريطًا، فهو المغرور.
** ولو أن رجلًا له أرض يؤمّل أن يعود عليه من مُغَلِّها ما ينفعه فأهملها، ولم يبذُرها، ولم يحرثها، وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلّها ما يأتي مَن حَرَث ، وبَذَر، وسقَى، وتعاهَد الأرضَ، لعدَّه الناس من أسفه
السفهاء.
** وكذلك لو حسّن ظنَّه وقوّى رجاءَه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلمَ أهل زمانه من غير طلبِ للعلم وحرص تامّ عليه، وأمثال ذلك.
فكذلك من حسّن ظنه وقوّى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم، من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وبالله التوفيق .
** وقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ} [البقرة: 218].
** فتأمَّلْ كيف جعل رجاءَهم إتيانَهم بهذه الطاعات!
** وقال المغترون: إنّ المفرِّطين المضيِّعين لحقوق الله، المعطِّلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرّئين على محارمه { أولئك يرجون رحمة الله } !
** وسرّ المسألة : أنّ الرَّجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه، وقدَره، وثوابه وكرامته؛ فيأتي العبد بها، ثم يحسن ظنّه بربه، ويرجوه أن لا يكِلَه إليها، وأن يجعلها موصلةً إلى ما ينفعه، ويصرف ما يعارضها، ويبطل أثرها.
(( فصل )) :
** ومما ينبغي أن يعلم أنّ من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورًا:
أحدها: محبة ما يرجوه .
الثاني: خوفه من فواته .
الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان .
** وأما رجاءٌ لا يقارنه شيء من ذلك، فهو من باب الأماني !
** والرجاء شيء، والأماني شيء آخر.
** فكلُّ راجٍ خائفٌ، والسائر على الطريق إذا خاف أسرَعَ السيرَ مخافةَ الفوات.
** وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “مَن خاف أدلَجَ، ومن أدلج بلغ المنزل .
ألا إنّ سلعة الله غالية، ألا إنّ سلعة الله الجنّة”.
** وهو سبحانه كما جعل الرَّجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال.
** فعُلِمَ أنّ الرَّجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل.
** قال الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) } [المؤمنون: 57 – 61].
** وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن هذه الآية فقلت : أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: “لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلّون ويتصدّقون، ويخافون أن لا يُتقبَل منهم . أولئك يسارعون في الخيرات”.
** وقد روي من حديث أبي هريرة أيضًا .
** والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير- بل التفريط- والأمن! فهذا الصدّيق يقول: “وددتُ أنّي شعرة في جنب عبد مؤمن”. / ذكره أحمد عنه .
** وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد!
** وكان يبكي كثيرًا، ويقول: ابكوا، فإنْ لم تبكُوا فتباكَوا .
** وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عَزَّ وَجَلَّ .
** وأتي بطائر، فقلّبه، ثم قال: ما صِيدَ مِن صَيدٍ ولا قُطعت من شجرة إلا بما ضيّعَتْ من [18/ ب] التسبيح .
. . .، وهذا باب يطول تتبعه . . . الخ كلامه رحمة الله عليه ) .
اهـ المراد .
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 18 / 10/ 1438 هـ
(61) فائدة اليوم بعنوان : ( التحذير من أساليب مكر النفس الخبيثة بصاحبها لإيقاعه في الذنوب )
** قال ابن القيم ـ رحمه الله في كتابه القيم 🙁 الجواب الكافي )،
(ص: 21)ـ :
فَصْلٌ :
الْأَمْرُ الثَّانِي :
** أَنْ يَحْذَرَ مُغَالَطَةَ نَفْسِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ،
** وَهَذَا مِنْ أَهَمِّ الْأُمُورِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْرِفُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ وَالْغَفْلَةَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُضِرَّةِ لَهُ فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ وَلَا بُدَّ،
** وَلَكِنْ تُغَالِطُهُ نَفْسُهُ بِالِاتِّكَالِ عَلَى عَفْوِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ تَارَةً ،
** وَبِالتَّسْوِيفِ بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ بِاللِّسَانِ تَارَةً،
** وَبِفِعْلِ الْمَنْدُوبَاتِ تَارَةً،
** وَبِالْعِلْمِ تَارَةً،
** وَبِالِاحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ تَارَةً،
** وَبِالِاحْتِجَاجِ بِالْأَشْبَاهِ وَالنُّظَرَاءِ تَارَةً،
** وَبِالِاقْتِدَاءِ بِالْأَكَابِرِ تَارَةً أُخْرَى.
** وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ ثُمَّ قَالَ : ( أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ )، زَالَ أَثَرُ الذَّنْبِ وَرَاحَ هَذَا بِهَذَا،
** وَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْفِقْهِ: أَنَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ ثُمَّ أَقُولُ:
( سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ) ، مِائَةَ مَرَّةٍ وَقَدْ غُفِرَ ذَلِكَ أَجْمَعُهُ ،
كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» ،
** وَقَالَ لِي آخَرُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ : نَحْنُ إِذَا فَعَلَ أَحَدُنَا مَا فَعَلَ، اغْتَسَلَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا وَقَدْ مُحِيَ عَنْهُ ذَلِكَ ،
** وَقَالَ لِي آخَرُ: قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي، فَغَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أَصَبْتُ ذَنْبًا، فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ.» وَقَالَ: أَنَا لَا أَشُكُّ أَنَّ لِي رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ،
** وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ قَدْ تَعَلَّقَ بِنُصُوصٍ مِنَ الرَّجَاءِ، وَاتَّكَلَ عَلَيْهَا وَتَعَلَّقَ بِهَا بِكِلْتَا يَدَيْهِ .
** وَإِذَا عُوتِبَ عَلَى الْخَطَايَا وَالِانْهِمَاكِ فِيهَا، سَرَدَ لَكَ مَا يَحْفَظُهُ مِنْ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَنُصُوصِ الرَّجَاءِ،
** وَلِلْجُهَّالِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ غَرَائِبُ وَعَجَائِبُ
** كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ:
وَكَثِّرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى كَرِيمٍ
** وَقَوْلِ الْآخَرِ: التَّنَزُّهُ مِنَ الذُّنُوبِ جَهْلٌ بِسَعَةِ عَفْوِ اللَّهِ .
** وَقَالَ الْآخَرُ: تَرْكُ الذُّنُوبِ جَرَاءَةٌ عَلَى مَغْفِرَةِ اللَّهِ وَاسْتِصْغَارٌ لها! .
** وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ : رَأَيْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِصْمَةِ .
** وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمَغْرُورِينَ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ الْجَبْرِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا فِعْلَ لَهُ الْبَتَّةَ وَلَا اخْتِيَارَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَجْبُورٌ عَلَى فِعْلِ الْمَعَاصِي .
** وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَغْتَرُّ بِمَسْأَلَةِ الْإِرْجَاءِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ مُجَرَّدُ التَّصْدِيقِ، وَالْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ إِيمَانَ أَفْسَقِ النَّاسِ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ .
** وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَغْتَرُّ بِمَحَبَّةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَشَايِخِ وَالصَّالِحِينَ، وَكَثْرَةِ التَّرَدُّدِ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِمْ، وَالِاسْتِشْفَاعِ بِهِمْ، وَالتَّوَسُّلِ إِلَى اللَّهِ بِهِمْ، وَسُؤَالِهِ بِحَقِّهِمْ عَلَيْهِ، وَحُرْمَتِهِمْ عِنْدَهُ .
** وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْتَرُّ بِآبَائِهِ وَأَسْلَافِهِ، وَأَنَّ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكَانَةً وَصَلَاحًا، فَلَا يَدَعُوهُ أَنْ يُخَلِّصُوهُ كَمَا يُشَاهِدُ فِي حَضْرَةِ الْمُلُوكِ،
** فَإِنَّ الْمُلُوكَ تَهَبُ لِخَوَاصِّهِمْ ذُنُوبَ أَبْنَائِهِمْ وَأَقَارِبِهِمْ ،
وَإِذَا وَقَعَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي أَمْرٍ مُفْظِعٍ خَلَّصَهُ أَبُوهُ وَجَدُّهُ بِجَاهِهِ وَمَنْزِلَتِهِ.
** وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْتَرُّ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَعَذَابُهُ لَا يَزِيدُ فِي مُلْكِهِ شَيْئًا، وَرَحْمَتُهُ لَهُ لَا تَنْقُصُ مِنْ مُلْكِهِ شَيْئًا، فَيَقُولُ: أَنَا مُضْطَرٌّ إِلَى رَحْمَتِهِ، وَهُوَ أَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ، وَلَوْ أَنَّ فَقِيرًا مِسْكِينًا مُضْطَرًّا إِلَى شَرْبَةِ مَاءٍ عِنْدَ مَنْ فِي دَارِهِ شَطٌّ يَجْرِي لَمَا مَنَعَهُ مِنْهَا فَاللَّهُ أَكْرَمُ وَأَوْسَعُ فَالْمَغْفِرَةُ لَا تَنْقُصُهُ شَيْئًا وَالْعُقُوبَةُ لَا تَزِيدُ فِي مُلْكِهِ شَيْئًا .
** وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْتَرُّ بِفَهْمٍ فَاسِدٍ فَهِمَهُ هُوَ وَأَضْرَابُهُ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فَاتَّكَلُوا عَلَيْهِ كَاتِّكَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [سُورَةُ الضُّحَى: 55] .
** قَالَ : وَهُوَ لَا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ فِي النَّارِ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ،
** وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْجَهْلِ، وَأَبْيَنِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ،
** وَاللَّهُ تَعَالَى يُرْضِيهِ تَعْذِيبُ الظَّلَمَةِ وَالْفَسَقَةِ وَالْخَوَنَةِ وَالْمُصِرِّينَ عَلَى الْكَبَائِرِ، فَحَاشَا رَسُولَهُ أَنْ يَرْضَى بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .
** وَكَاتِّكَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا } [سُورَةُ الزُّمَرِ: 53]
** وَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَقْبَحِ الْجَهْلِ، فَإِنَّ الشِّرْكَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ الذُّنُوبِ وَأَسَاسُهَا، وَلَا خِلَافَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي حَقِّ التَّائِبِينَ، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ ذَنْبَ كُلِّ تَائِبٍ مِنْ أَيِّ ذَنْبٍ كَانَ، وَلَوْ كَانَتِ الْآيَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ التَّائِبِينَ لَبَطَلَتْ نُصُوصُ الْوَعِيدِ كُلُّهَا .
** وَأَحَادِيثُ إِخْرَاجِ قَوْمٍ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ .
** وَهَذَا إِنَّمَا أَتَى صَاحِبَهُ مِنْ قِلَّةِ عِلْمِهِ وَفَهْمِهِ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ هَاهُنَا عَمَّمَ وَأَطْلَقَ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ التَّائِبِينَ،
وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ خَصَّصَ وَقَيَّدَ فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: 48] ،
فَأَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَغْفِرُ مَا دُونَهُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي حَقِّ التَّائِبِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهِ،
** وَكَاغْتِرَارِ بَعْضِ الْجُهَّالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ } [سُورَةُ الِانْفِطَارِ: 66]
فَيَقُولُ : كَرَّمَهُ ، وَقَدْ يَقُولُ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ لَقَّنَ الْمُغْتَرَّ حُجَّتَهُ،
** وَهَذَا جَهْلٌ قَبِيحٌ، وَإِنَّمَا غَرَّهُ بِرَبِّهِ الْغَرُورُ، وَهُوَ الشَّيْطَانُ، وَنَفْسُهُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ وَجَهْلُهُ وَهَوَاهُ،
وَأَتَى سُبْحَانَهُ بِلَفْظِ ( الْكَرِيمِ ) وَهُوَ السَّيِّدُ الْعَظِيمُ الْمُطَاعُ، الَّذِي لَا يَنْبَغِي الِاغْتِرَارُ بِهِ ، وَلَا إِهْمَالُ حَقِّهِ ، فَوَضَعَ هَذَا الْمُغْتَرُّ الْغَرُورَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَاغْتَرَّ بِمَنْ لَا يَنْبَغِي الِاغْتِرَارُ بِهِ .
. . . الخ . اهـ المراد
** وننصح بقراءة بقية كلامه الماتع والمفيد رحمه الله تعالى .
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 17 / 10/ 1438 هـ
(60) فائدة اليوم بعنوان : ( التواضع خلق رفيع، والتكبر خلق وضيع )
** التواضع وصف كريم وخلق عظيم، أمر الله به، وحث عليه، ورغب فيه ووعد عليه الأجر العظيم والنفع العميم في الدنيا والآخرة .
** وهو علامة بارزة للأنبياء والمرسلين وعباد الله المؤمنين،
** والكبر : عكسه تمامًا .
** فمن تواضع لله فقدوته الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من عباد الله الصالحين.
** ومن تكبر فقدوته الشيطان الرجيم ومن تبعه من المتكبرين الجبارين من الإنس والجن والشياطين .
** قال تعالى : { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } .
** قال تعالى : { وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا }.
** وقال الله تعالى : { وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا }.
** وقال تعالى: { تِلْكَ الدّارُ الاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ } .
** وقال تعالى عن لقمان موصيًا ولده : { وَلاَ تُصَعّرْ خَدّكَ لِلنّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحاً إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } .
** وقال الله تعالى:{ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ }.
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: « … وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ » رواه مسلم .
** وعَنْ عِيَاضِ المُجَاشِعٍي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « … وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » رواه مسلم .
** وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رضي الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ » رواه مسلم .
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدَةً مِنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ ” رواه مسلم وغيره، وهذا لفظ أحمد.
** وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ، قَالَ: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الخَبَالِ . رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني .
وفي كتاب : ( شرح الزرقاني على الموطأ )، (4/ 678):
** وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: التَّوَاضُعُ انْكِسَارٌ، وَالتَّذَلُّلُ ضِدُّ التَّكَبُّرِ،
** فَالتَّوَاضُعُ إِنْ كَانَ لِلَّهِ، أَوْ لِرَسُولِهِ، أَوْ لِلْحَاكِمِ، أَوْ لِلْعَالِمِ، فَهَذَا وَاجِبٌ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ فِي الدَّارَيْنِ،
** وَأَمَّا لِسَائِرِ الْخَلْقِ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ قَدْرَ صَاحِبِهِ فِي الْقُلُوبِ، وَيُطَيِّبُ ذِكْرَهُ فِي الْأَفْوَاهِ، وَيَرْفَعُ قَدْرَهُ فِي الْآخِرَةِ،
** وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الدُّنْيَا فَلَا عِزَّ مَعَهُ. اهـ المراد
** وقال ابن القيم في كتابه : ( الروح )، (ص: 233):
** التَّوَاضُع : هُوَ انكسار الْقلب لله، وخفض جنَاح الذل وَالرَّحْمَة بعباده، فَلَا يرى لَهُ على أحد فضلا، وَلَا يرى لَهُ عِنْد أحد حَقًا ، بل يرى الْفضل للنَّاس عَلَيْهِ والحقوق لَهُم قبله.
** وَهَذَا خلق إِنَّمَا يُعْطِيهِ الله عز وَجل من يُحِبهُ ويكرمه ويقربه. اهـ المراد
** وفي كتاب : ( التنوير شرح الجامع الصغير )، للصنعاني (10/ 184):
** وقال الطبري: في التواضع مصلحة الدارين فلو استعمله الناس في الدنيا لزالت بينهم الشحناء فاستراحوا من نصب المباهات والمفاخرات. اهـ
** وفي كتاب: ( الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة )، (ص:10):
** وذكر الكبر عند المعتصم. فقال : حظ صاحبه من الله المقت، ومن الناس اللعن.
** وقال بعضهم : إذا نال الشريف رتبة تواضع فيها، وإذا نال الوضيع رتبة تكبر فيها.
** وقال يحيى بن خالد: من بلغ رتبة فتاه فيها، فقد أخبر أن محله دونها،
ومن بلغ رتبة فتواضع فيها، فقد أخبر أن محله فوقها .
. . . . . . .
** وقال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : رأس التواضع أن تبدأ بالسلام لمن لقيت، وترضى بالدون من المجلس .
** وقال مصعب بن الزبير : التواضع من مصائد الشرف . اهـ
** وفي كتاب : ( فتح القدير ) للشوكاني (5/ 464):
** { مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ } أَيْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، وَهَذَا تَحْقِيرٌ لَهُ.
** قَالَ الْحَسَنُ: كَيْفَ يَتَكَبَّرُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَرَّتَيْنِ. اهـ المراد
** و في ( تفسير القرطبي ) ، (7 / 334) :
** ولا يتكبر على أحد من عباد الله، فإنه مؤلف من أقذار، مشحون من أوضار(1)، صائر إلى جنة إن أطاع أو إلى نار.
** وقال ابن العربي : وكان شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الأبيات الحكمية التي جمعت هذه الأوصاف العلمية :
كيف يزهو مَنْ رجيعهُ(2) أَبَدَ الدهرِ ضجيعُه
فـهــو مـنـه وإلـيـه وأَخــوه ورضـيـعُـه
وهو يـدعـوه إلى الحُ (3) شِّ بصغر فيطيعه؟!!. اهـ
(1) والأوضار: الأوساخ.
(2) الرجيع: العذرة والروث .
(3) الحش بالتثليث: النخل المجتمع، ويكنى به عن بيت الخلاء، لما كان من عادتهم التغوط في البساتين .
** وفي ( تفسير القرطبي ) أيضا ، (18/ 294) :
** وَرُوِيَ أَنَّ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ رَأَى المهلب ابن أَبِي صُفْرَةَ يَتَبَخْتَرُ فِي مُطْرَفٍ خَزٍّ وَجُبَّةِ خَزٍّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا هذه المشية التي يبغضها الله؟!
** فقال له : أتعرفني ؟
** قال نعم ، أولك نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ، وَآخِرُكَ جِيفَةُ قَذِرَةٌ، وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ.
** فَمَضَى الْمُهَلَّبُ وَتَرَكَ مِشْيَتَهُ .
** نَظَمَ الْكَلَامَ مَحْمُودٌ الْوَرَّاقُ فَقَالَ :
عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بِصُورَتِهِ وَكَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً مَذِرَهْ
وَفِي غَدٍ بَعْدَ حُسْنِ هَيْئَتِهِ يَصِيرُ فِي الْأَرْضِ جِيفَةً قَذِرَهْ
وَهُوَ عَلَى عُجْبِهِ وَنَخْوَتِهِ مَا بَيْنَ يَوْمَيْنِ يَحْمِلُ الْعَذِرَهْ
** وَقَالَ آخَرُ:
هَلْ فِي ابْنِ آدَمَ غَيْرَ الرَّأْسِ مَكْرُمَةٌ وَهُوَ بِخَمْسٍ مِنَ الْأَوْسَاخِ مَضْرُوبُ
أَنْفٌ يَسِيلُ وَأُذْنٌ رِيحُهَا سَهِكٌ (**) وَالْعَيْنُ مُرْمَصَةٌ وَالثَّغْرُ مَلْهُوبُ
يَا ابْنَ التُّرَابِ وَمَأْكُولَ التُّرَابِ غَدًا قَصِّرْ فَإِنَّكَ مَأْكُولٌ وَمَشْرُوبُ
(**) السهك- محركة- ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق. اهـ
** وقال الشاعر :
تواضع تكن كالنجم لاح لناظرٍ على صفحات الماء وهو رفيعُ
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعُ
وأكرم أخلاق الفتى وأجلها تواضعه للناس وهو رفيع
وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع
** وقال آخر :
إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى
** وقال آخر :
وكفى بملتمس التواضع رفعة وكفى بملتمس العلو سفالا
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 14 / 10/ 1438 هـ
(59) فائدة اليوم بعنوان : ( التفصيل والبيان في كيفية مكابدة الإنسان )
** قال تعالى :{ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ }
** في هذه الآية العظيمة يخبر الله سبحانه وتعالى خبرا مؤكدا بثلاثة مؤكدات ، وهي : القسم ، واللام. وحرف ( قد ) الدالة على التحقيق ، أنه خلق الإنسان في شدة ومشقة ، منذ بداية تخلقه في بطن أمه إِلى أَن يستقر به القرار إِماَّ في الجنة وإِمَّا في النار .
** فإن كان من أهل الجنة استراح وذهبت عنه تلك الشدائد والمشاق .
** وإن كان من أهل النار تَضَاعَفت عليه تلك الشدائد والمشاق أضعافا كثيرة .
** وفي ( تفسير القرطبي ) (20/ 62) :
{ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4) }
** إِلَى هُنَا انْتَهَى الْقَسَمُ، وَهَذَا جَوَابُهُ.
** وَلِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ بِمَا يَشَاءُ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ لِتَعْظِيمِهَا، كَمَا تَقَدَّمَ.
** وَالْإِنْسَانُ هُنَا ابْنُ آدَمَ.
** ( فِي كَبَدٍ ) أَيْ : فِي شِدَّةٍ وَعَنَاءٍ مِنْ مُكَابَدَةِ الدُّنْيَا.
** وَأَصْلُ ( الْكَبَدِ ) الشِّدَّةُ. وَمِنْهُ ( تَكَبَّدَ اللَّبَنُ ): غَلُظَ وَخَثَرَ وَاشْتَدَّ.
** وَمِنْهُ ( الْكَبِدُ) ، لِأَنَّهُ دَمٌ تَغَلَّظَ وَاشْتَدَّ.
** وَيُقَالُ: ( كَابَدْتُ هَذَا الْأَمْرَ): قَاسَيْتُ شِدَّتَهُ:
** قَالَ لَبِيدٌ:
يَا عَيْنُ هَلَّا بَكَيْتِ أَرْبَدَ إِذْ * * * قُمْنَا وَقَامَ الْخُصُومُ فِي كَبَدِ
** قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ: ( فِي كَبَدٍ ) أَيْ فِي شِدَّةٍ وَنَصَبٍ.
** وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: فِي شِدَّةٍ مِنْ حَمْلِهُ ، وَوِلَادَتِهِ ، وَرَضَاعِهِ ، وَنَبْتِ أَسْنَانِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِهِ.
** وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنْهُ قَالَ : مُنْتَصِبًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ.
** وَالْكَبَدُ: الِاسْتِوَاءُ وَالِاسْتِقَامَةُ.
** فَهَذَا امْتِنَانٌ عَلَيْهِ فِي الْخِلْقَةِ.
** وَلَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ دَابَّةً فِي بَطْنِ أُمِّهَا إِلَّا مُنْكَبَّةً عَلَى وَجْهِهَا إِلَّا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ مُنْتَصِبٌ انْتِصَابًا، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرهِمَا.
** ابْنُ كَيْسَانَ: مُنْتَصِبًا رَأْسُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَلَبَ رَأْسَهُ إِلَى رِجْلَيْ أُمِّهِ.
** وَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَابِدُ مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَشَدَائِدَ الْآخِرَةِ.
** وَعَنْهُ أَيْضًا: يُكَابِدُ الشُّكْرَ عَلَى السَّرَّاءِ وَيُكَابِدُ الصَّبْرَ عَلَى الضَّرَّاءِ، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِهِمَا. وَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ.
** وَقَالَ يَمَانٌ: لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ خَلْقًا يُكَابِدُ مَا يُكَابِدُ ابْنُ آدَمَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْخَلْقِ.
** ( قَالَ عُلَمَاؤُنَا ):
** أَوَّلُ مَا يُكَابِدُ قَطْعَ سُرَّتِهِ،
** ثُمَّ إذا قُمِطَ قِمَاطًا، وَشُدَّ رِبَاطًا، يُكَابِدُ الضِّيقَ وَالتَّعَبَ،
** ثُمَّ يُكَابِدُ الِارْتِضَاعَ، وَلَوْ فَاتَهُ لَضَاعَ،
** ثُمَّ يُكَابِدُ نَبْتَ أَسْنَانِهِ، وَتَحَرُّكَ لِسَانِهِ،
** ثُمَّ يُكَابِدُ الْفِطَامَ، الَّذِي هُوَ أَشَدُّ مِنَ اللِّطَامِ،
** ثُمَّ يُكَابِدُ الْخِتَانَ، وَالْأَوْجَاعَ وَالْأَحْزَانَ،
** ثُمَّ يُكَابِدُ الْمُعَلِّمَ وَصَوْلَتَهُ، وَالْمُؤَدِّبَ وَسِيَاسَتَهُ، وَالْأُسْتَاذَ وَهَيْبَتَهُ،
** ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ التَّزْوِيجِ وَالتَّعْجِيلَ فِيهِ ،
** ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ الْأَوْلَادِ، وَالْخَدَمِ وَالْأَجْنَادِ،
** ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ الدُّورِ، وَبِنَاءِ الْقُصُورِ،
** ثُمَّ الْكِبَرَ وَالْهَرَمَ، وَضَعْفَ الرُّكْبَةِ وَالْقَدَمِ، فِي مَصَائِبَ يَكْثُرُ تَعْدَادُهَا، وَنَوَائِبَ يَطُولُ إِيرَادُهَا، مِنْ :
صُدَاعِ الرَّأْسِ، وَوَجَعِ الْأَضْرَاسِ، وَرَمَدِ الْعَيْنِ، وَغَمِّ الدَّيْنِ، وَوَجَعِ السِّنِّ، وَأَلَمِ الْأُذُنِ. ** وَيُكَابِدُ مِحَنًا فِي الْمَالِ وَالنَّفْسِ، مِثْلَ الضَّرْبِ وَالْحَبْسِ، وَلَا يَمْضِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا يُقَاسِي فِيهِ شِدَّةً، وَلَا يُكَابِدُ إِلَّا مَشَقَّةً،
** ثُمَّ الموت بعد ذلك كله،
** ثم مسألة الْمَلَكِ، وَضَغْطَةَ الْقَبْرِ وَظُلْمَتَهُ ،
** ثُمَّ الْبَعْثَ وَالْعَرْضَ عَلَى اللَّهِ، إِلَى أَنْ يَسْتَقِرَّ بِهِ الْقَرَارُ، إِمَّا فِي الْجَنَّةِ وَإِمَّا فِي النَّارِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ ) ،
** فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ لَمَّا اخْتَارَ هَذِهِ الشَّدَائِدَ .
** وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ لَهُ خَالِقًا دَبَّرَهُ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَحْوَالِ، فَلْيَمْتَثِلْ أَمْرَهُ. اهـ
** قال أبو عبد الله ، وفقه الله :
( تنبيه ) :
** المعلوم أن مكَابِدة الْخِتَان تكون قبل مكَابِدة الْفِطَام ،
** فالْخِتَان في اليوم السابع ، والْفِطَام بعد الحولين .
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 12 / 10/ 1438 هـ
(58) فائدة اليوم بعنوان : ( ذكر بعض الألقاب والنسب التي على غير ظاهرها )
(1) يزيد الفقير ، لقب بذلك ؛ بسبب فقار الظهر لا من فقر المال .
** في ( شرح النووي على مسلم ) ،(3/ 50):
** (حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ) هُوَ يَزِيدُ بْنُ صُهَيْبٍ الْكُوفِيُّ ثُمَّ الْمَكِّيُّ أَبُو عُثْمَانَ ،
** قِيلَ لَهُ : الْفَقِيرُ ؛ لِأَنَّهُ أُصِيبَ فِي فَقَارِ ظَهْرِهِ فَكَانَ يَأْلَمُ مِنْهُ حَتَّى يَنْحَنِيَ لَهُ .
** وفي ( فتح الباري ) لابن حجر (1/ 436):
** قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِير ) هُوَ بن صُهَيْبٍ يُكَنَّى أَبَا عُثْمَانَ تَابِعِيُّ مَشْهُورٌ ،
** قِيلَ لَهُ : الْفَقِيرُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَشْكُوُ فَقَارِ ظَهْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ فَقِيرًا مِنَ الْمَالِ .
** قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ : رَجُلٌ فَقِيرٌ مَكْسُورُ فَقَارِ الظَّهْرِ ، وَيُقَالُ لَهُ : فَقِّيرٌ بِالتَّشْدِيدِ أَيْضًا . اهـ
(2) أبو حمزة السكري ، لقب بذلك ؛ بسبب حلاوة كلامه ، لا من بيعه السكر :
** وفي ( سير أعلام النبلاء ) ط الحديث (7/ 68):
** الحَافِظُ، الإِمَامُ، الحُجَّةُ، مُحَمَّدُ بنُ مَيْمُوْنٍ المَرْوَزي، عَالِمُ مَرْوٍ.
** وَلَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ السُّكَّرَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ السُّكَّرِيّ؛ لِحَلاَوَةِ كَلاَمِهِ. اهـ
(3) حميد الطويل ، لم يكن طويلا . وإنما لقب بذلك ؛ بسبب جاره حميد القصير .
** وقيل : بسبب طول في يديه .
** وفي كتاب : ( الوافي بالوفيات ) للصفدي ، (13/ 120):
** وَلم يكن بالطويل ، وَلَكِن كَانَ طَوِيل الْيَدَيْنِ يغسل الْمَوْتَى ،
فَإِذا وقف عِنْد رَأس الْمَيِّت تبلغ يَده رجل الْمَيِّت من طولهَا.
** وَقيل كَانَ فِي جِيرَانه رجل قصير سميُّه فَقَالَ الْجِيرَان لَهُ : الطَّوِيل تمييزاً .
(4) عبيد الله بن عبد الله الْيَهُودِيّ ، لم يكن يَهُودِيّا .
وإنما لقب بذلك ؛ بسبب أنه سكن درب الْيَهُود بِبَغْدَاد .
** وفي كتاب : ( نزهة الألباب في الألقاب ) لابن حجر (2/ 314):
3278 – ( الْيَهُودِيّ )
** جمَاعَة من أهل أَصْبَهَان من قَرْيَة الْيَهُودِيَّة ، وَعرف بهَا أَبُو مُحَمَّد عبيد الله بن عبد الله بن البيع صَاحب الْمحَامِلِي لِأَنَّهُ كَانَ يسكن درب الْيَهُود بِبَغْدَاد
3279 – وَمثله أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الْكَرِيم الْجِرْجَانِيّ كَانَ يسكن بَاب الْيَهُود بجرجان . اهـ
(5) مُعَاوِيَة بن عبد الْكَرِيم ( الضال ) ، لقب بذلك ؛ بسبب أنه ضل فِي طَرِيق مَكَّة .
(6) عبد الله بن مُحَمَّد ( الضَّعِيف ) ، لقب بذلك ؛ بسبب أنه كَانَ ضَعِيفا فِي بدنه لَا فِي حَدِيثه .
** وفي ( الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث ) (ص: 220):
** قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان: ** معاوية بن عبد الكريم ” الضال “، وإنما ضل في طريق مكة.
** وعبد الله بن محمد ” الضعيف “، وإنما كان ضعيفاً في جسمه، لا في حديثه.
(7) خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، لَمْ يَكُنْ حَذَّاءً، وإنما لقب بذلك ؛ بسبب أنه كان يجالس الحذائين .
** وفي كتاب : ( شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي ) ، (2/ 287):
( . . . وقريبٌ منْ ذلكَ: خالدٌ الحَذَّاءُ، وهوَ خالدُ بنُ مِهْرانَ.
** واختلِفَ في سببِ انتسابِهِ لذلكَ :
** فقالَ يزيدُ بنُ هارونَ فيما حكاهُ البخاريُّ في” التاريخ ” : ما حذا نعلاً قطُّ، إنما كانَ يجلسُ إلى حَذَّاءٍ فنسبَ إليهِ،
** وكذا قالَ محمدُ بنُ سعدٍ : (( لَمْ يكنْ بحذَّاءٍ، ولكنْ كانَ يجلسُ إليهمْ )) ،
** قالَ: وقالَ فهدُ بنُ حيَّانَ: لَمْ يَحذُ خالدٌ قطُّ، وإنما كانَ يقولُ: احذُ على هذا النحوِ؛ فلقِّبَ: الحذَّاءَ. اهـ
** وفي كتاب : ( مقدمة ابن الصلاح ) ، (ص: 373) :
النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ
مَعْرِفَةُ النِّسَبِ الَّتِي بَاطِنُهَا عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا الَّذِي هُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْهَا
** مِنْ ذَلِكَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو: لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ، وَلَكِنْ نَزَلَ بَدْرًا فَنُسِبَ إِلَيْهَا.
** سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ: نَزَلَ فِي تَيْمٍ وَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَوْلَى بَنِي مُرَّةَ.
** أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هُوَ أَسَدِيٌّ مَوْلَى لِبَنِي أَسَدٍ، نَزَلَ فِي بَنِي دَالَانَ بَطْنٍ مِنْ هَمْدَانَ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ.
** إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ: لَيْسَ مِنَ الْخُوزِ، إِنَّمَا نَزَلَ شِعْبَ الْخُوزِ بِمَكَّةَ.
** عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيُّ: نَزَلَ جَبَّانَةَ عَرْزَمٍ بِالْكُوفَةِ، وَهِيَ قَبِيلَةٌ مَعْدُودَةٌ فِي فَزَارَةَ، فَقِيلَ: عَرْزَمِيٌّ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الزَّايِ.
** مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، أَبُو بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ: بَاهِلِيٌّ نَزَلَ فِي الْعَوَقَةِ – بِالْقَافِ وَالْفَتْحِ – وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ.
** أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: جَلِيلٌ رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، هُوَ أَزْدِيٌّ عُرِفَ بِالسُّلَمِيِّ، لِأَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ سُلَمِيَّةً، ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ،
** وَأَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ حَفيِدُهُ،
** وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: مُصَنِّفُ الْكُتُبِ لِلصُّوفِيَّةِ، كَانَتْ أُمُّهُ ابْنَةَ أَبِي عَمْرٍو الْمَذْكُورِ، فَنُسِبَ سُلَمِيًّا، وَهُوَ أَزْدِيٌّ أَيْضًا جَدُّهُ ابْنُ عَمِّ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ.
** وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ وَيَلْتَحِقُ بِهِ :
** مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: هُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، لَزِمَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقِيلَ لَهُ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، لِلُزُومِهِ إِيَّاهُ.
** يَزِيدُ الْفَقِيرُ: أَحَدُ التَّابِعِينَ، وُصِفَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أُصِيبَ فِي فَقَارِ ظَهْرِهِ، فَكَانَ يَأْلَمُ مِنْهُ حَتَّى يَنْحَنِيَ لَهُ.
** خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: لَمْ يَكُنْ حَذَّاءً، وَوُصِفَ بِذَلِكَ لِجُلُوسِهِ فِي الْحَذَّائِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.اهـ
** قال أبو عبد الله ، وفقه الله :
** واستفدنا أكثر هذه الأسماء من دورس شيخنا ووالدنا علامة اليمن أبي عيد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ، رحمه الله رحمة الأبرار .
** فإنها كانت تمر علينا في دورسه فيسأل عنها ويقول –مثلا – :
** هل تحل الرواية عن عبيدالله بن عبد الله اليهودي ؟!
عندك ، عندك ، عندك ، حتى يمر السؤال على جماعة من الطلاب ،
** ثم يرفع أحد الطلاب يده فيجيب بالجواب الصحيح الذي قد عرفه سابقا من شيخنا ، رحمة الله عليه .
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 11 / 10/ 1438 هـ
(57) فائدة اليوم بعنوان : ( أنواع المحبة )
** قال الله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ } [البقرة: 165] .
** وَقال: { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [آل عمران31] .
** وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ” متفق عليه .
** قال ابن القيم – رحمه الله – في كتابه القيم : ( إغاثة اللهفان ) ، (2/ 140) :
** فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع:
** محبة الله ، ومحبة فى الله ، ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته.
** والمحبة الضارة ثلاثة أنواع :
** المحبة مع الله ، ومحبة ما يبغضه الله تعالى ، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها .
** فهذه ستة أنواع، عليها مدار محاب الخلق.
** فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة ، وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها .
** والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة ، والنوعان الآخران تبع لها.
** ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك ،
** وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد ،
** وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدا ، كان أبعد من عشق الصور ،
** ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق ، لشركها.
** ونجا منه يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه، قال تعالى: { كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ} [يوسف: 24] .
** فالسوء: العشق، والفحشاء: الزنا.
** فالمخلص قد خلص حبه لله ، فخلصه الله من فتنة عشق الصور.
** والمشرك قلبه متعلق بغير الله، لم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل .
اهـ المراد
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 10 / 10/ 1438 هـ
(56) فائدة اليوم بعنوان : ( ذكر أسماء الشهور والأيام العربية ، وسبب تسميتها ، وذكر جموعها )
** في : ( تفسير ابن كثير ) ، ط العلمية (4/ 128):
[فَصْلٍ] ذَكَرَ الشَّيْخُ عَلَمُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ فِي جُزْءٍ جَمَعَهُ سَمَّاهُ :
«الْمَشْهُورُ فِي أَسْمَاءِ الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ»
** أَنَّ ( الْمُحَرَّمَ ) سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِكَوْنِهِ شَهْرًا مُحَرَّمًا،
** وَعِنْدِي أَنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ تَأْكِيدًا لِتَحْرِيمِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَتَقَلَّبُ بِهِ فَتُحِلُّهُ عَامًا وَتُحَرِّمُهُ عَامًا .
** قَالَ وَيُجْمَعُ عَلَى : مُحَرَّمَاتٍ ، وَمَحَارِمَ ، ومحاريم .
** و( صفر ) سمي بذلك ، لخلو بيوتهم منهم حِينَ يَخْرُجُونَ لِلْقِتَالِ وَالْأَسْفَارِ .
** يُقَالُ : ( صَفِرَ الْمَكَانُ ) إِذَا خَلَا ، وَيُجْمَعُ عَلَى : ( أَصْفَارٍ ) كَجَمَلٍ وَأَجْمَالٍ،
** و( شهر رَبِيعٍ الْأَوَّلِ ) سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِارْتِبَاعِهِمْ فِيهِ .
** وَالِارْتِبَاعُ : الْإِقَامَةُ فِي عِمَارَةِ الرَّبْعِ ،
** وَيُجْمَعُ عَلَى : ( أَرْبِعَاءَ ) كنصيب وأنصباء ، وعلى ( أربعة ) كرغيف وأرغفة،
** و( ربيع الْآخِرُ ) كَالْأَوَّلِ .
** ( جُمَادَى ) سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِجُمُودِ الْمَاءِ فِيهِ ،
** قَالَ : وَكَانَتِ الشُّهُورُ فِي حِسَابِهِمْ لَا تَدُورُ .
** وَفِي هَذَا نَظَرٌ ؛ إِذْ كَانَتْ شُهُورُهُمْ منوطة بالأهلة فلا بُدَّ مِنْ دَوَرَانِهَا .
** فَلَعَلَّهُمْ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَا سُمِّيَ عِنْدَ جُمُودِ الْمَاءِ فِي الْبَرْدِ، كما قال الشاعر:
وَلَيلَةٍ مِنْ جُمَادَى ذَاتِ أَنْدِيَةٍ *** لَا يُبْصِرُ العبد في ظلمائها الطُّنُبَا
لَا يَنْبَحُ الْكَلْبُ فِيهَا غَيْرُ وَاحِدَةٍ *** حَتَّى يَلُفَّ عَلَى خُرْطُومِهِ الذَّنَبَا
** وَيُجْمَعُ عَلَى : ( جُمَادِيَاتٍ ) كَحُبَارَى وحُبَارِيَاتٍ .
** وَقَدْ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَيُقَالُ : ( جمادى الأولى والأول ، جمادى الْآخِرُ وَالْآخِرَةُ). ** ( رَجَبٌ ) مِنَ التَّرْجِيبِ ، وَهُوَ التَّعْظِيمُ .
** وَيُجْمَعُ عَلَى ( أَرْجَابٍ ، ورِجَابٍ ، ورَجَبَاتٍ ).
** ( شَعْبَانُ ) مِنْ تَشَعُّبِ الْقَبَائِلِ وَتَفَرُّقِهَا لِلْغَارَةِ .
** وَيُجْمَعُ عَلَى : ( شَعَابِينَ ، وشعبانات ) .
** ( رمضان ) مِنْ شِدَّةِ الرَّمْضَاءِ ، وَهُوَ الْحُرُّ . يُقَالُ : ( رَمِضَتِ الْفِصَالُ ) إِذَا عَطِشَتْ ،
** وَيُجْمَعُ عَلَى : ( رَمَضَانَاتٍ ، وَرَمَاضِينَ ، وَأَرْمِضَةٍ ) .
** قَالَ: وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ خَطَأٌ لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، ** قُلْتُ: قَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ ، وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَبَيَّنْتُهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصِّيَامِ .
** ( شَوَّالٌ ) مِنْ شَالَتِ الْإِبِلُ بِأَذْنَابِهَا لِلطِّرَاقِ .
** قَالَ : وَيُجْمَعُ عَلَى : ( شَوَاوِلَ وَشَوَاوِيلَ وَشَوَّالَاتٍ ).
** ( الْقَعْدَةُ ) بِفَتْحِ الْقَافِ ، قُلْتُ : وَكَسْرِهَا، لِقُعُودِهِمْ فِيهِ عَنِ الْقِتَالِ وَالتَّرْحَالِ ** وَيُجْمَعُ عَلَى ( ذَوَاتِ الْقَعْدَةِ ) .
** ( الْحِجَّةُ ) بكسر الحاء ، قلت : وفتحها ، سمي بذلك ؛ لإقامتهم الْحَجَّ فِيهِ ،
** وَيُجْمَعُ عَلَى : ( ذَوَاتِ الْحِجَّةِ ) .
(( أَسْمَاءُ الأيام )) :
** أولها : ( الأحد ) ، ويجمع على : ( آحاد ، وأوحاد ، ووحود ) ،
** ثُمَّ ( يَوْمُ الْاثْنَيْنِ ) وَيُجْمَعُ عَلَى : ( أَثَانِينَ ) ،
** ( الثُّلَاثَاءُ ) يُمَدُّ ، وَيُذَكَّرُ ، وَيُؤَنَّثُ .
** وَيُجْمَعُ عَلَى : ( ثَلَاثَاوَاتٍ ، وَأَثَالِثَ ) ،
** ثُمَّ ( الْأَرْبِعَاءُ ) بِالْمَدِّ ، وَيُجْمَعُ عَلَى : ( أَرْبَعَاوَاتٍ ، وَأَرَابِيعَ ) .
** ( وَالْخَمِيسُ ) ، يُجْمَعُ عَلَى : ( أَخْمِسَةٍ ، وَأَخَامِسَ ) .
** ثُمَّ ( الْجُمُعَةُ ) ، بِضَمِّ الْمِيمِ ، وَإِسْكَانِهَا ، وَفَتْحِهَا أَيْضًا ، وَيُجْمَعُ عَلَى :
( جمع ، وجماعات ) ،
** ( السَّبْتُ ) ، مَأْخُوذٌ مِنَ : السَّبْتِ ، وَهُوَ الْقَطْعُ :لِانْتِهَاءِ الْعَدَدِ عِنْدَهُ .
** وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْأَيَّامَ : أَوَّلَ ، ثُمَّ أَهْوَنَ ، ثُمَّ جُبَارَ ، ثُمَّ دُبَارَ ، ثُمَّ مؤنس ، ثم العروبة ، ثم شيار،
** قَالَ الشَّاعِرُ مِنَ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ الْعَارِبَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ: [الوافر]
أُرَجِّي أَنْ أَعِيشَ وَأَنَّ يَوْمِي *** بِأَوَّلَ أَوْ بِأَهْوَنَ أَوْ جُبَارِ
أَوِ التَّالِي دُبَارِ فِإِنْ أَفُتْهُ *** فَمُؤْنِسَ أَوْ عَرُوبَةَ أَوْ شِيَارِ . اهـ
** وفي ( شرح النووي على مسلم ) ، (1/ 183) :
** قَالَ النَّحَّاسُ : وَأُدْخِلَتِ ( الْأَلِفُ وَاللَّامُ ) فِي الْمُحَرَّمِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ . ** قَالَ : وَجَاءَ مِنَ الشُّهُورِ ثَلَاثَةُ مُضَافَاتٍ : شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَشَهْرَا رَبِيعٍ ،
يَعْنِي وَالْبَاقِي غَيْرُ مُضَافَاتٍ .
** وَسُمِّيَ الشَّهْرُ شَهْرًا : لِشُهْرَتِهِ وَظُهُورِهِ . اهـ
** وانظر كتاب :
( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ، (15/ 125) .
وكتاب : ( الأزمنة وتلبية الجاهلية ) ، لقُطْرُب (ص: 44) .
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 9 / 10/ 1438 هـ
(55) فائدة اليوم بعنوان : ( معرفة الحروف الزائدة، وذكر بعض التراكيب التي جمعت فيها )
** حروف الزيادة عشرةٌ، وهي : الهمزة، والألف، والهاء، والياء، والنون، والتاء، والسين، والميم، والواو، واللام .
** وَمعنى كَونهَا زائدةٌ : أنه لا يقع في كلام العرب حرف زائد في اسم ولا فعل إلا من هذه الأحرف ، لا أنها لا تقع إلا زائدة .
** وفي كتاب ( اللباب في علل البناء والإعراب )، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (2/ 223) :
** وَمعنى كَونهَا زائدةٌ أنَّها تكون فِي بعضِ الْمَوَاضِع زائدةٌ ، لَا فِي كلِّ موضعٍ ، بل قد تكون كلّها أصولاً أَلا ترى أنَّ : ( أَوَى ، وَيَوْم ، وسل ) كلّها أصُول . اهـ
** وفي كتاب ( تاج العروس ) (8/ 161) للزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ)
** قَالَ شيخُنا: وَقد أَورَدَ هذه الحروفَ العُلماءُ فِي كُتبهم، وجمعوها فِي تراكِيبَ مُخْتَلفَة، أَوْصَلُوهَا إِلى نحوِ مائةٍ ونَيّف وَثَلَاثِينَ تَركيباً.
** وَمن أَحسن ضَوَابطِها: قَول أَبي مُحَمَّد عبدِ المَجيد بن عَبدُونَ الفِهْرِيّ:
سَأَلْتُ الحُروفَ الزَّائداتِ عنِ اسْمِها * * * فقالَتْ وَلم تَكْذِب: أَمانٌ وتَسْهِيلُ
** قَالَ : وَمن ضوابطها: أَهْوَى تِلِمْسَانَ
** ونظَمَه الإِمام أَبو الْعَبَّاس أَحمد الْمقري فِي قَوْله :
قَالَتْ حُرُوفُ زِيَادَاتٍ لسائِلِهَا * * * هَوِيت من بَلْدةٍ: أَهْوَى تِلِمْسَانَا
** قَالَ: وجَمعها الشيخُ ابنُ مالِك أَربَع مرّاتٍ فِي أَربعةِ أَمثلة بِلَا حَشْو، فِي بيتٍ واحِد، مَعَ كمالِ العُذُوبة، فَقَالَ:
هَنَاءٌ وتَسْلِيمٌ ، تَلَا يَوْمَ أُنْسِهِ * * * نِهَايَةُ مَسْئولٍ ، أَمانٌ وتَسْهِيل
** وحُكِيَ أَنَّ أَبا عُثمانَ المازنيّ سُئل عَنْهَا فأَنْشَدَ:
هَوِيتُ السِّمانَ فَشَيَّبْنَنِي * * * وَقَدْ كُنْتُ قِدْماً هَوِيتُ السِّمَانا
** فَقيل لَهُ: أَجِبْنَا فَقَالَ: أَجبتكم مَرَّتين .
** ويروى أَنه قَالَ: سَأَلْتُمونِيها، فأَعطيتكم ثلاثةَ أَجوبَة . اهـ المراد
** وفي كتاب : ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )
لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (المتوفى: 1041هـ)
ت / إحسان عباس (3/ 455) :
** ( قلت : وعلى ذكر حروف الزيادة فقد أكثر الناس في انتقاء الكلمات الضابطة لها ، وقد كنت جمعت فيها نحو مائة ضابط ، ولنذكر الآن بعضها ، فنقول :
(( منها : . . . ثم قال : فهذه مائة وأربعة وثلاثون تركيباً، منها ما هو متين ، ومنها ما هو غير متين ، . . . ))
** وقال أيضا : (( وقد جمعت في المغرب زيادة على ما تقدم، وكنت قدرت رسالة فيها أسميها :
” إتحاف أهل السيادة بضوابط حروف الزيادة “. الخ )) . اهـ
** قلت : وقد ذكرت بعضا من هذه التراكيب على سبيل المثال ، ورتبتها على حروف الهجاء ، وهي كالتالي :
** فمن التراكيب المبدوءة بالهمزة :
( أسلم وانتهي ) ، ( أتلهو يا مسن ) ( أَسْهَلُ مَا تَنْوِي) ( أمان وتسهيل ) ، ( أيهما نتوسل ).
** ومن التراكيب المبدوءة بالألف :
( اسلمتونيها ) ، ( الْتَمَسْنَ هواي ) ، ( استَمَالَنِي هُوَ ) ، ( اسألي مؤنته ) ،
( استهون ألمي )
** ومن التراكيب المبدوءة بالتاء :
( تأوه سليمان ) ، ( تلا يوم أنسه ) ، ( تأَمَّلَهَا يُونُس ) ، ( تَيمَّن لي وَسهَا) ،
( تَسالمِي أَهْون ) .
** ومن التراكيب المبدوءة بالسين :
( سَأَلْتُمُونِيهَا ) ، ( سَائِل وانْتَهِمْ ) ، و ( سألتم هواني ) ، ( سأَلْتَنِي ما هُوَ ) ،
( سأَلتَ مَا يَهُونَ ) .
** ومن التراكيب المبدوءة باللام :
( لم يأتنا سهو ) ، ( لا أنسيتموه ) ، ( لأيهما نتوسم ) ، ( لهواء تنسمي)
(لسموه أتاني) .
** ومن التراكيب المبدوءة بالميم :
( ما أنت وسهيل ) ، ( مسألتي نواه ) ، ( مسألتي أهون ) ،
(ما سألت نهوي) ، ( ما تسأل يهون ) .
** ومن التراكيب المبدوءة بالنون :
( نويت أسالمه ) ، ( نويت ألمسها) ، ( نويت ألامسه ) ، ( نهاية مسؤول ) ،
( نهوي ما تسأل ) .
** ومن التراكيب المبدوءة بالواو :
(وَهِي أَسلمتنا ) ، ( واليتم أنسه ) ، ( وَنهى مَا تسأَل ) ،
( وإِنّي سأَلْتهم ) ، ( وَهَيّنٌ مَا سأَلت ) .
** ومن التراكيب المبدوءة بالهاء :
( هل أنت مواسي ) ،( هناء وتسليم ) ، ( هم يتساءلون ) ( هويتُ السّمان ) ،
( هُو لى استأْمَن ) .
** ومن التراكيب المبدوءة بالياء :
( يا أوس هل نمت ) ، ( يمنها أتوسل ) ، ( يَا هَوْلُ اسْتَنِمْ ) ، ( يتأملن سواه ) ،
( يهون ما سألت ) .
** ( تنبيه ) :
** (( قول الزبيدي : ** قَالَ شيخُنا : . . . ))
** في أرشيف منتدى الألوكة – 4 (ص: 0)
[ابو عبد الاله المسعودي]
** قلتُ: المقصودُ بشيخِه هنا، و في غيره من المواضع في الكتاب هو شيخُه:
أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي الشركي – وقد مر بنا في هذا الموضوع -، فقد كتب على القاموس شرحاً ..
** قال عنه الزبيدي 1/ 3
** “ومن أجمعِ ما كُتِبَ عليه (يعني القاموس) مما سَمِعْتُ ورأيتُ شَرْحَ شيخنا الإمام اللّغوي أبي عبد الله محمّد بن الطّيّب بن محمّد الفاسيّ،المتولد بفاس سنة 1110 و المتوفَّى بالمدينة المنورة سنة 1170،
** وهو عُمدتي في هذا الفنّ، والمقلد جيدي العاطل بحلى تقريره المستحسن، و شرحُه هذا عندي في مجلدَيْن ضَخميْن.” اهـ
** قلتُ : سمّى شرحه: ( إضاءة الراموس و إضافة الناموس على إضاءة القاموس ) انظر عن مخطوطاته وما طُبع منه، مقدمةَ محقّق كتابه ” فيض نشر الانشراح” ص 33 – 34 . اهـ
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 13 / 8 / 1438 هـ
(54) فائدة اليوم بعنوان : ( الإسناد من خصائص هذه الأمة )
قال النووي في كتابه : ( التقريب والتيسير ) ، (ص: 84)
النوع التاسع والعشرون // ( معرفة الإسناد العالي والنازل ) :
الإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة .
** وقال السيوطي في كتاب : ( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )،
(2/ 604) : (النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ :
** ( الْإِسْنَادُ ) فِي أَصْلِهِ ( خِصِّيصَةٌ ) فَاضِلَةٌ ( لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ) لَيْسَتْ لِغَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ.
** قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: نَقْلُ الثِّقَةُ عَنِ الثِّقَةِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الِاتِّصَالِ، خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ سَائِرِ الْمِلَلِ،
** وَأَمَّا مَعَ الْإِرْسَالِ وَالْإِعْضَالِ فَيُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ، لَكِنْ لَا يَقْرُبُونَ مِنْ مُوسَى قُرْبَنَا مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ يَقِفُونَ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُوسَى أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ عَصْرًا، وَإِنَّمَا يَبْلُغُونَ إِلَى شَمْعُونَ وَنَحْوِهِ.
** قَالَ: وَأَمَّا النَّصَارَى فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِفَةِ هَذَا النَّقْلِ إِلَّا تَحْرِيمُ الطَّلَاقِ فَقَطْ، وَأَمَّا النَّقْلُ بِالطَّرِيقِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى كَذَّابٍ أَوْ مَجْهُولِ الْعَيْنِ فَكَثِيرٌ فِي نَقْلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
** قَالَ : وَأَمَّا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَلَا يُمْكِنُ الْيَهُودُ أَنْ يَبْلُغُوا إِلَى صَاحِبِ نَبِيٍّ أَصْلًا، وَلَا إِلَى تَابِعٍ لَهُ، وَلَا يُمْكِنُ النَّصَارَى أَنْ يَصِلُوا إِلَى أَعْلَى مِنْ شَمْعُونَ وَبُولِصَ .
** وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ: خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، لَمْ يُعْطِهَا مَنْ قَبْلَهَا: الْإِسْنَادِ، وَالْأَنْسَابِ، وَالْإِعْرَابِ.
** وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ } ، قَالَ: إِسْنَادُ الْحَدِيثِ.
( وَسُنَّةٌ بَالِغَةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) ،
** قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
** وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ يَوْمًا بِحَدِيثٍ؛ فَقُلْتُ: هَاتِهِ بِلَا إِسْنَادٍ؛ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَتَرْقَى السَّطْحَ بِلَا سُلَّمٍ.
** وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ.
** (وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ سُنَّةٌ)
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ، لِأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَرْحَلُونَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ عُمَرَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ.
** وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطَّوْسِيُّ: قُرْبُ الْإِسْنَادِ قُرْبٌ – أَوْ قُرْبَةٌ – إِلَى اللَّهِ.
** (وَلِهَذَا اسْتُحِبَّتِ الرِّحْلَةُ)
كَمَا تَقَدَّمَ، قَالَ الْحَاكِمُ: وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ أَنَسٍ، «فِي الرَّجُلِ الَّذِي أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ كَذَا» ، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اهـ المراد
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 7 / 8 / 1438 هـ
(53) فائدة اليوم بعنوان : (من لطائف وظرائف كتاب : مغني اللبيب )
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: 33) :
** ( إِن ) الْمَكْسُورَة الْخَفِيفَة
** ترد على أَرْبَعَة أوجه
** أَحدهَا : أَن تكون شَرْطِيَّة نَحْو {إِن ينْتَهوا يغْفر لَهُم} {وَإِن تعودوا نعد}
** وَقد تقترن بِـ( لا ) النافية فيظن من لَا معرفَة لَهُ أَنَّهَا ( إِلَّا ) الاستثنائية نَحْو : { إِلَّا تنصروه فقد نَصره الله }،{ إِلَّا تنفرُوا يعذبكم }،{ وَإِلَّا تغْفر لي وترحمني أكن من الخاسرين }،{ وَإِلَّا تصرف عني كيدهن أصب إلَيْهِنَّ } .
** وَقد بَلغنِي أَن بعض من يَدعِي الْفضل سَأَلَ فِي { إِلَّا تفعلوه } فَقَالَ : مَا هَذَا الِاسْتِثْنَاء ؟ أمتصل أم مُنْقَطع ؟
** وفي صـ(697) :
** حُكيَ عَن اليزيدي أَنه قَالَ فِي قَول العرجي
937 – ( أظلوم إِن مصابكم رجلا … رد السَّلَام تَحِيَّة ظلم )
: إِن الصَّوَاب ( رجل ) بِالرَّفْع خَبرا لـ( إن ) .
** وعَلى هَذَا الْإِعْرَاب يفْسد الْمَعْنى المُرَاد فِي الْبَيْت وَلَا يتَحَصَّل لَهُ معنى الْبَتَّةَ .
** وَله حِكَايَة مَشْهُورَة بَين أهل الْأَدَب .
** رووا عَن أبي عُثْمَان الْمَازِني : أَن بعض أهل الذِّمَّة بذل لَهُ مئة دِينَار على أَن يقرئه كتاب سِيبَوَيْهٍ ، فَامْتنعَ من ذَلِك ، مَعَ مَا كَانَ بِهِ من شدَّة احْتِيَاج .
** فلامه تِلْمِيذه الْمبرد ، فَأَجَابَهُ بِأَن الْكتاب مُشْتَمل على ثلاثمئة وَكَذَا كَذَا آيَة من كتاب الله تَعَالَى ، فَلَا يَنْبَغِي تَمْكِين ذمِّي من قرَاءَتهَا .
** ثمَّ قدر أَن غنت جَارِيَة بِحَضْرَة الواثق بِهَذَا الْبَيْت ، فَاخْتلف الْحَاضِرُونَ فِي نصب رجل وَرَفعه ، وأصرت الْجَارِيَة على النصب ، وَزَعَمت أَنَّهَا قرأته على أبي عُثْمَان كَذَلِك ، فَأمر الواثق بإشخاصه من الْبَصْرَة ، فَلَمَّا حضر أوجب النصب ، وَشَرحه بِأَن : ( مصابكم ) بِمَعْنى : ( إصابتكم ) ، و ( رجلا ) مَفْعُوله و ( ظلم ) ، الْخَبَر ، وَلِهَذَا لَا يتم الْمَعْنى بِدُونِهِ .
قَالَ : فَأخذ اليزيدي فِي معارضتي ، فَقلت لَهُ : وَهُوَ كَقَوْلِك : ( إِن ضربك زيدا ظلم ) ، فَاسْتَحْسَنَهُ الواثق ، ثمَّ أَمر لَهُ بِأَلف دِينَار ورده مكرما .
فَقَالَ للمبرد : تركنَا لله مئة دِينَار فعوضنا ألفا .
** وفي صـ(877) :
** وَحكى العسكري فِي كتاب التَّصْحِيف : أَنه قيل لبَعْضهِم : مَا فعل أَبوك بحماره فَقَالَ : بَاعه .
فَقيل لَهُ : لم قلت : بَاعه .
قَالَ : فَلم قلت أَنْت : بحماره .
فَقَالَ : أَنا جررته بِالْبَاء .
فَقَالَ : فَلم تجر باؤك وبائي لَا تجر ؟
** وَمثله من الْقيَاس الْفَاسِد : مَا حَكَاهُ أَبُو بكر التاريخي فِي كتاب أَخْبَار النَّحْوِيين : أَن رجلا قَالَ لسماك بِالْبَصْرَةِ : بكم هَذِه السَّمَكَة ؟
فَقَالَ : بدرهمان .
فَضَحِك الرجل .
فَقَالَ السماك : أَنْت أَحمَق ، سَمِعت سِيبَوَيْهٍ يَقُول : ثمنهَا دِرْهَمَانِ .
** وَقلت يَوْمًا : ترد الْجُمْلَة الاسمية الحالية بِغَيْر وَاو فِي فصيح الْكَلَام خلافًا للزمخشري كَقَوْلِه تَعَالَى : { وَيَوْم الْقِيَامَة ترى الَّذين كذبُوا على الله وُجُوههم مسودة } .
** فَقَالَ بعض من حضر : هَذِه الْوَاو فِي أَولهَا.
** وَقلت يَوْمًا : الْفُقَهَاء يلحنون فِي قَوْلهم : ( البايع ) بِغَيْر همز .
فَقَالَ قَائِل : فقد قَالَ الله تَعَالَى : { فبايعهن }
** وَقَالَ الطَّبَرِيّ فِي قَوْله تَعَالَى { أَثم إِذا مَا وَقع } إِن ( ثمَّ ) بِمَعْنى هُنَالك .
** وَقَالَ جمَاعَة من المعربين فِي قَوْله تَعَالَى { وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤمنِينَ } فِي قِرَاءَة ابْن عَامر وَأبي بكر بنُون وَاحِدَة : إِن الْفِعْل مَاض .
وَلَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ آخِره مَفْتُوحًا وَ( الْمُؤمنِينَ ) مَرْفُوعا .
فَإِن قيل : سكنت الْيَاء للتَّخْفِيف كَقَوْلِه
1128 – (هُوَ الْخَلِيفَة فارضوا مَا رَضِي لكم … )
وأقيم ضمير الْمصدر مقَام الْفَاعِل .
قُلْنَا : الإسكان ضَرُورَة ، وَإِقَامَة غير الْمَفْعُول بِهِ مقَامه مَعَ وجوده ممتنعة ، بل إِقَامَة ضمير الْمصدر ممتنعة وَلَو كَانَ وَحده لِأَنَّهُ مُبْهَم .
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 3 / 8 / 1438 هـ
(52) فائدة اليوم بعنوان : ( الفرق بين : علم اليقين ، وعين اليقن ، وحق القين ) :
** اليقين ثلاث مراتب : علم اليقين ؛ وعين اليقين ؛ وحق اليقين ؛ فأدناها الأولى وأعلاها الأخيرة ، وكلها مذكورة في القرآن .
** قال الله تعالى في سورة الواقعة : { إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }
** وقال في سورة التَّكَاثُرُ: { كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ }
** فعلم اليقين : هو اليقين الجازم الذي يعلمه الإنسان بالدليل الشرعي أو العقلي .
** وعين اليقين : هو الذي يحصل بمشاهدة الشيء بعد العلم اليقيني به .
** وحق اليقين: هو الذي يحصل بمباشرة الشيء بعد العلم اليقيني به ومشاهدته .
قال ابن القيم في كتابه القيم : ( مدارج السالكين ) ، (2/ 379):
** الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِ الْيَقِينِ وَعَيْنِ الْيَقِينِ: كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْخَبَرِ الصَّادِقِ وَالْعَيَانِ.
** وَحَقُّ الْيَقِينِ: فَوْقَ هَذَا.
** وَقَدْ مَثَّلْتُ الْمَرَاتِبَ الثَّلَاثَةِ بِمَنْ أَخْبَرَكَ: أَنَّ عِنْدَهُ عَسَلًا، وَأَنْتَ لَا تَشُكُّ فِي صِدْقِهِ. ثُمَّ أَرَاكَ إِيَّاهُ. فَازْدَدْتَ يَقِينًا. ثُمَّ ذُقْتَ مِنْهُ.
** فَالْأَوَّلُ: عِلْمُ الْيَقِينِ. وَالثَّانِي: عَيْنُ الْيَقِينِ. وَالثَّالِثُ: حَقُّ الْيَقِينِ.
** فَعِلْمُنَا الْآنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ: عِلْمُ يَقِينٍ.
** فَإِذَا أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ فِي الْمَوْقِفِ لِلْمُتَّقِينَ وَشَاهَدَهَا الْخَلَائِقُ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. وَعَايَنَهَا الْخَلَائِقُ. فَذَلِكَ: عَيْنُ الْيَقِينِ.
** فَإِذَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ: فَذَلِكَ حِينَئِذٍ حَقُّ الْيَقِينِ . اهـ
** وقال الله تعالى في سورة البقرة [260] عن خليله إبراهيم : { رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْييِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي }
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده الخبر اليقين بأن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى ؛ ولكنه أرد المرتبة الأعلى منها وهي مرتبة المشاهدة ، وهي : ( عين اليقين ) .
** وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ،
فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا، أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ ” رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الشيخان ( الألباني والوادعي ) عليهما رحمة الله .
** وقال الشَّاعِرِ:
يا ابنَ الكرامِ ألا تَدْنُو فَتُبْصِرَ ما … قَدْ حَدَّثُوكَ فَمَا راءٍ كمَنْ سمَعَا .
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 3 / 8 / 1438 هـ
(51) فائدة اليوم بعنوان : ( أهمية حديث ( الأعمال بالنيات ) ، وذكر بعض الكتب التي بدأت به )
** هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والهامة التي عليها مدار الإسلام .
** قال الإمام النووي رحمه في : ( المجموع شرح المهذب ) ، (1/ 16) :
** حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ .
** مُجْمَعٌ عَلَى عِظَمِ مَوْقِعِهِ وَجَلَالَتِهِ .
** وَهُوَ إحْدَى قَوَاعِدِ الْإِيمَانِ وَأَوَّلُ دَعَائِمِهِ وَآكَدُ الْأَرْكَانِ .
* قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَدْخُلُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنْ الْفِقْهِ .
** وَقَالَ أَيْضًا هُوَ ثُلُثُ الْعِلْمِ .
** وَكَذَا قَالَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ
** وَهُوَ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَامِ .
** وَإِنَّمَا بَدَأْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَأَسِّيًا بِأَئِمَّتِنَا وَمُتَقَدِّمِي أَسْلَافِنَا مِنْ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
** وَقَدْ ابْتَدَأَ بِهِ إمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِلَا مُدَافَعَةٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البخاري صَحِيحِهِ .
وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ افْتِتَاحَ الْكُتُبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنْبِيهًا لِلطَّالِبِ عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ ، وَإِرَادَتِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ أَعْمَالِهِ الْبَارِزَةِ وَالْخَفِيَّةِ .
** وَرَوَيْنَا عَنْ الْإِمَامِ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : لَوْ صَنَّفْتُ كِتَابًا بَدَأْتُ فِي أَوَّلِ كُلِّ بَابٍ مِنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
** وَرَوَيْنَا عَنْهُ أيضا قال : من راد أَنْ يُصَنِّفَ كِتَابًا فَلْيَبْدَأْ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
** وَقَالَ الامام أبو سليمان أحمد بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِيُّ الشَّافِعِيُّ الْإِمَامُ في علوم رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : كَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ شُيُوخِنَا يَسْتَحِبُّونَ تَقْدِيمَ حَدِيثِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ أَمَامَ كُلِّ شئ يُنْشَأُ وَيُبْتَدَأُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهَا .اهـ المراد باختصار يسير .
** وقال رحمه الله في شرحه على مسلم (13/ 53)
بعد أن ذكر شيئا مما تقدم :
** وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وغيره فابتدؤا به قبل كل شئ .
** وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ ، اهـ المراد .
** وممن بدأ به :
** الإمام البخاري في : ( صحيحه ) كما تقدم .
** وبدأ به الإمام النووي في كتبه :
( الأذكار ) ، و : ( رياض الصالحين ) ، و: ( الأربعين النووية) ، ** والبغوي في كتابيه : ( مصابيح السنة ) ، و: ( شرح السنة) .
** والسيوطي، في كتابه : ( الجامع الصغير ) ،
** وعبد الغني المقدسي في كتابه : ( عمدة الأحكام ) ،
** والبيحاني رحمه الله في كتابه : ( إصلاح المجتمع ) .
** ( فائدة وتنبيه ) :
هذا الحديث فؤائده كثيرة جدا فقد أوصلها الحافظ العراقي رحمه الله إلى ثلاث وَستينَ فائدة كما في كتابه القيم : ( طرح التثريب في شرح التقريب ) ، (2 / 29) .
(50) فائدة اليوم بعنوان : ( فضل شعبان ، ولا يقال : شعبان الأكرم ، وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله تارة ، وأكثره تارة أخرى )
** عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ : ( ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ) رواه أحمد وغيره [وحسنه الألباني]
** وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . متفق عليه
** وفي رواية لمسلم 🙁 … وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا (
** وعَنْها رضي الله عنه قالت 🙁 كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ: شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ) رواه أبو داود وصححه الألباني
صحيح الترغيب والترهيب (1/ 597)
** وفي ( شرح النووي على مسلم ) ، (8/ 37) :
** وَقَوْلُهَا : ( كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا ) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلْأَوَّلِ وَبَيَانٌ أَنَّ قَوْلَهَا كُلَّهُ أَيْ غَالِبَهُ .
** وَقِيلَ : كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ فِي وَقْتٍ ، وَيَصُومُ بَعْضَهُ فِي سَنَةٍ أُخْرَى .
** وَقِيلَ : كَانَ يَصُومُ تَارَةً مِنْ أَوَّلِهِ وَتَارَةً مِنْ آخِرِهِ وَتَارَةً بَيْنَهُمَا ، وَمَا يُخَلِّي مِنْهُ شَيْئًا بِلَا صِيَامٍ لَكِنْ فِي سِنِينَ .
** وَقِيلَ فِي تَخْصِيصِ شَعْبَانَ بِكَثْرَةِ الصَّوْمِ : لِكَوْنِهِ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ .
** وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ .
** فَإِنْ قِيلَ : سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : ( أَنَّ أَفْضَلَ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ ) فَكَيْفَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ .
** فَالْجَوَابُ : لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِ إِلَّا فِي آخِرِ الْحَيَاةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ.
** أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِضُ فِيهِ أَعْذَارٌ تَمْنَعُ مِنْ إِكْثَارِ الصَّوْمِ فِيهِ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَغَيْرِهِمَا ** قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَإِنَّمَا لَمْ يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه .
** وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“يطَّلع اللهُ إلى جميعِ خلقِه ليلةَ النصفِ من شعبانَ ، فيغفرُ لجميعِ خلقه إلا لمشركٍ ، أو مُشاحن ” . رواه الطبراني وابن حبان في “صحيحه” .
[وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح]** والمشرك : كل من أشرك مع الله شيئا في ذاته تعالى أو في صفاته أو في عبادته .
** والمشاحن :
** قال ابن الأثير في كتابه : ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ، (2/ 449) :
** الْمُشَاحِنُ: المُعاَدِي ،
** والشَّحْنَاءُ العَداوة. والتَّشَاحُنُ تفاعُل مِنْهُ.
** وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَرَادَ بِالْمُشَاحِنِ هَاهُنَا صاحبَ البِدْعة المُفارق لجَماعة الأُمة. اهـ
** وفي كتاب : ( لطائف المعارف ) لابن رجب ، (ص: 134)
** وقد قيل: في صوم شعبان معنى آخر: أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط .
** ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن .
** روينا بإسناد ضعيف عن أنس قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان .
** وقال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء .
** وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء .
** وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن .
** قال الحسن بن سهل: قال شعبان: يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي؟ قال: جعلت فيك قراءة القرآن .
** يا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها.
مضى رجب وما أحسنت فيه * * * وهذا شهر شعبان المبارك
فيا من ضيع الأوقات جهلا * * * بحرمتها أفق واحذر بوارك
فسوف تفارق اللذات قسرا * * * ويخلي الموت كرها منك دارك
تدارك ما استطعت من الخطايا * * * بتوبة مخلص واجعل مدارك
على طلب السلامة من جحيم * * * فخير ذوي الجرائم من تدارك
** وفي كتاب : ( لطائف المعارف ) لابن رجب (ص: (138 :
** ويتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في تلك الليلة
** وقد روي: أنها: الشرك وقتل النفس والزنا .
** وهذه الثلاثة أعظم الذنوب عند الله كما في حديث ابن مسعود المتفق على صحته أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال “أن تجعل لله ندا وهو خلقك” قال: ثم أي؟ قال: “أن تقتل ولدك خسية أن يطعم معك” قال: ثم أي؟ قال: “أن تزاني حليلة جارك” فأنزل الله تعالى ذلك: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68] الآية ** ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضا الشحناء وهي حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه
** وذلك يمنع أيضا من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: “تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا”
** وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
** ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا .
** وعن الأوزاعي أنه قال : المشاحن : كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة .
** وكذا قال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الطاعن على أمته السافك دماءهم .
** وهذا الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم . اهـ
** وفي كتاب : ) معجم المناهي اللفظية ) لبكر بن عبد الله أبو زيد ،(ص: 308):
** ( شعبان الأكرم ) :
** لا يعرف في السُّنَّة إثبات فضل لشهر شعبان إلا ما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من إكثار الصيام فيه،
** وأما حديث: (( فضل شعبان على سائر الشهور كفضلي على سائر الأنبياء )) فهو موضوع.
** قال ابن عاشور – رحمه الله تعالى -:
((ولعلَّ هذا الحديث هو الذي حمل الكُتاب على أن يُتْبِعُون اسم شعبان بوصف الأكرم، وهو فُضُوْلٌ زايد)) انتهى .
** (( تنبيه )) :
لم يثبت – فيما أعلم – تحصيص ليلة أو يوم النصف من شعبان بعبادة من العبادات.
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 29/ 7 / 1438 هـ
(49) فائدة اليوم بعنوان : ( ذكر الصور التي يتألف منها الكلام جملة وتفصيلا )
** فائدة :
** قال الأزهري في كتابه : ( شرح التصريح ) ، (1/ 15) :
والتألُّف والتأليف: وقوع الألفة والتناسب بين الجزأين. وهو أخص من التركيب، إذ التركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، فكل مؤلف مركب من غير عكس . اهـ
** وقد تتبع النحويون كلام العرب شعره ونثره ، فوجدوا أن الصور التي يتألف منها الكلام سبع صور على سبيل الإجمال – وثلاث عشرة صورة على سبيل التفصيل :
الأولى : أن يتألف من اسمين .
الثانية : أن يتألف من فعل واسم .
الثالثة : أن يتألف من جملتين .
الرابعة : أن يتألف من فعل واسمين .
الخامسة : أن يتألف من فعل وثلاثة أسماء .
السادسة : أن يتألف من فعل وأربعة أسماء،
السابعة : أن يتألف من اسم وجملة .
فهذه سبع صور على وجه الإجمال .
** وأما على وجه التفصيل:
فالمؤلف من اسمين له أربع صور؛ لأن الاسمين:
** إما مبتدأ وخبر، نحو: ” محمد عالم ”
** وإما مبتدأ وفاعل، سدَّ مسدَّ الخبر، نحو: ” أمسافر الزيدان ”
** وإما مبتدأ ونائب فاعل، سد مسد الخبر، نحو: ” أمضروب الزيدون ”
** وإما اسم فعل وفاعله نحو ” هيهات العقيق “.
والمؤلف من فعل اسم، له صورتان؛ لأنه :
** إما من فعل وفاعل نحو ” قام زيد ” ،
** ومنه “استقم”؛ فإنه من فعل الأمر المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر بـ”أنت”.
** ومنه أيضا : المنادى نحو : ( يا زيد ) ؛ لأنه في الأصل مؤلف من الفعل المحذوف مع فاعله المستتر فيه ، وما بعده فُضْلَةٌ لأنه مفعول به ، والتقدير :
( أدعو زيدا ) .
** وإما من فعل ونائب فعل نحو ” يكرم المجتهد “.
والمؤلف من جملتين، له صورتان ؛ لأن الجملتين :
** إما جملتا القسم وجوابه ، نحو: ” أقسمت بالله لأكرمنك ”
** وإما جملتا الشرط وجوابه ، نحو” إن يجتهد زيد ينجح “.
** والمؤلف من فعل واسمين ، له صورة واحدة، وهي ” كان ” أو إحدى أخواتها مع اسمها وخبرها، نحو قولك : ” كان المطر غزيرا ” و” أصبح البرد شديدا “.
** والمؤلف من فعل وثلاثة أسماء، له صورة واحدة أيضا ، وهي ” ظن ” أو إحدى أخواتها مع فاعلها ومفعوليها ، نحو ” ظننت بكرا مسافرا “. و ” وجدت العلم نافعا ”
** والمؤلف من فعل وأربعة أسماء ، له صورة واحدة أيضا ، وهي : ” أعلم ” أو إحدى أخواتها مع فاعلها ومفعولاتها ، نحو ” أعلمت زيدا عمرا منطلقا ”
و ” أريت خالدا بكرا أخاك “.
** والمؤلف من اسم وجملة له صورتان ؛ لأنه :
** إما من اسم وجملة اسمية نحو : ” زيد أبوه قائم ” .
** وإما من اسم وجملة فعلية نحو : ” زيد قام أبوه ” .
** (( تنبيه )) :
** ذهب بعضهم إلى أن الكلام بقي له صورة ثامنة يتألف منها ، وهي : أن يكون مؤلفا من حرف واسم ، نحو 🙁 أَلا مَاء ) فهذا كلَام تام مؤلف من حرف وَاسم ؛ وَإِنَّمَا تمّ الْكَلَام بذلك حملا على مَعْنَاهُ ، وَهُوَ : ( أَتَمَنَّى مَاء ) .
** فـ( الهمزة ) حرف استفهام يراد به التمني ،
** و ( لا ) نافية للجنس ، و ( ماء) اسمها ،
** وليس لها خبر لا لفظا ولا تقديرا ؛ لِأَن ( أَلا ) الَّتِي لِلتَّمَنِّي لَا خبر لَهَا عِنْد سِيبَوَيْهٍ لفظا وَلَا تَقْديرا .
** وخالفه الْمَازِني والمبرد فذهبا إلى أن ( أَلا ) الَّتِي لِلتَّمَنِّي لها خبر محذوف تقديره : ( موجود ، أو حاضر ) أو نحو ذلك .
** وعلى هذا الأخير يكون الكلام مؤلفا من اسمين وهما : اسم ( لا ) وحبرها المحذوف اللذان أصلهما متدأ وخبر ، وليس من حرف واسم .
والله أعلم
من المراجع :
** شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (2/ 21)
** شرح قطر الندى صـ ( 61 ) مع حاشية السجاعي .
** ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: 499)
** وحاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/ 37)
** وحاشية الخضري على ابن عقيل (1/ 36)
** وحاشية أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (1/ 34) ليوسف الشيخ محمد البقاعي .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 25/ 7 / 1438 هـ
** والله الموفق .
(48) فائدة اليوم بعنوان : ( ذُّنُوب العباد كلها لا تَخْرُجُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : مَلَكِيَّةٍ ، وَشَيْطَانِيَّةٍ ، وَسَبُعِيَّةٍ ، وَبَهِيمِيَّةٍ ، وهَذِهِ الذُّنُوبُ الأَرْبَعَة ترجع إلى قسمين أساسين ، وهما : تَرْكُ مَأْمُورٍ، وَفِعْلُ مَحْظُورٍ )
** قال ابن القيم رحمه الله في كتابه : ( الجواب الكافي ) (ص: 123) :
فَصْلٌ :
وَلَمَّا كَانَتِ الذُّنُوبُ مُتَفَاوِتَةً فِي دَرَجَاتِهَا وَمَفَاسِدِهَا تَفَاوَتَتْ عُقُوبَاتُهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِحَسَبِ تَفَاوُتِهَا.
وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِيهَا بِعَوْنِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ فَصْلًا وَجِيزًا جَامِعًا، فَنَقُولُ:
أَصْلُهَا نَوْعَانِ: تَرْكُ مَأْمُورٍ، وَفِعْلُ مَحْظُورٍ، وَهُمَا الذَّنْبَانِ اللَّذَانِ ابْتَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِمَا أَبَوَيِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.
** وَكِلَاهُمَا يَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ مَحِلِّهِ إِلَى ظَاهِرٍ عَلَى الْجَوَارِحِ، وَبَاطِنٍ فِي الْقُلُوبِ.
** وَبِاعْتِبَارِ مُتَعَلَّقِهِ إِلَى حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ خَلْقِهِ.
وَإِنْ كَانَ كُلُّ حَقٍّ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِحَقِّهِ، لَكِنْ سُمِّي حَقًّا لِلْخَلْقِ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِمُطَالَبَتِهِمْ وَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِمْ.
** ثُمَّ هَذِهِ الذُّنُوبُ تَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ :
مَلَكِيَّةٍ ، وَشَيْطَانِيَّةٍ ، وَسَبُعِيَّةٍ ، وَبَهِيمِيَّةٍ ، وَلَا تَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ .
** فَالذُّنُوبُ الْمَلَكِيَّةُ أَنْ يَتَعَاطَى مَا لَا يَصِحُّ لَهُ مِنْ صِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ، كَالْعَظَمَةِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْجَبَرُوتِ، وَالْقَهْرِ، وَالْعُلُوِّ، وَاسْتِعْبَادِ الْخَلْقِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
** وَيَدْخُلُ فِي هَذَا شِرْكٌ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ نَوْعَانِ:
* شِرْكٌ بِهِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَجَعْلُ آلِهَةٍ أُخْرَى مَعَهُ،
* وَشِرْكٌ بِهِ فِي مُعَامَلَتِهِ، وَهَذَا الثَّانِي قَدْ لَا يُوجِبُ دُخُولَ النَّارِ، وَإِنْ أَحْبَطَ الْعَمَلَ الَّذِي أَشْرَكَ فِيهِ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ.
** وَهَذَا الْقِسْمُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الذُّنُوبِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ،
** فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الذُّنُوبِ، فَقَدْ نَازَعَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَمُلْكِهِ، وَجَعَلَ لَهُ نِدًّا، وَهَذَا أَعْظَمُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا يَنْفَعُ مَعَهُ عَمَلٌ.
** وَأَمَّا الشَّيْطَانِيَّةُ: فَالتَّشَبُّهُ بِالشَّيْطَانِ فِي الْحَسَدِ، وَالْبَغْيِ وَالْغِشِّ وَالْغِلِّ وَالْخِدَاعِ وَالْمَكْرِ، وَالْأَمْرِ بِمَعَاصِي اللَّهِ وَتَحْسِينِهَا، وَالنَّهْيِ عَنْ طَاعَتِهِ وَتَهْجِينِهَا، وَالِابْتِدَاعِ فِي دِينِهِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ.
** وَهَذَا النَّوْعُ يَلِي النَّوْعَ الْأَوَّلَ فِي الْمَفْسَدَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَفْسَدَتُهُ دُونَهُ.
** وَأَمَّا السَّبُعِيَّةُ : فَذُنُوبُ الْعُدْوَانِ وَالْغَضَبِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَالتَّوَثُّبِ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَالْعَاجِزِينَ،
** وَيَتَوَلَّدُ مِنْهَا أَنْوَاعُ أَذَى النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ وَالْجَرْأَةِ عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ.
** وَأَمَّا الذُّنُوبُ الْبَهِيمِيَّةُ: فَمِثْلُ الشَّرَهِ وَالْحِرْصِ عَلَى قَضَاءِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ، ** وَمِنْهَا يَتَوَلَّدُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَأَكْلُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالْبُخْلُ، وَالشُّحُّ، وَالْجُبْنُ، وَالْهَلَعُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
** وَهَذَا الْقِسْمُ أَكْثَرُ ذُنُوبِ الْخَلْقِ لِعَجْزِهِمْ عَنِ الذُّنُوبِ السَّبُعِيَّةِ وَالْمَلَكِيَّةِ ،
** وَمِنْهُ يَدْخُلُونَ إِلَى سَائِرِ الْأَقْسَامِ، فَهُوَ يَجُرُّهُمْ إِلَيْهَا بِالزِّمَامِ، فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ إِلَى الذُّنُوبِ السَّبُعِيَّةِ، ثُمَّ إِلَى الشَّيْطَانِيَّةِ، ثُمَّ مُنَازَعَةِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَالشِّرْكِ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ،
** وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا حَقَّ التَّأَمُّلِ، تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الذُّنُوبَ دِهْلِيزُ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَمُنَازَعَةِ اللَّهِ رُبُوبِيَّتَهُ . اهـ بتصرف يسير
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 23 / 7 / 1438 هـ
** والله الموفق .
(47) فائدة اليوم بعنوان : ( صفات المنافقين في الصلاة )
** قال تعالى: ِ { إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً } .
** وفي سنن أبي داود (1/ 112)
413 – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» [حكم الألباني] : صحيح .انتهى .
وأصله في مسلم .
** عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مَنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ » رواه مسلم
** فهذه ست صفات في الصلاة من علامات النفاق :
(1) الكسل عند القيام إليها،
(2) مراءاة الناس في فعلها،
(3) تأخيرها،
(4) نقرها،
(5) قلة ذكر الله فيها،
(6) التخلف عن جماعتها.
** المرجع / الصلاة وأحكام تاركها (ص: 123) لابن القيم
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 5 / 7 / 1438 هـ
** والله الموفق .
(46) فائدة اليوم بعنوان : ( الزنا جريمة عظيمة ، وبعضه أشد جرما من بعض )
** قَالَ اللَّهُ تعالى { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (68) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً (69) }[ الْفَرْقَان ] ** وقَالَ اللَّهُ تعالى { وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا } [الْإِسْرَاءِ: 32]
** وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: « سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ،
قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ،
قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ »
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [سُورَةُ الْفُرْقَانِ 68] .
** وعن الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَدِ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : ” مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ ” قَالُوا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: ” لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ “، قَالَ: فَقَالَ: ” مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ ” قَالُوا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ، قَالَ: ” لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ ” رواه الإمام أحمد وصححه الشيخان .
** وعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ ؟ » رواه مسلم
** قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا أَعْلَمُ بَعْدَ الْقَتْلِ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا .
** قال الإمام النووي في شرحه على مسلم (2/ 81)
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ )
هِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِكَوْنِهَا تَحِلُّ لَهُ .
وَقِيلَ : لِكَوْنِهَا تَحِلُّ مَعَهُ .
وَمَعْنَى ( تُزَانِي ) أى : تزنى بها برضاها ، وذلك يتضمن الزنى ، وَإِفْسَادَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وَاسْتِمَالَةَ قَلْبِهَا إِلَى الزَّانِي ، وَذَلِكَ أَفْحَشُ ، وَهُوَ مَعَ امْرَأَةِ الْجَارِ أَشَدُّ قُبْحًا وَأَعْظَمُ جُرْمًا ؛ لِأَنَّ الْجَارَ يَتَوَقَّعُ مِنْ جَارِهِ الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمِهِ ، وَيَأْمَنُ بَوَائِقَهُ ، وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، فاذا قابل هذا كله بالزنى بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادِهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّنُ غَيْرُهُ مِنْهُ كَانَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْقُبْحِ . اهـ
** وقال الإمام القرطبيُّ في كتابه : ( المفهم ) ، (12/ 44)
وقوله : (( فما ظنكم )) ؛ يعني : أن المخونَ في أهله إذا مُكن مِن أخْذ حسنات الخائن لم يُبْقِ له منها شيئًا ، ويكون مصيرُه إلى النار . وقد اقتُصِرَ على مفعول الظن .
وظَهَرَ مِن هذا الحديث : أن خيانةَ الغازي في أهله أعظمُ من كل خيانةٍ ؛ لأن لم ما عداها لا يخير في أخذ كل الحسنات ؛ وإنما يأخذُ بكلّ خيانةٍ قدرًا معلومًا من حسنات الخائن . اهـ
** قال الإمام ابن القيم في كتابه القيم : ( الجواب الكافي ) ، (ص: 112) :
** وَأَعْظَمُ أَنْوَاعِ الزِّنَا: أَنْ يَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، فَإِنَّ مَفْسَدَةَ الزِّنَا تَتَضَاعَفُ بِتَضَاعُفِ مَا انْتَهَكَهُ مِنَ الْحَقِّ.
** فَالزِّنَا بِالْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ أَعْظَمُ إِثْمًا وَعُقُوبَةً مِنَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، إِذْ فِيهِ انْتِهَاكُ حُرْمَةِ الزَّوْجِ، وَإِفْسَادُ فِرَاشِهِ وَتَعْلِيقُ نَسَبٍ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ أَذَاهُ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا وَجُرْمًا مِنَ الزِّنَا بِغَيْرِ ذَاتِ الْبَعْلِ.
** فَالزِّنَا بِمِائَةِ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا أَيْسَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الزِّنَا بِامْرَأَةِ الْجَارِ،
فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا جَارًا لَهُ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ سُوءُ الْجِوَارِ، وَأَذَى جَارِهِ بِأَعْلَى أَنْوَاعِ الْأَذَى وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْبَوَائِقِ.
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» وَلَا بَائِقَةَ أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا بِامْرَأَةِ الْجَارِ.
فَإِنْ كَانَ الْجَارُ أَخًا لَهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَقَارِبِهِ انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، فَيَتَضَاعَفُ الْإِثْمُ لَهُ،
** فَإِنْ كَانَ الْجَارُ غَائِبًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ كَالصَّلَاةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ تَضَاعَفَ لَهُ الْإِثْمُ، حَتَّى إِنَّ الزَّانِيَ بِامْرَأَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوقَفُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ.
قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَمَا ظَنُّكُمْ؟ أَيْ مَا ظَنُّكُمْ أَنَّهُ يَتْرُكُ لَهُ حَسَنَاتٍ، قَدْ حُكِّمَ فِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا شَاءَ؟ عَلَى شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، حَيْثُ لَا يَتْرُكُ الْأَبُ لِابْنِهِ وَلَا الصَّدِيقُ لِصَدِيقِهِ حَقًّا يَجِبُ عَلَيْهِ،
** فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَحِمًا مِنْهُ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمِهَا،
فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ الزَّانِي مُحْصَنًا كَانَ الْإِثْمُ أَعْظَمَ،
** فَإِنْ كَانَ شَيْخًا كَانَ أَعْظَمَ إِثْمًا، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
** فَإِنِ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ أَوْ بَلَدٍ حَرَامٍ أَوْ وَقْتٍ مُعَظَّمٍ عِنْدَ اللَّهِ، كَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ، تَضَاعَفَ الْإِثْمُ.
** وَعَلَى هَذَا فَاعْتَبِرْ مَفَاسِدَ الذُّنُوبِ وَتَضَاعُفَ دَرَجَاتِهَا فِي الْإِثْمِ وَالْعُقُوبَةِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ . اهـ
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 5 / 7 / 1438 هـ
** والله الموفق .
(45) فائدة اليوم بعنوان : ( ذكر حروف المعاني الخاصة والمشتركة ، من حيث عددها ، أقسامها ، معانيها )
** الحروف كلها مبنية ، وهي قليلة بحيث لا يتجاوز عددها ثمانين ،
** ويقال لها : حروف المعاني ، كما أَن حروف الهجاءِ يقال لها : حروف المباني .
** حروف المعاني على خمسة أقسام : أحادية ، وثنائية ، وثلاثية ، ورباعية ، وخماسية .
** “أما الأحادية” فثلاثة عشر وهي: ( الهمزة ، والألف ، والباء ، والتاء ، والسين ، والفاء ، والكاف ، واللام ، والميم ، والنون ، والهاء ، والواو ، والياء ) .
** و”أما الثنائية” فستة وعشرون وهي 🙁 آ، وإذ ، وأل ، وأم ، وأن ، وإن ، وأو ، وأي ، وإي ، وبل ، وعن ، وفي ، وقد ، وكي ، ولا ، ولم ، ولن ، ولو ، وما ، ومُذ ، ومِنْ ، وها ، وهل ، ووا ، ويا ، والنون الثقيلة ) .
** و”أما الثلاثية” فخمسة وعشرون ، وهي ( آي ، وأجَلْ ، وإذا ، وإذنْ ، وألا ، وإلى ، وأما ، وإنَّ ، وأنّ ، وأيا ، وبلى ، وثم ، وجَلَلْ ، وجَيْرِ ، وخلا ، ورُبَّ ، وسوف ، وعدا ، وعَلَّ ، وعلى ، ولاتَ ، وليت ، ومنذ ، ونَعَمْ ، وهَيَا ) .
** “وأما الرباعية” فخمسة عشر ، وهي : ( إذما ، وألاّ ، وإلاّ ، وأمّا ، وإمّا ، وحاشا ، وحتى ، وكأن ، وكلا ، ولكنْ ، ولعلّ ، ولمّا ، ولولا ، ولوما ، وهلاَّ ) .
** و”أما الخماسية” فلم يأت منها إلا ( لكن ) وهي للاستدراك نحو : ( فلان عالم لكنه جبان ) .
** ومما تقدّم يعلم أن الحروف تنقسم إلى أصناف ، فكل طائفة منها اشتركت في معنى أو عمل تنسب إليه فيقال :
** “أحرف الجواب” : ( لا ، ونعَمْ ، وبلى ، وإي ، وأجَلْ ، وجلَلْ ، وجَيْرِ ، وإنّ ) .
** و” أحرف النفي ” : ( لم ، ولمّا ، ولن ، وما ، ولا ، ولات ) .
** و” أحرف الشرط ” : ( إنْ ، وإِذما ، ولو ، ولولا ، ولوما ، وأمّا ) .
** و”أحرف التحضيض ” : ” ( ألا ، وألاّ ، وهلاّ ، ولولا ، ولوما ) .
** و”الأحرف المصدرية ” : ” ( أنّ ، وأن ، وكي ، ولو ، وما ) .
** و” أحرف الاستقبال ” : ( السين ، وسوف ، وأنْ ، وإنْ ، ولن ، وهل ).
** و” أحرف التنبيه ” : ( ألا ، وإما ، وها ، ويا ) .
** و” أحرف التوكيد ” : ( إنّ ، وأنّ ، والنون ، ولام الابتداء ، وقد ) .
** ومن ذلك ” حروف الجر ، والعطف ، والنداء ، ونواصب المضارع ، وجوازمه ” ، وقد مر بيانها .
** وتنقسم الحروف إلى عاملة كـ( أنَّ وأخواتها ) ، وغير عاملة كـ( أحرف الجواب ) .
** وتنقسم أيضاً إلى :
مختصة بالأفعال كـ( أحرف التحضيض ) ،
ومختصة بالأسماء ك( حروف الجر ) ،
ومشتركة كـ( ما ، ولا النافيتين ، والواو ، والفاء العاطفتين ) .
اهـ باختصار من كتاب : (الموجز في قواعد اللغة العربية ) ، لسعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني (المتوفى : 1417هـ) (ص: 388) .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 5 / 7 / 1438 هـ
** والله الموفق .
(44) فائدة اليوم بعنوان : ( القسم وأهميته ، وأركانه ، وتعدده في القران الكريم )
** مما جرت به عادة العرب استعمال القسم في توكيد الأخبار نفيا أوإثباتا ؛ لتستقر في النفوس ، وقد نزل القرآن بلغة العرب مستمعلا هذا الأسلوب .
وفي كتاب : ( أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم ) ، تأليف : د. سامي عطا حسن (ص: 44)
** لجأ القرآن الكريم إلى القسم جريا على عادة العرب في توكيد الأخبار ، لتستقر في النفس ، ويتزعزع فيها ما يخالفها ،
** وإذا كان القسم لا ينجح أحيانا في حمل المخاطب على التصديق ، فإنه كثيرا ما يوهن في النفس الفكرة المخالفة ، ويدفع إلى الشك فيها ، ويبعث المرء على التفكير الجاد والقوي فيما ورد القسم من أجله.
** وقال في (ص: 27)
** المبحث الخامس / أغراض القسم القرآني ، وأهدافه :
** يقول ابن يعيش : – (الغرض من القسم : توكيد ما يقسم عليه من نفي وإثبات)
** وقال ابن القيم : ( والمقسم عليه : يراد بالقسم توكيده ، وتحقيقه ) ،
** والقرآن نزل بلغة العرب ، ومن عاداتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمرا ، وقلما نجد القسم مستعملا في اللغات الأخرى وآدابها.
** وكثيرا ما يحتاج المتكلم إلى تأكيد خبر يسوقه ، أو توثيق وعد يصدر منه، وبخاصة في الأمور المهمة كالمحالفات ، والمعاهدات ، وكان للتأكيد عند العرب صيغ مختلفة ، وكان القسم أقواها تأكيدا وتحقيقا ، لأنه يفيد الجزم بصحته ، والقطع بصدقه ،
** وقد بلغ من شأن القسم عندهم ، أنهم كانوا يحترزون كل الإحتراز من الأيمان الكاذبة ، ويعتقدون أنها شؤم على صاحبها ، تخرب الديار ، وتدعها بلاقع ، لما فيها من الغدر والخيانة ،
** ومن أجل هذا كانت اليمين عندهم قاطعة في إثبات الحقوق . اهـ المراد
** وأركان القسم أربعة :
الأول : المقسم ، – بكسر السين – وهو الله جل جلاله ، أو العبد .
الثاني : المقسم به ، وهو الشيء المعظم عند الحالف ، لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم .
** ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء ، بذاته المقدسة ، أو بمخلوقاته العظيمة ،
** وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله العظيم ، لأن الحلف تعظيم ، والتعظيم لا يكون إلا لله العظيم سبحانه وتعالى .
الثالث : المقسم عليه ، ولا يكون إلا شيئا عظيما .
الرابع : أداة القسم : وهي حروف القسم الثلاثة : ( الواو ، الباء ، والتاء ، والواو أكثرها استعمالا ) .
قال الإمام القرطبي في كتابه : ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 26)
( . . . والقَسَمُ : الإيلاءُ والحَلِفُ.
وهذا وأشباهه قَسَمٌ من الله تعالى على جهة التشريفِ للمقسَمِ به ، والتأكيدِ للمُقسَمِ له ،
** وأنَّه تعالى له أن يُقْسِمَ بما شاء مِنْ أسمائه وصفاتِهِ ومخلوقاتِهِ تشريفًا وتنويهًا ؛ كما قال : {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى *} ، {وَالْعَادِيَاتِ} {وَالصَّآفَّاتِ} ، {فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا *} ، {وَالنَّازِعَاتِ} ، ونحو هذا.
** وقد تكلَّف بعضُ العلماء ، وقال : إنَّ المقسَمَ به في مثلِ هذه المواضع محذوفٌ للعلم به ؛ فكأنه قال : وربِّ الشمسِ ، وربِّ الليل.
** والذي حمله على ذلك : أنَّه لمَّا سَمِع أنَّ الشرع قد نهانا أن نَحْلِفَ بغير الله تعالى ، ظنَّ أنَّ الله تعالى يمتنعُ مِنْ ذلك ،
وهذا ظن قاصر وفهمٌ غيرُ حاضر ؛ إذْ لا يَلْزَمُ شيءٌ من ذلك ؛ لأنَّ للهِ تعالى أن يحكمَ بما شاء ، ويفعَلَ من ذلك ما يشاء ؛ إذْ لا يتوجَّهُ عليه حُكْم ، ولا يترتَّبُ عليه حَقٌّ. ** وأيضًا : فإنَّ الشرع إنما منعنا من القسمِ بغيرِ الله تعالى ؛ حمايةً عن التشبُّهِ بالجاهليةِ فيما كانوا يُقْسِمون به من معبوداتهم ومُعَظَّمَاتِهم الباطلةِ ؛ على ما يأتي الكلامُ عليه في “الأَيْمَان” ) . اهـ
وفي تفسير العثيمين: جزء عم (ص: 146)
{والسماء والطارق} ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالقسم، أقسم الله تعالى بالسماء والطارق .
** وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» ،
وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» .
** فلا يجوز الحلف بغير الله لا بالأنبياء، ولا بالملائكة، ولا بالكعبة، ولا بالوطن، ولا بأي شيء من المخلوقات؟
** والجواب على هذا الإشكال أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه،
** وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل، لأن عِظم المخلوق يدل على عِظم الخالق،
** وقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه، ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله في كتابه : ( التبيان في أقسام القرآن ) وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيراً . اهـ المراد
** وقد أقسم الله تعالى بنفسه المقدسة في القرآن الكريم في سبعة مواضع :
1- في قوله: { زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ } ، التغابن : 7 .
2- وقوله: { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ } ، سبأ: 3 .
3- وقوله: { وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ } ، يونس: 53.
** وفي هذه الثلاثة أمر الله نبيه – صلى الله عليه وسلم – أن يقسم به .
4- وقوله: { فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ } ، مريم: 68.
5- وقوله: { فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ } ، الحجر: 92.
6- وقوله: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } ، النساء: 65.
7- وقوله: { فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ } ، المعارج: 40.
** وسائر القسم في القرآن بمخلوقاته سبحانه وتعالى ،
** تعدد القسم في القران الكريم :
** قد وقع القسم من اللَّه جل جلاله في القران الكريم بأمر واحد ،
مثل : { وَالْعَصْرِ }، { وَالنَّجْمِ } .
** ووقع بأمرين ، مثل : { وَالضُّحى وَاللَّيْلِ } ، { وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ } .
** ووقع بثلاثة أمور، مثل : { وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3) } .
** ووقع بأربعة أمور، مثل : { وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) }
وفي : { وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) }.
وفي: { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) }.
** ووقع بخمسة أمور، مثل : { وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) }،
* وفي { وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا }،
* وفي : { وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) }،
* وفي { وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) }.
** ولم يقسم بأكثر من خمسة أشياء إلا في سورة واحدة وهي :
{ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) } .
وانظر كتاب : ( السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ) ، (4/ 77) لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)
وكتاب : ( اللباب في علوم الكتاب ) ، (18/ 5) لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني ( المتوفى: 775هـ )
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 24 / 6/ 1438 هـ
** والله الموفق .
(43) فائدة اليوم بعنوان : ( أحوال الناس في الصلاة )
** قال تعالى : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) } .
** عن عبادةَ بنِ الصامتِ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ »[رواه أبو داود وغيره ، وصححه الألباني ]
** وعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا »[ رواه أبو داود وغيره ، وحسنه الألباني ]
** قال ابن القيم في كتابه : ( الوابل الصيب ) ، (ص: 23)
والناس في الصلاة على مراتب خمسة :
أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط ، وهو الذي انتقص من وضوئها ، ومواقيتها ، وحدودها ، وأركانها .
الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار .
الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد .
الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها ، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاً منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها واتمامها، قد استغرق قلب شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها.
الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظراً بقبله إليه مراقباً له ممتلئاً من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به.
** فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه لأن له نصيباً ممن جعلت قرة عينه في الصلاة،
** فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضاً به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين،
** ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات،
** وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ( ارفعوا الحجب ، فإذا التفت قال أرخوها ) ،
** وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، ،
** فإذا التفت إلى غيره، أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة،
** وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب ، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب ،
** فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة . اهـ
وقال في كتابه : ( أسرار الصَّلاة ) ، (ص: 1)
فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عُيون المحبين ، و لذة أرواح الموحدين ، و بستان العابدين و لذة نفوس الخاشعين ، و محك أحوال الصادقين ، و ميزان أحوال السالكين ، و هي رحمةُ الله المهداة إلى عباده المؤمنين .
هداهم إليها ، وعرَّفهم بها ، وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين ، رحمة بهم ، و إكراما لهم ، لينالوا بها شرف كرامته ، و الفوز بقربه لا لحاجة منه إليهم ، بل منَّة منه ، و تفضَّلا عليهم ، . . . الخ ) . اهـ
وقال في كتابه : ( الفوائد ) ، (ص: 200)
** للعبدِ بين يَدَيِّ اللهِ مَوْقفان: مَوْقفٌ بيْنَ يديْهِ في الصَّلاة. وَمَوْقِفٌ بينَ يديْهِ يوْمَ لقائِهِ.
** فمَنْ قامَ بِحَقِّ المَوقِفِ الأوَّلِ هُوِّنَ عليهِ المَوْقفَ الآخرَ،
** ومَنَِ اسْتهانَ بهذا الموْقفِ ولم يُوَفِّهِ حقَّهُ شُدِّدَ عليهِ ذلك الموقِفَ
** قال تعالى ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً * إِنَّ هَؤُلاَء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً ) . اهـ
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 16 / 6/ 1438 هـ
** والله الموفق .
(42) فائدة اليوم بعنوان : ( كراهة الزيادة على رَكْعَتَيْنِ خفيفتين بعد آذان الفجر الثاني إلا لسبب )
** عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. متفق عليه .
** وفي ( سنن الترمذي ) ت ، بشار (1/ 542)
** عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ.
** وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: إِنَّمَا يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، إِلاَّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
** وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَفْصَةَ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.
** وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ . اهـ [ وصححه الألباني ] :
** قال الحافظ ابن حجر في كتابه ( التلخيص الحبير ) ، ط / العلمية (1/ 483)
( تَنْبِيهٌ ) :
دَعْوَى التِّرْمِذِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِذَلِكَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَشْهُورٌ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ . اهـ
وفي كتاب : ( مصنف ابن أبي شيبة ) ، (2/ 135) :
7371 – حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: رَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْضَ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»
7372 – حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ » . اهـ
** وفي كتاب : ( السنن الكبرى ) ، للبيهقي (2/ 654)
** عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُكْثِرُ فِيهَا الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ فَنَهَاهُ،
** فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ ؟
** قَالَ: ” لَا وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ ” . اهـ
** قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على هذا الأثر في كتابه : ( إرواء الغليل )، (2/ 236):
** وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ،
** وهو سلاح قوى على المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة! ! وهم فى الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة فى الذكر والصلاة ونحو ذلك . اهـ
وفي كتاب : ( تحفة الأحوذي )، (2/ 393)
** وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ أَجَازَ التَّنَفُّلَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِيرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ وَفِي لَفْظٍ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ الْحَدِيثَ .
** قُلْتُ : الرَّاجِحُ عِنْدِي هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ لِدَلَالَةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَيْهِ صَرَاحَةً وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . اهـ
** فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (10/ 344)
س: الأخ م. ح. من اليمن يقول:
إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر وصليت أربع ركعات، فقال لي بعض الناس بأن ذلك لا يجوز إلا ركعتين، فهل هذا صحيح؟
ج: نعم ، إذا دخلت صل ركعتي السنة فقط، ويكفي ،
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر » تصلي سنة الفجر ثنتين، ثم تجلس تنتظر الفريضة .
** فتاوى نور على الدرب للعثيمين (8/ 2)
هل بين طلوع الفجر الثاني وصلاة الفجر غير ركعتي الفجر وهل الذي يصلى بين طلوع الفجر وصلاة الفجر أكثر من سنة الفجر يأثم أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
الصحيح أن من صلى بين طلوع الفجر وصلاة الفجر صلاة سوى سنة الفجر فإنه لا يأثم لأن وقت النهي لا يدخل إلا بعد صلاة الصبح كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيداً بها ،
** ولكن ليس من السنة أن يصلى أكثر من ركعتي الفجر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى إذا طلع الفجر إلا ركعتين خفيفتين ، وهما راتبة الفجر ، إلا أن يكون لذلك سبب كما لو صلى الإنسان راتبة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة فإنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين تحية المسجد فإذا صلاهما جلس ينتظر إقامة الصلاة . اهـ
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 14 / 6/ 1438 هـ
** والله الموفق .
(41) فائدة اليوم بعنوان : ( خصائص نافلة الفجر )
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في كتابه الماتع : ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ، (4/69) :
قوله: « وركعتان قبل الفجر وهما آكدها »
** أي: آكد هذه الرَّواتب. ودليل آكديتها: قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «ركعتا الفَجْرِ خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها» (م)
** الدُّنيا منذ خُلقت إلى قيام الساعة بما فيها مِن كُلِّ الزَّخارف مِن ذَهَبٍ وفضَّةٍ ومَتَاعٍ وقُصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الرَّكعتان خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها ؛ لأنَّ هاتين الرَّكعتين باقيتان والدُّنيا زائلة.
** ودليل آخر على آكديتهما: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم : «كان لا يدعهما حضراً ولا سفراً » . (خ ، م)
** وتختصُّ هاتان الرَّكعتان ـ أعني ركعتي الفجر بأمور ـ:
أولاً : مشروعيتهما في السَّفر والحضر.
ثانياً: ثوابهما ؛ بأنهما خير من الدُّنيا وما فيها.
ثالثاً:أنه يُسَنُّ تخفيفهما، فَخَفِّفْهُمَا بقَدْرِ ما تستطيع ، لكن بشرط أن لا تُخِلَّ بواجب ؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يُخَفِّفُ الركعتين اللتين قبل صَلاةِ الصُّبحِ ، حتى إنِّي لأقولُ : هل قَرَأَ بأُمِّ الكتابِ » ؟ (خ ، م)
تعني : مِن شدَّة تخفيفه إيَّاهما .
رابعاً: أنْ يقرأ في الرَّكعة الأُولى بـ: { قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ، وفي الثانية: بـ: { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } (م)
** أو في الأُوْلَى { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ } الآية في سورة البقرة و{ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} الآية في سورة آل عمران (م) .
** فتقرأ أحياناً بسورتي الإخلاص،
** وأحياناً بآيتي البقرة وآل عمران،
** وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران، فاقرأ بسورتي الإخلاص والكافرون.
خامساً : أنه يُسَنُّ بعدهما الاضطجاع على الجَنْبِ الأيمن ،
** وهذا الاضطجاع اخْتَلَفَ العلماءُ فيه:
** فمِنْهم مَن قال: إنَّه ليس بسُنَّةٍ مطلقاً.
** ومِنْهم مَن قال: إنَّه سُنَّةٌ مطلقاً.
** ومِنْهم مَن قال: إنه سُنَّةٌ لِمَن يقوم الليل؛ لأنَّه يحتاج إلى راحة حتى ينشطَ لصلاة الفجر.
ومِنْهم مَن قال: إنَّه شرط لصحَّة صلاة الفجر، وأنَّ مَنْ لم يضطجع بعد الرَّكعتين فصلاةُ الفجر باطلة. وهذا ما ذهب إليه ابنُ حَزْمٍ رحمه الله، وقال: إِنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إِذا صَلَّى أحدُكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما»،
فأمر بالاضطجاع. لكن يُجاب بما يلي:
أولاً: هذا الحديث ضعيف، فلم يصحَّ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم مِن أمْرِه، بل صَحَّ مِن فِعْلِهِ.
ثانياً : ما علاقةُ هذا بصلاةِ الفَجْرِ! ولكن يدلُّكَ هذا على أنَّ الإنسانَ مهما بلغ في العلم فلا يسلم من الخطأ.
** وأصحُّ ما قيل في هذا: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو التفصيل ، فيكون سُنَّةً لمن يقوم الليل ؛ لأنَّه يحتاج إلى أن يستريحَ ،
** ولكن إذا كان مِن الذين إذا وضع جَنْبَهُ على الأرض نام ؛ ولم يستيقظ إلا بعد مُدَّة طويلة ؛ فإنه لا يُسَنُّ له هذا ؛ لأن هذا يُفضي إلى تَرْكِ واجب . اهـ
** وفي كتاب : (زاد المعاد ) ، (1/ 308)
فَصْلٌ
وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، هَذَا الَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ فِي “الصَّحِيحَيْنِ” مِنْ حَدِيثِ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
** وَذَكَرَ الترمذي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» “. قَالَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
** وَسَمِعْتُ ابن تيمية يَقُولُ: هَذَا بَاطِلٌ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْهُ الْفِعْلُ لَا الْأَمْرُ بِهَا، وَالْأَمْرُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَغَلِطَ فِيهِ،
** وَأَمَّا ابْنُ حَزْمٍ وَمَنْ تَابَعَهُ، فَإِنَّهُمْ يُوجِبُونَ هَذِهِ الضَّجْعَةَ، وَيُبْطِلُ ابْنُ حَزْمٍ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَضْطَجِعْهَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ الْأُمَّةِ،
** وَرَأَيْتُ مُجَلَّدًا لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قَدْ نَصَرَ فِيهِ هَذَا الْمَذْهَبَ….
** وَقَدْ غَلَا فِي هَذِهِ الضَّجْعَةِ طَائِفَتَانِ، وَتَوَسَّطَ فِيهَا طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ،
** فَأَوْجَبَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَأَبْطَلُوا الصَّلَاةَ بِتَرْكِهَا كَابْنِ حَزْمٍ وَمَنْ وَافَقَهُ،
** وَكَرِهَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَسَمَّوْهَا بِدْعَةً،
** وَتَوَسَّطَ فِيهَا مالك وَغَيْرُهُ فَلَمْ يَرَوْا بِهَا بَأْسًا لِمَنْ فَعَلَهَا رَاحَةً، وَكَرِهُوهَا لِمَنْ فَعَلَهَا اسْتِنَانًا،
** وَاسْتَحَبَّهَا طَائِفَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، سَوَاءٌ اسْتَرَاحَ بِهَا أَمْ لَا، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، . . . الخ . اهـ المراد
** قلت :
** وحديث الأمر بالاضطجاع قد ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه :
( أحاديث معلة ظاهرها الصحة ) ، (ص: 428) فقال :
(. . . وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في”الميزان”هذا الحديث مما أنكر على عبد الوحد. اهـ
والحديث في”الصحيحين”عن عائشة من فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ . اهـ
** وصححه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود” برقم : (1146) ، وناقش فيه ، بل ورد إعلال البيهقي للحديث وكذا شيخ الإسلام .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 12 / 6/ 1438 هـ
** والله الموفق .
(40) فائدة اليوم بعنوان : ( الوقت أغلى من الذهب , إن اغتنمته وإلا ذهب )
** الوقت أنفاس معدودة وساعات محدودة ، وهو حياة الإنسان ورأس ماله ، وعليه تبنى سعادته أو شقاوته .
** قال الله تعالى : { كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ }
** وقال الله تعالى : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ }
** وقال الله تعالى : { يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي }
** وعن ابن عباسٍ رضي الله عنْهما قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِرَجلٍ وهو يَعِظُه : ” اغْتَنِمْ خَمْساً قبلَ خَمْسٍ :
شبابَكَ قبلَ هَرمِكَ، وصِحَّتَك قبل سَقْمِكَ، وغِناكَ قبْلَ فقْرِكَ، وفَراغَك قَبْلَ شُغْلِكَ، وحياتَك قَبْلَ مَوْتِكَ”.
رواه الحاكم وقال: “صحيح على شرطهما”. ( وصححه الألباني )
** وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه: أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! أيُّ الناسِ خَيرٌ؟ قال : ” مَنْ طالَ عُمُره، وحَسُنَ عَملُه ” .
قال: فأيُّ الناسِ شَرٌّ؟
قال : ” مَنْ طالَ عُمرهُ ، وساءَ عَملُه ” .
رواه الترمذي وقال: “حديث حسن صحيح”، والطبراني بإسناد صحيح، والحاكم، والبيهقي في “الزهد” وغيره. ( وقال الشيخ الألباني : صحيح لغيره )
** وفي ( جامع العلوم والحكم) ، (2/ 382)
** وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا أَنْتِ أَيَّامٌ مَجْمُوعَةٌ، كُلَّمَا مَضَى يَوْمٌ مَضَى بَعْضُكِ.
** وقَالَ أيضا : لَمْ يَزَلِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَرِيعَيْنِ فِي نَقْصِ الْأَعْمَارِ، وَتَقْرِيبِ الْآجَالِ.
** وقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: كَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا مَنْ يَوْمُهُ يَهْدِمُ شَهْرَهُ، وَشَهْرُهُ يَهْدِمُ سَنَتَهُ، وَسَنَتُهُ تَهْدِمُ عُمْرَهُ، كَيْفَ يَفْرَحُ مَنْ يَقُودُهُ عُمْرُهُ إِلَى أَجْلِهِ، وَتَقُودُهُ حَيَاتُهُ إِلَى مَوْتِهِ. اهـ بتصرف
** وفي كتاب : ( الفوائد ) ، لابن القيم (ص: 31)
إضاعة الوقت أشد من الموت لأَن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها .
** وفي كتاب : ( الجواب الكافي ) ، لابن القيم (ص: 156)
قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ” صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ فَلَمْ أَسْتَفِدْ مِنْهُمْ سِوَى حَرْفَيْنِ: أَحَدُهُمَا قَوْلُهُمْ: الْوَقْتُ سَيْفٌ، فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَإِلَّا قَطَعَكَ “.
وَذَكَرَ الْكَلِمَةَ الْأُخْرَى: ” وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ “.
فَوَقْتُ الْإِنْسَانِ هُوَ عُمُرُهُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ مَادَّةُ حَيَاتِهِ الْأَبَدِيَّةِ فِي النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَمَادَّةُ الْمَعِيشَةِ الضَّنْكِ فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، وَهُوَ يَمُرُّ أَسْرَعَ مِنَ السَّحَابِ، فَمَا كَانَ مِنْ وَقْتِهِ لِلَّهِ وَبِاللَّهِ فَهُوَ حَيَاتُهُ وَعُمُرُهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَيْسَ مَحْسُوبًا مِنْ حَيَاتِهِ، وَإِنْ عَاشَ فِيهِ عَاشَ عَيْشَ الْبَهَائِمِ، فَإِذَا قَطَعَ وَقْتَهُ فِي الْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ وَالْأَمَانِيِّ الْبَاطِلَةِ، وَكَانَ خَيْرَ مَا قَطَعَهُ بِهِ النَّوْمُ وَالْبِطَالَةُ، فَمَوْتُ هَذَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ حَيَاتِهِ. اهـ
وفي كتاب : ( الجواب الكافي ) أيضا (ص: 84)
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُمْرَ الْعَبْدِ هُوَ مادَّةُ حَيَاتِهِ، وَلَا حَيَاةَ لِمَنْ أَعْرَضَ عَنِ اللَّهِ وَاشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ، بَلْ حَيَاةُ الْبَهَائِمِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ، فَإِنَّ حَيَاةَ الْإِنْسَانِ بِحَيَاةِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ، وَلَا حَيَاةَ لِقَلْبِهِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ فَاطِرِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ، وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَالطُّمَأْنِينَةِ بِذِكْرِهِ، وَالْأُنْسِ بِقُرْبِهِ، وَمَنْ فَقَدَ هَذِهِ الْحَيَاةَ فَقَدَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَوْ تَعَوَّضَ عَنْهَا بِمَا تَعَوَّضَ مِمَّا فِي الدُّنْيَا، بَلْ لَيْسَتِ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا عِوَضًا عَنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَفُوتُ الْعَبْدَ عِوَضٌ، وَإِذَا فَاتَهُ اللَّهُ لَمْ يُعَوِّضْ عَنْهُ شَيْءٌ الْبَتَّةَ. اهـ
** وقال بعض السلف :
من أمضى يومًا من عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. ولا تسأل عن ندمه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه .
** (( الأبيات الشعرية )) :
** قال الشاعر :
إذا مر يومٌ ولم أقتبس هدىً * * * ولم أستفد علماً فما ذاك من عمري.
** وقال آخر :
إذا كان رأسُ المالِ عُمْرَك فاحْترِسْ * * * عليهْ من الإنْفاقِ في غيرِ واجبِ
** وقال الوزير الصالح يحيى بن هبيرة رحمه الله كما في كتاب : ( الأعلام ) للزركلي (8/ 175) :
والوقتُ أنفَسُ مَا عيِنتُ بِحفظه * * * وَأرَاهُ أشهَلُ مَا عليكَ يَضِيع
** وفي ( جامع العلوم والحكم) ، (2/ 382)
وَمِمَّا أَنْشَدَ بَعْضُ السَّلَفِ:
إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا * * * وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ
فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا * * * فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ .
** وفي كتاب ( فتح الباري ) ، لابن حجر (1/ 481) :
وَأخرج الْحَاكِم فِي تَارِيخه من شعره [ يعني البخاري ] قَوْله :
اغْتَنِمْ فِي الْفَرَاغِ فَضْلَ رُكُوعٍ * * * فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مَوْتُكَ بَغْتَةْ
كَمْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ * * * ذَهَبَتْ نَفْسُهُ الصَّحِيحَةُ فَلْتَةْ
** وفي كتاب ( الزهد الكبير ) ، للبيهقي (ص: 235)
قال مَحْمُودُ بْنُ الْحَسَنِ [ الورّاق ] :
مَضَى أَمْسُكَ الْمَاضِي شَهِيدًا مُعَدَّلًا * * * وَأَعْقَبَهُ يَوْمٌ عَلَيْكَ جَدِيدُ
فَإِنْ كُنْتَ بِالْأَمْسِ اقْتَرَفْتَ إِسَاءَةً * * * فَثَنِّ بِإِحْسَانٍ وَأَنْتَ حَمِيدُ
فَيَوْمُكَ إِنْ أَعْتَبْتَهُ عَادَ نَفْعُهُ * * * عَلَيْكَ وَمَاضِي الْأَمْسِ لَيْسَ يَعُودُ
وَلَا تُرْجِ فِعْلَ الْخَيْرِ يَوْمًا إِلَى غَدٍ * * * لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدُ
تفسير القرطبي (5/ 384)
وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:
إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا * * * فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُكُونُ
وَلَا تَغْفُلْ عَنِ الْإِحْسَانِ فِيهَا * * * فَمَا تَدْرِي السُّكُونُ مَتَى يَكُونُ
وفي كتاب ( سير أعلام النبلاء ) ، (14/ 58)
وَمِنْ نَظْمِ أَبِي الوَلِيْد [سليمان بن خلف الأندلسي ]:
إِذَا كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْماً يَقِيْنَا * * * بِأَنَّ جَمِيْعَ حَيَاتِي كَسَاعَه
فَلِمَ لاَ أَكُوْنُ ضَنِيْناً بِهَا * * * وَأَجْعَلُهَا فِي صلاحٍ وَطَاعَهْ
** (( وأخيرا )) :
قال ابن الجوزي بعد أن تكلم عن أهمية الوقت والحرص على اغتنامه ، في كتابه:
( صيد الخاطر ) ، (ص: 493) :
( . . . والذي يعين على اغتنام الزمان : الانفراد والعزلة مهما أمكن، والاختصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى، وقلة الأكل؛ فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل، ومن نظر في سير السلف، وآمن بالجزاء، بان له ما ذكرته ) اهـ .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأربعاء 9 / 6/ 1438 هـ
** والله الموفق .
(39) فائدة اليوم بعنوان : ( من الأخلاق الكريمة شكر من أفادك بفائدة دينية أو دنيوية )
** قال الله تعالى : { أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ }
** وقال الله تعالى : { هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ }
** وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ” .[ رواه الترمذي ، وصححه الألباني ]
** وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( . . . وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْ قد كافأتموه) . [ رواه أحمد وغيره ، وصححه الألباني ]
** وفي كتاب ( فيض القدير ) ، (6/ 172) :
( فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ) لاعترافه بالتقصير ، ولعجزه عن جزائه فوض جزاءه إلى الله ليجزيه الجزاء الأوفى .
** قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء بالجزاء الأوفى . اهـ
** وفي كتاب : ( مفهوم الشكر عند ابن تيمية رحمه الله )، جمع: أبي حمزة الشامي (1/ 19):
شُكْرُ الْمُنْعِمِ أَمْرٌ لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُقَلَاءُ فِي اسْتِحْسَانِهِ . وَكُلُّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ يَنْبَغِي لَهُ الشُّكْرُ لِمَنْ أَوْلَاهُ تِلْكَ النِّعْمَةَ وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَةً لِحَدِيثِ : { مَنْ لَمْ يَشْكُرْ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرْ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ } وَحَدِيثِ:{ إنَّ أَشْكَرَ النَّاسِ لِلَّهِ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ} وَإِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى شَكَرَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُمْ فَالْعَبْدُ أَوْلَى بِأَنْ يَشْكُرَ لِمَنْ أَحْسَنَ إلَيْهِ ، . . . الخ ) . اهـ المراد
** وفي كتاب ( زاد المعاد ) ، (2/ 424)
فَصْلٌ
** وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو لِمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ وَبِمَا يُنَاسِبُ
** « فَلَمَّا وَضَعَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَضُوءَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ »
** وَلَمَّا « دَعَّمَهُ أَبُو قَتَادَةَ فِي مَسِيرِهِ بِاللَّيْلِ لَمَّا مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ »
** وَقَالَ ( « مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ »
** « وَاسْتَقْرَضَ مِنْ عبد الله بن أبي ربيعة مَالًا، ثُمَّ وَفَّاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ: ” بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ »
** « وَلَمَّا أَرَاحَهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ: صَنَمِ دَوْسٍ، بَرَّكَ عَلَى خَيْلِ قَبِيلَتِهِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ »
** وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا، كَافَأَ عَلَيْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا، وَإِنْ رَدَّهَا اعْتَذَرَ إِلَى مُهْدِيهَا، «كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للصعب بن جثامة لَمَّا أَهْدَى إِلَيْهِ لَحْمَ الصَّيْدِ: ” إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
** وفي كتاب ( طبقات الشافعية الكبرى ) للسبكي، (6/176) :
قال محمد بن عبد الملك الفارقي المتوفي سنة أربع وستين وخمسمائة :
إذَا أَفَادَكَ إنْسانٌ بفائدةٍ *** مِنْ العلومِ فأكثِرْ شُكرَهُ أبدَا
وقُلْ فُلانٌ جزاهُ اللهُ صالحةً *** أفادَنِيها وألقِ الكبر والحَسَدَا
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 8 / 6/ 1438 هـ
** والله الموفق .
( 38 ) فائدة اليوم بعنوان : ( عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها )
** قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم : ( الفوائد ) ، (ص: 111)
فصل : عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها :
** علم لا يعمل به .
** وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء .
** ومال لا ينفق منه ، فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة .
** وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به .
** وبدن معطل من طاعته وخدمته .
** ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره .
** ووقت معطل عن استدراك فارطه أو اغتنام بر وقربه .
** وفكر يجول فيما لا ينفع .
** وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ، ولا تعود عليك بصلاح دنياك .
** وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله ، وهو أسير في قبضته ، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا .
** وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان ، هما أصل كل إضاعة :
** إضاعة القلب ، وإضاعة الوقت .
** فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة .
** وإضاعة الوقت من طول الأمل .
** فاجتمع الفساد كله فى اتباع الهوى ، وطول الأمل .
** والصلاح كله فى اتباع الهدى ، والاستعداد للقاء . والله المستعان . اهـ
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الإثنين 7 / 6/ 1438 هـ
** والله الموفق .
(37) فائدة اليوم بعنوان : (أَبُو جَعْفَرٍ محمد بن جرير الطبري اثنان ، أحدهما إمام هداية ، والآخر إمام غواية )
** قال تعالى: { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ } .
** وقَالَ تَعَالَى: { وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ } .
** قد اتفق اثنان من الأئمة في هذه الكنية والاسم واسم الأب والنسبة ، وافترقا في اسم الجد:
أحدهما : إمام هداية ، وهو أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرِ بنِ يَزِيْدَ الطَّبَرِيُّ .
والثاني : إمام ضلالة ، وهو أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرِ بنِ رُسْتُمَ الطَّبَرِيُّ .
** وربما التبس أحدهما بالآخر .
** قال الأمام الذهبي في كتابه : ( سير أعلام النبلاء ) ، (14/ 267) :
175- مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرِ بنِ يَزِيْدَ بنِ كَثِيْرٍ الطَّبَرِيُّ: الإِمَامُ، العَلَمُ، المجتهدُ، عَالِمُ العَصر، أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيّ،
** صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ البَدِيْعَة، مِنْ أَهْلِ آمُل طَبَرِسْتَان.
** مَوْلِدُه: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمائَتَيْنِ،
** وَطَلَبَ العِلْمَ بَعْد الأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ ،
** وَأَكْثَرَ التَّرحَال،
** وَلقِي نُبَلاَء الرِّجَال،
** وَكَانَ مِنْ أَفرَاد الدَّهْر عِلْماً، وَذكَاءً، وَكَثْرَةَ تَصَانِيْف.
** قلَّ أَنْ تَرَى العُيُونُ مثلَه.
. . . وَقَالَ مخلدُ البَاقَرحِي:أَنشدنَا مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرٍ لِنَفْسِهِ:
إِذَا أَعْسَرْتُ لَمْ يعلم رفيقي *** وَأَسْتَغْنِي فَيَسْتَغْنِي صَدِيْقِي
حَيَائِي حَافِظٌ لِي مَاءَ وَجْهِي *** وَرِفْقِي فِي مُطَالَبَتِي رَفِيْقِي
وَلَوْ أَنِّي سَمَحْتُ بماء وجهي *** لكنت إلى العلا سَهْلَ الطَّرِيْقِ
وَله:
خُلْقَانِ لاَ أَرْضَى فَعَالَهُمَا *** بَطَرُ الغِنَى وَمَذَلَّةُ الفَقْرِ
فَإِذَا غَنِيْتَ فَلاَ تَكُنْ بَطِراً *** وَإِذَا افْتَقَرْتَ فَتِهْ عَلَى الدَّهْرِ
. . . وَرثَاهُ خلقٌ مِنَ الأَدباء وَأَهْل الدِّين، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْل أَبِي سَعِيْدٍ بن الأَعْرَابِيّ:
حَدَثٌ مُفْظِعٌ وَخَطْبٌ جَلِيْلٌ *** دَقَّ عَنْ مِثْلِهِ اصْطِبَارُ الصَّبُورِ
قَامَ نَاعِي العُلُومِ أَجْمَعِ لمَّا *** قَامَ نَاعِي مُحَمَّدِ بنِ جَرِيْرٍ . اهـ
** وقال الحافظ ابن حجر في كتابه : لسان الميزان (7/ 147)
1775 – بن جرير الطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد صاحب التفسير وسميه : أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم المعتزلي .
** وفي ( سير أعلام النبلاء ) ، (14/ 282) :
176 – مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرِ بنِ رُسْتُمَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ .
قَالَ عَبْدُ العَزِيْزِ الكتَّانِيّ : هُوَ مِنَ الرَّوَافض ، صَنّف كتباً كَثِيْرَة فِي ضلاَلتهِم ،
لَهُ كِتَاب : ( الرُّوَاة عَنْ أَهْلِ البَيْت ) ، وَكِتَاب : ( الْمُسْتَرْشِد فِي الإِمَامَة ) .
نقلته مِنْ خطّ الصَّائِن .
** وفي كتاب ( ذيل ميزان الاعتدال ) ، (ص: 178) للحافظ العراقي:
637 – مُحَمَّد بن جرير بن رستم أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ
رَافِضِي خَبِيث ذكره الْحَافِظ عبد الْعَزِيز الكتاني ، وَقَالَ إِنَّه رَافِضِي ، وَله مؤلفات مِنْهَا : ( الرُّوَاة عَنْ أَهْلِ البَيْت ) ،
** وَلَعَلَّ السُّلَيْمَانِي إِنَّمَا أَرَادَ بالتضعيف هَذَا، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ : إِنَّه كَانَ يضع للروافض ، فَذكر الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ الإِمَام الْمَشْهُور ، وَذكر قَول السُّلَيْمَانِي ورده ، وَكَأَنَّهُ لم يعلم بِأَن فِي الرافضة من شَاركهُ فِي الإسم وَاسم الْأَب والكنية وَالنِّسْبَة ، وَإِنَّمَا يفترقان فِي إسم الْجد فَقَط ،
** فالرافضي إسم جده رستم ،
** وَالْإِمَام الْمَشْهُور إسم جده يزِيد ،
** وَلَعَلَّ مَا حكى عَن مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ من الِاكْتِفَاء فِي الْوضُوء بمسح الرجلَيْن إِنَّمَا هُوَ عَن هَذَا الرافضي فَإِنَّهُ مَذْهَب الشِّيعَة . وَالله أعلم .
** وانظر كتاب : ( لسان الميزان ) ، (5/ 103) للحافظ ابن حجر
رقم الترجمة : ( 345 )
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 5 / 6/ 1438 هـ
** والله الموفق .
(36) فائدة اليوم بعنوان : ( الفاتحة : أم الكتاب ، وحديث عمر في قصة جبريل : أم السنة )
** قال الله تعالى : { وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ }
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي »[ رواه أبو داود ، وصححه الألباني] .
** قال الحافظ رحمه الله في كتابه : ( فتح الباري لابن حجر ) ، (2/ 421) :
( . . . وَقِيلَ : سُمِّيَتْ أُمَّ الْقُرْآنِ ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْمَعَانِي الَّتِي فِي الْقُرْآنِ مِنَ :
الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَالتَّعَبُّدِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ
وَعَلَى مَا فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْفِعْلِ
وَاشْتِمَالِهَا عَلَى ذِكْرِ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ وَالْمَعَاشِ ) .اهـ المراد
** وعن عُمَر بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ،
لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ،
وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، . . . الخ الحديث ) .
** قال الإمام أبو العبَّاس القرطبيُّ في كتابه :
( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (1/ 67) :
فيصلُحُ في هذا الحديث أن يقالَ فيه : إنه أُمُّ السُّنَّة ؛ لما تضمَّنه مِنْ جُمَلِ عِلْمِ السُّنَّة ،
كما سُمِّيَتِ الفاتحةُ : أُمُّ القرآن ؛ لما تضمَّنته مِنْ جملِ معاني القرآن .
** وقال القَاضِى عِيَاض في كتابه : ( إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ، (1/ 204) :
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اشْتَمَلَ عَلَى شَرْحِ جَمِيعِ وَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنْ :
عُقُودِ الْإِيمَانِ
وَأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ
وَإِخْلَاصِ السَّرَائِرِ
وَالتَّحَفُّظِ مِنْ آفَاتِ الْأَعْمَالِ حَتَّى إِنَّ عُلُومَ الشَّرِيعَةِ كُلَّهَا راجعة إليه ومتشعبة مِنْهُ .
** وَعَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ أَلَّفْنَا كِتَابَنَا الَّذِي سَمَّيْنَاهُ :
( بِالْمَقَاصِدِ الْحِسَانِ فِيمَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ ) (1)
إِذْ لَا يَشِذُّ شَيْءٌ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ وَالرَّغَائِبِ وَالْمَحْظُورَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ عَنْ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ
** (1) قال المحقق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل على كتاب (إكمال المعلم بفوائد مسلم) :
ذكره ابنه له، وقال: إنه لم يكمله، والغالب على الظن أنه من الكتب المفقودة، فلم أجد له ذكراً فى غير هذين الموضعين. راجع: الديباج المذهب.
** وقال ابن علان في كتابه :
( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ) ، (1/ 229) :
بعد أن ذكر كلام القاضي عياض وكلام القرطبي :
ومن ثم : قيل لو لم يكن في السنة كلها غير هذا الحديث لكان وافياً بأحكام الشريعة لاشتماله على جملها مطابقة وعلى تفصيلها تضمناً،
فهو جامع لها علماً ومعرفة وأدباً ولطفاً،
ومرجعه من القرآن والسنة كل آية تتضمن ذكر الإسلام أو الإيمان أو الإحسان أو الإخلاص أو المراقبة أو نحو ذلك . اهـ
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 29 / 5 / 1438 هـ
** والله الموفق .
(35) فائدة اليوم بعنوان : ( تعريف كل من : ( الصَّبْر الْجَمِيل , وَالصفح الْجَمِيل , والهجر الْجَمِيل )
** هذ الثلاثة من الأخلاق الكريمة التي حثنا عليها ديننا الحنيف .
** وقد ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم .
** فقال سبحانه على لسانه عبده ونبيه يعقوب عليه السلام : { قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ }
** وقال سبحانه : { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ }
** وقال سبحانه : { وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا }
** والصَّبْر الْجَمِيل : هو الصبر الذي لا جَزَع فيه , ولَا شَكْوى إلى النَّاسِ.
** وَالصفح الْجَمِيل : هو الصفح الذي لا عتاب معه .
** والهجر الْجَمِيل : هو الذي لا أذية معه .
** وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“قال الله تبارك وتعالى : ” إذا ابْتَلْيتُ عبدي المؤْمِنَ فلَمْ يَشكُني إلى عُوّادِه ؛ أطْلَقْتُه مِنْ إساري، ثُمَّ أَبْدَلْتُه لَحْماً خيراً مِنْ لَحْمِه، ودَماً خيراً مِنْ دمِه، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ العَملَ”.
رواه الحاكم وقال: “صحيح على شرطهما”. [ وصححه الألباني ] .
** قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : ( العبودية ) , (ص: 85)
** وَالله تَعَالَى ذكر فِي الْقُرْآن : الهجر الْجَمِيل , والصفح الْجَمِيل , وَالصَّبْر الْجَمِيل ** وَقد قيل: إِن الهجر الْجَمِيل : هُوَ هجر بِلَا أَذَى
** والصفح الْجَمِيل : صفح بِلَا معاتبة
** وَالصَّبْر الْجَمِيل : صَبر بِغَيْر شكوى إِلَى الْمَخْلُوق .
** وَلِهَذَا قرئَ على أَحْمد بن حَنْبَل فِي مَرضه: إِن طاوسا كَانَ يكره أَنِين الْمَرِيض وَيَقُول: إِنَّه شكوى فَمَا أنّ أَحْمد حَتَّى مَاتَ .
** وَأما الشكوى إِلَى الْخَالِق فَلَا تنَافِي الصَّبْر الْجَمِيل فَإِن يَعْقُوب قَالَ : { فَصَبر جميل} وَقَالَ: { إِنَّمَا أَشْكُو بثي وحزني إِلَى الله } . . . الخ . اهـ المراد
** وقال ابن القيم في كتابه : ( مدارج السالكين ) , (2/ 160)
** وَالشَّكْوَى إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُنَافِي الصَّبْرَ .
** فَإِنَّ يَعْقُوبَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – وَعَدَ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ. وَالنَّبِيُّ إِذَا وَعَدَ لَا يُخْلِفُ.
ثُمَّ قَالَ: { إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ }
** وَكَذَلِكَ أَيُّوبُ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَجَدَهُ صَابِرًا مَعَ قَوْلِهِ: { مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ } .
** وَإِنَّمَا يُنَافِي الصَّبْرَ شَكْوَى اللَّهِ، لَا الشَّكْوَى إِلَى اللَّهِ.
** كَمَا رَأَى بَعْضُهُمْ رَجُلًا يَشْكُو إِلَى آخَرَ فَاقَةً وَضَرُورَةً. فَقَالَ: يَا هَذَا، تَشْكُو مَنْ يَرْحَمُكَ إِلَى مَنْ لَا يَرْحَمُكَ؟ ثُمَّ أَنْشَدَ:
وَإِذَا عَرَتْكَ بَلِيَّةٌ فَاصْبِرْ لَهَا *** صَبْرَ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ بِكَ أَعْلَمُ
وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا *** تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ.
وقال الإمام البيهقي في كتابه : ( شعب الإيمان ) , (12/ 397)
9623 – أَنْشَدَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَانَ الْكِرْمَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ , قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو الْفَتْحِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ لِنَفْسِهِ:
لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ فِي *** دُنْيَاهُ مِنْ فَرَحٍ وَغَمْ
وَمِنَ التَّقَلُّبِ دَائِمًا *** فِي رَاحَةٍ أَوْ فِي أَلَمْ
فَإِذَا فَرِحْتَ بِرَاحَةٍ *** فَاشْكُرْ لِوَهَّابِ النِّعَمْ
وَافْزَعْ إِلَى الصَّبْرِ الْجَمِيلِ *** إِذَا أَذَى الْمُرِّ أَلَمْ . اهـ
** وقال الشاعر :
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد *** جاءت محاسنه بألف شفيع
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** السبت 28 / 5 / 1438 هـ
** والله الموفق .
( 34 ) فائدة اليوم بعنوان : ( علماء الجرح والتعديل - في كل زمان ومكان - قليلون جدا )
- قال الحافظ ابن رجب في كتابه القيم : ( جامع العلوم والحكم ) , ت الأرنؤوط (2/ 107) :
( … وَبِكُلِّ حَالٍ فَالْجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ الْعَارِفُونَ بِعِلَلِ الْحَدِيثِ أَفْرَادٌ قَلِيلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ جِدًّا،
- وَأَوَّلُ مَنِ اشْتُهِرَ فِي الْكَلَامِ فِي نَقْدِ الْحَدِيثِ ابْنُ سِيرِينَ،
- ثُمَّ خَلَفَهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ،
- وَأَخَذَ ذَلِكَ عَنْهُ شُعْبَةُ،
- وَأَخَذَ عَنْ شُعْبَةَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ،
- وَأَخَذَ عَنْهُمَا أَحْمَدُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ مَعِينٍ،
- وَأَخَذَ عَنْهُمْ مِثْلُ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَأَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ.
- وَكَانَ أَبُو زُرْعَةَ فِي زَمَانِهِ يَقُولُ: قَلَّ مَنْ يَفْهَمُ هَذَا، وَمَا أَعَزَّهُ ، إِذَا دَفَعْتَ هَذَا عَنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ، فَمَا أَقَلَّ مَنْ تَجِدُ مَنْ يُحْسِنُ هَذَا !
- وَلَمَّا مَاتَ أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ذَهَبَ الَّذِي كَانَ يُحْسِنُ هَذَا – يَعْنِي أَبَا زُرْعَةَ – مَا بَقِيَ بِمِصْرَ وَلَا بِالْعِرَاقِ وَاحِدٌ يُحْسِنُ هَذَا.
- وَقِيلَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي زُرْعَةَ: تَعْرِفُ الْيَوْمَ وَاحِدًا يَعْرِفُ هَذَا ؟ قَالَ : لَا .
- وَجَاءَ بَعْدَ هَؤُلَاءِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ النَّسَائِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عُدَيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ،
- وَقَلَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مَنْ هُوَ بَارِعٌ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْجَوْزِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ ” الْمَوْضُوعَاتُ “:
قَدْ قَلَّ مَنْ يَفْهَمُ هَذَا بَلْ عُدِمَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأربعاء 25 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(33) فائدة اليوم بعنوان : ( شروط دخول حرف (( قد )) على الفعل )
** (( قد )) الحرفية : علامة من العلامات الدالة على فعلية الكلمة .
** وهي علامة مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع , ولا تدخل على فعل الأمر .
** فمثال دخولها على الماضي قولك : ( قد نجح علي ) , و( قد قامت الصلاة ) .
** فمثال دخولها على المضارع قولك 🙁 قد ينجح الكسول ), و( قد يجود الكريم ) .
** ويشترط لدخولها على الفعل شروط .
الأول : أن يكون الفعل متصرفا , كالأمثلة المتقدمة , فلا تدخل على جامد مثل : ( عسى , وليس ) , ونعم , وبئس ) .
الثاني : أن يكون الفعل خبريا , أي : حدثا قد مضى . فلا تدخل على فعل إنشائي , فلا تقل : ( قد بعتك الدار ) تريد إنشاء بيع في الحال .
الثالث : أن يكون الفعل مثبتا . فلا تدخل على فعل منفي , فلا تقل 🙁 ما قد قام زيد)
الرابع : أن يكون الفعل مجرّدا من جازم أو ناصب أو حرف تَنْفِيس , فلا يقال : ( قد لم يذهب ) , ولا : ( قد أن يخرج ) , ولا : ( قد سيقوم , أو قد سوف يقوم )
الخامس : أن يكون الفعل متصلا بها ؛ لأنها كالجُزءِ منه , فلا يقال : ( قد في الدار نام زيد ) , ويَجُوزُ الفَصْلُ بَيْنَها وَبَيْنَ الفِعْلِ بِالقَسَمِ خاصة ، كقول العرب : ( قَدْ وَاللَهِ أَحْسَنْتَ ) .
** قال الشاعر :
أخالِدُ قَدْ – واللهِ – أَوْطَأتَ عَشوَةً … وَمَا العَاشِقُ المِسكينُ فينا بسَارقٍ
وانظر كتاب : ( مغني اللبيب ) , (ص: 227)
(( تنبيه )) :
من الأخطاء الشائعة التي تجري على ألسنة كثير من الناس خاصتهم وعامتهم استعمالهم (( ما )) النافية قبل حرف (( قد )) فيقولون : ( ما قد جاء , ما قد سافر … الخ ).
وأذكر قصة وقعت بيني وبين شيخنا الوادعي رحمه الله , وهي :
أنني كنت يوما من الأيام حارسا للشيخ – وذلك قبل أن يعين الإخوة مجموعة خاصة لحراسة الشيخ – وبعد أن تناولنا طعام الغداء مع الشيخ قلت له : يا شيخ : ما إعراب : ( ما قد قام زيد ) , فسكت الشيخ قليلا ثم قال : ماذا تريد يا أخانا أحمد ؟ هل تريد أنه كيف يكون فاعلا وهو لم يحدث فعلا ؟ فقلت له : لا , ما أردت هذا . فقال لي : فماذا إذن ؟ فقلت له : يا شيخ إنما أردت بهذا أن أنبهك إلى شيء وهو أنه يجري على لسانك كثيرا استعمال (( ما )) النافية قبل حرف (( قد )) وهي لا تدخل عليها .
فقال : جزاك الله خيرا يا أخانا أحمد وبارك فيك .
فقلت له : آمين وإياك .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الثلاثاء 24 / 5 / 1438 هـ
** والله الموفق .
(32) فائدة اليوم بعنوان : ( الفرق بين الكلام والجملة )
** الكلام : هو اللفظ المفيد ، نحو : ( قام زيد ) ، و ( زيد قائم )
** والجملة : هي المركب الإسنادي ( من اسمين أو اسم وفعل ) أفاد نحو : ( زيد قائم ) ونحو : ( قام زيد ) ، أو لم يفد نحو : ( إن قام زيد ) .
** فتبين مما تقدم أن بين الكلام والجملة العموم والخصوص المطلق :
** فالجملة أعم من الكلام ، والكلام أخص منها ،
** فيجتمعان في نحو : ( قام زيد ، و زيد قائم )
** وتنفرد الجملة في نحو : (إن قام زيد ).
** فعلى ما تقدم يقال : ( كل كلام جملة ) ، (وليس كل جملة كلاما ) .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الإثنين 23 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(31) ** فائدة اليوم بعنوان : ( من عجائب الدنيا : الجَمَلُ فِيْ صَنْعَاءَ يُعَلِمُ النَاسَ أَحْكَامَ الدِيْنِ )
** قَالَ الشاعر الشامى :
(إنى رَأَيْت عَجِيبَةً فِي ذَا الزَّمن … شاهدتها فِي وسط صنعاء الْيمن)
(إن تسألونى مَا الذى شاهدته … جملاً بهَا يقرى الورى فِي كل فن)
** فمن هذا الجمل الذي كان يعلم الناس فنون العلم ؟؟؟
** إنه الشيخ العلامة الأجل المطهر بن كثير الجمل اليمنى الصنعانى .
** قال محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسني اليمني الصنعاني (المتوفى: 1381هـ) في كتابه : ( الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) , (2/ 212) :
** الشَّيْخ المطهر بن كثير الْجمل
** الشَّيْخ الْعَلامَة الْأَجَل المطهر بن كثير الْجمل الْيُمْنَى الصنعانى .
** أَخذ عَن عُلَمَاء عصره , وَكَانَ عَالما كَبِيرا محققا شهيرا متفننا فِي جَمِيع الْعُلُوم .
** وَله تلامذة أجلاء , مِنْهُم : السَّيِّد صارم الدّين إبراهيم بن مُحَمَّد الْوَزير , وَالسَّيِّد يحيى بن صَلَاح , وَغَيرهمَا .
** وصنف كتاب : ( الْمِعْرَاج فِي الْأُصُول ) , وتمم كتاب ( جَامع الْخلاف ) , لشيخه السَّيِّد أَحْمد بن مُحَمَّد الأزرقى .
** وصنف غير ذَلِك .
** وَلما وصل بعض عُلَمَاء الْبِلَاد الشامية إِلَى صنعاء , وَرَأى الطّلبَة حافين بِصَاحِب التَّرْجَمَة للأخذ عَنهُ قَالَ الشامى :
(إنى رَأَيْت عَجِيبَة فِي ذَا الزَّمن *** شاهدتها فِي وسط صنعاء الْيمن)
(إن تسألونى مَا الذى شاهدته *** جملا بهَا يقرى الورى فِي كل فن)
** وَمَات صَاحب التَّرْجَمَة بِصَنْعَاء فِي الْمحرم سنة 863 ثَلَاث وَسِتِّينَ وَثَمَانمِائَة رَحمَه الله وإيانا وَالْمُؤمنِينَ . آمين . اهـ
قلت : وهذه الفائدة قد سمعتها كثيرا من شيخنا المبارك علامة اليمن أبي عبد الرحمن الوادعي رحمه الله رحمة الأبرار .
فكان أحيانا يقرأ هذين البيتين ثم يوجه السؤال إلى بعض الطلاب قائلا :
من هذا الجمل يا أخانا ؟ ثم الثاني , ثم الثالث , حتى يجيبه بعض الطلاب ممن قد سمعها منه رحمه الله .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأحد 22 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(30) فائدة اليوم بعنوان : ( البكاء أنواع ، وأعظمه البكاء من خشية الله )
** قَالَ تَعَالَى : { قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً وَيَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً }
** وعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ. رواه الإمام أحمد وغيره ،[وصححه الألباني]
** وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .رواه الترمذي وغيره،[وصححه الألباني]
** زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 176)
** وَأَمَّا بُكَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مِنْ جِنْسِ ضَحِكِهِ لَمْ يَكُنْ بِشَهِيقٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ، كَمَا لَمْ يَكُنْ ضَحِكُهُ بِقَهْقَهَةٍ، وَلَكِنْ كَانَتْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَّى تَهْمُلَا، وَيُسْمَعُ لِصَدْرِهِ أَزِيزٌ.
** وَكَانَ بُكَاؤُهُ تَارَةً رَحْمَةً لِلْمَيِّتِ،
** وَتَارَةً خَوْفًا عَلَى أُمَّتِهِ وَشَفَقَةً عَلَيْهَا،
** وَتَارَةً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَتَارَةً عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَهُوَ بُكَاءُ اشْتِيَاقٍ وَمَحَبَّةٍ وَإِجْلَالٍ مُصَاحِبٌ لِلْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ.
** وَلَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إبراهيم دَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَبَكَى رَحْمَةً لَهُ وَقَالَ: ( «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِكَ يَا إبراهيم لَمَحْزُونُونَ» ) ،
** وَبَكَى لَمَّا شَاهَدَ إِحْدَى بَنَاتِهِ وَنَفْسُهَا تَفِيضُ،
** وَبَكَى لَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ النِّسَاءِ وَانْتَهَى فِيهَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا}
** وَبَكَى لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ،
** وَبَكَى لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَجَعَلَ يَبْكِي فِي صَلَاتِهِ، وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَقُولُ: ( «رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ» ) وَبَكَى لَمَّا جَلَسَ عَلَى قَبْرِ إِحْدَى بَنَاتِهِ، وَكَانَ يَبْكِي أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ.
وَالْبُكَاءُ أَنْوَاعٌ.
** أَحَدُهَا: بُكَاءُ الرَّحْمَةِ وَالرِّقَّةِ.
** وَالثَّانِي: بُكَاءُ الْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ.
** وَالثَّالِثُ: بُكَاءُ الْمَحَبَّةِ وَالشَّوْقِ.
** وَالرَّابِعُ: بُكَاءُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ.
** وَالْخَامِسُ: بُكَاءُ الْجَزَعِ مِنْ وُرُودِ الْمُؤْلِمِ وَعَدَمِ احْتِمَالِهِ.
** وَالسَّادِسُ: بُكَاءُ الْحُزْنِ.
** وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بُكَاءِ الْخَوْفِ، أَنَّ بُكَاءَ الْحُزْنِ يَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ أَوْ فَوَاتِ مَحْبُوبٍ، وَبُكَاءُ الْخَوْفِ يَكُونُ لِمَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ،
** وَالْفَرْقُ بَيْنَ بُكَاءِ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ وَبُكَاءِ الْحُزْنِ، أَنَّ دَمْعَةَ السُّرُورِ بَارِدَةٌ وَالْقَلْبُ فَرْحَانُ، وَدَمْعَةُ الْحُزْنِ حَارَّةٌ وَالْقَلْبُ حَزِينٌ، وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَا يُفْرَحُ بِهِ: هُوَ قُرَّةُ عَيْنٍ، وَأَقَرَّ اللَّهُ بِهِ عَيْنَهُ، وَلِمَا يُحْزِنُ: هُوَ سَخِينَةُ الْعَيْنِ، وَأَسْخَنَ اللَّهُ عَيْنَهُ بِهِ.
** وَالسَّابِعُ: بُكَاءُ الْخَوْرِ وَالضَّعْفِ.
** وَالثَّامِنُ: بُكَاءُ النِّفَاقِ، وَهُوَ أَنْ تَدْمَعَ الْعَيْنُ وَالْقَلْبُ قَاسٍ، فَيُظْهِرُ صَاحِبُهُ الْخُشُوعَ وَهُوَ مِنْ أَقْسَى النَّاسِ قَلْبًا.
** وَالتَّاسِعُ: الْبُكَاءُ الْمُسْتَعَارُ وَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ، كَبُكَاءِ النَّائِحَةِ بِالْأُجْرَةِ، فَإِنَّهَا كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (تَبِيعُ عَبْرَتَهَا وَتَبْكِي شَجْوَ غَيْرِهَا)
** وَالْعَاشِرُ: بُكَاءُ الْمُوَافَقَةِ، وَهُوَ أَنْ يَرَى الرَّجُلُ النَّاسَ يَبْكُونَ لِأَمْرٍ وَرَدَ عَلَيْهِمْ فَيَبْكِي مَعَهُمْ، وَلَا يَدْرِي لِأَيِّ شَيْءٍ يَبْكُونَ، وَلَكِنْ يَرَاهُمْ يَبْكُونَ فَيَبْكِي.
وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ دَمْعًا بِلَا صَوْتٍ فَهُوَ بُكًى -مَقْصُورٌ – وَمَا كَانَ مَعَهُ صَوْتٌ فَهُوَ بُكَاءٌ – مَمْدُودٌ – عَلَى بِنَاءِ الْأَصْوَاتِ.
** وَقَالَ الشَّاعِرُ:
بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا بُكَاهَا … وَمَا يُغْنِي الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيلُ
** وَمَا كَانَ مِنْهُ مُسْتَدْعًى مُتَكَلَّفًا فَهُوَ التَّبَاكِي، وَهُوَ نَوْعَانِ: مَحْمُودٌ وَمَذْمُومٌ، فَالْمَحْمُودُ أَنْ يُسْتَجْلَبَ لِرِقَّةِ الْقَلْبِ وَلِخَشْيَةِ اللَّهِ لَا لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ. وَالْمَذْمُومُ أَنْ يُجْتَلَبَ لِأَجْلِ الْخَلْقِ،
** وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَآهُ يَبْكِي هُوَ وأبو بكر فِي شَأْنِ أُسَارَى بَدْرٍ: أَخْبِرْنِي مَا يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» )
** وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفُ: ابْكُوا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا.
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
السبت 21 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(29) فائدة اليوم فائدة طريفة بعنوان : ( رجل من العرب طلق خمس نسوة في مجلس واحد )
في كتاب : ( العقد الفريد ) , (7/ 129) :
** قَالَ الأصمعي ( واسمه : عبد الملك بن قريب ) للرشيد في بعض حديثه :
بَلغنِي يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَن رجلا من الْعَرَب طلق فِي يَوْم خمس نسْوَة
** قَالَ : إِنَّمَا يجوز ملك الرجل على أَربع نسْوَة , فَكيف طلق خمْسا ؟!!!
** قَالَ : كَانَ لرجل أَربع نسْوَة , فَدخل عَلَيْهِنَّ يَوْمًا فوجدهن متلاحيات متنازعات ,
فَقَالَ : إِلَى مَتى هَذَا التَّنَازُع ؟
مَا إخال هَذَا الْأَمر إِلَّا من قبلك , يَقُول ذَلِك لَا مرأة مِنْهُنَّ , اذهبى فَأَنت طَالِق .
** فَقَالَت لَهُ صاحبتها : عجلت عَلَيْهَا بِالطَّلَاق , وَلَو أدبتها بِغَيْر ذَلِك لَكَانَ حَقِيقا .
** فَقَالَ لَهَا : وَأَنت أَيْضا طَالِق .
** فَقَالَت لَهُ الثَّالِثَة : قبحك الله , فوَاللَّه لقد كَانَتَا إِلَيْك محسنتين , وَعَلَيْك مفضلتين .
** فَقَالَ : وَأَنت أيتها المعددة أياديهما طَالِق أَيْضا .
** فَقَالَت لَهُ الرَّابِعَة – وَكَانَت هلالية , وفيهَا أَنَاة شَدِيدَة -: ضَاقَ صدرك عَن أَن تؤدب نِسَاءَك إِلَّا بِالطَّلَاق .
** فَقَالَ لَهَا : وَأَنت طَالِق أَيْضا .
** وَكَانَ ذَلِك بمسمع جَارة لَهُ فَأَشْرَفت عَلَيْهِ وَقد سَمِعت كَلَامه , فَقَالَت : وَالله مَا شهِدت الْعَرَب عَلَيْك وعَلى قَوْمك بالضعف إِلَّا لما بلوه مِنْكُم ووجدوه فِيكُم , أَبيت إِلَّا طَلَاق نِسَائِك فى سَاعَة وَاحِدَة .!!!
** قَالَ : وَأَنت أَيْضا أيتها المؤنبة المتكلفة طَالِق إِن أجَاز زَوجك .
** فَأَجَابَهُ من دَاخل بَيته : قد أجزت قد أجزت . اهـ
** قلت : وقد سمعت هذه الفائدة كثيرا من شيخنا المبارك علامة اليمن أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الخميس 19 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(28) فائدة اليوم فائدة لطيفة بعنوان : (عليك بالبكر الودود الولود ، وإياك والمنانة ، والأنانة ، والحنانة ، و. . . )
** قال الله تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }.
** عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ، قَالَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُعْطِيكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ»
رواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ، (13/ 160) ، وصححه الألباني .
** وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ : «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: « أَبِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟ » قُلْتُ: ثَيِّبًا،
قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى، وَلِعَابِهَا»،
قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ، وَإِنَّمَا قَالَ:
« فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ » متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم .
** قوله:(ولِعَابِهَا) بالكسر، وهو من الملاعبة، مصدر لاعب ملاعبة كقاتل مقاتلة.
** والعذارى : أي الأبكار ، جمع عذراء ، ومعناها ذات عذرة .
** وعذرة الجارية : بكارتها .
** وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ»[ رواه النسائي وغيره ، وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح ]
** قال الشيخ الألباني رحمه الله في ( صحيح الترغيب والترهيب ) ، (2/ 407) :
** (الودود): هي التي تحب زوجها.
** (الولود): التي تكثر ولادتها.
** وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تكن ودودًا لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولودًا لم يحصل المطلوب، وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد،
** ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربها، إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض.
** قوله: “فإني مكاثر بكم الأمم” أي: مفاخر بسببكم سائر الأمم بكثرة أتباعي. والله أعلم. اهـ المراد
وقال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب ( الكبائر ) (ص: 174) :
** وَيَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تعرف أَنَّهَا كالمملوك للزَّوْج فَلَا تتصرف فِي نَفسهَا وَلَا فِي مَاله إِلَّا بِإِذْنِهِ
** وَتقدم حَقه على حَقّهَا وَحُقُوق أَقَاربه على حُقُوق أقاربها
** وَتَكون مستعدة لتمتعه بهَا بِجَمِيعِ أَسبَاب النَّظَافَة
** وَلَا تفتخر عَلَيْهِ بجمالها
** وَلَا تعيبه بقبح إِن كَانَ فِيهِ
** قَالَ الْأَصْمَعِي دخلت الْبَادِيَة فَإِذا امْرَأَة حسناء لَهَا بعل قَبِيح فَقلت لَهَا كَيفَ ترْضينَ لنَفسك أَن تَكُونِي تَحت مثل هَذَا فَقَالَت : اسْمَع يَا هَذَا لَعَلَّه أحسن فِيمَا بَينه وَبَين الله خالقه فجعلني ثَوَابه ولعلي أَسَأْت فَجعله عقوبتي .
وقال أيضًا في (ص: 175) :
** وَيجب على الْمَرْأَة أَيْضا دوَام الْحيَاء من زَوجهَا
** وغض طرفها قدامه
** وَالطَّاعَة لأَمره
** وَالسُّكُوت عِنْد كَلَامه
** وَالْقِيَام عِنْد قدومه
** والابتعاد عَن جَمِيع مَا يسخطه
** وَالْقِيَام مَعَه عِنْد خُرُوجه
** وَعرض نَفسهَا عَلَيْهِ عِنْد نَومه
** وَترك الْخِيَانَة لَهُ فِي غيبته فِي فرَاشه وَمَاله وبيته
** وَطيب الرَّائِحَة وتعاهد الْفَم بِالسِّوَاكِ وبالمسك وَالطّيب
** ودوام الزِّينَة بِحَضْرَتِهِ
** وَتركهَا الْغَيْبَة
** وإكرام أَهله وأقاربه
** وَترى الْقَلِيل مِنْهُ كثيرًا . اهـ
قال الشاعر :
إذا رمتها كانت فراشا تقلني *** وعند فراغي خادم يتملق
وفي كتاب ( مجالس ثعلب ) ، (ص: 46)
** وقال رجل لابنه يوصيه: يا بنى، إياك والرقوب، الغضوب القطوب، الغلباء الرقباء، اللفوت الشوساء، المنانة، الأنانة، الحنانة . . .
** يعني بالرقوب: التي تراقبه أن يموت فترثه.
** والغضوب : كثيرة الغضب .
** والقطوب : العابسة .
** الغلباء الرقباء: الغليظة الرقبة.
** واللفوت: التي عينها لا تثبت في موضع واحد، إنما همها أن يغفل عنها فتغمز غيره.
** والشوساء : المتشاوسة النظر من التيه.
** والمنانة: الَّتِي تَمُنُّ عَلَى زَوْجِهَا بِمَالِها .
** والحنانة: التي تحن إلى زوجها الأَوَّل وتعطِفُ عَلَيْهِ ،
وقيلَ : هِيَ الَّتِي تَحِنُّ على ولدِها الَّذِي مِن زَوْجِها المُفارِقِ لَهَا.
** وَالْأَنَّانَةُ : الَّتِي تَئِنُّ من غير وجع كَسَلًا وَتَمَارُضًا .
اهـ بتصرف يسير مع زيادة .
وانظر كتاب : ( محاضرات الأدباء ) ، (1 / 411)
وكتاب : ( أدب الدنيا والدين ) – (1 / 196)
وكتاب : ( تاج العروس ) – (1 / 8016)
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الثلاثاء 17 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(27) فائدة اليوم بعنوان : (جِهَاد النَّفْسِ : أعظم أنواع الْجِهَاد وأساسها )
** قال تعالى : { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ }
** وقال تعالى : { وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى }
** وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أفضلُ الْمُؤْمِنينَ إسْلاماً مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدِه وأفْضَلُ المُؤْمِنينَ إيمَاناً أحْسَنُهُمْ خُلُقاً وأفْضَلُ المُهاجِرِينَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وأفضلُ الجهادِ منْ جاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذاتِ اللَّهِ عزّ وجَل » (رواه الطبراني , وصححه الألباني)
** قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم : ( زاد المعاد ) , (3/ 5)
وَلَمَّا كَانَ جِهَادُ أَعْدَاءِ اللَّهِ فِي الْخَارِجِ فَرْعًا عَلَى جِهَادِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( « الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» ) كَانَ جِهَادُ النَّفْسِ مُقَدَّمًا عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ فِي الْخَارِجِ، وَأَصْلًا لَهُ، فَإِنَّهُ مَا لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَّلًا لِتَفْعَلَ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَتَتْرُكَ مَا نُهِيَتْ عَنْهُ وَيُحَارِبُهَا فِي اللَّهِ لَمْ يُمْكِنْهُ جِهَادُ عَدُوِّهِ فِي الْخَارِجِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُهُ جِهَادُ عَدُوِّهِ وَالِانْتِصَافُ مِنْهُ وَعَدُوُّهُ الَّذِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ قَاهِرٌ لَهُ مُتَسَلِّطٌ عَلَيْهِ لَمْ يُجَاهِدْهُ وَلَمْ يُحَارِبْهُ فِي اللَّهِ، بَلْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى عَدُوِّهِ حَتّى يُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى الْخُرُوجِ .
(( مراتب مجاهدة النّفس )) :
** قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم : ( زاد المعاد ), (3/ 9) :
فَجِهَادُ النَّفْسِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ أَيْضًا:
** إِحْدَاهَا: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى تَعَلُّمِ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الَّذِي لَا فَلَاحَ لَهَا وَلَا سَعَادَةَ فِي مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَا إِلَّا بِهِ، وَمَتَى فَاتَهَا عِلْمُهُ شَقِيَتْ فِي الدَّارَيْنِ.
** الثَّانِيَةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ الْعِلْمِ بِلَا عَمَلٍ إِنْ لَمْ يَضُرَّهَا لَمْ يَنْفَعْهَا.
** الثَّالِثَةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، وَتَعْلِيمِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ، وَإِلَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ، وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.
** الرَّابِعَةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَشَاقِّ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَأَذَى الْخَلْقِ، وَيَتَحَمَّلُ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهِ.
** فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ، فَإِنَّ السَّلَفَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّى رَبَّانِيًّا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ، فَمَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ فَذَاكَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ . اهـ
** قال الشاعر وهو أَبُو ذُؤَيْب :
والنفس راغبة إذا رغبتها * * * وإذا ترد إلى قليل تقنع
** وقال أبو نواس:
وإذا نزعْتَ عن الغوايةِ فليكنْ * * * للهِ ذاكَ النزعُ لا للناسِ
** وقال أبو دُلَف:
صبرْتُ عنِ اللذاتِ حتى تولّتِ * * * وألزمتُ نفسي صبرَها فاستمرَّتِ
وما النفسُ إلاّ حيثُ يجعلُها الفتى * * * فإنْ أُطمعَتْ تاقَتْ وإلاّ تسلّتِ
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأحد 15 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
( 26 ) فائدة اليوم بعنوان : ( الفرق بين الكلام والكلم ) :
** الكلام : هو اللفظ المفيد ، سواء كان مركبا من كلمتين نحو : ( قام زيد ) ، أو أكثر نحو : ( قد قام زيد )
** والكلم : هو اللفظ المركب من ثلاث كلمات ، مفيدًا كان نحو : ( قد قام زيد ) أو غير مفيد نحو : ( إن قام زيد )
** فتبين مما تقدم أن بين الكلام والكلم العموم والخصوص الوجهي :
** فالكلام أعم من جهة التركيب ، وأخص من جهة الإفادة .
** والكلم أخص من جهة التركيب، وأعم من جهة الإفادة .
** فيجتمعان في نحو : ( قد قام زيد ) ، فإنه كلام ؛ لإفادته ، وكلم ؛ لأنه مركب من ثلاث كلمات .
** وينفرد الكلم في نحو : ( إن قام زيد ) .
** وينفرد الكلام في نحو : ( قام زيد ).
** وعلى ما تقدم فلا يقال : كل كلام كلم ، ولا كل كلم كلام .
[فائدة ]:
** قال الخضري في ( حاشيته على ابن عقيل ) ، (1/ 43) :
قوله: [يعني: ابن عقيل] : (إِنْ قَامَ زَيْدٌ)،
يُلْغَزُ بذلك فيقال : أي قَوْلٍ: إنْ نَقَصَ زَادَ، وإن زَادَ نَقَصَ ، أَي : إنْ نَقَصَ لَفْظُهُ زاد مَعْنَاهُ وعَكْسُهُ .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
السبت 14 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
( 25 ) فائدة اليوم بعنوان : (( اغتنم إجابة الدعوة في ساعة يوم الجمعة، وهي آخر ساعة منه على الصحيح ))
** قال الله تعالى: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ :
( فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ) متفق عليه.
** وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
« يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ »[رواه النسائي وغيره وصححه الألباني]
** وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ على أكثر من أربعين قولا ، كما في كتاب فتح الباري لابن حجر (2/ 416)
والصحيح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة كما رجحه كثير من أهل العلم ، منهم ابن القيم رحمه الله .
** قال رحمه الله في كتابه القيم : ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) ، (1/ 378) :
( . . . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهَذَا أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَخَلْقٍ. . . . ) اهـ
** وأما الحديث الذي رواه مسلم من طريق مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» فقد أُعِلَّ بِالِانْقِطَاعِ وَالِاضْطِرَابِ .
** قال الحافظ رحمه الله في كتابه : ( فتح الباري لابن حجر ) ، (2/ 421) :
( . . . وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ على ذَلِك
وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ أَثْبَتُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ
وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الصَّحَابَةِ اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا سَاعَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ افْتَرَقُوا فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَرَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَيْضًا كَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمِنَ الْمَالِكِيَّةِ الطُّرْطُوشِيُّ
وَحَكَى العلائي أَن شَيْخه بن الزَّمْلَكَانِيِّ شَيْخَ الشَّافِعِيَّةِ فِي وَقْتِهِ كَانَ يَخْتَارُهُ وَيَحْكِيهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ
وَأَجَابُوا عَنْ كَوْنِهِ لَيْسَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ لَا يَكُونُ مِمَّا انْتَقَدَهُ الْحُفَّاظُ كَحَدِيثِ أَبِي مُوسَى هَذَا فَإِنَّهُ أُعِلَّ بِالِانْقِطَاعِ وَالِاضْطِرَابِ
أَمَّا الِانْقِطَاعُ فَلِأَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ بُكَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ قَالَهُ أَحْمَدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ نَفْسِهِ وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَخْرَمَةَ وَزَادَ إِنَّمَا هِيَ كُتُبٌ كَانَتْ عِنْدَنَا وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ عَنْ مَخْرَمَةَ إِنَّهُ قَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبِي وَلَا يُقَالُ مُسْلِمٌ يَكْتَفِي فِي الْمُعَنْعَنِ بِإِمْكَانِ اللِّقَاءِ مَعَ الْمُعَاصَرَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا لِأَنَّا نَقُولُ وُجُودُ التَّصْرِيحِ عَنْ مَخْرَمَةَ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ كَافٍ فِي دَعْوَى الِانْقِطَاعِ
وَأَمَّا الِاضْطِرَابُ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَوَاصِلٌ الْأَحْدَبُ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَبُو بُرْدَةَ كُوفِيٌّ فَهُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِهِ مِنْ بُكَيْرٍ الْمَدَنِيِّ وَهُمْ عَدَدٌ وَهُوَ وَاحِدٌ وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ مَرْفُوعًا لَمْ يُفْتِ فِيهِ بِرَأْيهِ بِخِلَافِ الْمَرْفُوعِ وَلِهَذَا جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ هُوَ الصَّوَابُ . ، . . . الخ ) اهـ المراد
** وانظر للفائدة كتاب : (( الإلزامات والتتبع )) للدارقطني بتحقيق شيخنا الوادعي رحمه الله صـ ( 272 ) رقم الحديث (40 ) .
** وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“أعْجَزُ الناسِ مَنْ عَجِزَ في الدُّعاءِ، وأبْخَلُ الناسِ مَنْ بَخِلَ بالسَّلامِ”.رواه الطبراني في “الأوسط” وقال الشيخ الألباني [حسن صحيح]
** وهذه بعض الأحاديث التي يرجى لمن دعاء بها أن يستجيب الله له :
** عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ” [رواه أحمد وغيره ، وصححه الألباني]
** عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي عَيَّاشٍ زَيْدِ بْنِ صَامِتٍ الزُّرَقِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا مَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ” [رواه أحمد وغيره ، وصححه الألباني]
** عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “دَعوة ذي النونِ إذ دعاهُ وهو في بَطنِ الحوتِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}؛ فإنَّه لمْ يَدْعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شَيْءٍ قَطُّ؛ إلا اسْتجابَ الله له”.
[رواه الترمذي وغيره ، وصححه الألباني]
** ذكر بعض شروط الدعاء وآدابه :
** تجنب الحرام في (المأكل – المشرب – الملبس – المكسب)
** الإخلاص لله تعالي .
** التنظف والتطهر والوضوء.
** أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي علي نبيه – صلى الله عليه وسلم – في أول الدعاء وفي أخره.
** أن يبسط اليدين ويرفعها حذو المنكبين.
** التأدب والتمسكن مع الخشوع والخضوع.
** أن يسأل الله تعالي بأسمائه الحسني وصفاته العُلا.
** أن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم لوالديه ، ثم المؤمنين والمؤمنات
** أن يخفض صوته .
** أن يدعو بجوامع الكلم من المأثور بالكتاب والسنة.
** أن يحضر قلبه ويحسن رجاءه.
** أن يلح على ربه في الدعاء.
** أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم.
** أن لا يستعجل بأن يستبطئ الإجابة.
** قال الشاعر :
سَلِ الإِلَهَ إِذَا نَابَتُكَ نَائِبَةٌ * * * فَهُوَ الذِيِ يُرْتَجَى مِنْ عِنْدِهِ الأَمَلُ
فَإِنْ مُنِحَتَ فَلا مَنٌ وَلا كَدَرٌ * * * وَإِنْ َ رَدِدْتَ فَلا ذِلٌ وَلا خَجَلُ
** وقال أخر :
وإني لأدعو الله والأمر ضيق * * * عليّ فما ينفك أن يتفرجا
ورب فتىً سُدت عليه وجوهه * * * أصاب له في دعوة الله مخرجا
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الخميس 12 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
( 24 ) فائدة اليوم بعنوان : ( معرفة الْمُتَّفِقِ والمُفْتَرِقِ من الأسماء، وأهمية ذلك )
** تعريفه : أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء ، أو الكنى والألقاب ، أو الأنساب خطاً ونطقاً وتختلف الأشخاص .
** فائدته : له فائدتان :
الأولى : أن لا يُظَن الاثنان واحدا .
الثانية : أن لا يلتبس الضعيف بالثقة إذا كانوا في طبقة واحدة .
** قال ابن الجوزي في كتابه ( المدهش ) ، (ص: 61)
وَاعْلَم أَن مثل هَذِه الْأَسْمَاء المشتبهة إِذا لم يُصَرح فِي الحَدِيث ببيانها لم يفرق بَينهَا إِلَّا النَّاقِد المجود
وَفِي الْفرق بَينهَا فَائِدَة عَظِيمَة وَهِي أَن بعض الروَاة ثِقَة ومشبهه فِي الِاسْم يكون ضَعِيفا فيطلب الْفرق لذَلِك مِثَاله أَن يروي قَتَادَة عَن عِكْرِمَة وَهُوَ يروي عَن عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس وَذَاكَ ثِقَة وَعَن عِكْرِمَة بن خَالِد وَهُوَ ضَعِيف وَكَذَا قَول وَكِيع حَدثنَا النَّضر عَن عِكْرِمَة وَهُوَ يروي عَن النَّضر بن عَرَبِيّ وَهُوَ ثِقَة وَعَن النَّضر بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ ضَعِيف وَمثله قَول حَفْص بن غياث عن أَشْعَث عَن الْحسن وَهُوَ يروي عَن أَشْعَث بن عبد الْملك وَهُوَ ثِقَة وَعَن أَشْعَث بن سوار وَهُوَ ضَعِيف .
** منتخب من الْمُتَّفق والمفترق
** ( أنس بن مَالك ) خَمْسَة :
اثْنَان من الصَّحَابَة : أَبُو حَمْزَة الْأنْصَارِيّ ، وَأَبُو أُميَّة الكعبي ، وَالثَّالِث : أَبُو مَالك الْفَقِيه ، وَالرَّابِع : كُوفِي ، وَالْخَامِس ، حمصي .
** ( أُسَامَة بن زيد ) سِتَّة :
أحدهم : مولى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، وَالثَّانِي : تنوخي ، وَالثَّالِث : ليثي ، وَالرَّابِع : كَلْبِي ، وَالْخَامِس : شيرازي ، وَالسَّادِس : مولى لعمر .
** ( أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان ) أَرْبَعَة فِي طبقَة وَاحِدَة :
أحدهم : دينوري ، وَالثَّانِي : طرسوسي ، وَالثَّالِث : قطيعي ، وَالرَّابِع : سقطي .
** ( جَابر بن عبد الله ) سَبْعَة :
أحدهم : ابْن عَمْرو ، وَالثَّانِي : ابْن رِئَاب ، صحابيان ، وَالثَّالِث : سلمى ، وَالرَّابِع: محاربي ، وَالْخَامِس : غطفاني ، وَالسَّادِس : مصري ، وَالسَّابِع : بَصرِي .
** ( الْخَلِيل بن أَحْمد ) خَمْسَة :
ثَلَاثَة : بصريون ، وَالرَّابِع : أصبهاني ، وَالْخَامِس : سجزي .
** ( سعيد بن الْمسيب ) ثَلَاثَة :
أحدهم : مدنِي ، وَالثَّانِي : بلوي ، وَالثَّالِث : شيرازي .
** ( عبد الله بن الْمُبَارك ) سِتَّة :
أحدهم : مروزي ، وَالثَّانِي : خراساني ، وَالثَّالِث : بخاري ، وَالرَّابِع : جوهري ، والباقيان : من أهل بَغْدَاد
** ( عمر بن الْخطاب ) سَبْعَة :
أحدهم : أَمِير الْمُؤمنِينَ ، وَالثَّانِي : كُوفِي ، وَالثَّالِث : بَصرِي ، وَالرَّابِع : اسكندراني ، وَالْخَامِس : سجستاني ، وَالسَّادِس : راسبي ، وَالسَّابِع : عنبري .
** ( عُثْمَان بن عَفَّان ) اثْنَان :
أَحدهمَا : أَمِير الْمُؤمنِينَ ، وَالثَّانِي : سجزي .
** ( عَليّ بن أبي طَالب ) ثَمَانِيَة :
أحدهم : أَمِير الْمُؤمنِينَ ، وَالثَّانِي : بَصرِي ، وَالثَّالِث : جرجاني ، وَالرَّابِع : اسْتُرْ اباذي ، وَالْخَامِس : تنوخي ، وَالسَّادِس : بكر اباذي ، وَالسَّابِع : بغدادي ، وَالثَّامِن: يُقَال لَهُ : الدهان .
** ( عمران بن حُصَيْن ) أَرْبَعَة
أحدهم : صَحَابِيّ ، وَالثَّانِي : ضبي ، وَالثَّالِث : بَصرِي ، وَالرَّابِع : اصبهاني .
** ( فُضَيْل بن عِيَاض ) اثْنَان :
أَحدهمَا : مصري ، وَالثَّانِي : مكي .
** ( يحيى بن معَاذ ) ثَلَاثَة :
أحدهم : نيسابوري ، وَالثَّانِي : رازي ، وَالثَّالِث : تستري .
** ( يُوسُف بن اسباط ) ثَلَاثَة :
أحدهم : كُوفِي ، وَالثَّانِي : حمصي ، وَالثَّالِث : سلمى . اهـ
( تنبيهان ) :
** أحدهما : قول ابن الجوزي : (( (الخليل بن أحمد) خمسة )) .
الصحيح أنهم ستة ، كما ذكره كثير من المصنفين .
** الثاني :
( أحمد الفراهيدي ) ، والد الخليل هذا : هو أول من تسمى : بـ( أحمد ) بعد نبينا صلى الله عليه وسلم .
وانظر كتاب : ( التقريب والتيسير ) ، للنووي رحمه الله (ص: 110)
و ( التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ) ، (ص: 406) وغيرهما.
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأربعاء 11 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(23) فائدة اليوم بعنوان : (جرح اللسان أعظم خطرا وأشد ضررا من جرح السنان )
** اللسان ضرره عظيم ، وخطره جسيم ، فهو صغير الجِرْمِ عظيم الجُرْمِ – بكسر الجيم في الأول وضمها في الثاني – ، أي : حجمه صغير وضرره كبير ، وربما أوصل صاحبه إلى الهلاك ، والعياذ بالله .
** قال الله تعالى : ((وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ))
** وعَنْ عَبْد اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» متفق عليه
** وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ»
** قال المناوي في كتابه : ( فيض القدير ) ، (5/ 411)
( لو مزجت بماء البحر لمزجته ) أي : خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه لشدة نتنها وقبحها كذا قرره النووي .
وقال غيره: معناه هذه غيبة منتنة لو كانت مما يمزج بالبحر مع عظمه لغيرته فكيف بغيره .
قال النووي: هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ {وما ينطق عن الهوى} اهـ
** قال الشاعر :
يَمُوتُ الفتى من عَثْرةٍ بلسانِهِ * * * وليس يموتُ المرءُ من عَثْرة الرِّجْلِ
فعثرتُه من فِيهِ تَرْمِي برأسهِ * * * وعثرتُه بالرّجْل تَبْرا على مَهْلِ
** العقد الفريد – (1 / 236)
** وقال يَعقوب الحَمْدونيّ:
وقد يُرْجَى لجُرح السًيف بُرءٌ * * * ولا بُرْءٌ لما جرح اللّسانُ
** وقال آمرؤُ القيس: وجُرْح اللّسان كجُرح اْلْيَد .
** وقال الأخطل: والقول يَنْفذ ما لا تَنفذ الإبرُ.
وفي اللطائف والظرائف (ص: 104)
باب ذم اللسان
كان يقال: مقتل الرجل بين فكّيه.
وقال بعض البلغاء: اللسان أجرح جوارح الإنسان.
وقال آخر: اللسان سبع صغير الجرم كبير الجرم.
قال بعض العرب لرجل وهو يعظه في حفظ اللسان: إياك أن يضرب لسانك عنقك. وقد قيل:
احْذَرْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ * * * لاَ يَلْدَغَنَّكَ إِنَّهُ ثُعْبَانُ
كَمْ في المَقَابِرِ مِنْ قتيل لِسَانِهِ * * * كَانَتْ تَهَابُ لِقَاءهُ الفرسانُ
وقال آخر:
جراحات السّنان لها التئام * * * لا يلتام ما جرح اللسان
وقال ابن المعتز:
أيا ربّ ألسنة كالسيوف * * * تقطّع أعناق أصحابها
وكم قد دهى المرء من نفسه * * * فلا تؤكلن بأنيابها .
اهـ باختصار .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الاثنين 9 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(22) فائدة اليوم بعنوان : (( الأمثال العربية ))
** قال الله تعالى ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )
** و( المثل ) – بفتح الميم والثاء – هو : ( قول مركب مشهور شُبِّه مضربه بمورده ) . اهـ
شرح التعريف :
** قولهم : ( مشهور ) أخرج ما لم يشتهر من الأقوال .
** قولهم : ( شُبِّه مضربه ) ، مضرب المثل : هو الواقعة الجديدة التي شبهت بالواقعة التي وقع فيها المثل .
** وقولهم : ( بمورده ) ، مورد المثل : هو الحالة الأولى التي نشأ الكلام لأجلها، أي : القِّصة التي ورد عليها المثل .
** ولذلك يحكى المثل بلفظه كما هو بدون تغيير مهما كان نوع الخطاب أو نسق الكلام ، كقولهم : “الصيف ضيعت اللبن”، يقال بكسر التاء لكل مخاطب .
** وهو مثل يضْرب لمن فرط فِي طلب الْحَاجة وَقت إمكانها ثمَّ طلبَهَا بعد فَوَاتهَا .
** ففي كتاب ( مجمع الأمثال ) ، (2/ 68) لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني :
2725- (( فِي الصِّيفِ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ ))
ويروى : “الصَّيْفَ ضَيَّعْتِ اللبن” والتاء من”ضيعت” مكسور في كل حال إذا خوطب به المذكر والمؤنث والاثنان والجمع؛ لأن المثَلَ في الأصل خوطبت به امرَأة، وهي دَخْتَنُوس بنت لقيط بن زرارة كانت تحت عمرو بن عُدَاس، وكان شيخاً كبيراً فَفَركَتْهُ (فركته : كرهته) فطلقها، ثم تزوجها فتى جميل الوجه، أجْدَبَتْ فبعثت إلى عمرو تطلب منه حَلُوبة، فَقَال عمرو “في الصيف ضيعت اللبن” فلما رجع الرسُولُ وقَال لها ما قَال عمرو ضربَتْ يَدَها على منكب زوجها، وقَالت “هذا ومَذْقُه خَيرٌ” تعني أن هذا الزوج مع عدم اللبن خيرٌ من عمرو، فذهبت كلماتها مَثَلاً .
فالأول يضرب لمن يطلب شيئاً قد فَوَّته على نفسه،
والثاني يضرب لمن قَنَع باليسير إذا لم يجد الخطير.
وإنما خص الصيف لأن سؤالها الطلاقَ كان في الصيف، أو أن الرجل إذا لم يطرق ماشيته في الصيف كان مضيعاً لألبانها عند الحاجة . اهـ
** والمثل : يكون شعرًا، ويكون نثرًا، ولكنه في النثر أكثر دورانًا، ولذلك يعد في النثر .
** وهو ثمرة ناضجة من ثمرات الاختبار الطويل، والتجربة الصادقة، والعقل الراجح، والرأي السديد)
** وانظر كتاب ( تاريخ الأدب الجاهلي ) (ص: 260) تأليف: علي الجندي
=======================
** وفي كتاب ( المدهش ) ، لابن الجوزي (ص: 16- 17) :
** فصل في ذكر أمثال القرآن : ( في القرآن ثلاثة وأربعون مثلا ، … )
** وكم من كلمة تدور على الألسن ( مثلا ) جاء القرآن بألخص منها وأحسن :
** فمن ذلك قولهم : (( القتل أنفى للقتل )) ، مذكور في قوله : ( ولكم في القصاص حيوة )
** وقولهم : (( ليس المخبر كالمعاين)) ، مذكور في قوله تعالى :
( ولكن ليطمئن قلبي )
** وقولهم : (( ما تزرع تحصد )) ، مذكور في قوله تعالى : ( من يعمل سوءا يجزيه )
** وقولهم : (( للحيطان آذان مذكور )) في قوله تعالى : ( وفيكم سماعون لهم)
** وقولهم : (( الحمية رأس الدواء ))، مذكور في قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا )
** وقولهم : (( احذر شر من أحسنت إليه ))، مذكور في قوله تعالى :
( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله )
** وقولهم : : من جهل شيئا عاداه )) ، مذكور في قوله تعالى :
( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) ، ( وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم )
** وقولهم : (( خير الأمور أوساطها )) ، مذكور في قوله تعالى :
( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط )
** وقولهم : (( من أعان ظالما سلطه الله عليه )) ، مذكور في قوله تعالى : ( كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله )
** وقولهم : (( لما انضج رمد )) ، مذكور في قوله تعالى : ( وأعطى قليلا و أكدى)
** وقولهم : (( لا تلد الحية إلا حية )) ، مذكور في قوله تعالى : ( ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
السبت 7 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(21) فائدة اليوم بعنوان : لقب (( سيبويه )) يطلق على أربعة من النحويين . ولقب : (( ثعلب )) يطلق على اثنين من النحويين .
** قال السيوطي في كتابه : ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) ، (2/ 387)
سيبويه أربعة:
أحدهم : إمام العربية عمرو بن عثمان بن قَنْبَر .
والثاني : محمد بن موسى بن عبد العزيز المصري .
والثالث : محمد بن عبد العزيز الأصبهاني .
والرابع : أبو الحسن علي بن عبد الله الكومي المغربي .
** ثعلب : اثنان:
أشهرهما: الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى .
والثاني : محمد بن عبد الرحمن . اهـ
** ثم قال السيوطي في صـ ( 388 ) :
وحيث أطلق البصريون أبا العباس فالمراد به المبرِّد.
وحيث أطلقه الكوفيون فالمراد به ثَعْلَب.
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأربعاء 4 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(20) فائدة اليوم بعنوان : (( أقسام القلوب من حيث قربها وبعدها من ربها علام الغيوب ))
** قد دلت النصوص الشرعية من الكتاب وصحيح السنة أن القلوب على ثلاثة أقسام :
** قلب حي سليم، وهو قلب المؤمن.
** وقلب ميت ، وهو قلب الكافر.
** وقلب مريض ، وهو قلب المؤمن العاصي ، ففيه مادة حياة ، ومادة موت ، أي: فيه صحة ومرض، وهو لما غلب عليه منهما .
** فالْقَلْبُ السَّلِيمُ : هُوَ الَّذِي سَلِمَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالشُّحِّ وَالْكِبْرِ وَحُبِّ الدُّنْيَا وَالرِّيَاسَةِ، فَسَلِمَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ تُبْعِدُهُ عَنِ اللَّهِ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ تُعَارِضُ خَبَرَهُ، وَمِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ تُعَارِضُ أَمْرَهُ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ إِرَادَةٍ تُزَاحِمُ مُرَادَهُ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِّ قَاطِعٍ يَقْطَعُ عَنِ اللَّهِ، فَهَذَا الْقَلْبُ السَّلِيمُ فِي جَنَّةٍ مُعَجَّلَةٍ فِي الدُّنْيَا، وَفِي جَنَّةٍ فِي الْبَرْزَخِ، وَفِي جَنَّةِ يَوْمِ الْمَعَادِ.
**وَلَا تَتِمُّ لَهُ سَلَامَتُهُ مُطْلَقًا حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ شِرْكٍ يُنَاقِضُ التَّوْحِيدَ، وَبِدْعَةٍ تُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَشَهْوَةٍ تُخَالِفُ الْأَمْرَ، وَغَفْلَةٍ تُنَاقِضُ الذِّكْرَ، وَهَوًى يُنَاقِضُ التَّجْرِيدَ وَالْإِخْلَاصَ.
وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ حُجُبٌ عَنِ اللَّهِ، وَتَحْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ، تَتَضَمَّنُ أَفْرَادًا لَا تَنْحَصِرُ.
** والقلب الميت : هو الذى لا حياة به، فهو لا يعرف ربه، ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته؛ ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالى إذا فاز بشهوته وحظه، رضى ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله : حبا، وخوفا، ورجاء، ورضا، وسخطا، وتعظيما؛ وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه .
** والقلب المريض : هو الذى له حياة وبه علة ؛ فله مادتان، تمده هذه مرة، وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له، والتوكل عليه: ما هو مادة حياته ، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، والحسد والكبر والعجب؛ وحب العلو والفساد فى الأرض بالرياسة : ما هو مادة هلاكه وعطبه . اهـ بتصرف يسير من كتاب (الجواب الكافي ) ، (ص: 121)
وكتاب (إغاثة اللهفان ) ، (1/ 7) .
** وفي كتاب ( شفاء العليل ) ، (ص: 106)
وقد ذكر سبحانه أنواع القلوب في قوله: { لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم }
** فذكر القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة الحق ،
** والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه فهذان القلبان شقيان معذبان.
** ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به . اهـ
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الثلاثاء 3 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(19) فائدة اليوم بعنوان : (( الأخافشة من النحويين ))
لفظ : ( الأخفش ) لقب لأحد عشر نحويا ، والمراد به عند الإطلاق : أبو الحسن سَعِيدُ بنُ مَسْعَدَةَ .
ففي كتاب ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) للسيوطي ، (2/ 386)
الأخفش أحدَ عَشَر نحويا :
أحدهم : الأخفش الأكبر أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد أحد شيوخ سيبويه .
والثاني: الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه .
مات سنة عشر ومائتين وقيل بعدها .
والثالث: الأخفش الأصغر أبو الحسن علي بن سليمان، من تلامذة المبرِّد وثعلب .
مات سنة خمس عشرة وثلثمائة .
والرابع: أحمد بن عمران بن سلامة الألهاني مصنف غريب الموطَّأ .
مات قبل الخمسين ومائتين .
والخامس: أحمد بن محمد الموصلي أحد شيوخ ابن جِنِّي، مصنف كتاب تعليل القراءات .
والسادس: خلف بن عمرو اليشكري البَلَنسي مات بعد الستين وأربعمائة .
والسابع: عبد الله بن محمد البغدادي من أصحاب الأصمعي .
والثامن: عبد العزيز بن أحمد الأندلسي من مشايخ ابن عبد البر .
والتاسع: علي بن محمد الإدْريسي .
مات بعد الخمسين وأربعمائة .
والعاشر: علي بن إسماعيل بن رجاء الفاطمي .
والحادي عشر: هارون بن موسى بن شريك القارىء .
مات سنة إحْدَى وسبعين ومائتين . اهـ
** ثم قال السيوطي في صـ ( 388 ) :
وحيث أطلق في كتب النحو الأخفش فهو الأوسط ، فإن أريد الأكبر أو الأصغر قَيَّدوه .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأحد 1 / 5 / 1438 هـ
والله الموفق .
(18) فائدة اليوم بعنوان : (( دوام الحال في هذه الدنيا من المحال ))
** قال الله تعالى :{ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ }
** وقال الله تعالى :{ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ }
** وفي تفسير القرطبي (4/ 218) :
(وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) قِيلَ: هَذَا فِي الْحَرْبِ، تَكُونُ مَرَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ لِيَنْصُرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دِينَهُ، وَمَرَّةً لِلْكَافِرِينَ إِذَا عَصَى الْمُؤْمِنُونَ لِيَبْتَلِيَهُمْ وَيُمَحِّصَ ذُنُوبَهُمْ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْصُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. وَقِيلَ:” نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ” مِنْ فَرَحٍ وَغَمٍّ وَصِحَّةٍ وَسَقَمٍ وَغِنًى وَفَقْرٍ. وَالدَّوْلَةُ الْكَرَّةُ، قَالَ الشَّاعِرُ:
فَيَوْمٌ علينا وَيَوْمٌ لَنَا * * * ويوم نساء ويوم نسر . اهـ بتصرف يسير
** وفي تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 300)
وَقَوْلُهُ: { وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً } أَيْ نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، فننظر مَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ، وَمَنْ يَصْبِرُ وَمَنْ يَقْنَطُ، كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
{ وَنَبْلُوكُمْ }يَقُولُ : نَبْتَلِيكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً :بِالشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، وَالصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَالْهُدَى وَالضَّلَالِ .
وقوله: وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ أي فنجازيكم بأعمالكم.
** وعَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» رواه مسلم .
** قال الشاعر:
ثمانية لابد منها على الفتى * * * ولابد أن تجري عليه الثمانية
سرور وهمٌّ واجتماع وفرقة * * * ويُسْر وعسر ثم سقم وعافية
** وقال الشاعر الآخر :
الدَّهْرُ لَا يَبْقَى على حَالهِ * * * لَا بُدَّ أَنْ يُقبِلَ أَو يُدْبِر
فإنْ أصِبتَ بمَكْرُوْهه * * * فاصْبِرْ فَإِنَّ الدَهْرَ لَا يَصْبر
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الخميس 27 / 4 / 1438 هـ
والله الموفق .
(17) فائدة اليوم بعنوان : (( كيفية إعراب أسماء الشرط والاستفهام ))
** جميع أسماء الشرط والاستفهام مبنية على حركة أو سكون ، فالحكم لمحلها على حسب موقعها ، ما عدا ” أيا ” فإنها معربة ، فيظهر أثر الإعراب على لفظها .
** وأما إعرابها فقال محمد بن عبد العزيز النجار في كتابه : ( ضياء السالك إلى أوضح المسالك) ، (4/ 45) :
** ومن المفيد أن نذكر هنا في إجمال كيفية إعراب أسماء الشرط والاستفهام فنقول :
1- إذا وقعت الأداة بعد حرف جر أو مضاف فهي في محل جر بالحرف أو بالإضافة نحو: (عمن تتعلم أتعلم ) ؛ و( كتاب من تقرأ أقرأ ) ، و (صفحة ما تكتب أكتب ) ،
** ولا تكاد الأداة تجر في غير هاتين الحالتين .
2- وإذا كان الأداة ظرفا للزمان أو المكان فهي في محل نصب على الظرفية لفعل الشرط إن كان تاما؛ نحو: متى يقبل الصيف يشتد الحر. وللخبر إن كان ناسخا. نحو: أينما تكن تجد تقديرًا لإخلاصك؛ فأينما ظرف متعلق بمحذوف خبر “تكن”
** وأدوات هذا النوع هي: متى، وأيان؛ للزمان. وأين، وأنى، وحيثما،؛ للمكان؛ وأي مضافة إلى الزمان أو المكان، كل حسب الحالة .
3- وإن دلت الأداة على حدث محض، فهي مفعول مطلق لفعل الشرط.
** وأداة هذا النوع؛ “أي” مضافة للمصدر؛ نحو: أي عمل تقدم للوطن تجز به خيرًا.
** أما إذا دلت على ذات؛ فإن كان فعل الشرط لازمًا، فهي مبتدأ خبره فعل الشرط على الأصح، وتوقف الفائدة على الجواب، إنما هو من حيث التعلق، لا من حيث الخبرية، وقيل: الجواب هو الخبر، وقيل: هما؛ نحو: من يسافر أسافر معه.
** وكذلك إن كان متعديًا ومفعوله أجنبي منها؛ نحو: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}
** وإن كان متعديًا مسلطًا عليها فهي مفعوله؛ نحو: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} ؛
** فإن سلط على ضميرها أو على ملابسه فاشتغال؛ نحو: من يكرمه محمد أكرمه، ومن يصاحب أخاه علي أصاحبه؛ فيجوز في “من” أن تكون مبتدأ، وأن تكون مفعولا لفعل محذوف يفسره فعل الشرط،
** وأدوات هذا النوع: من، وما، ومهما، وأي مضافة إلى اسم ذات.
** ويتبين مما تقدم:
** أن متى وأيان، يدلان على الزمان؛ فكلاهما ظرف زمان جازم.
** وأين، وأنى، وحيثما، تدل على المكان،
** ومن، وما، ومهما غير ظروف،
** أما “أي” فبحسب ما تضاف إليه؛ فإن أضيفت إلى زمان فزمان أو إلى مكان فمكان أو إلى غيرهما فغير ظرف.
** أما “إن” و”إذ ما” فلتعليق الجواب على الشرط تعليقًا مجردًا من غير دلالة على زمان أو مكان أو غيرهما، وتفيدان الشك والظن .
** كما أن ” إذا ” الشرطية تفيد الأمر المتقين غالبًا،
** و”كيفما” تدل على الحال .اهـ
(( تنبيه )) :
لم يمثل النجار لأدوات الاستفهام ، ونحن نمثل لها على ترتيبه تتميما للفائدة فنقول :
** مثال الاستفهام المجرور محلا قولك : ( على من سلمت ؟ ) ، و ( غلام من ضربت ؟ ) .
** ومثال الاستفهام المنصوب على الظرفية ، أو على الخبرية للناسخ قولك: ( متى سافرت ؟ )، و ( أين جلست ؟ ) ، و ( أين كان زيد ).
** ومثال الاستفهام المنصوب على المفعولية المطلقة قولك : ( أي ضرب ضربت ؟ ) .
** ومثال الاستفهام المرفوع محلا على أنه مبتدأ لكون الفعل الذي بعده لازما أو متعديا وأخذ مفعوله قولك : ( من سافر ؟ ) ، و ( من أكرم زيدا ؟ ) .
** ومثال الاستفهام المنصوب محلا على أنه مفعول به لكون الفعل الذي بعده متعديا ووقع عليه قولك : ( من أكرمت ، وما قرأت ؟).
** ومثال الاستفهام المرفوع محلا على أنه مبتدأ ، أو على أنه منصوب على الاشتغال قولك : ( من ضربته ؟ ) ، أو ( من ضربت أخاه ؟ ).
** ومثال الاستفهام في (كيفما) قولك : كيف زيد ؟ )
فـ( كيف ) خبر مقدم وجوبا ، و ( زيد ) مبتدأ مؤخر ) .
** وانظر كتاب : ( مغني اللبيب )، (ص: 607)
وكتاب : ( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) ، (2/ 566)
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأربعاء 27 / 4 / 1438 هـ
والله الموفق .
(16) تنقسم أدوات الشرط الجازمة من حيث اتصال ( ما( بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام :
** الأول : ما لا يجزم إلا متصلا بها ، وهو اثنان : ( حيث وإذ ) .
** الثاني : ما لا يجزم إلا منفصلا عنها ، وهو أربعة : ( من ، و ما ، و مهما ، و أنى ) .
** الثالث : ما يجوز فيه الأمران الاتصال والانفصال ، وهو خمسة : ( إن، و أي، و متى، و أين ، و أيان ) .
** وقد نظمها بعضهم فقال :
قد لزمت ( ما ) حيثما وإذما * * * وامتنعت في من وما ومهما
كذاك في أنى وباقيها أتى * * * وجهان إثبات وحذف ثبتا
(15) فائدة اليوم بعنوان : ( من الدين التحذير من أهل الباطل بأسمائهم عند الحاجة , وعلى حسب القدرة )
** قال تعالى : {فَقُلْنَا ياآدَمُ إِنَّ هَـذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ} يعني بالعدو إبليس.
** عن أَبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ: سمعت رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم – جِهَاراً غَيْرَ سِرٍّ، يَقُولُ: « إِنَّ آلَ أَبِي – قَالَ عَمْرٌو: فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ – لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، واللفظ للبخاري.
** شرح النووي على مسلم (3/ 87)
هَذِهِ الْكِنَايَةُ بِقَوْلِهِ : ( يَعْنِي فُلَانًا ) هِيَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ خَشِيَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ وَفِتْنَةٌ ، إِمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَإِمَّا فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ فَكَنَى عَنْهُ ،
وَالْغَرَضُ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ .
وَمَعْنَاهُ إِنَّمَا وَلِيِّيَ مَنْ كَانَ صَالِحًا وَإِنْ بَعُدَ نسبه مِنِّي وَلَيْسَ وَلِيِّي مَنْ كَانَ غَيْرُ صَالِحٍ وان كان نسبه قريبا
قال القاضي عياض رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قِيلَ إِنَّ الْمُكَنَّى عَنْهُ ها هنا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
** فتح الباري لابن حجر (1/ 331)
قَالَ أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ : المُرَاد آل أبي طَالب ، وَمعنى الحَدِيث : أَنِّي لَا أخص قَرَابَتي وَلَا فصيلتي الأدنين دون الْمُؤمنِينَ .
وَقَالَ غَيره : المُرَاد آل أبي الْعَاصِ بن أُميَّة . اهـ
** ومن كتاب ( لسان الميزان ) ، (2/ 363)
قال يحيى بن معين : كذاب زماننا أربعة :
الحسين بن عبد الأول وأبو هشام الرفاعي وحميد بن الربيع والقاسم بن أبي شيبة .
** ومن كتاب تاريخ دمشق (53/ 81)
قال النسائي : محمد بن سعيد الشامي متروك الحديث .
والكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعة:
ابن أبي يحيى بالمدينة ، والواقدي ببغداد ، ومقاتل بن سليمان بخراسان ، ومحمد بن سعيد بالشام يعرف بالمصلوب
** وللّه تعالى در القائل :
مِنْ الدِّينِ كَشْفُ السِّتْرِ عَنْ كُلِّ كَاذِبٍ * * * وَعَنْ كُلِّ بِدْعِيٍّ أَتَى بِالْعَجَائِبِ
فَـلَـوْلَا رِجَـالٌ مُـؤْمِـنُـونَ لَـهُدِّمـَتْ * * * صَوَامِعُ دِينِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
السبت 23 / 4 / 1438 هـ
والله الموفق .
(14) فائدة اليوم بعنوان : ( أنواع الصبر , ومراتب أصحابه )
الصبر : ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. وَصَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. وَصَبْرٌ عَلَى أقدار اللَّهِ .
وينقسم باعتبار أخر إلى أنواع أخرى :
** منها : الصَّبْرُ بِاللَّهِ : وهو صَبْرُ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ، وَرُؤْيَتُهُ أَنَّهُ هُوَ الْمُصَبِّرُ، وَأَنَّ صَبْرَ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ لَا بِنَفْسِهِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} يَعْنِي إِنْ لَمْ يُصَبِّرْكَ هُوَ لَمْ تَصْبِرْ.
** وَمنها : الصَّبْرُ لِلَّهِ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الصَّبْرِ مَحَبَّةَ اللَّهِ، وَإِرَادَةَ وَجْهِهِ. وَالتَّقَرُّبَ إِلَيْهِ. لَا لِإِظْهَارِهِ قُوَّةَ النَّفْسِ، وَالِاسْتِحْمَادَ إِلَى الْخَلْقِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْرَاضِ.
** وَمنها : الصَّبْرُ مَعَ اللَّهِ : وَهُوَ دَوَرَانُ الْعَبْدِ مَعَ مُرَادِ اللَّهِ الدِّينِيِّ مِنْهُ. وَمَعَ أَحْكَامِهِ الدِّينِيَّةِ .
** وَهذه الأنواع الثلاثة كلها محمودة .
** ومنها : الصَّبْرُ عن الِلَّهِ ، وهو صبر المعرضين المحجوبين عن الله ، فالصبر عن المحبوب أقبح شيء وأسوؤُه، وهو الذى يسقط المحب من عين محبوبه، فإن المحب كلما كان أَكمل محبة كان صبره عن محبوبه متعذراً .
** قال الشاعر
والصبر عنك فمذموم عواقبه * * * والصبر في سائر الأشياء محمود
** وقال آخر :
والصبر يحمد في المواطن كلها * * * إلا عليك فإنه لا يحمد
** وهذ الصبر مذموم ، وهو أقبح أَنْوَاعٍ الصَّبْرُ وأشده .
قال ابن القيم في كتابه ( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) ، (ص: 44)
فالمذموم: الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذى لا حياة له بدونه البتة كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب لزهده “ما رأيت أزهد منك! ” فقال: “أنت أزهد منى أنا زهدت في الدنيا وهى لا بقاء لها ولا وفاء وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منا”
** قال يحيى بن معاذ الرازى “صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين واعجبا كيف يصبرون! ” اهـ
** وأما مَرَاتِبُ الصَّابِرِينَ فهي خَمْس : صَابِرٌ ، وَمُصْطَبِرٌ ، وَمُتَصَبِّرٌ ، وَصَبُورٌ ، وَصَبَّارٌ ،
** فَالصَّابِرُ: أَعَمُّهَا،
** وَالْمُصْطَبِرُ: الْمُكْتَسِبُ الصَّبْرَ الْمَلِيءُ بِهِ.
** وَالْمُتَصَبِّرُ: الْمُتَكَلِّفُ حَامِلٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ.
** وَالصَّبُورُ: الْعَظِيمُ الصَّبْرِ الَّذِي صَبْرُهُ أَشَدُّ مِنْ صَبْرِ غَيْرِهِ.
** وَالصَّبَّارُ: الْكَثِيرُ الصَّبْرِ. فَهَذَا فِي الْقَدْرِ وَالْكَمِّ. وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي الْوَصْفِ وَالْكَيْفِ.
اهـ بتصرف مع زيادة من كتاب ( مدارج السالكين ) (2/ 156 ، وما بعدها ) .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الخميس 21 / 4 / 1438 هـ
والله الموفق .
(13) فائدة اليوم بعنوان : ( أسماء الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين من حيث كونها عربية أو عجمية , مصروفة وغير مصروفة ) :
** أسماء الأنبياء والمرسلين كلها أعجمية إلا أربعة ، وهم : هودٌ وشعيبٌ وصالحٌ ومحمدُ ، عليهم الصلاة والسلام .
** و أسماء الملائكة المكرمين كلها أعجمية إلا أربعة ، وهم : رضوانُ ومالكٌ ونكيرٌ و منكرٌ عليهم السلام .
** وقد نظمها بعضهم في قوله :
هودٌ شعيبٌ صالحٌ محمدُ * * * أوضاعها في العجم ليست توجدُ
رضوانُ مالكٌ نكيرٌ منكرُ * * * أمثالها في الحكم ما قد ذكروا
** لكن اسم ( رضوان ) ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون ، بخلاف بقية الأربعة فإنها مصروفة .
** وأسماء النبيين كلها ممنوعة من الصرف ؛ للعلمية والعجمة إلا سبعة ، مجموعة في قولك : ( صن شمله )
فالصاد: لصالح ، والنون : لنوح ، والشين : لشعيب ، وشيث ، والميم : لمحمد ، واللام : للوط ، والهاء : لهود .
** وقد نظمها بعضهم بقوله :
أَلَا إِنَّ أَسْمَاءَ النَّبِيِّيْنَ سَبْعَةٌ * * * لَهَا الصَّرْفُ فِيْ إِعْرَابِ مَنْ يَتَنَشَّدُ
فَشِيْثٌ وَنُوْحٌ ثُمَّ هُوْدٌ وَصَالِحٌ * * * شُعَيْبٌ وَلُوْطٌ وَالنَّبِيُّ مُحَمَّدُ
فهذه السبعة مصروفة ؛ لأن أربعة منها عربية : وهم :
محمد، وصالح، وشعيب، وهود . كما تقدم ،
وثلاثة منها أعجمية ، ولكنها صرفت لخفتها بكونها ساكنة الوسط، وهم :
نوح ، ولوط ، وشيث ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
** ونَظَمَهَا بَعْضُهُمْ في بيت واحد فَقَالَ :
تذكّر شعيبًا ثم نوحًا وصالحاً * * * وهودًا ولوطًا ثم شيثًا محمدا
( تنبيه ) :
لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فيما أعلم – أن ( شيثا ) كان نبيا ، وأن اسم خازن الجنة ( رضوان ) .
وأما ( منكر ، ونكير ) فهما اسمان ثابتان للملكين الموكلين بسؤال الميت كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا قُبِرَ المَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَلِلْآخَرِ: النَّكِيرُ ، . . . ) الحديث الترمذي برقم :(1071) [وحسنه الألباني] .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الإثنين 18 / 4 / 1438 هـ
والله الموفق .
(12) فائدة اليوم بعنوان : ( العشرة المبشرون بالجنة ) :
** عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
” أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ ”
رواه أحمد وغيره [وصححه الألباني]
** وعَنْ سَعِيد بْن زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَشَرَةٌ فِي الجَنَّةِ : أَبُو بَكْرٍ فِي الجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ.
قَالَ: فَعَدَّ هَؤُلاَءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ العَاشِرِ،
فَقَالَ القَوْمُ: نَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا الأَعْوَرِ مَنِ العَاشِرُ؟ قَالَ: نَشَدْتُمُونِي بِاللَّهِ، أَبُو الأَعْوَرِ فِي الجَنَّةِ . رواه الترمذي وغيره ، [وصححه الألباني]
وأَبُو الأَعْوَرِ هُوَ: سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ .
** وقد نظمهم الإمام الشريف السيد الحافظ محمد بن إبراهيم بن المرتضى الملقب بابن الوزير في كتابه : (الروض الباسم ) (1/ 133)
فقال :
للمصطفى خير صحب نص أنهم *** في جنة الخلد نصا زادهم شرفا
هم طلحة وابن عوف والزبير كذا *** أبو عبيدة والسعدان والخلفا.
** ومن كتاب ( أبيات جمع الشتات ) – (1 / 5)
العشرة المبشرون بالجنة :
جمع بعض فضلاء الشعراء العشرة رضي الله عنهم في بيتين فقال:
عليٌّ والثلاثة وابن عوف *** وسعد منهم وكذا سعيد
كذاك أبو عبيدة فهو منهم *** وطلحة والزبير ولا مزيد
** وفي كتاب : «الرياض المستطابة» للعامري (ص/19) قال :
ونظم أسماءهم الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال :
لقد بشر الهادي من الصحب عشرة *** بجنات عدن كلهم قدره علي
عتيق سعيد سعد عثمان طلحة *** زبير ابن عوف عامر عمر علي
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
السبت 16 / 4 / 1438 هـ
والله الموفق .
(11) فائدة اليوم بعنوان : ( المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم أربعة لا خامس لها ) :
** الموضع الأول : في سورة ( ص ) ،
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص وَقَالَ :
« سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا »
** الموضع الثاني : في سورة ( النجم ) ،
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا – يَعْنِي النَّجْمَ – وَالمُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ» رواه الترمذي وغيره [وصححه الألباني] :
** الموضع الثالث : في سورة ( الانشقاق ) ،
لحديث أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَرَأَ لَهُمْ «إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا» متفق عليه
** الموضع الرابع : في سورة ( العلق ) ،
لحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ » رواه مسلم .
( تنبيه ) : سجود التلاوة مستحب في هذه المواضع وفي غيرها ، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ – وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ ” .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الخميس 14 / 4 / 1438 هـ
والله الموفق .
(10) فائدة اليوم بعنوان : ( المكلفون من الجن والأنس على ثلاث طبقات )
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسيرجزء عم (ص: 207) :
والبشر طبقاته ثلاث: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون، وكل هذه الطبقات مذكورة في سورة الفاتحة { اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين } .
الطبقة الأولى: الذين أنعم الله عليهم وهم: النبيون، والصديقون، والشهداء، والصالحون.
والثانية: {المغضوب عليهم} وهم اليهود وأشباه اليهود من كل من علم الحق وخالفه، فكل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة ـ رحمه الله ـ: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود.
والثالثة: {الضالون} وهم النصارى الذين جهلوا الحق، أرادوه لكن عموا عنه، ما اهتدوا إليه، قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى؛ لأن العبّاد يريدون الخير يريدون العبادة لكن لا علم عندهم، فهم ضالون .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأربعاء 13 / 4 / 1438 هـ
والله الموفق .
(9) فائدة اليوم بعنوان : ( النوافل التي يستحب فيها قراءة سورتي الكافرون والإخلاص )
** أولا : ركعتا الفجر :
لحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ” صحيح مسلم (1/ 502)
** ثانيا : ركعتا الطواف خلف المقام :
لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا “
رواه النسائي وغيره وصححه الألباني ، وأصله في صحيح مسلم .
** ثالثا : ركعتا الْمَغْرِبِ البعدية :
لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: « رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَرَّةً، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» رواه النسائي وغيره ، وحسنه الألباني
** رابعا : ركعتا الوتر الأخيرتان :
لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» سنن النسائي وغيره ، وصححه الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله .
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الثلاثاء 12 / 4 / 1438 هـ
والله الموفق .
(8) فائدة اليوم بعنوان : ( ثلاث نعم عظمية يجهل قدرها كثير من الناس )
** عن عُبيْدِ الله بنِ محْصن الأَنصَارِيِّ الخطميِّ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً في سربِهِ، مُعَافَىً في جَسَدِهِ،
عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا» . رواه الترمذي وغيره .
[وحسن الألباني كما في صحيح الجامع , برقم : 6042]
** ومن كتاب ( فيض القدير ) ، (6/ 68)
[قوله] : (من أصبح منكم آمنا في سربه) بكسر السين على الأشهر أي في نفسه وروي بفتحها أي في مسلكه وقيل بفتحتين أي في بيته
[قوله] : (معافى في جسده) أي صحيحا بدنه
[قوله] : (عنده قوت يومه) أي غذاؤه وعشاؤه الذي يحتاجه في يومه ذلك .
يعني من جمع الله له بين عافية بدنه ، وأمن قلبه حيث توجه ، وكفاف عيشه بقوت يومه ، وسلامة أهله فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها ، فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها بأن يصرفها في طاعة المنعم لا في معصية ولا يفتر عن ذكره
[قوله] : (فكأنما حيزت) بكسر المهملة
[قوله] : (له الدنيا) أي ضمت وجمعت
[قوله] : (بحذافيرها) أي بجوانبها أي فكأنما أعطي الدنيا بأسرها .
** ومن ثم قال نفطويه:
إذا ما كساك الدهر ثوب مصحة * * * ولم يخل من قوت يحلى ويعذب
فلا تغبطن المترفين فإنه * * * على حسب ما يعطيهم الدهر يسلب اهـ المراد
** ومن كتاب (معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (5/ 2152) :
قال: غانم بن وليد النحوي لنفسه :
ثلاثة يجهل مقدارها … الأمن والصحة والقوت
فلا تثق بالمال من غيرها … لو أنه درّ وياقوت
** ومن كتاب ( رحيق الشعر) ، (ص: 278)
** وقال ابن طباطبا:
ألا إنما الدّنيا كفاف و صحة … و أمن ، ثلاث هنّ طيب حياتي
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الإثنين 11 / 4 / 1438 هـ
(7) فائدة اليوم بعنوان : ( معرفة أنواع البناء والإعراب )
** أنواع البناء أربعة : الضم ، والفتح ، والكسر ، والسكون .
** وأنواع الإعراب أربعة : الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم
** والكوفيون لا يفرقون بينهما , فيطلقون هذا على هذا , وهذا على هذا .
** وفي حاشية الخضري على ابن عقيل (1/ 86)
وأنواعه [ يعني البناء ] تسمى عند البصريين ضماً وفتحاً وكسراً وسكوناً.
. . . وأنواع الإعراب تسمى بالرفع وأخواته.
** والكوفيون لا يفرقون بين أسمائهما .
** ولقد أحسن من نظم ألقابهما بقوله:
لَقَدْ فتحَ الرحمنُ أَبْوَابَ فَضْلِهِ *** ومَنَّ بِضَمِّ الشَّملِ فانجبَرَ الكَسْرُ
وَمَن سَكَّنَ القَلْبَ انْتَصَبْتُ لِشُكْرِهِ *** لِجَزْمِي بأنَّ الرَّفعَ قَدْ جَرَّهُ الشُّكْرُ
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأحد 10 / 4 / 1438 هـ
(6) فائدة اليوم بعنوان :(فضل العلماء ومعرفة حقهم من الإجلال والاحترام):
** قَالِ اللَّهِ تَعَالَى ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )
** وقال تعالى : ( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) .
** وعَنِ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
” مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ “. متفق عليه
** وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مِنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حقه “.
رواه الأمام أحمد وغيره , وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع برقم ( 5443 )
** وفي كتاب ( أخلاق العلماء ) (ص 20).
قال الحسن البصري -رحمه الله-: «لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم » اهـ
أي : أنهم بالتعليم يُخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية .
وفي كتاب ( الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام ) (ص: 199)
قال الشاعر:
أفضِّل أستاذي على فَضْل والدي * * * وإن نالني من والدي المجدُ والشرفْ
فهذا مُرَبِّي الروحِ والروحُ جوهرٌ * * * وذاك مربي الجسمِ والجسمُ كالصدف
** وفي كتاب ( كيف تحفظ العلم ) (ص: 30)/ لأبي حسام الدين الطرفاوي
** وأنشد الأزدي :
وقِّر مشائخ أهل العلم قاطبة * * * حتى تُوقَّرَ إن أفضى بك الكبرُ
واخدم أكابرهم حتى تنال به * * * مثلاً بمثلٍ إذا ما شارف العُمُرُ
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
السبت 9 / 4 / 1438 هـ
(5) فائدة اليوم بعنوان :(( أول واضع لعلم النحو (على المشهور) )):
** قال الأزهري في شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو (1/ 5)
( . . . وقد تضافرت الروايات على أن أول من وضع النحو أبو الأسود، وأنه أخذه أولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، . . .) اهـ المراد
** وفي كتاب : ( بغية الوعاة ) , (2/ 210)
في ترجمة عَليّ بن مُؤمن بن مُحَمَّد بن عَليّ أَبُو الْحسن بن عُصْفُور النَّحْوِيّ الْحَضْرَمِيّ الإشبيلي أنه لما مات رثاه القَاضِي نَاصِر الدّين بن الْمُنِير بقوله :
(أسْند النَّحْو إِلَيْنَا الدؤَلِي * * * عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ البطل)
(بَدَأَ النَّحْو عَليّ وَكَذَا * * * قل بِحَق ختم النَّحْو عَليّ)
فـ (علي) الأول هو : أمير المؤمنين رضي الله عنه .
و(علي) الثاني هو : ابن عصفور .
** قال شيخنا علامة اليمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة الأبرار , في كتابه القيم : (( إرشاد ذوي الفطن , ص ( 66) )) :
نسبة علم النحو إلى علي رضي الله عنه تحتاج إلى سند صحيح , ولا يكفي نسبة بعض النحويين له إلى علي رضي الله عنه .
. . .
قال أبو عبد الرحمن : ليست نسبة وضع علم النحو إلى علي متفق عليها ,
ففي ( نزهة الألباء ص 40 ) : أن عمر الذي أمر أبا الأسود ,
وفيها أيضا أن أبا الأسود أخذ النحو عن علي ,
وفيها أيضا ص (9) : أن زياد هو الذي أمر أبا الأسود ,
وهكذا إلى آخر ما هنالك ,
وليست هناك أسانيد حتى ينظر في الترجيح . اهـ المراد
كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
الأربعاء 6 / 4 / 1438 هـ
(4) فائدة اليوم بعنوان : ( فضل الاستشارة وصفة المستشار )
** للاستشارة قدر كبير وأهمية عظيمة في الوصول إلى سداد الرأي وصواب القرار، ولهذا كانت من صفات العقلاء وسمات الفضلاء حرصا على إصابة الحق ومجانبة الزلل .
** وقديما قيل: ما خاب من استخار، وما ندم من استشار .
** وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين لتخلقهم بهذا الخلق العظيم، فقال عز وجل: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} ،
** وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فقال عز وجل: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} .
** وعن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المستشار مؤتمن. رواه ابن ماجة . [حكم الألباني] : (صحيح)
** وفي كتاب ( فيض القدير شرح الجامع الصغير) -المناوي – (5 / 442)
وقال بعضهم :
إذا عز أمر فاستشر فيه صاحبا * * * وإن كنت ذا رأي تشير على الصحب
فإني رأيت العين تجهل نفسها * * * وتدرك ما قد حل في موضع الشهب
** وقال آخر في صفة المستشار :
خصائص من تشاوره ثلاث * * * فخذها من لساني بالوثيقة
ودادٌ خالص ووفور عقل * * * ومعرفة بحالك بالحقيقة
كتبها : أبو عبد الله النقذي الجعدي
الأربعاء 6 / 4 / 1438 هـ
تنبيه : عدل شيخنا العبدلي رحمه الله تعالى البيت الثاني بقوله ) : فدين صالح )
(3) فائدة اليوم بعنوان : ( الأقربون أحق الناس بالمعاملة الحسنة )
** عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “خَيْرُكُمْ خيركم لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي” (ت) حكم الألباني [صحيح لغيره].
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره/ ط العلمية (2/ 212)
وَكَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمِيلُ الْعِشْرَةِ دَائِمُ الْبِشْرِ، يُدَاعِبُ أَهْلَهُ، وَيَتَلَطَّفُ بِهِمْ ويُوسِعُهُمْ نَفَقَتَهُ، وَيُضَاحِكُ نِسَاءَهُ حَتَّى إِنَّهُ كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يَتَوَدَّدُ إِلَيْهَا بِذَلِكَ، قَالَتْ: سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَحْمِلَ اللَّحْمَ، ثُمَّ سَابَقْتُهُ بَعْدَ مَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ «هَذِهِ بِتِلْكَ» . . . الخ . اهـ
** وقال الإمام الشوكاني في كتابه : (نيل الأوطار) (6/ 246):
( . . . فَإِنَّ الْأَهْلَ هُمْ الْأَحِقَّاءُ بِالْبِشْرِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالْإِحْسَانِ وَجَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضُّرِّ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ فَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنْ الشَّرِّ، وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشحهم نفسا وأقلهم خيرا وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق نسأل الله السلامة ) . اهـ
** ومن كتاب ( الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة ) (ص: 33)
** قال الأمير أبو الفضل الميكالي :
كم والد يحرم أولاده * * * وخيره يحظى به الأبعد
كالعين لا تبصر ما حولها * * * ولحظها يدرك ما يبعد
** ومثله لبعضهم:
من الناس من يغشى الأباعد نفعه * * * ويشقى به حتى الممات أقاربه
فإن كان خيرا فالبعيد يناله * * * وإن كان شرا فابن عمك صاحبه
** تنبيه :
حديث ” الأقربون أولى بالمعروف “.
** لا أصل له بهذا اللفظ.
كما أشار إليه السخاوي في ” المقاصد ” (ص 34) ،
** وبعضهم يتوهم أنه آية!
وإنما في القرآن قوله تعالى {قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين} . اهـ من سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 555) رقم 376
كتبها : أبو عبد الله النقذي الجعدي
الثلاثاء 5 / 4 / 1438 هـ
(2) فائدة اليوم بعنوان : ( دعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن حفظ حديثه وبلغه غيره )
** عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ» ( د ) ، [حكم الألباني] : صحيح
** هذا الحديث من الأحاديث المتواترة ،
** وقد روي بألفاظ مختلفة متقاربة .
وجاء عن نحو ثلاثين صحابياً، منهم وابن مسعود , وجبير بن مطعم , وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم جميعا .
** قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي (2/ 630) تحت : ( النوع الثلاثون المشهور من الحديث )– وهو يسرد الأحاديث المتواترة – :
وَحَدِيثُ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي» مِنْ رِوَايَةِ نَحْوِ ثَلَاثِينَ . اهـ المراد
** وفي شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: 20)
قَوْلُهُ : ” نضر “ بفتح الضاد المعجمة، روى مخففاً ومشدداً، وهو الأكثر من النضارة، وهي حسن الوجه وبريقه، كما قال بعضهم:
من كان من أهل الحديث فإنه *** ذو نضرة في وجهه نور سطع
إن النبي دعا بنضرة وجه من *** أدى الحديث كما تحمل واستمع
كتبها : أبو عبد الله النقذي الجعدي
الإثنين 4 / 4 / 1438 هـ
(1) فائدة اليوم : بعنوان ( من آداب الدعاء رفع اليدين تضرعا وتذللا )
** عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“إنَّ الله حَيِيٌّ كريم، يَسْتَحي إذا رَفع الرجلُ إليه يدَيه أن يردَّهما صِفْراً خائبتين”.
رواه أبو داود والترمذي، وحسنه -واللفظ له-، وابن ماجه، وابن حبان في “صحيحه”، والحاكم وقال: “صحيح على شرط الشيخين”.
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/ 278)
(الصِّفْر) بكسر الصاد المهملة وإسكان الفاء: هو الفارغ.
**وفي كتاب (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين بالدعاء)(ص:102) للسيوطي .
قال رحمه الله : وَقد قلت شعرًا :
ارْفَعْ يَديك إلى الرَّحْمَن مبتهلا *** واسأل سُؤال ذليل بالبكا ضرعا
فَالله أكْرم من يُرْجَى وَأعظم أَن *** يرد باليأس من كفا لَهُ رفعا
أبو عبد الله النقذي الجعدي
الأحد 26 / 3 / 1438 هـ